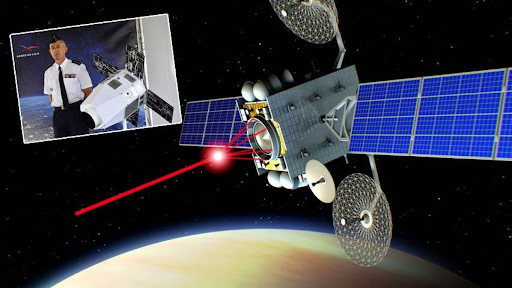
في سياق المتغيرات العالمية في السنوات الخمسين المنقضية، برزت ظواهر سلبية كثيرة تمثلت في تراجع الأحزاب والنقابات وسطوة المضاربات المالية والمال الغاشم وتغول الأجهزة الأمنية وصناعة التجسس.
١ – تراجع الأحزاب والنقابات..
صعود وانتشار الإعلام وتقنياته المتعددة وهيمنة المال ورجالاته في عالم السياسة إضافة إلى صعود صاروخي للأنانيات وتضخم الذات وغلبة المصالح والحاجة إلى التمويل وتغطية مصاريف العمل؛ كل ذلك أدى إلى خفوت صوت ودور الأحزاب والنقابات في كل بلاد العالم تقريبا وتراجع تأثيرها حتى باتت جزءً من الديكور الشكلي المصاحب لأنظمة الحكم القائمة وانقساماتها الوظيفية والمصلحية؛ والمرتهن لها. فبعد أن كان دورها فاعلا في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين وما قبلها لعدة عقود خلت، وكان استمرارا متصاعدا لدورها النشط منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ بهتت وتهافت منطقها وشاخت رموزها حتى ذبلت وانزوت.
فمن جهة وقعت فريسة حاجتها إلى المال لتشغيل ماكيناتها الحزبية ومصاريفها المتزايدة؛ فمدت يدها إلى من يملك المال ولم يكن هذا متوفرا إلا في مؤسسات الأنظمة والسلطات النافذة؛ أو لدى رجال الأعمال الأثرياء المرتبطين -مصلحيا على الأقل – بالأنظمة أو السلطات والسلاطين والأجهزة؛ المخفي منها والمكشوف. ومن جهة ثانية وقعت ضحية حاجتها للإعلام ليغطي أنشطتها ويتحدث عنها ويبرز رموزها فيما الإعلام تملكه إما السلطات النافذة ذاتها أو رجال المال والإعلام وجميعهم يشكلون دائرة متكاملة الحلقات في منهج إلحاقي متجانس لا يتقبل استقلالية رأي ولا يسمح باستقلالية حركة أو إرادة سياسية بمعزل عن مصالحه الاقتصادية والمادية.
ولم تكن إلا برهة قصيرة في عمر الزمن حتى وجدت الأحزاب والنقابات ذاتها أسيرة حدود النفوذ والتأثير اللذين يصنعهما المال والإعلام والسلطة. ففقدت استقلاليتها وبهت تأثيرها وصار ما يشبه الألواح الخشبية أو تحركها أدمغة ببغاوية مقلدة.
يكفي أن نتنبه ونعي هذه الظاهرة السلبية لندرك بعض نتائجها المؤذية للمجتمعات الإنسانية عامة، فقد أسفرت عن استفراد المؤسسة الرأسمالية العملاقة وأذرعها الأخطبوطية بالإنسان المعاصر؛ تتلاعب به وتشكل له وعيه وفق ما تقتضيه مصالحها ورؤاها وتتحكم بإرادته وتسيره لما تريد وترغب. حيث بات وحيدا أمام تغولها المفرط في وحشيته؛ لا يملك من المعرفة والعلم ووضوح الرؤية إلا ما تزوده به هي ذاتها. فلا أحزاب تدافع عنه أو تحمي وعيه أو تفسر له خلفيات الأحداث بما يكشف المصالح القابعة وراءها تحركها وتؤثر فيها. ولا نقابات تدافع عن حقوقه ومكتسباته في مواجهة الجشع الرأسمالي الذي أضحى متوحشا بل مفترسا.
وكان هذا سببا آخر أضاف إلى وحشية النظام الرأسمالي العالمي، مزيدا من أسباب استفراد الإنسان والسيطرة عليه والتحكم به…
(يتفاوت هذا التراجع من بلد لآخر حيث لا يزال بعضها ينشط ويتمتع ببعض التأثير والفعالية النسبية المحدودة..)
٢ – استرداد المكتسبات الشعبية المطلبية:
يحصل هذا في بلدان العالم المتقدم حيث حققت النضالات الشعبية خلال القرن العشرين مكتسبات حقيقية كثيرة انتزعتها انتزاعا بقوة الضغط الشعبي
بوسائل نضالية شعبية ليست كلها سلمية..
فبعد أن سادت في الخطاب العالمي مفاهيم العدل الاجتماعي والرعاية والتنمية وتكافؤ الفرص كجزء متمم لدعوات التحرر الوطني والديمقراطية الاجتماعية ، لا سيما خلال حقبة خمسينات وستينات القرن العشرين المنصرم ، استعاد نظام القهر الرأسمالي الفردي المادي الاستهلاكي زمام الهجوم منذ أواسط سبعينات ذلك القرن الحافل بالمتغيرات حيث غياب القيادات التاريخية لعدم الانحياز وتراجع حركات التحرر ومطالبات العدالة في أغلب بلاد العالم لا سيما في المنطقة العربية وعموم العالم الثالث ؛ ثم خفوت صوت الإتحاد السوفييتي والدول ” الاشتراكية ” وشيخوخة خطابها الداعم لحركات التحرر العالمية … خلت الساحات العالمية من تلك القوى الشعبية ذات الآفاق الإنسانية القادرة على مواجهة مد العولمة الرأسمالية الصاعدة بقوة وبإصرار على الاستفراد والهيمنة…وفي تلك الأجواء ، راحت أنظمة الحكم في كل مكان ولا سيما في بلدان العالم المتقدم تمارس ضغوطا اقتصادية وثقافية وأمنية مصحوبة بحروب إعلامية ونفسية تستهدف ليس فقط مصادرة إمكانيات الحركات الشعبية في المواجهة ؛ وإنما هدفت إلى استرجاع ما حققته تلك الحركات من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتشريعية خلال عقود سابقة ؛ فنجحت أنظمة الحكم تلك في غضون أقل من عقدين في تغيير كثير من قوانين العمل والضمانات والرعاية وتشريعاتها واستبدلتها بقوانين السوق والمضاربة والاحتكار وما رافقها من استغلال واحتكار وفساد..
حتى أنها تمكنت من إفراغ الديمقراطية السياسية من محتواها الحقيقي محولة إياها إلى شكل تمارسه أحزاب السلطة بانتخابات دورية تتحكم بها القوى التي تملك المال والإعلام. ففقدت القوى الشعبية حتى قدرتها على اختيار ممثليها في السلطة بحرية وكفاءة..
مما فتح الأبواب مشرعة لتنامي تكدس الأموال في جانب وتكدس الفقر والجوع والبطالة في جانب مقابل وتضخمت الفوارق الاجتماعية بين الناس في كل المجتمعات الإنسانية..
وفي الوقت الذي استشعرت الحركات والقوى الشعبية استهداف مكاسبها وحقوقها من قبل سلطات الحكم بعد صعود وتغول نهج الخصخصة الرأسمالية منذ أوائل سبعينات القرن العشرين ( كانت مارغريت تاتشر رئيسة حكومة بريطانيا منطلق ذلك الصعود الرأسمالي وتلاها إيصال رونالد ريغان لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية ) ؛ راحت تحاول الاحتفاظ بمكاسبها ؛ لكنها كانت قد فقدت كثيرا من عوامل قوتها التي تمكنت من خلالها وبفضلها ، من انتزاع تلك المكاسب ، مما جعلها تتراجع أمام ضغط قوانين الخصخصة الرأسمالية الزاحفة إليها ، وكان أن تم تغيير كثير من قوانين العمل والرعاية والتأمينات الاجتماعية والضمان ؛ لصالح السلطات الحاكمة على حساب الفئات والقوى الشعبية. مرة أخرى تفاوتت هذه التغييرات من بلد لآخر حيث لا تزال بعض الدول الأوروبية تحديدا تقدم الكثير من تلك التأمينات لفئات اجتماعية متنوعة ..
٣ – سطوة الأجهزة الأمنية:
شكلت حاجة الدولة الحديثة إلى أجهزة أمنية بوظائفها المتعددة، سمة من سمات السياسة المعاصرة.. فمع تزايد وتيرة الصراعات والمنافسات الدولية والحروب وتطور صناعة الأسلحة وتقنيات التخابر والاتصال والتسجيل؛ صار التجسس صناعة مستقلة قائمة بذاتها لها أسسها ومؤسساتها وأدواتها الكثيرة وتفرعاتها..
كما زادت ضرورات المنافسة الاقتصادية، الحاجة إلى صناعة التجسس ما أدى إلى تخصيصها بميزانيات إضافية ضخمة ومهمات مستجدة..
وكان العامل الأبرز في تدعيم دور الأجهزة الأمنية وتزايد تأثيرها ؛ اعتماد السياسة المعاصرة على الكذب والخداع والمراوغة ؛ واقترابها من التعبير عن المصالح الاقتصادية وليس عن الحقوق الإنسانية – المجتمعية. الأمر الذي جعلها في حاجة إلى حماية أمنية أكبر وأكثر فعالية. فالأمن والاطمئنان السياسي يعتمد أولا على الثقة الشعبية التي تمنح لمن يعبر بصدق وإخلاص عن آمال وتطلعات وحقوق الناس. أما أولئك الذين يتاجرون بالناس ويخادعونهم ويستخدمون آلامهم لتحقيق مكاسب لهم وتمرير مصالحهم ويدركون في الوقت ذاته أن الناس لن تنقاد لهم بيسر وسهولة؛ ولن ينالون الرضى والقبول الشعبيين على سياساتهم والسكوت عنها.. لذا فهم يحتاجون إلى أجهزة الأمن والتجسس لحماية مشاريعهم السياسية وتسويق رؤاهم وتغطيتها وتزويدها بالمعلومات الكافية لمعرفة ما يجول في خواطر الناس وما يفكرون به، كما لمعرفة ما يخطط له الخصوم وما يريدون تحقيقه وماذا يرسمون من مشاريع بديلة نقيضة. يدخل في هذا تمرير معلومات مغلوطة مشوشة وتسويق أفكار خبيثة بعناوين مغرية. كما عمليات التضليل والابتزاز والاستيعاب وشراء الذمم والاغتيال والانقلابات وغيرها كثير من الوسائل التي تحتاج قدرا عاليا من السربة والإخفاء والإنكار والتضليل..
لكل هذه الأسباب تضخم دور أجهزة الأمن وزاد اعتماد السياسة والسياسيين عليها حتى صارت تتحكم بالسياسة في كثير من الأمور وغالبا من وراء الحجب..
وقد كانت مرحلة الصراع الأميركي – السوفييتي عقب الحرب العالمية الثانية ؛ انطلاقة كبيرة لبروز دور وفعالية الأجهزة الأمنية وتشعب مهماتها ..
وفي العالم المعاصر والراهن تمارس تلك الأجهزة تأثيرا عميقا ومباشرا في السياسة والأحداث حتى صار مسؤولوها الكبار يتولون التفاوض ويعقدون الاتفاقات والصفقات ويقررون المصائر ويصنعون الأحداث ويديرون الحروب والمعارك..
يكفي أن نعرف دور ونفوذ وإمكانيات وفعالية أجهزة الأمن الأميركية، الداخلية والخارجية ؛ وما قامت وتقوم به من توجيه للأحداث أو صناعتها ؛ لندرك إلى أي مدى تغولت أجهزة الأمن الحديثة في تدخلها وتأثيرها على حياة البشر ورسم مصائرهم…
ويمكن القول إن سطوة اجهزة الأمن وصناعة التجسس صارت صفة لصيقة بالحياة الحديثة وما يدور فيها من أحداث. فيبرز دورها فاعلا حتى في أكثر عمليات السياسة ديمقراطية أي الانتخابات في أكثر البلاد تقدما وتفتحا واستقرارا..
ومما لا شك فيه أن بلدان العالم الثالث وفي القلب منها البلدان العربية شهدت طفرة كبيرة في تغلغل الأجهزة الأمنية وتزايد نفوذها في السنوات الخمسين الماضية وبرز دورها السلبي القامع للإرادة الشعبية والعامل على وأدها والتخلص منها؛ على حساب أية مسؤولية عن حماية الأمن الوطني والقومي..
٤ – سطوة المضاربات المالية: – المال الغاشم –
تراجعت قيمة العمل كوسيلة نافعة مفيدة للكسب، لحساب نهج العولمة الليبرالية الاستهلاكية وما رافقها من بروز ظاهرة التجارة بالمال بعد أن تجمعت أرقام فلكية منه في أيدي أفراد أو شركات أو مؤسسات مالية ومافيات دولية..
تقدم المال ليصبح معيار القيمة الوظيفية والتشريعية والإنسانية وأصبح امتلاك المال هو الهدف الأكبر بأية وسيلة، بل وبصرف النظر عن الوسيلة؛ وسنت القوانين والتشريعات التي تعطي أصحاب المال ما يناسبهم من مزايا ومكاسب ومعاملات تفضيلية متميزة؛ الأمر الذي جعلهم يتقدمون عن جميع من سواهم أيا كانوا. مما مهد الطريق لسيطرتهم على عالم السياسة ثم الإعلام وبالتالي أصبحوا هم من يوجه الرأي العام ويشكل الوعي كما يريد ويتحكم بالأحداث وفقا لمصالحه بما يملكه من إمكانيات مالية واقتصادية وتشغيلية هائلة ومن امتدادات توظيفية هائلة أيضا. وكان أن احتلت تجارة الأسهم ومضاربات السوق المالية المكانة المتقدمة والأبرز كوسيلة للربح؛ وبذلت جهود وقدمت إغراءات ضخمة لدفع الناس جميعا للدخول في هذا السوق الورقي الافتراضي الوهمي. وصارت أخبار البورصة والأسهم وما يسمى أسعار التداول تحتل حيزا يوميا بارزا في كل نشرة أخبار وظهر مسوقو الأسهم ومذيعات البورصة ونشأت مؤسسات مالية وظيفتها فقط رعاية وتدعيم تلك التجارة والتبشير بها …وباتت المقارنة الكاسحة: ما الذي يحقق أرباحا أكثر … وكانت الغلبة لمنطق المضاربة المالية وتوابعها ومتفرعاتها على حساب العمل والعلم معا … فكم من صاحب مال كثير ليس له من العلم والمعرفة أي نصيب؛ لكنه صار يمتلك نفوذا فاعلا بما يملكه من مال غاشم…. وكان لهذا الأمر تداعيات اجتماعية قيمية مؤذية أقل ما يقال فيها أنها سببت انقلابا سلبيا رجعيا في مفاهيم القيم ونظام الأخلاق والعمل والاستقرار الاجتماعي والأمن النفسي الإنساني والمجتمعي. ليس أقلها أهمية، ازدياد مقدرة القوى المالية العالمية على التحكم بثروات البشر وأموالهم. ولسوف يفتح هذا الباب واسعًا إلى التجارة الرقمية وربما إلى ما سوف يليها من تقنيات أكثر خبثًا ورياء.
يتبع..







