
لم يتخاذل الشعب الفلسطيني قط عن النضال من أجل الحصول على حريته، والتطلّع نحو بناء دولته الوطنية المستقلّة، وقدّم عبر مسيرته النضالية الطويلة من صنوف النضال ما لم يكن بمقدور شعوب أخرى كثيرة عانت من الاستعمار أن تقدّمه، وكان بمقدوره أن يحقّق استقلاله الوطني منذ زمن بعيد، لو كانت التحدّيات التي واجهها من نوع التحدّيات نفسها التي واجهت بقية الشعوب التي تعرّضت أوطانها للغزو والاحتلال إبّان الحقبة الاستعمارية. ولأنها كانت تحدّيات من نوع فريد، جسّدها تقاطع المصالح بين حركة صهيونية بازغة تسعى إلى إقامة دولة يهودية في أرضه وقوى أوروبية عتيدة تسعى إلى استخدام هذه الحركة أداةً في مخطّطاتها الرامية إلى تكريس هيمنتها على النظام الدولي، فقد تعيّن على الشعب الفلسطيني أن يشقَّ طريقه في النضال في ظلّ نظام دولي متواطئ، ونظام إقليمي مخترق، وأوضاع محلّية معقّدة.
لم يكن بمقدور الحركة الصهيونية تحقيق هدفها في إقامة دولة يهودية في أرض فلسطين، اعتماداً على قواها الذاتية وحدها، ما دفع بريطانيا، باعتبارها القوة المهيمنة على النظام الدولي في مرحلة ما بين الحربَيْن، إلى أخذ زمام المبادرة في يدها والشروع في اتخاذ الخطوات التأسيسية الأولى لدولة يهودية أرادتها حاجزاً يفصل مشرق العالم العربي عن مغربه، ويحول دون قيام دولة عربية أو إسلامية كبرى في المنطقة، تحلّ محلّ الإمبراطورية العثمانية المتداعية، ما يُفسّر إصدار بريطانيا “وعد بلفور” في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1917، ثمّ احتلالها فلسطين في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، ثمّ توقيع “صكّ الانتداب على فلسطين” مع عصبة الأمم (24 يوليو/ تموز عام 1922)، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 29 سبتمبر/ أيلول عام 1923، وجميعها قرارات عكست بوضوح هيمنتها على النظام الدولي في ذلك الوقت.
بريطانيا قرّرت إنهاء انتدابها على فلسطين من جانب واحد، ما أفسح المجال أمام ديفيد بن غوريون لإعلان قيام دولة إسرائيل في اليوم التالي
تجدر الإشارة هنا إلى أن القرارات البريطانية الأحادية، مثل “وعد بلفور” واحتلال فلسطين، على أهميتها، لم تكن كافيةً لإضفاء الشرعية على الخطط الرامية لإقامة دولة لليهود في فلسطين. فالوعد الذي قطعه وزير الخارجية البريطاني بهذا الخصوص صدر عن “مَن لا يملك لمَن لا يستحقّ”، واحتلال بريطانيا لفلسطين لا يكفل لدولة الاحتلال حقوقاً تبيح لها القيام بعمليات تهجير جماعي ممنهج يغيّر من الطبيعة الديموغرافية للإقليم المُحتَلّ، خصوصاً إذا كانت من دون موافقة سكّانه الأصليين، ما يُفسِّر حرصها الشديد على إدراج نصّ “وعد بلفور”، البريطاني الجوهر، في صلب “صكّ الانتداب”، العالمي المظهر عبر توقيع “عصبة الأمم” عليه، كي يبدو كل نشاط يتعلّق بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تقوم به دولة الاحتلال، بمثابة تكليف صادر عن أعلى هيئة أممية يفترض أنها تمثّل المجتمع الدولي، وتقوم بما يشبه دور المتحدّث الرسمي للنظام الدولي، ما يُضفي عليه شرعية قانونية وسياسية. ومع ذلك، يتعيّن الانتباه إلى مسألة مهمّة جدّاً، أنّ تبنّي عصبة الأمم وعد بلفور، وإدراجه واحداً من بنود اتفاقية الانتداب على فلسطين، عكس هيمنة بريطانيا على النظام الدولي، بما هو أمر واقع، بأكثر ممّا نجح في إضفاء أيّ قدر من المشروعية القانونية أو السياسية على المشروع الصهيوني نفسه.
ما قامت به بريطانيا في مرحلة ما بين الحربَيْن، خصوصاً ما تعلّق منه بتحرّكات أفضت إلى إدراج نصّ وعد كان وزير خارجيتها قد أصدره لصالح الحركة الصهيونية، ضمن بنود صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين، وبتفويض أممي كامل صادر من عصبة الأمم، يذكّرنا بما تقوم به الولايات المتحدة في هذه الأيام، خصوصاً ما تعلّق منه بتحرّكات أفضت إلى تمكين ترامب من تحويل مخططاته الخاصة تجاه القضية الفلسطينية، بصفة عامة، وتجاه قطاع غزّة، بصفة خاصة، إلى خطط أممية يتبناها مجلس الأمن، ويَصدر بها قرار يحمل اسمه (القرار رقم 2803)، ويُعهد بتنفيذها إلى ترامب نفسه، وذلك من خلال “مجلس السلام” الذي يرأسه بنفسه، وسيعيّن بقية أعضائه بنفسه، ولديه الصلاحيات كلّها التي تمكّنه من وضع “خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزّة”، المؤرخة في 29 سبتمبر 2025، موضع التنفيذ.
يبدو قرار مجلس الأمن 2803 صكَّ انتداب أميركي على فلسطين يعيد إنتاج دور بريطانيا التاريخي بثوب مختلف
بين صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين، الذي دخل حيّز التنفيذ في 1923، وقرار مجلس الأمن 2803، الذي صدر عام 2025، ويُعدُّ بمثابة صكّ انتداب أميركي على فلسطين، انقضت فترة تجاوزت قرناً كاملاً من الزمان، جرت خلاله أحداث جسام. فخلال فترة الاحتلال والانتداب البريطاني، ارتفع عدد اليهود في فلسطين من أقلّ من 5% من إجمالي عدد السكّان عام 1917 إلى ما يقرب من 33% عام 1947. ولم يكن هؤلاء كلّهم أشخاصاً مسالمين فارّين من أجواء الاضطهاد في الغرب، لكنّهم كانوا في معظمهم جنوداً مدرّبين ومستعدّين للقتال. وحين انهارت عصبة الأمم، وانهار معها نظام الانتداب، كان ميثاق الأمم المتحدة يفرض على بريطانيا (بمجرّد دخوله حيّز التنفيذ عام 1945) إبرام اتفاق توضع فلسطين بموجبه تحت مظلة نظام الوصاية، غير أنها لم تفعل، وقرّرت إحالة المسألة الفلسطينية برمّتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947. ولأنها أدركت أن مكانتها الدولية آخذة في الأفول، فقد نسّقت مع الولايات المتحدة، الطامح الجديد للهيمنة على النظام الدولي ليحلّ محلّها في رعاية المشروع الصهيوني، فكان قرار التقسيم الذي أمكن تمريره في الجمعية العامة بضغط هائل من الولايات المتحدة. ورغم ما انطوى عليه هذا القرار من إجحاف بحقّ الفلسطينيين (لأن نصيبهم كان 46% فقط من إجمالي مساحة فلسطين، في وقت كانوا يشكّلون أكثر من ثلثَي عدد السكّان)، ومن مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، لأن الجمعية العامة لا تملك صلاحية تقرير مستقبل إقليم خاضع للانتداب من دون استطلاع رأي سكّانه، ورفضت في الوقت نفسه مشروع قرار تقدّمت به الدول العربية للحصول على فتوى بهذا الشأن من محكمة العدل الدولية.
ما يثير التأمل هنا أن بريطانيا قرّرت إنهاء انتدابها على فلسطين من جانب واحد، ما أفسح المجال أمام ديفيد بن غوريون لإعلان قيام دولة إسرائيل في اليوم التالي، أي قبل الشروع في وضع قرار التقسيم موضع التنفيذ، ومهّد لاندلاع أولى الحروب العربية الإسرائيلية. كما يثير التأمّل أيضاً أن عناصر يهودية متطرّفة قامت باغتيال الكونت برنادوت، مبعوث الأمم المتحدة الذي أوصى بالعودة الفورية لجميع اللاجئين الفلسطينيين، وأصبح أحد الضالعين في عملية الاغتيال (وهو إسحاق شامير) رئيساً لوزراء إسرائيل فيما بعد. وتلك كلّها مؤشّرات كانت توحي مبكّراً بأن الدولة اليهودية التي يحاول النظام الدولي غرسها في قلب العالم العربي لن تكون مسالمةً، وأن أطماعها لا تقتصر على فلسطين التاريخية، وإنما تمتدّ “من النيل إلى الفرات”، وأنها تحرص على الهيمنة على المنطقة بأكثر ممّا تحرص على التعايش مع شعوبها. فقد أسفرت حرب 1948 عن تمكين إسرائيل من السيطرة على نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية، وطرد أكثر من 75 ألفاً من سكّانها الذين تحوّلوا لاجئين. وكان بمقدور مجلس الأمن أن يسهم في تسوية الأزمة نهائياً، لو أنه اتخذ قراراً يقضي بانسحاب إسرائيل إلى الحدود المرسومة في قرار التقسيم وعودة اللاجئين أو تعويضهم، وهو ما كانت تسمح به موازين القوى السائدة داخل المجلس في ذلك الوقت، خصوصاً أن علاقة الدول العربية بالمعسكر الشرقي الآخذ في التشكّل كانت شبه معدومة. غير أن إسرائيل لم تكن مستعدّةً لقبول حلول تستند إلى أيٍّ من هذَيْن المبدأَيْن، ومن ثمّ لم يكن هناك من خيار آخر سوى اتفاق للهدنة (1949)، وهو ما مهّد لاندلاع سلسلة من المواجهات المسلّحة، جرت أولاً مع الجيوش النظامية في 1956 و1967 و1973، قبل أن تنتقل راية الكفاح المسلّح إلى فصائل المقاومة، التي اقتصرت على الفلسطينيين في البداية، خصوصاً عقب هزيمة 1967، ثمّ بدأت ساحة المواجهة العسكرية تتسع تدريجياً لتشمل فصائل عربية أخرى، خصوصاً بعد خروج مصر من ساحة المواجهة العسكرية عقب توقيعها اتفاقية سلام منفرد مع إسرائيل، وهي اللحظة نفسها التي بدأت إيران تدخل فيها ساحة المواجهة العسكرية غير المباشرة مع إسرائيل، إلى أن اندلعت عملية “طوفان الأقصى”، التي بادرت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأدت في الوقت نفسه إلى أن تشنّ إسرائيل حربَ إبادةٍ جماعيةٍ استمرّت عامَيْن متواصلَيْن، تخلّلتهما معاركُ متقطّعةٌ مع جميع أطراف محور المقاومة، بما فيها إيران، في ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع إسرائيل.
طالما أن التسوية لا تُبنى على قرارات الشرعية الدولية، ستظلّ فلسطين ملهمةً للمقاومة
بقي أن نشير إلى أن جميع مفاوضات التسوية السلمية التي جرت مع إسرائيل كانت ثنائيةً، لأن الأخيرة كانت (وما تزال) ترفض التفاوض مع الدول العربية مجتمعةً، وتصرّ دائماً على التفاوض مع كل دولة عربية على حدة، ولأن جميع جولات التفاوض مع إسرائيل نُظّمت خارج إطار الأمم المتحدة، وتحت الإشراف المنفرد للولايات المتحدة حين تقتضي الضرورة، خصوصاً وأن إسرائيل تكره كلَّ ما له صلة بمؤسّسات الأمم المتحدة، ولا تقبل سوى بالولايات المتحدة وسيطاً أو مراقباً أو شاهداً في مفاوضات تصرّ على أن تظلّ ثنائية. أمّا حين يتعلّق الأمر بالتطبيع، فتتبنّى إسرائيل موقفاً مغايراً تماماً، وتتمنّى لو استطاعت جمع الدول العربية والإسلامية كافّة في محفل واحد، يُعلَن من فوق منصّته قراراً جماعياً بتطبيع العلاقات معها. ولأن الولايات المتحدة تشجّع على هذا النهج، فمن الطبيعي أن تتمادى إسرائيل في غيّها، وأن تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي وهي مطمئنة تماماً إلى قدرتها على الإفلات من العقاب، وأن حقّ النقض (فيتو) الأميركي سيظلّ مشرعاً لحمايتها على الدوام.
اليوم، وبعد أن أصبحت إدارة ترامب المفوّض الرسمي من مجلس الأمن للبحث عن تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استناداً إلى الخطط الأميركية نفسها، وليس إلى قرارات الشرعية الدولية، يدخل الصراع في المنطقة مرحلةً جديدةً تماماً. ولأن إسرائيل لا تُصرّ على نزع السلاح الفلسطيني فحسب، وإنما إزالة مصادر التهديد في المنطقة ككل، فسوف تظهر الأسابيع والشهور القليلة المقبلة ما إذا كان بمقدور إدارة ترامب العثور على صيغة للتوصّل إلى تسوية شاملة تحقّق التوازن بين مصالحها مع إسرائيل، ومصالحها مع العالمَيْن العربي والإسلامي. ومن دون هذه التسوية، ستظلّ القضية الفلسطينية ملهمةً لكلّ أشكال المقاومة في المنطقة.
المصدر: العربي الجديد



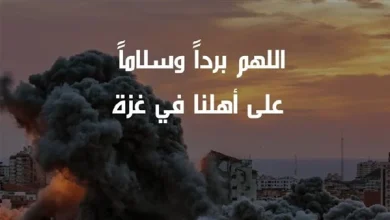




قراءة موضوعية ودقيقة عن تطور وضع فلسطين من وعد بلفور 1916 ولتاريخ قرار مجلس الامن الأخير وقم 2803 ، من الانتداب الانكليزي الى صكَّ جديد لانتداب أميركي على فلسطين ومحاولة لانهاء القضية الفلسطينية ، ولكن الحق لن يموت وشعبنا لن تهون عليه قضيته وارضه .