
من بين الإشكاليات الكبرى التي رافقت التاريخ السياسي السوري أنّ الحدود بين الدولة والسلطة لم تكن واضحة؛ فكثيراً ما جرى التعامل مع الحاكم أو النخبة الحاكمة على أنهم الدولة ذاتها، وكثيراً ما ارتبطت مؤسسات الدولة بمصير سلطة بعينها، ما جعل فكرة “المشترك الوطني” عرضة للتصدع والانهيار.
ولعلّ من أبرز ملامح المأزق السوري اليوم أنّ النقاش العام ما زال يتعامل مع السلطة القائمة وكأنها الدولة ذاتها. هذا الخلط، الذي يراه البعض تفصيلاً لغوياً، هو في جوهره أحد الأسباب البنيوية لاستمرار الأزمة؛ إذ لا يمكن تصوّر بناء عقد اجتماعي جديد أو إصلاح المجال السياسي ما لم نضع خطاً فاصلاً بين الدولة ككيان دائم، والسلطة كجهاز متغيّر.
الدولة، في معناها الحديث، إطار جامع يتألف من الإقليم والشعب والسيادة والمؤسسات. هي البنية التي تضمن الاستمرارية بغضّ النظر عن تبدّل الحكام أو تعاقب السلطات. في المقابل، السلطة ليست سوى أداة لإدارة هذا الإطار، تكتسب مشروعيتها من العقد الاجتماعي مع المواطنين، وتفقدها متى فشلت في حماية مصالحهم الأساسية. إنّ الخلط بين الدولة والسلطة ينتج أزمة وجودية تختزل الوطن في شخص أو حزب أو جماعة، ويحوّل الولاء للدولة إلى ولاء عابر للمؤسسات والدساتير.
حين تتماهى الدولة بالسلطة، يتحول الحاكم تدريجياً إلى المرجع الوحيد للشرعية، فيُختزل مفهوم الوطنية في الولاء له وحده. عندها يغدو الاعتراض السياسي أقرب إلى فعل خيانة.
الدولة الحديثة ليست ملكاً لحاكم أو جماعة، بل هي الكيان الذي يمنح الهوية السياسية ويضمن استمرارية المجتمع. وفي سوريا، غاب هذا التمييز طويلاً؛ فارتبطت الدولة بأسماء وسلالات ونخب ضيقة، حتى صار الاعتراض على السلطة يُقرأ وكأنه اعتراض على وجود الدولة.
ووفق ما يشير ابن خلدون في مقدمته، فإن الدولة تقوم على العصبية، لكنها تضعف عندما تتحول العصبية إلى غاية في ذاتها. ويمكن إسقاط هذا على التجربة السورية، حيث تحوّلت الهويات الفرعية والطائفية إلى بديل عن العصبية الوطنية الجامعة، ما جعل الدولة نفسها مهدَّدة بالتفكك. هنا يظهر الفرق بين الدولة ككيان جامع يتجاوز العصبيات، والسلطة التي قد تعيد إنتاجها وتوظيفها لتأبيد حكمها. إنّ الدولة الحديثة لا تستقر إلا إذا نجحت في إنتاج ثقافة سياسية جامعة تتجاوز الفوارق المحلية. فشل الدولة في سوريا يكمن في أنها لم تنتج هذه الثقافة الوطنية الجامعة، بل تركت فراغاً ملأته الولاءات الطائفية والعشائرية. وحين تتماهى السلطة مع الدولة، يتضاعف هذا الفشل، لأن مشروع الدولة يتقلّص ليصبح مجرد مشروع سلطة ضيّقة.
وعندما تُختزل الدولة في السلطة، يصبح الاعتراض السياسي تهديداً للكيان كله، وتُجرَّم المعارضة باعتبارها مساساً بالوطن. هنا يفقد المجتمع أدواته السلمية للتغيير، فيندفع نحو خيارات قصوى. وهذا ما يجعل التمييز بين المفهومين شرطاً ضرورياً لأي عملية انتقالية أو لأي عقد اجتماعي جديد.
وحين تتماهى الدولة بالسلطة، يتحول الحاكم تدريجياً إلى المرجع الوحيد للشرعية، فيُختزل مفهوم الوطنية في الولاء له وحده. عندها يغدو الاعتراض السياسي أقرب إلى فعل خيانة. وفي هذه الأثناء، تفقد مؤسسات الدولة استقلاليتها، وتتحول من أطر يُفترض أن تكون محايدة إلى أدوات طيّعة بيد السلطة.
الشرعية هي علاقة ثقة مستمرة بين المواطنين ومؤسسات الحكم، وليست مجرد تفويض مؤقت يُمنح للسلطة. هذه العلاقة قائمة على شرط أساسي يتمثّل في أن تكون الدولة إطاراً محايداً فوق الجميع، وأن تكون السلطة قابلة للتداول وفق معايير الدستور أو العقد الاجتماعي. وحين تفشل السلطة في الوفاء بهذه الشروط، يجب أن تكون هناك آليات لتغييرها من دون أن تهتز الدولة نفسها.
إن الدولة هي “تجسيد للعقل”، أي الإطار الذي يحقق الحرية عبر القانون.
وبحسب ماكس فيبر، تقوم الشرعية على ثلاثة أنماط: التقليدية، والكاريزمية، والقانونية–العقلانية. في الحالة السورية، ظلّت السلطة تستند إلى شرعية تقليدية (السلالة أو التاريخ) أو كاريزمية (شخص الحاكم)، لكنها لم تنجح في بناء شرعية عقلانية–قانونية تستند إلى المؤسسات والدستور. غياب هذا النمط الأخير هو ما جعل السلطة تتماهى مع الدولة، لأن مؤسساتها لم تُبنَ على أسس عقلانية مستقلة، بل على الولاء الشخصي.
التجربة السورية الحديثة تُظهر أنّ الخلط بين الدولة والسلطة جعل أي هزّة سياسية تهدّد بقاء الكيان كله. ولذلك فإن مهمة المرحلة المقبلة ليست في إعادة بناء مؤسسات الدولة فحسب، وإنما في إعادة ترسيخ الوعي العام بأن الدولة كيان دائم فوق التغييرات السياسية، وأن السلطة جهاز متغير خاضع للمساءلة والتداول. من دون هذا التمييز، ستظل أي سلطة تُعامل نفسها كالدولة، وسيظل خصومها يعاملون الدولة كأنها خصماً، لتتكرّر الحلقة ذاتها من الهشاشة والانقسام.
وكما يرى الفيلسوف الألماني جورج هيغل، فإن الدولة هي “تجسيد للعقل”، أي الإطار الذي يحقق الحرية عبر القانون. وإذا أسقطنا هذا على الحالة السورية، فإن غياب التمييز بين الدولة والسلطة يعني غياب الدولة العقلانية بالمعنى الهيغلي، لأن الحرية هنا لا تتحقق عبر القانون، بل عبر الولاءات والعصبيات.
المصدر: تلفزيون سوريا

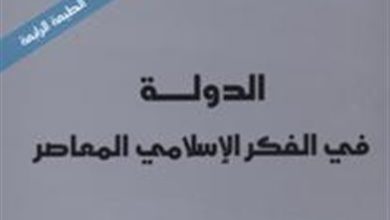




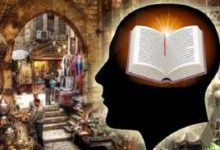

الإشكالية المستمرة بالتاريخ السوري هو غياب الفصل بين الدولة والسلطة ، إذ يتم التعامل مع الحاكم أو الزمرة الحاكمة بأنها الدولة ، لذلك ارتبطت مؤسسات الدولة بمصير السلطة الحاكمة بعينها، ما جعل فكرة “المشترك الوطني” عرضة للتصدع والانهيار، قراءة موضوعية لهذه الإشكالية، وضرورة الفصل بينهما. بإعتبار الدولة هي “تجسيد للعقل”، والسلطة هي المطبقة للقانون وتحقيق الحريات.