
ولا مرّة كان نبع الفيجة مجرّد منبع مائي يغذّي مدينة دمشق، بل هو، ومنذ أقدم العصور، قلبها النابض بالحياة، وسرّ بقائها، ومصدر سحرها الطبيعي.
من بين الصخور الكلسية التي تشقّ جبال وادي بردى، تتدفّق مياه الفيجة بعذوبةٍ نادرةٍ وبرودةٍ قارّةٍ في بلّوراته، فينبهر بها العابر كما ينعم بها المقيم، ويصعب على العين أو الذاكرة أن تفصل بين ماء الفيجة وصورة دمشق. منذ العهد الروماني، بل ربما قبله، أدرك الإنسان أن هذه الينابيع ليست نعمة فقط، بل مسؤولية، فتحوّلت إلى محور لنظام مائي متقن، تدخّلت فيه تقنيات البشر لتروي ظمأ المدينة وتربتها.
الرومان شقّوا القنوات وبنوا الأنفاق الحجرية، وربطوا النبع بقلب المدينة من خلال قنوات تصل إلى باب توما، واستمرت هذه الشبكة في الخدمة خلال العصور البيزنطية والإسلامية، مع تطويرات جزئية وتأقلم مع تغيّر أنماط العمران. في العهد الإسلامي، غلب الطابع الوقفي والديني على إدارة المياه، فأصبحت “سقايات” الفيجة مرتبطة بالجوامع، والخانات، والسبل العامة، وكان للأوقاف دور كبير في الحفاظ على انتظام جريان الماء عبر المدينة، إذ اعتُبر الماء وقفًا عامًا لا يُباع ولا يُشترى، بل يُدار وفق نظام أخلاقي واجتماعي دقيق.
في عام 1927، دُشّن خزان الفيجة الحجري، وهو من أبرز إنجازات تلك المرحلة، صُمّم بأسلوب هندسي محكم، ونُحت في قلب الجبل، وبُني بمواد صلبة تضمن عزل الماء ونقله دون تسرّب.
في العصر العثماني، ورغم الإهمال العام الذي أصاب البنى التحتية في أغلب المدن العربية، ظلّت الفيجة تحتلّ موقعًا خاصًا في الحياة الدمشقية. ومع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر، بدأ التفكير في تطوير جلب المياه إلى المدينة بأسلوب أكثر تنظيمًا، فمُدّت أنابيب فخّارية، وأُنشئت محطات ضخ بدائية، وإن بقيت محدودة الفاعلية.
الانطلاقة الكبرى جاءت مع الانتداب الفرنسي، حين بدأ مشروع ضخم لتحديث شبكة مياه الشرب في دمشق عام 1924، تحت ضغط الأوبئة المتفشية في المدينة، وأُسند المشروع إلى المهندس الفرنسي فرناند كلييه، الذي وضع تصورًا متكاملًا يقوم على إنشاء خزان رئيس عند نبع الفيجة، ومد شبكة من الأنابيب المعدنية نحو المدينة، بدل الاعتماد على القنوات المفتوحة أو الوسائل التقليدية.
في عام 1927، دُشّن خزان الفيجة الحجري، وهو من أبرز إنجازات تلك المرحلة، صُمّم بأسلوب هندسي محكم، ونُحت في قلب الجبل، وبُني بمواد صلبة تضمن عزل الماء ونقله دون تسرّب، وبلغت سعته قرابة 15 ألف متر مكعب. كان هذا الخزان نقطة تحوّل في العلاقة بين دمشق ومائها، حيث بدأ الضخ المنظم والمتساوي للمنازل، وانتهى عصر الحظوة والعشوائية.
وفي عام 1932، تأسست أول شركة وطنية سُمّيت “شركة مياه عين الفيجة”، وهي التي تولّت لاحقًا إدارة المشروع وتوسيع نطاق خدماته، وفرض رسوم مالية بسيطة على المياه المستهلكة، ما ساعد في تمويل عمليات الصيانة والتوسيع. بعد الاستقلال، أخذت الحكومة الوطنية على عاتقها تطوير المنظومة بأكملها، فأنشأت محطات ضخ ومعالجة جديدة، ومدّت أنابيب إسمنتية وحديدية أكثر قوة، وزادت سعة الخزانات.
وفي ستينيات القرن العشرين وسبعينياته، شهدت الفيجة قفزة نوعية مع بناء خزان إسمنتي جديد في موقع مرتفع، ما سمح بزيادة ضغط المياه في الأحياء المرتفعة، وأتاح للمدينة التوسع العمراني في ضواحٍ مثل المزة وبرزة وركن الدين. أصبح النبع رمزًا للماء النظيف والمجاني، وتحوّلت منشآته إلى معالم شبه مقدّسة، يزورها الناس، ويصوّرونها، ويربطون بها ذكرياتهم.
قبل مشروع جر مياه الفيجة الحديث، كانت دمشق تعتمد في شربها على مياه الأنهر المكشوفة والعيون المحيطة بها مثل عين الكرش، وعين الزينبية، وعين علي، أو على الآبار السطحية في المنازل، التي كثيرًا ما تكون ملوّثة، ما جعل مياه الشرب مصدرًا دائمًا للأمراض والأوبئة الفتّاكة كالتيفوئيد والزحار.
ومع تزايد الحاجة إلى الماء النقي، بدأت أولى المحاولات في عهد الوالي العثماني ناظم باشا عام 1908، حين جرى جر جزء من مياه الفيجة بأنبوب من الفونت بقطر 250 مم إلى خزانين في شمال المدينة، هما خزان العفيف بسعة 2000 م³، وخزان ظبيان بسعة 500 م³، لتوزيع المياه عبر 400 سبيل بمعدل ساعتين في اليوم، تغطي بالكاد حاجة السكان.
غير أن التحوّل الحقيقي في حياة المدينة بدأ عام 1924، عندما أنشأ عدد من أبناء دمشق أول جمعية تعاونية في البلاد، سُمّيت “جمعية ملّاكي المياه”، قامت على أساس شراء المواطنين لحقوق الأسهم المشاركة في مياه النبع، إذ بلغ سعر المتر المكعب الواحد 30 ليرة عثمانية ذهبية، وجُمِع رأس مال قدره 270 ألف ليرة ذهبية، مكّن من إطلاق مشروع طموح أشرفت عليه لجنة “عين الفيجة”، التي عملت كسلطة تنفيذية مستقلة عن سلطة الانتداب الفرنسي.
وقد قامت شركة هندسية فرنسية بدراسة المشروع، وبدأ التنفيذ فعليًا قبل أن يتوقف ما بين عامي 1926 و1928 بسبب اندلاع الثورة السورية عام 1925، ليُستأنف العمل لاحقًا، ويُستكمل المشروع حتى تدشينه رسميًا عام 1932، بإيصال مياه الفيجة إلى بيوت دمشق عبر شبكة منظمة.
تشهد دمشق في صيف عام 2025 انهيارًا حادًا في بنيتها الخدمية المائية، مع تراجع تدفق نبع الفيجة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ستين عامًا.
وقد تضمن المشروع إنشاء قناة جر مكسوة بالبيتون بطول 16.8 كيلومتر وتصريف 3 م³/ثا، إضافة إلى إنشاء ثلاثة خزانات مركزية: الوالي، والفواخير، وقاسيون العالي، الذي يعمل عبر عنفة هيدروليكية. وتم تمديد شبكة من الفونت غطّت معظم أحياء المدينة، وما تزال بعض عناصرها الأساسية قائمة حتى يومنا هذا، ممثّلة بذلك ولادة البنية التحتية الحديثة للعاصمة التي شهدت، ولا تزال، توسعًا فاق قدرتها، وانتصارًا لرؤية أهلها الذين أرادوا، ويريدون، التحرر من العطش، ومن التبعية للشركات الأجنبية، وبناء مستقبل مائي قائم على الحكم الوطني والتخطيط العلمي.
تشهد دمشق في صيف عام 2025 انهيارًا حادًا في بنيتها الخدمية المائية، مع تراجع تدفق نبع الفيجة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ستين عامًا، وبلوغ الخزانات الاحتياطية الكبرى في العدوي، والعفيف، ودوما، وصحنايا مرحلة الجفاف شبه الكامل. وتعجز المدينة اليوم عن تأمين حاجتها اليومية من مياه الشرب، مع اعتمادها المتزايد على آبار جوفية مهددة بالنضوب، في ظل شح غير مسبوق بالأمطار، وانعدام التخطيط المستدام.
وقد فرضت مؤسسة المياه برنامج تقنين قاسٍ لتوزيع الحصص، فيما يقف المواطن الدمشقي أمام واقع خدمي متردٍّ، عنوانه العطش، والاستنزاف، وغياب الحلول، مع انهيار شبه كامل في منظومة الخدمات المائية والبيئية، وفقدان البلاد غطاءها الأخضر الموازي لعملية الإمطار، مع استنزاف هائل للمياه الجوفية في حوض دمشق.
وتلوح في الأفق عدة مشاريع تتوالى هذه الأيام أخبارها في الإعلام والصالونات، ضمن مشاريع الاستثمار في البلاد، منها مشروع بناء محطة تحلية في طرطوس، ومن ثم جر المياه إلى المنطقة الجنوبية ودمشق، أو مشروع جر مياه الفرات إلى منطقة حوض دمشق.
المصدر: تلفزيون سوريا

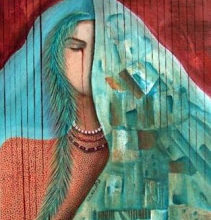
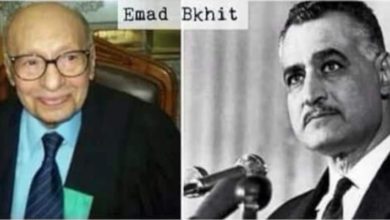





“نبع الفيجة” ليس مجرّد منبع مائي يغذّي مدينة دمشق، بل هو، ومنذ أقدم العصور، قلبها النابض بالحياة، وسرّ بقائها، ومصدر سحرها الطبيعي. قراءة موضوعية عن نبع الفيجة وتاريخ الإستفادة منه لإرواء مدينة دمشق 1927 حينما دُشّن خزان الفيجة الحجري، كأبرز إنجازات تلك المرحلة، صُمّم بأسلوب هندسي محكم، ونُحت في قلب الجبل،