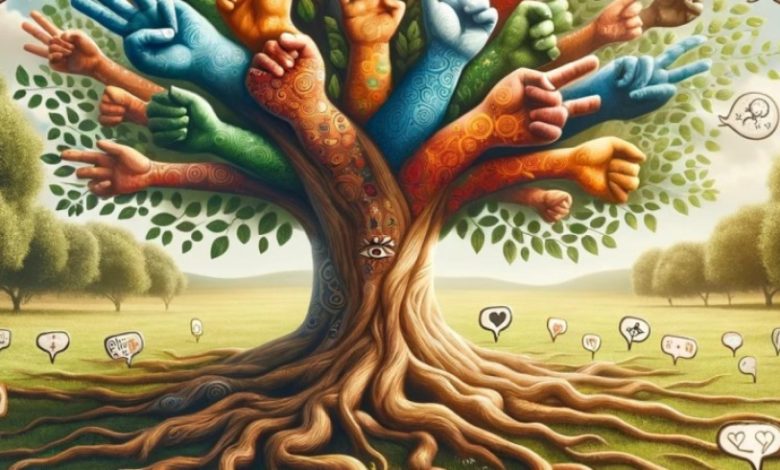
ما من خطاب كراهية يمكن فهمه في السياق السوري من دون الانتباه إلى بنيته الأعمق والمتمثلة بنظام الازدراء الرمزي. فهو لا يُمارس على شكل تحريض مباشر فحسب، وإنما يتجلّى في تفاصيل الحياة اليومية، وفي اللغة، في التنميط، وفي التفاعل بين الفئات والمناطق والهويات.
وهنا لا يعود الازدراء مجرّد عارض أخلاقي أو أثر جانبي للحرب، بقدر ما يتحوّل إلى سلطة صامتة تعيد إنتاج الانقسام الاجتماعي، وتعوق أي مسار لإعادة بناء المجال الوطني.
لم تكن بنية الازدراء في سوريا نتاج الحرب وحدها، فهي تضرب جذورها في العقود السابقة، حين تكرّست أنماط غير معلنة من التراتب الاجتماعي داخل النظام السياسي المركزي.
لقد أسّس نظام الأسد نموذجاً سلطوياً يعتمد على مركزية دمشق بوصفها محور القرار ومصدر الامتياز، ليس فقط على المستوى الإداري، وإنما على المستوى الرمزي والثقافي.
لم يكن التهجير في سوريا مجرّد انتقال قسري في الجغرافيا، بل مثّل لحظة إعادة توزيع رمزي للشرعية والانتماء.
كانت العلاقة بين السلطة المركزية وبعض المناطق السورية تُبنى على مزيج من الإدماج الانتقائي والتهميش المحسوب؛ إذ كانت تُمنح مدن محددة أو فئات بعينها فرصاً رمزية للظهور في مؤسسات الدولة أو في واجهتها الإعلامية، على اعتبارها كمكوّنات وظيفية تُستدعى لأداء أدوار ولائية، أو للمشاركة في مشاهد احتفالية تُكرّس صورة الوحدة الشكلية.
هذا التمايز لم يتخذ بالضرورة طابعاً طائفياً مباشراً، وإنما تداخلت فيه عناصر جغرافية، طبقية، وجهوية، أسهمت في إنتاج ما يمكن وصفه بـ”الازدراء الرمزي المقنّن”، حيث تُعامَل بعض المناطق كأطراف غير مؤهلة للتمثيل الحقيقي، وإنما للاستخدام السياسي المؤقت أو للتسويق الإعلامي في لحظات محددة.
تجلّى ذلك في سرديات التعليم والتوظيف وتوزيع المشاريع، بل وحتى في اللهجة المقبولة على الشاشات، أو الصورة المتخيّلة للمواطن النموذجي في الخطاب الرسمي.
هذا التأسيس الصامت، وإن بدا مستقراً لسنوات، مهّد الأرض لتفجّر رمزي لاحق مع انطلاق الثورة، حين خرجت الفئات المهمّشة من وضعية التابع الصامت إلى موقع المطالبة بالاعتراف الكامل، ليس فقط كحق سياسي، وإنما ككرامة رمزية متساوية.
لم يكن التهجير في سوريا مجرّد انتقال قسري في الجغرافيا، بل مثّل لحظة إعادة توزيع رمزي للشرعية والانتماء. لقد أسست الحرب وما تلاها من موجات لجوء، طبقة جديدة من التراتب غير المُعلن، تستند إلى مواضع الجماعات في خارطة الشتات.
من بقي في الداخل، وإن بغير خيار أو تحت ضغط الضرورة، أصبح موضع اشتباه ضمن بعض دوائر المنفى؛ هل صمت أو هل ساوم؟
ومن غادر، حتى وإن فعل ذلك بعد تجربة اعتقال أو قصف أو حصار، يُنظر إليه كمن فقد صلته بـ”النبض الحقيقي” للمجتمع السوري.
وهكذا تُعاد هندسة المجال الرمزي السوري بطريقة تجعل من المنفى موقع امتياز رمزي مشروط، ومن الداخل موقع شبهة تحتاج دائماً إلى التبرير أو إثبات النقاء السياسي. بذلك أصبح الازدراء نظاماً ضمنياً لإعادة إنتاج مركزية رمزية جديدة، تتوزع داخلها مراتب السوريين وفق معايير غير مُعلَنة.
كذلك فإن منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرّد وسيلة للتعبير أو التقاطع، بل باتت مساحات رمزية لصياغة التراتب الاجتماعي من جديد.
فمن خلال بنيتها التقنية–الخوارزمية، تُعيد هذه المنصات فرز الخطابات وفق معيار واحد أساسي وهو القدرة على إثارة الانفعال. ويُهمَّش الخطاب المتماسك ويُقصى الصوت الهادئ المتروّي، لأنهما لا يُنتجان التفاعل السريع المطلوب، وفي المقابل، يصعد الخطاب الحاد المُستفز؛ المشحون بالتقليل أو الاستعلاء أو السخرية من جماعة أو لهجة أو تجربة محددة، لأنه ببساطة يحقق ما تريده المنصة، تفاعلاً أكبر وزمن مشاهدة أطول.
في بلد مزّقته الحرب وتفكّكت فيه منظومات التمثيل، لا تكفي الدعوة إلى الوحدة أو السلم الأهلي كمجرد شعارات، إن لم تسبقها إعادة تعريف صريحة للكرامة بوصفها قيمة مؤسِّسة لأي عقد اجتماعي، وليس مجرّد امتياز يُمنَح من فوق أو يُصادَر عند أول اختلاف.
بهذا المعنى، لا تُنتج خوارزميات المنصات محتوىً منحازاً بالمعنى السياسي المباشر، لكنها تُنتج بيئة قيمية منحازة لخطاب الازدراء، ولتتحوّل المنصات بذلك إلى مسرح يُعاد فيه إنتاج السلطة الرمزية عبر الضجيج الفعّال.
وتتشكل طبقة من المؤثرين الذين لا يملكون بالضرورة مشروعاً معرفياً أو سياسياً، لكنهم يتقنون إدارة الغضب الجمعي وتحويله إلى مادة قابلة للاستهلاك.
إن تفكيك خطاب الكراهية في سوريا، بما فيه من أنماط الازدراء الصامت أو العنيف، لا يمكن أن يتم عبر أدوات الرقابة التقليدية أو العقوبات الزجرية وحدها، وإنما عبر عملية أعمق تتصل بإعادة بناء الفضاء الرمزي الوطني على أسس الاعتراف المتبادل.
في بلد مزّقته الحرب وتفكّكت فيه منظومات التمثيل، لا تكفي الدعوة إلى الوحدة أو السلم الأهلي كمجرد شعارات، إن لم تسبقها إعادة تعريف صريحة للكرامة بوصفها قيمة مؤسِّسة لأي عقد اجتماعي، وليس مجرّد امتياز يُمنَح من فوق أو يُصادَر عند أول اختلاف.
مواجهة الازدراء تتطلّب بداية الاعتراف بوجوده كمشكلة بنيوية، وليس كمجموعة حوادث معزولة. يجب تفكيك اللغة اليومية التي تعيد إنتاج التمييز، وتحليل السياسات الإعلامية والثقافية التي كرّست التهميش داخل ما تبقى من بنى الدولة.
ومن هنا، فإن أي مشروع إعلامي وطني لا يستقيم من دون إصغاء فعلي للجميع، ليس على سبيل التجميل أو التمثيل الرمزي، وإنما كجزء من إعادة توزيع سرديات الحاضر والمستقبل.
وما لم تُعالج بنية الازدراء بوصفها آلية لإقصاء الآخر، سيبقى خطاب الكراهية قائماً حتى حين يتخفّى في نبرة وطنية أو بلغة تصالحية زائفة. وهذا بالتحديد هو الامتحان الرمزي الأكبر لأي سلطة انتقالية تسعى للتماسك، ليس من خلال فرض مركزية جديدة، وإنما عبر تأسيس أرضية مشتركة للتعدد والاحترام.







