
للأرقام أسرار، لذا ينظر إليها الإنسان بصفتها رموزًا حاملة لرسائل ومعانٍ تفيد في الشحّ أو الرزق، والقلة أو الكثرة، وفي التقعيد والتزمين، والاستخفاف أو الاستهوال. لذا، يتخذ إحياء ذكرى الثالث عشر من نيسان هذا العام زخماً إضافياً باعتباره الذكرى الخمسين لانطلاقة الحرب الأهلية، وهو رقم يحضر كثيرًا في المعتقدات الشعبية وفي التعبير الكلامي.
ويعكس هذا الإحياء، الذي دأب عليه اللبنانيون منذ عقودٍ طويلة، التوافق على اعتبار أن الأحد الثاني من شهر نيسان العام 1975 هو التأريخ المحدّد لانفجار الحرب الأهلية اللبنانية ما يفسّر الاحتفاء به تكراراً؛ ويقابل هذا التوافق، على الثالث عشر من نيسان والاحتفاء به، افتقاد اللبنانيين إلى تأريخٍ محدّد لطيّ صفحة الحرب والانتقال إلى مرحلة جديدة تتوفر فيها الشروط اللازمة لإدارة الاختلافات والنزاعات بعيداً عن العنف.
والحال أن نملك تاريخًا محددًا لاندلاع الحرب ونحتفل به للمرة الخمسين من دون أن نملك تاريخًا محددًا للاحتفال بانتهائها، فذلك يعني أن لبنان لا يزال يراوح طويلًا في مرحلةٍ انتقالية بين مرحلتين: مرحلة الحرب القاتمة التي لم تُقفل كما ينبغي، ومرحلة السلم المستدام التي لم تُفتتح كما يجب. وبالتالي، علينا الاعتراف بأن هناك ما ينبغي أن نفعله للخروج من هذه المراوحة، ولم نفعله؛ أي أننا لم نفعل ما فعله غيرنا، ولم ننجز ما من شأنه أن يُبدّد الحذر والتوجس المتبادل بين الأفراد والجماعات، ويُعزّز الشعور بوجود دولة للجميع وفوق الجميع.
العدالة الانتقالية وتجديد العقد الاجتماعي
بعيداً عن الاسقاطات فإن الكثير من المجتمعات التي نجحت في معالجة تركة وتجاوزات الماضي، والانتقال إلى استعادة ثقة الأفراد بين بعضهم البعض وثقتهم في مؤسسات الدولة، قد اعتمدت في ذلك مبادئ العدالة الانتقالية التي يقع بموجبها على عاتق الدولة توفير السبل اللازمة لإنصاف الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات، والمبادئ تلك ليست وصفات جاهزة وإنما يمكن أن تتلاءم مع الإطار الاجتماعي وأن تراعي تمايزاته وخصوصياته الثقافية.
ومعه، فإن هذا المدخل في تناول ذكرى الحرب الأهلية يحمل دعوته بنفسه، وهي أن طيّ صفحة الحروب الأهلية إلى غير رجعة رهن بناء المستندات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تكرّس (أو تعيد تكريس) الدولة وحدها كإطار يستطيع أن يتنقل بالجميع من حالة الفوضى إلى حالة الأمن والاستقرار، وأن يرعى كافة أمور اللبنانيين ويلبي حاجاتهم المتشعبة ويضمن كافة حقوقهم ويؤدون واجباتهم. ويدير شؤون اجتماعهم السياسي، بما فيها قضايا اتصالهم مع محيطهم، وما يعتمل بهذه القضايا من علاقات تعاون وتكامل، أو مواقف عداوة وحرب وهدنة. ويصون حدودهم، ويكفل أمنهم ويحافظ على ممتلكاتهم، ويفض نزاعاتهم. كما تتوسّع مهام الدولة لتشمل أعظم الأمور وأصغرها، مثل شؤون الاقتصاد والتربية والمأكل، والمسكن، والعمل، ومقاعد الدراسة وحبة الدواء. ما يساعد على تقليص القنوات التي تتوسط العلاقة بين الدولة والمواطن ويمنح اللبنانيين هويتهم العامة التي تحترم تنوعهم لكنها يتُقصي انتماءاتهم الأوليّة إلى عشائرهم ومناطقهم وطوائفهم إلى مراتب متدنية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة المقصودة تنجح في تنكب هذه المهام بقدر ما تتماشى مع جوهر العقد الاجتماعي، وبالتالي بقدر العودة للتشديد على هذا العقد ومراجعته وتجديده ليؤهلها أن تكون دولة الجميع، وأن يُعيد تعريفها بصفتها سلطة مقّيدة، تحتكر العنف لكن تتوفر فيها قنوات التغيير الديمقراطي التي تضمن إمكانية المساءلة والمحاسبة، وإمكانية سحب الشرعية الممنوحة عند الفشل في الالتزام بموجبات التعاقد، وتاليا إمكانية تداول السلطة. وبغير ذلك قد تضاف خمسونٌ على خمسين الحرب، ليصل المحتفون إلى يوبيلهم “الذهبي” على واقعٍ يزداد زرايةً.
سؤال التذكر والنسيان
والحال، إذ لا تغيب النوايا الصادقة عن الفعاليات التي تدعو لتذكر الحرب، باعتبار أن التذكّر، وخصوصًا تذكر الخسائر والأهوال والمآسي، شرطٌ من شروط عدم التكرار؛ فإن ذلك يطرح التساؤل: كيف يمكن للبنانيين الإقامة بين حدّين غير سويّين ويحملان خطر تكرار تجربة الحرب، وهما: النسيان المفرط الذي يعادل الإنكار، والذاكرة الغارقة أو العالقة التي تتحوّل إلى ذاكرة خشنة تُبقي الأحقاد وتؤجّجها؟ والتساؤل التالي: ما الذي يتوجب تذكّره، وما الذي يجب نسيانه من تجربة الحرب الأهلية؟
فيما يجب تذكره
يحضر في العديد من السرديات التي تتناول الماضي اللبناني السابق على الحرب الأهلية، الاستعانة بالكثير من المؤشرات الدالّة على زمنٍ جميل أمعنت الحرب في تقويضه وتهشيمه؛ وعلى الرغم من كون هذه السرديات تتسم بالحنين النوستالجي إلى “لبنان الذي كان”، وتفيد في الإشارة إلى أن ماضي اللبنانيين لا يقتصر على فترات التنابذ والاحتراب الأهلي، غير أن حُسن النيّة لا يعفي هذه السرديات من شُبهة الاختزالية المفرطة لكأنها ترى الشجرة ولا ترى الغابة، وهي اختزالية لأنها لا تُحيط بكافة أسباب الحرب ولا تأخذ بالترابط بين العديد من العوامل المؤثرة بها، وتتنكر لحقيقة أن الحرب ظاهرة مركّبة تشكّل مجموعاً يتكوّن من عددٍ من الجوانب التي يتعلق واحدها بالآخر وتتبادل التأثير فيما بينها. وبالتالي لا يمكن فهم الحرب إلا إذا أعيد وضعها بين الجوانب الفاعلة الأخرى أي الجوانب السياسية والحقوقية والفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. لذا لا شيء يبرّر الاختيار الانتقائي للهواجس بحيث يبرز بعضها ويُهمل بعضها الآخر، ولا يفيد بشيء تصوير الحرب كما لو أنها جائحة انتزعت اللبنانيين من هناءة العيش التي كانت تساوي بعدالة اجتماعية تامة بينهم ونقلتهم إلى غبار المتاريس. ويُضاف إلى هذه السرديات الانتقائية المبادرة إلى لوم الذات على دخول الحرب، لتغدو معالجة نتائج الحرب وكأنها شؤون أفراد لا يكتمل نصابها قبل اكتمال عقد اللائمين. أو سردية التقليل من شأن الأسباب الداخلية وتغليب سببية محورية تتجلى في تنفيذ إرادة الآخرين الغرباء وخوض حروبهم على أرضنا. أو سردية تغليب فرضية التضحية بالنموذج اللبناني وتحميله فوق طاقته كرمى لقضايا الآخرين، ليحضر بذلك وجهٌ آخر لهذا التغليب وهو إنكار حقيقة الاستقواء بالآخرين للضغط من أجل تغيير التركيبة الطائفية التي تعمل تبادلية ثنائية الهيمنة والحرمان على إدامة بقائها وضمان اشتغالها؛ ونستطرد هنا لنشير إلى أنه في هذه التبادلية العجيبة يكمن ليس سر تعاقب هوية المحاربين من أجل حراسة النظام اللبناني أو هوية المحاربين المطالبين بتعديله وإعادة توزيع أنصبة وحصص الطوائف فيه وحسب، وإنما يكمن أيضاً سر تبدل هوية القوى الخارجية المتعاقبة الحاضرة دوماً كمصدر استقواء لتحسين وضعية هذا الطرف الداخلي أو ذاك، وأحياناً فقط لضمان استمرار لعبة التبادلية نفسها، التي تشبه لعبة “يا طالعة يا نازلة”، التي تكف عن الاشتغال ما لم يكن هناك طائفة فوق وأخرى تحت… إنها لائحة لا تنتهي، الهدف منها الإضاءة على أن إقفال صفحة الحرب الأهلية تقتضي بداهةً تذكر الأسباب والعوامل الجمّة والمتداخلة التي أشعلت هذه الحرب، وعلى رأسها التركيبة البنيوية التي تشكّل نسق انتاجٍ دائم للحروب والأزمات، وبهذا المعنى يمكن أن تكتسب الدعوة إلى المصارحة مشروعيتها وأهميتها وجدواها.
في شروط ما يجب نسيانه
يقول جون دولاي إن “النسيان حارس الذاكرة”، وإذا كان الإفراط في النسيان يعادل فقدانها، فإن الإفراط في التذكّر لا يقلّ ضررًا على التوازن النفسي، سواء لدى الأفراد أو الجماعات ؛ وهذا يطرح السؤال ما الذي يبقي ذاكرات الجماعات اللبنانية حيّة على الدوام وتكاد لا تنسى، وما الذي بجعل الماضي يتخذ شكل الجذور التي تمتد في الذاكرة السحيقة وتفسر المعاش؟ في الجواب يمكن لحظ أن صعوبة النسيان لا تتغذى من الماضي المليء بالأحقاد والضغائن وحسب، بل من الحاضر أيضًا، الذي يستدعي الذاكرة الجماعية ويغذيها بمشاهد وأحداث تلعب وظيفة التأهب والتعبئة. ونحن مدينون هنا ليوهان غالتونغ الذي لا يساعدنا فقط على التفريق بين السلام السلبي، بما هو الحيلولة دون نشوب الحرب، والسلام الإيجابي المستقر القائم على مؤشرات قابلة للقياس، بل يساعدنا أيضاً على فهم كيف يمكن أن يمسك الماضي بالحاضر ( ماركس يقول بأن الميت يمسك بتلابيب الحي) عبر كشف أشكال العنف الثلاثة التي تعمل على طريقة الأواني المستطرقة، وتتبادل التأثير وتستدعي بعضها البعض؛ وهي المواقف والسياق والسلوك.
المواقف والتوجهات(العنف الثقافي): يتشكّل من كل ما يُبرّر العنف ويحرّض عليه ويمنحه الشرعية؛ مثل: خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، والتنميط والأحكام المسبقة والتعصب والتعامل الفوقي مع الاختلاف الحاصل في دوائر الهويات الثقافية، والتمييز أو التفاخر القائم على الانتماء المناطقي أو الطائفي، وغيره. وهي توجهات مستمرة وتستفيد خصوصاً مما توفّره وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الإعلام ، ومن كافة المرويات التي تنتقل عبر التواتر الشفاهي وغيره.
السياق( العنف الهيكلي أو البنيوي) يتجلى في غياب العدالة والفقر والتهميش والحرمان وغياب المساواة في الفرص وانتهاكات للحقوق، وانتشار البطالة، وتعثر التعليم، والمحسوبية والفساد. وهي الأشكال التي وسمت مرحلة بناء الدولة بعد انتهاء الحرب، ثم عملت الأزمة المتنامية منذ العام 2019 على مفاقمتها.
السلوك ( العنف المباشر) ويشمل الممارسات السائدة التي لا تزال تطل برأسها بين الحين والآخر، مثل المنازلات الأهلية، والقمع الأهلي والتهديد والتخوين، والتصريحات النارية ونزع صفة المواطنة عن الآخرين؛ وغياب سلوك حقيقي تجاه طيّ ملف الحرب.
النسيان، بمعناه الإيجابي، يعني التسامح، لكنه يفترض مسبقًا المصارحة والحقيقة. وهنا تبرز قضية المخطوفين والمفقودين قسرًا كحقّ أساسي يجب معالجته، بالإضافة إلى الاعتراف بالانتهاكات، وتكريم الضحايا، وتعزيز ثقافة المساءلة، وبناء دولة تستعيد ثقة مواطنيها عبر الإصلاح المؤسسي لقطاعات القضاء والتربية والأمن، وتدعيم احترام حقوق الإنسان (بما فيه حقوق الضحايا) وتعزيز سيادة القانون؛ وصولاً إلى تحقيق المصالحة وإلى بناء سلام إيجابي مستدام، قائمٍ على مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات. فالسلوك البديل لسلوك الحرب والتعامل المسؤول مع نتائجها وتذكر ومعالجة أسبابها، جميعها شروط ضرورية من شروط النسيان.
في الختام، تحويل الثالث عشر من نيسان إلى يومٍ للذاكرة والعِبرة، بعيدًا عن الطابع الفولكلوري، رهنٌ بتوفّر شروط تُنهي هذه المراوحة اللبنانية بين حرب لا تُنسى، وسلام لم يُختبر بعد. وأولى هذه الشروط أن تكون العدالة الانتقالية مهمة الدولة، خصوصاً في ظل التوجهات السائدة التي تتذرع بضعف المؤسسات الحكومية لتوكل ما يفترض أن يكون من مهام الدول واختصاصها إلى المنظمات والأطر غير الحكومية، مع عودة المجتمع المدني إلى أدواره الطبيعية في الضغط والمناصرة والتأثير في رسم السياسات.
المصدر: المدن



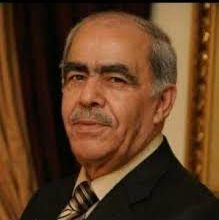



في الذكرى الخمسون للحرب الأهلية في لبنان، لابد من تذكر الوضع وما انتهت اليه هذه الحرب، حرب أشعلتها تدخلات خارجية وتغذية من أطراف دولية، لتجعلها حرب طائفية، علماً بإن بدايتها كانت بتطويع القوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وزرع أجسام لاوطنية لحماية الكيان الصh يوني، وتطويع شعبنا في لبنان، قراءة موضوعية للحدث.