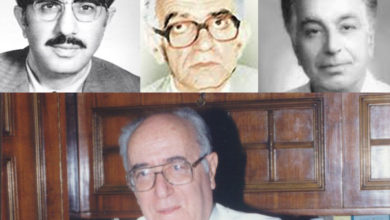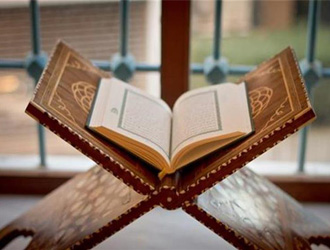
مدخل
منذ فترة أرسل لي أخ عزيز مقطعي يوتيوب يحتويان على هجوم شديد على السنة النبوية، وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، ويحتوي أحدها زعماً بأن التاريخ الإسلامي تاريخ مبتور، قُطع، وفُقد منه، نحو من مئة وخمسين سنة، هي تلك السنوات التي تبدأ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أي تلك السنوات التي تبدأ منها ولادة هذه الأمة.
والحق أن فحش القول في المقطعين مما لم نعهده إلا في القنوات الدعوية الدينية المعادية للإسلام، أما من تلك التي لا تقف في هذا الصف فلم نعهد منها وفيها مثل هذا أبدا.
وحين تتبعت الأفكار المطروحة، ومنطقها العام، وجدت نفسي أمام منهج جماعة تسمى ب “جماعة أهل القرآن”، أو “القرآنيين”، أو “المسلمين الحنفاء”. ولدى هذه الجماعة حشد من الأفكار والمواقف والأحكام غير المسبوقة، تمس دين الإسلام، وجماعة الإسلام وأمته، وإرث الإسلام الحضاري والفكري، ولغة الإسلام، وهي في كل هذا تقيم نشأ جديداً، أو دينا جديداً، وتقدم لنا تاريخاَ وقيماً جديدة، لذلك فإن الاسم الذي أطلقوه على أنفسهم “المسلمين الحنفاء”، أو أطلقه عليهم خصومهم ثم استحبوه هم وتمسكوا به ” أهل القرآن، أو القرآنيين”، لا يعبر عن حقيقة هذه الجماعة، فكل المسلمين قرآنيون، والقرآن هو كتاب المسلمين لا كتاب غيره عندهم، وحين يتطلع المسلم إلى السنة النبوية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما يفعل ذلك لأن القرآن أمر بذلك في آيات كثيرة، لكن الجماعة القرآنية شيء مختلف، تقف على الجانب الآخر من هذا كله.
يمكن أن نبدأ بتقليب صفحات هذه الجماعة من حيث النشأة أولاً، ومن حيث الأفكار والمعتقدات، ومن ثم نتناولها بالنقد، ولقد رأيت أن أبدأ من الأفكار والمعتقدات، لأن هذا هو الأهم، ثم بعد ذلك نعرج على النشأة، قبل أن اختم بنقد فكر هذه الجماعة
أولا: الأفكار الرئيسية لجماعة ” أهل القرآن”.
أقامت الجماعة دعواها على أصلين اثنين، تفرعت عنهما كل الأفكار الأخرى، واستندت إليهما كل الأحكام التي أصدرتها بحق المسلمين، ودينهم، وتاريخهم، ولغتهم.
الأصل الأول: الاكتفاء بالقرآن مصدرا للاعتقاد والتشريع.
الأصل الثاني: إنكار وجود السنة النبوية، وما يتصل بهذا الجانب ويتفرع عنه.
وهذان الأصلان يعنيان بدقة:
** أن كل رأي استند إلى حديث نبوي فهو رأي مهدور، لأن مستنده ” أي الحديث النبوي” لا أساس له عندهم.
** وأن كل منتج فكري أو فقهي أو أصولي أقيم مستنداً إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قيمته الدينية مهدورة، لأنه أقيم على أساس لا وجود حقيقي له، أي على أساس زائف.
** وبالتالي فإن المذاهب والفرق والمدارس الفقهية والعقدية والفكرية التي عرفها التاريخ الإسلامي، “وكلها تحتفي بالأحاديث النبوية”، لا قيمة دينية لها، لأنها كانت فيما تقوم به تنشئ دينا أرضيا يستوي في ذلك السنة والشيعة، لا فرق.
وهم في نفيهم للسنة النبوية، واقتصارهم على القرآن يستندون إلى حجج محددة:
** الحجة الأولى أن القرآن الكريم هو كتاب الله، وأن الله جل وعلا تولاه بالحفظ، وبالتالي فإن كل ما عداه يدخل عليه الزيف والخطأ، والتشريع والعقائد لا بد أن يكون أساسها ثابت لا يداخله خطأ أو زيف.
** الحجة الثانية: أن الرسول ليس مشرعاً، وأن كل قول قاله يجب أن يطابق ما جاء به القرآن دون أي إضافة، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، أي في تبليغ القرآن، وليس في أي شيء غير ذلك. ففيما عدا التبليغ، فإن الرسول مجرد إنسان يصيب ويخطئ، وهو صلى الله عليه وسلم شأنه شأن الرسل والأنبياء جميعا لا يفضلهم في شيء، ولا يتقدم عليهم بمزية، والقول بتقديمه وإفراده شذوذ ومخالفة لما نص عليه القرآن الكريم.
** الحجة الثالثة: أنه ليس هناك قول أو توجيه آخر رواه الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العزة، إذ وحده القرآن له هذه الصفة، فلا أحاديث قدسية، ولا أحاديث وحيها من الله وألفاظها من الرسول، ولا أي شيء من هذا القبيل، فالموحى به فقط هو القرآن، وفيما عدا القرآن فكلام رسول الله ككلام أي أحد آخر.
ولأن من المعلوم أن تفاصيل العبادات غير موجودة في القرآن: الصلاة، الزكاة، الحج، فإنهم يقبلون “السنة العملية” التي انتقلت عبر الأجيال بالسلوك الجماعي، فمن خلال هذه السنة عرفنا أن الصلوات خمسة، وأنها تؤدى على هذا النحو، ….. الخ.
“الفارق بيننا وبين السنيين أنهم يقولون إن السنة العملية هي العبادات، وهذا نتفق معهم فيه، والسُّنّة القولية هي أحاديث البخاري وغيره، وهذا ما نخالفهم فيه. فالله جل وعلا سيحاسبنا وفق ما جاء في كتابه وليس ما افتراه البخاري وغيره” أحمد صبحي منصور / موقع رصيف 22 حوار مع دعاء أحمد 31 / 1 / 2017.
** أن صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وهذه الأمة، انقطعت بوفاته، ففي حياته كانت وظيفته فقط التبليغ، تبليغ الناس القرآن الكريم على وجه الحصر، وبعد وفاته، انتهى الأمر، وكل إضافة يعطيها المسلمون لشخص الرسول إضافة مصطنعة، بدءاً من الحديث عن دوره كمشرع، إلى الحديث عن مكانته المميزة بين الأنبياء، وصولاً الى القول بشفاعته، وسنة زيارة مسجده الشريف، أو حرمة مدينته، أو إدخال الصلاة عليه في صلب صلاة المسلم اليومية، وذلك حين نقرأ في الصلاة الصلوات الابراهيمية …. الخ.
** كذلك فإنهم لا يعيرون أي أهمية لفكرة تفسير القرآن وما بذله علماء المسلمين في هذا الجانب، لأن القرآن عندهم واضح يفسر بعضه بعضاً، ولا داعي لطرق أخرى في تفسير القرآن، ولا أي وسيلة أخرى تتبع لفهم القرآن، فلديهم أن العقل وحده هو الذي يجب الاعتماد عليه لفهم القرآن بالقرآن.
إذن في شأن السنة فإن” جماعة أهل القرآن ” ينفون صحة الأحاديث المروية عن رسول الله نفيا أصيلا، ثم أنهم ينفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة التشريع خارج نص القرآن، ويعتبرون ما نقل عن رسول الله هو تلفيق ليس إلا، باعتباره وصلنا رواية بعد زمن طويل جداً.
واستنادا إلى هذا الموقف، فإنهم يفسرون كل آيات القرآن التي تحض على اتباع الرسول، وعلى الانصياع له وإطاعته، وعلى أخذ والتزام ما أمر به، والابتعاد عما نهى عنه، وأن هذه الطاعة من طاعة الله…. الخ، يفسرون ذلك كله على أنه يقتصر على ما خص وارتبط بنص القرآن الكريم فقط.
بشكل عام هذه رؤية وموقف ” أهل القرآن”، ويتفرع عن هذه الرؤية العديد من المواقف والأحكام الكلية والجزئية:
** ولما كان المسلمون يأخذون بالسنة، ويعتبرون أحاديث رسول الله مصدراً من مصادر التشريع، فإن القرآنيين يرونهم بذلك قد خرجوا عن دين الله، وأصبحوا يتبعون “ديناً أرضياً” لا ديناً سماوياً، وأنهم باتوا مشركين حينما أضافوا إلى شهادة: لا إله إلا الله، لفظ محمد رسول الله، إذ بهذه الإضافة بات المسلمون يعبدون الله ويعبدون الرسول، أي لم يعودوا موحدين، وأنهم أضافوا للصلاة ما نعرفه باسم “الصلوات الإبراهيمية”، ويقولون هل يعقل أن يصلي الرسول على نفسه “، بعض المسلمين مثل بقية البشر نسبوا أعمالهم إلى الله تعالى ورسوله افتراء على الله ورسوله، وبذلك الإفك أقام أولئك المسلمون لهم أديانا أرضية، بدأ بذلك أهل السنة، ونافسهم الشيعة، ثم دخل الصوفية إلى الميدان، وتوالى اختراع الأديان الأرضية في تاريخ المسلمين”، (أحمد صبحي صالح/ مقالته: البهائيون وأديان المسلمين الأرضية 6/8/ 2006)
** وحين نتابع محاضرات وكتابات زعيم هذه الجماعة المعاصر المقيم في الولايات المتحدة “أحمد صبحي منصور ” في موقعه على الشبكة العنكبوتية، نجد الدعوة مبسوطة بأبعادها كاملة، دون أي تزويق، بل نراه ذهب فيها مذاهب في التطرف قد لا يكون دعاتها الأولون من الهنود قد وصلوا إليه، وعنده أن صحابة رسول الله الذين نعرفهم، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الأربعة، والعشرة المبشرون بالجنة، والصحابة الآخرون الذين عايشوا هؤلاء وكانوا معهم، والصحابة الذين نقول بعدالتهم، كلهم كفار خانوا رسول الله عمداً وعن سابق إصرار وتدبير. وكانوا يتطاولون عليه في حياته، بل إنهم اشتركوا في منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكمال تبليغ الرسالة، حينما وصفوه في مرحلة المرض الشديد الذي انقضت حياته فيه “مرض الموت” بأنه يهجر، ورفضوا أن يقدموا له ما يعينه على أن يكتب لهم ما كان يريد أن يكتبه “كتابا لا يضلوا بعده أبداً”.
إنهم هنا لا يتحدثون عن أفراد منافقين تسللوا إلى من نصفهم بالصحابة ” إذ نعتمد مفهوم أن الصحابي هو كل من شاهد رسول الله”، وتحدث عنهم القرآن، وتحدث عنهم رسول الله، ولكن الحديث هنا يستهدف ويصيب أعلام الصحابة، وكلهم ممن حضروا بيعة الرضوان، وشهد الله لهم ورضي عنهم “لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحا قريبا “الفتح/18
** وإذا كان هذا حكمهم على الصحابة، فإن حكمهم على عملية تدوين الأحاديث النبوية، والصحاح والسنن، والمجاميع، تحصيل حاصل، لأن الخلل في هذه الصحاح والسنن والمجاميع يأتي من طرفين: من أن هؤلاء “العلماء”، جمعوا ما اعتبروه أحاديث بعد مئات السنين، ثم إنهم جمعوا الرواية عن “الصحابة”، والصحابة هم أنفسهم “كفرة منافقون” خانوا الله والرسول.
** وفي خضم هذا المنطق تصبح عندهم حركة الفتوح الإسلامية “جريمة” ارتكبها الصحابة بحق هذا الدين، مثلها مثل الحروب الأهلية التي أدخلوا فيها المجتمع الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ارتكبوا جريمة اختراع أحاديث ونسبتها إلى رسول الله.
وإذا كان هذا هو الرأي بالصحابة والأحاديث النبوية والفتوح الإسلامية، فإن الرأي عندهم يذهب إلى المنتج الحضاري لهذه الأمة، فكل هذا المنتج الذي أقيم عليه صرح الحضارة العربية الإسلامية، أو الحضارة الإسلامية عموما، لا صلة له بالدين، وكله نتاج أنظمة ليست في الأصل إسلامية.
** والذي يطالع كتاب أحمد صبحي منصور المنشور باسم ” أكذوبة المسجد الأقصى”، يمكن أن يكتشف إلى أين ذهب أصحاب هذه الدعوة، ففي هذا الكتاب يسمي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب”القبر الرجسي”، ومسجده ب”المسجد الضرار”، مثله في ذلك مثل المسجد الأقصى الذي أنشأه عبد الملك بن مروان مكان الهيكل الإسرائيلي، ويعلن هدفاً له هو هدم هذا المسجد الأقصى، ” الذى يعنينا هو هدم صنم مقدس للمحمديين، وهو ما يسمى بالمسجد الأقصى في القدس، هو مسجد أسسه عبد الملك بن مروان على الضلال من أول يوم، ليصرف الناس عن الحج للبيت الحرام ..وأسسه على أنقاض الهيكل الإسرائيلي في القدس…. وبسبب هذا المسجد الضرار (الأقصى) في القدس تمت التعمية على المسجد الأقصى الحقيقي في طور سيناء، ثم أصبح هذا المسجد الأقصى الرجسى مقدسا لدى (المسلمين) يعتبرونه أول القبلتين وثالث الحرمين…….وبسبب هذا المسجد الضرار الأقصى في القدس تم إقحام دين الإسلام العظيم في الصراع العربي الفلسطيني ……. ووقعوا في الكفر العقيدي أسسوا معابد مقدسة رجسية منها هذا الأقصى في القدس الذي جعلوه أولى القبلتين وثالث الحرمين، وذلك القبر الرجسى المنسوب للنبي محمد في مسجد المدينة، وجعلوه ثاني الحرمين، وأوجبوا بأحاديث شيطانية الحج إلى هذا وذاك “.
هل يكفي ما سبق في تبيان أفكار هذه الجماعة، قد يستطيع الباحث إضافة قضايا أخرى خاصة بالأحكام والفقه الذي يعرضوه بدلا عن الفقه الإسلامي المعروف، لكنني أكتفي بهذا القدر لأنتقل إلى الحديث عن الولادة التاريخية لهذه الجماعة.
التعريف بمنشأ جماعة القرآنيين
ونقول بشكل قاطع إن هذه الجماعة ذات منشأ حديث، الذين يبحثون عن هذه الجماعة عبر الشبكة العنكبوتية وفي موقع ويكيبيديا سيجدون إشارات أولية معتمدة من الجماعة بأن أصول هذه الدعوة تعود إلى موقف عمر بن الخطاب الذي منع تداول الحديث، أو إلى موقف الخوارج في معركة صفين الذين دعوا إلى تحكيم كتاب الله بدل الاحتكام إلى رأي المحكمين، أو إلى موقف المعتزلة الذين رجحوا جانب العقل في النظر إلى أحاديث رسول الله، وقد وصلوا في التتبع إلى العصر الحديث ـ مشيرين إلى الإمام محمد عبده، وإلى الامام محمود شلتوت، اللذين كانت لهما آراء في أحاديث موجودة لدى البخاري ومسلم، رأوا أنها تنافي العقل، أو تتنافى مع ما أكده القرآن.
والحق أن الصلة منعدمة بين كل من سبقت الإشارة إليه، وبين هذه الجماعة، إذ أن الاعتماد على السنة النبوية لم يخرج عنها أحد ممن تمت الإشارة إليه، لكن كان التدقيق ينصب على حوادث معينة (التحكيم) أو نصوص وأحاديث بعينها فحسب، أما هذه الجماعة فموقفها مختلف وهو موقف الرفض للسنة كلها، وهو موقف لم يكن له نظير في تاريخ المسلمين وحضارتهم: “الخلافة الإسلامية، والدول الإسلامية، والمجتمعات الاسلامية”.
منذ أن نزلت الرسالة، لم يقل بذلك عالم، ولا جماعة، ولا مذهب، ولا طائفة: تاريخنا، ورجالات أمتنا، وعلماؤها، بريؤون من هذه الدعوة، حتى جاء هؤلاء، في هذا العصر، فكانت عموم هذه الأفكار بدعة ابتدعوها لم يسبقهم إليها أحد.
بداية هذه البدعة كانت في مطلع القرن العشرين في لاهور بالهند التي كانت تحت الاحتلال البريطاني، وجاءت على يد “غلام نبي” المعروف ب”عبد الله جكرالوي” ت 1914، وقد أسس حينها الحركة القرآنية، على قاعدة “الاكتفاء بالقرآن في تفسير القرآن وفهم الإسلام، ” وظهر من بعد جكرالوي في شرق الهند، “محبُّ الحقّ عظيم آبادي”، وأسّس الحركة القرآنيّة هناك، وظل يدافع عنها حتى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين. وجاء بعده “أحمد الدين الأمرتسري” المتوفي سنة 1936م، فأسّس جماعة (أمّة مسلمة) سنة 1926م، ثم بعد ذلك جاء الحافظ “أسلم الجراجبوري” المتوفى عام 1955م، فساند حركة رفض نظام الإرث القائمة على السنّة، لكنّه ركّز اهتمامه النقدي بشكل مبالغ فيه على الحديث وعلم الرجال، واعتبر أنّ الأنظمة التي وضعها علماء الإسلام في مجال الحديث، وعلم الرجال غير قادرة على تقديم نتائج يُطمئنّ لها. واستمرّ تطوّر الحركة القرآنيّة في شبه القارّة الهنديّة، إلى أن جاء أهمّ شخص فيها وهو “غلام أحمد برويز” المتوفي عام 1985، وهو الذي يُطلق عليه اسم: مؤلّف الحركة القرآنيّة؛ إذ كان عطاؤه العلميّ غزيراً، فقد آمن برويز بالعلوم العصريّة ودافع عن تفسير القرآن، وأسّس حزباً تحت عنوان “طلوع إسلام”، وعُدّ حزبه من أقوى الأحزاب وأنشطها، وشهد فترة ذهبيّة هائلة في الخمسينيّات والستينيات من القرن العشرين، لكنّه تراجع تراجعاً كبيراً بسبب سيلٍ من فتاوى التكفير التي حُملت على القرآنيين من قبل فقهاء أهل السنّة، والمجامع العلميّة لديهم، من مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي أدّى إلى ضمور حركته وانحسار الحركة القرآنية في شبه القارّة الهندية عموماً، وباكستان خصوصاً”.
كان هذا شأن هذه الدعوة في الهند، كما كتب الشيخ الاثني عشري “حيدر حب الله” في مقالة له منشورة على موقع مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط، أما في البلاد العربية فقد ظهرت هذه الدعوة في مصر على يد الدكتور “أحمد صبحي منصور”، الأزهري، وظهرت في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وهي الفترة التي بدأ انفتاح النظام المصري فيها على إسرائيل، وعقد المعاهدات معها، وفتح أبواب مصر أمام جماعات البحث الأمريكية التي كانت تقوم بدراسات ميدانية موسعة من أجل التعرف على طبيعة المجتمع المصري بعد عصر جمال عبدالناصر، وعصر الصراع مع الإمبريالية، ومواجهة الكيان الاسرائيلي، ومشروع بناء نهضة مصر المعاصرة المستقلة من خلال منظومة علاقات ومفاهيم وقيم داخل المجتمع وعلى المستوى الدولي غير مسبوقة.
في مقالة له على موقعه بعنوان “ماهي جريمة القرآنيين” يروي منصور مرحلة انطلاق هذه الدعوة في مصر، وما واجهه فيها، من صراعات وملاحقات وخصومات دفعته في نهاية المطاف إلى الهروب من مصر إلى الولايات المتحدة عام 2002 حيث أقام، واستقامت له دعوته.
ويقول منصور إن الضغط عليه ومحاصرته بدأ منذ كان طالباً يحضر رسالة الدكتوراه حيث اضطر لحذف ثلثي الرسالة بسبب الاعتراض الشديد على مضمونها، ثم حين أصبح مدرساً في الأزهر استمر الضغط عليه، حتى تمكنوا من فصله من التدريس في العام 1987، وصدر بحقه حكم بالردة من مؤتمر إسلامي عقد في إسلام اباد في ذلك العام، وكان رئيس باكستان حينها ضياء الحق، وتعزز الحكم بنظيره من مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في جدة من العام نفسه.
ويذكر في مقاله أنه عمل في الصحافة ثم عمل ونشط لسنوات عدة في “مركز ابن خلدون” مع الدكتور سعد الدين إبراهيم، وأنه بعد أن استقر في الولايات المتحدة أسس في العام 2005 المركز العلمي للقرآن الكريم في ولاية فيرجينيا، وموقعه على الانترنت “أهل القرآن”. ومن خلال هذا الموقع بدأ ينشر كتبه وأبحاثه للتعريف بمنهجه والدعوة إليه.
ولم يذكر منصور في مقاله هذا الفترة التي كان فيها متعاونا مع الأجهزة الأمنية في مصر، وكان يتنقل ويحاضر برعايتها وحراستها.” كما أوضح بنفسه في مقابلة تلفزيونية مع قناة مصرية يجد الباحث مقاطع منها على اليوتيوب.
هذا هو مسار الشخصية الرئيسية والمؤسسة على الساحة العربية في جماعة “أهل القرآن”، وهناك آخرون معه في الترويج لفكرة تجريد الإسلام من السنة النبوية، ومن كل آثارها، والذي يطالع الشبكة العنكبوتية سيجد عدداً من الأسماء معظمهم من مصر.
ثالثاً: نقد آراء هذه الجماعة
من مدخل الإعراض عن السنة، واعتبارها غير ذات معنى لأنها لا تمت للرسول صلى الله عليه وسلم بصلة، ولأنها تضيف للرسول مهمة ليست من مهامه، ولدت كل الأفكار والمفاهيم والمواقف التي طرحها أصحاب هذا الرأي، ويستشهدون في دعم آرائهم وحججهم للإعراض عن الحديث والسنة، بوجود أحاديث في الصحاح والسنن منسوبة إلى رسول الله لا يقبلها العقل، أو أنها تخالف ما اعتُبر نصاً قرآنياً قاطعاً، ويستشهدون كذلك بفتاوى وآراء فقهاء لا تبدو قويمة، أو أنها واضحة الشذوذ.
والحق أن نقد أصحاب هذا الرأي “إن صح أن ندعوه رأياً”، لا يجوز أن ينطلق من محاولة تبرير أو تصحيح أو التدقيق في هذه الأحاديث، أو الفتاوى، أو الآراء التي يوردونها توكيدا لرأيهم في هذا المجال، فمثل هذا المنهج يدفع الحوار إلى سبل متفرعة لا تنتهي، ثم إنها ليست ذات قيمة في منهج البحث.
الأصل الذي يجب الوقوف عليه مع جماعة أهل القرآن هو: “السنة”، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي القضية المركزية، مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يتصل بهذه القضية، سواء ما يتصل بنصوص القرآن، أو بالرجال” الصحابة”، وما ترتب على ذلك كله من أحكام بالشرك على مجتمع المسلمين.
نحن هنا لا نبحث ما إذا كانت هناك أحاديث غير صحيحة، تسللت إلى ما جمعه علماء الأمة من أحاديث رسول الله، ووجِدت في صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو غيرهما من كتب السنة، أي لسنا في مجال الحديث عن التدقيق في الأحاديث، وغربلتها، لإبعاد ما يمكن الشك فيه عنها، فهذا مجال آخر لا صلة له بهذا السياق.
السؤال هل هناك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة، ونقلت عنهم حتى وصلت الينا، أم لا؟
ثم هل لهذه الأحاديث أو بعضها صفة التشريع، على مختلف درجات التشريع؟
وكذلك هل كان هناك صحابة حول رسول الله، بنوا معه مجتمع المسلمين الأول، وهم الذين حملوا من بعده عبء ومسؤولية بناء هذا المجتمع، وتطويره، وعبء ومسؤولية حمل الرسالة، “الحفاظ عليها وصيانتها ونشرها”؟
من حيث العقل والطبيعة الإنسانية، لا يمكن ألا يكون هناك أحاديث لرسول الله، وهو رجل قام بالدعوة على مدى 23 عاماً، وهو في مكة حاور وخاصم واصطدم، وسمح لأتباعه بالهجرة إلى الحبشة، ثم حالف وبايع وفتح الطريق للهجرة إلى المدينة، وهو في المدينة وجه المسلمين وغير المسلمين، ودخل أحلافاً وحروباً، وأقام دولة، وأفتى وأصدر أحكاما في منازعات، وعقد معاهدات، ونقل عن ربه قرآنا استمر نزوله بالتوالي طوال كل تلك الفترة.
ومن حيث العقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل هذا الحراك: التواصل مع الله عبر الوحي، والتواصل مع البشر عبر مسار الحياة اليومي، كان يخلف تساؤلات، ويطرح مشكلات، ويستدعي إجابات، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لكل ذلك، ويلبي كل هذه الاحتياجات، لأنه كان صلى الله عليه وسلم، أكثر الأشخاص فهماً للرسالة، وإدراكا لمقاصدها، ولأن إفهام الرسالة وشرحها، وتوضيح مقاصدها، هو الوجه الثاني من مهمة التبليغ الموكلة للرسل، وهي مهمة أثبتها الله في كتابه الكريم حين قال: (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون) النحل / 43ـ 44 ، والتبيين معنى مختلف عن التبليغ. فقد ذكر الله مهمة التبليغ وهي مهمة أولى للرسل جميعا بقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين) المائدة 67.
لا بد أن تكون هناك أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، إنكار ذلك فيه شيء من اللاعقلانية، أو العبث.
ومن حيث العقل والطبيعة الإنسانية فإن رسولاً ونبياً وقائداً لا شك سيحظى كل ما يقوم به باهتمام ومتابعة وتَمَثُل أصحابه، ولا شك أن رسول الله كانت له مكانة متميزة بين أصحابه، كانوا يحتفون به، وكانوا يهتمون بكل ما يقوم به ويقوله، وكانوا يتابعونه في كل صغيرة وكبيرة، كان هو التجسيد للدين الذي ارتضوه لأنفسهم، وافتراض غير ذلك مما لا يصح عقلاً.
السؤال الذي يطرح أمام من ينكر السنة النبوية: أين ذهب هذا كله؟
الحديث عن أن كتاب الله هو وحده المعتمد حديث فيه الكثير من الإغراء،
لكن
لنمضي معه ببعض التدقيق.
من نقل كتابَ الله إلينا؟
الجواب أن جبريل عليه السلام نقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نقله إلى الصحابة، والصحابة جمعوه جمعاً أوليا زمن “أبو بكر الصديق”، ثم نسخ ووزع زمن عثمان بن عفان، رضي الله عنهم جميعاً.
إن هذا يعني أن القرآن الكريم، لم ينزل من عند ربنا كتاباً، أو ألواحاً، وحُفظ لنا هكذا، وإنما نزل آيات منجمة، حفظ في الصدور، وفي الرقاع، ومن ثم، حين استحر القتل بحفظة القرآن في حروب الردة “حرب اليمامة”، كان رأي الصحابة أن يُجمع كتاب الله في حيز واحد، ومكان واحد.
والتاريخ يروي أن أبا بكر لم يكن من هذا الرأي بداية، باعتبار أن هذا عمل لم يقم به رسول الله، ولم يوص به، لكن عمر استمر يراجع أبا بكر في الأمر حتى فتح الله عليه. ثم كلف أبو بكر الصحابي “زيدَ بن حارثة” أن يجمع كتاب الله، يقول زيد: “فتتبعتُ القرآن أجمعه، من العُسب، واللخاف، وصدور الرجال”، واعتمد زيد منهجاً صارماً في جمع القرآن، وقبول الآيات المتفرقة من الصحابة، ومنهج زيد مبسوط في كل المصادر التي تحدثت عن جمع القرآن، وأولها كتب الحديث.
ما أريد أن أثَبتَه هنا أن القرآن نقل إلينا رواية، وعبر العسب واللخاف، حتى صار كله مكتوبا، وما زالت الرواية هل الأصل والمرجع في ضبط القراءات القرآنية، وليس النص المكتوب، إذ صحة النص المكتوب آتية من مطابقته للرواية، وليس العكس، فإذا كان هناك من يريد أن يوقع الشك بطريق الرواية، فإن شكه يجب أن يذهب أولاً إلى القرآن، قبل أن يذهب إلى السنة.
والقول إن القرآن محفوظ بحفظ الله له، لقوله تعالى” إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون”، الحجر /9 ، وقوله تعالى ” لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه” 16، 17 / القيامة، ليس دليلاً إذا اتخذنا موقفاً مناهضا للسنة والحديث، لأن الشك لا بد أن يطال هذه الآية وغيرها، فالذي أكد أن هذه الآية وغيرها من آيات القرآن قد أنزلها الله جل وعلا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها لنا عن المصطفى الصحابةُ رضوان الله عليهم، ونحن لا نجد ذلك إلا في أحاديث رسول الله، فإذا كان الطعن والرفض يطال في الأصل” الحديث والسنة” فإن الشك لا بد أن يطال كل ما وصل إلينا عن هذا السبيل.
من أين عرفنا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو” القرآن”، الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
من أين عرفنا أن هذا الترتيب في المصحف هو الترتيب الذي أنزله وأراده رب العزة؟
من أين عرفنا أن هذه الآية أو تلك، هي في الموضع الذي وضعت فيه في المصحف؟
من أين عرفنا بوجود القراءات السبع أو العشر المتواترة للقرآن الكريم وكلها يتعبد بتلاوتها؟!
من أين عرفنا أن القرآن قد جمع زمن “أبو بكر الصديق”، وأنه نسخ في زمن “عثمان”؟
من اين عرفنا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرة الدعوة، ومسيرة بناء الدولة زمن الرسول الكريم … الخ؟!
كل هذا الذي عرفناه، عرفناه من السنة، وتحديداً من السنة القولية، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة العملية.
إن الذي يطعن بوجود السنة والحديث النبوي، إنما يكون قد طعن أو فتح الباب للطعن بالقرآن الكريم نفسه. وبالتالي طعن في الإسلام، فليس لدين الإسلام غير هذه المصادر.
الرسول المشرع، والنسخ في القرآن
هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دور المشرع؟
هم ينفون ذلك نفياً قاطعاً، وهذا النفي ضروري عندهم لأنه أحد الأعمدة التي يقيمون عليها فكرة نفي السنة، لأن الإقرار بكونه مشرعاً يستدعي بالضرورة البحث عن هذا الجانب باعتباره جزءاً من مكونات التشريع في الدين الاسلامي.
وكون الرسول مشرعاً أدلته عديدة في كتاب الله، ولقد كان لعلماء المسلمين أبحاث مستفيضة في هذا الجانب، بينوا فيها الأحكام المجملة التي جاء عليها القرآن، ثم جاء تفصيلها من قبل رسول الله، وليس الأمر هنا مختص بالعبادات، وإنما بمختلف شؤون الجماعة الإسلامية والمجتمع الجديد، وهذه كلها جزء من التشريع الإسلامي.
وقد يكفي للدلالة على المكانة التشريعية للرسول الكريم التذكير بآيات محددة جاء عليها كتاب الله، قال تعالى:”… وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون” النحل 44. وقال الله تعالى: “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون” النور/ 56. وقال تعالى: “وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون” آل عمران / 132. وقال تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا” النساء/59، فالطاعة المأمورون بها هنا لله وللرسول وإلى أولي الأمر، لكن حين الخلاف يرد. الأمر في حسم الخلاف إلى الله، وإلى الرسول.
وقال تعالى: “لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم” النور/ 63
وقال تعالى “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكن لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا” المائدة 92
وينفي أتباع هذه الجماعة مفهوم ” النسخ في القرآن”، ويعرضون هذا النفي، وكأنه اكتشاف أو سبيل جديد يسلطون الضوء عليه، ولم يعرفه علماء المسلمين من قبل، ويقولون إن النسخ الوارد في القرآن هو فقط بمعنى “نقل صورة عن الكتاب المعني”، وليس كما يقول علماء المسلمين أنه بمعنى الإزالة، ويعتبرون النسخ الذي قال به العلماء شأن عظيم، وجرم بحق القرآن ارتكبه هؤلاء العلماء بليل بهيم، ولأغراض بأنفسهم، لم يكشفوا عنها. ولعلهم يستندون في تمرير هذا الزعم إلى أن الاهتمام بهذا الجانب من علوم القرآن من شأن المختصين فقط.
يقولون باستنكار: كيف يمكن أن تنسخ آيات من القران، أو يتخذ الرسول مكان رب العزة في التشريع، فيكون مشرعاً كما أن الله مشرع، وهم في هذا الطرح يريدون أن يثيروا القارئ الذي لا معرفة له بقول العلماء في هذا الشأن، ولا دراية له بعلوم القرآن، لكن هذا قول لا يصمد أمام البحث والتدقيق بأبسط مستوياته:
** فالنسخ فرع من فروع علوم القرآن، وفيه رد على كل ما أثارته هذه الجماعة من شبهات لا قيمة لها، وهذا كله لا يعدو أن يكون توهيما لا حظ له من الواقع، والذي يطالع ما جاء في “معرفة الناسخ والمنسوخ ” من كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي “ت 794 هجري،” أو ما جاء في هذا الباب عند الإمام السيوطي “ت 849 هجري” في كتابه ” الإتقان في علوم القرآن”، سيجد إجابة على كل تساؤل يطرح في هذا المجال، وسيجد أن العلماء تناولوا مفهوم النسخ بكل أوجهه، وناقشوا جواز وجود هذه الأوجه في القرآن، وأدلتهم من القرآن على ما جوزوه، وعلى ما منعوا جوازه.
يقول الزركشي: ((فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة، ومنه قول الله تعالى، (فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) النحل / 101، ويعطينا أمثلة من كتاب الله على هذا النوع من النسخ.
والنسخ يأتي بمعنى التبديل والتحويل كقوله تعالى (وإذا بدلنا آية مكان آية) الحج / 52.
والنسخ يأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع “وهو ما أشار إليه هؤلاء، واعتبروه بأنه المعنى المعتمد شرعا في القرآن”، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه، قال مكي: وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن وأنكر النحاس إجازته أيضاً …..
ثم اختلف العلماء فقيل: المنسوخ ما رفع تلاوة تنزيله، كما رفع العمل به….. وقيل لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل…. وقيل إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه، والنسخ لا يكون إلا من الأصل…..
والصحيح: جواز النسخ ووقوعه سمعاً وعقلاً.
ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن … وقيل السنة إذا كانت بأمر من الله عن طريق الوحي نَسَخَت، وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه. … لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، … واختلف في نسخ الكتاب بالسنة، …… والجمهور على أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي، وزاد بعضهم الإخبار وأطلق، وقيدها آخرون بالتي يراد الأمر والنهي.)).
ثم يورد ثلاثة تنبيهات ويختمها بفائدة من المهم أن نعرضها في هذا المقام
((فائدة:
قيل في قوله تعالى (ما ننسخ من أية..) البقرة / 106، ولم يقل “من القرآن”، لأن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب، وليس يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل، بين الله ناسخه عند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول، والعدة، والفرار في الجهاد ونحوه، وأما غير ذلك فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل، كالسبيل في حق الآية بالفاحشة، فبينته السنة، وكل ما في القرآن مما يدعى بنسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن/ وقال سبحانه: (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس) النحل / 44. وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ، وإنما هو نسأ وتأخير، أو مجملا أُخِر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب آخر، أو مخصوص من عموم، أو حكم عام لخاص، أو لمداخلة معنى في معنى.
وأنواع الخطاب كثيرة، فظنوا أن ذلك نسخا وليس به، وأنه الكتاب المهيمن على غيره، وهو في نفسه متعاضد، وقد تولى الله حفظه فقال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر / 9.)).
في كل ما قدمنا نقلا عن الإمام الزركشي، لم نكن نقصد الرد على زعم أولئك بشأن النسخ، وتفنيد ما قالوه، ولم يكن قصدنا أن نقدم للقارئ بسطا لهذه المسألة كما بسطها الإمام الزركشي، ولكنا أردنا فقط توضيح أن كل التساؤلات التي طرحها أولئك كحجج لم تكن غائبة عن علمائنا، وأنهم تتبعوها وجاؤا بالأدلة والآراء والمواقف المختلفة وثبتوا ما رأوه صحيحاً، ونقضوا ما رأوه غير ذلك، واحترموا آراء العلماء المخالفين، ومن يريد أن يتزيد في هذا الشأن فهذه المصادر والمراجع متاحة بيسر.
تفسير القرآن بالقرآن
وهذا عنصر رئيس من عناصر دعوة تلك الجماعة، وكما أشرت سابقا فإنها دعوة مغرية، وتأتي منهم وكأنهم يعرضون طريقا لتخليص وتشذيب كل التفاسير مما لحق بها.
لكن القول بتفسير القرآن بالقرآن ليس قولا اختُص به هؤلاء، بل هو قول مستقر عند علماء التفسير، وقد ألف العلماء تفاسير تعتمد تفسير القرآن بالقرآن قديما، وحديثا “انظر على سبيل المثال تفسير عبد الكريم الخطيب: التفسير القرآني للقرآن”. إذ الأصل عند علمائنا أن يفسر القرآن بالقران، فإن لم يكن هذا متاحاً، فأفضل وخير من يفسره ويكشف مكنوناته، ويُعًرف إلى محكمه ومتشابهة، هو من تلقى هذا الكتاب ابتداء، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل الرسول ذلك، فإن احتجنا إلى شيء بعد ذلك فعلينا بالرعيل الأول الذي تلقى الكتاب من رسول الله، وتعرف إلى أسراره من رسول الله، وصاحَبَ النزول منجماً، يعرف متى نزلت هذه الآية، وأين نزلت هذه الآية، ومناسبة نزولها.
وفي ذلك يقول ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير:
“فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أحسن طرق التفسير في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان فإنه قد يفسر في موضع آخر، وما اُختصر من مكان فقد يبسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقران، وموضحة له، ……..وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القران ولا السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك، لما عهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم “.
وهذا المنهج الذي يحدده ابن تيمية، وينقله عنه الدكتور أسد رستم في كتابه القيم “مصطلح التاريخ”، هو المنهج المتوافق مع العقل والمنطق، وهو لا يخص تفسير القرآن وفهمه فحسب، وإنما يخص تفسير أي نص، أدبي كان أم علمي، نثري كان أم شعري، فالأصل في التفسير العودة إلى صاحب النص، وإلى بيئة النص وأهله وأصحاب الاختصاص به، وكل ذلك في إطار ما تسمح به لغة النص ذاته.
أما القول بأن القرآن لا يحتاج إلى تفسير، وأنه يفسر نفسه بنفسه، فهذا ادعاء تنفيه آيات القرآن الكريم، كما ينفيه المنطق والمشاهد، فحين يقول القرآن الكريم ” … وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ” النحل / 44، فإن منطوق الآية لا يشير إلى تبليغ آيات القرآن المنزلة، وإنما يشير إلى وظيفته صلى الله عليه وسلم في توضيح وتبيين هذه الآيات، وما استدعته من تساؤلات واستفسارات، أما التبليغ فقد قال الله تعالى بشأنه ” يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين” المائدة / 67، فالتبليغ والإبانة من مهام الرسول، وهما أمران متمايزان.
كذلك ينفي هذا الادعاءَ المنطقُ والمشاهدُ في مختلف شؤون الحياة، فالشرح والتبيين ضرورة وحقيقة، يراها رجل القانون فيما يتعرض إليه من نصوص قانونية، وهو لأجل ذلك يلجأ الى شراح القانون، وإلى أحكام المحاكم الأعلى وصولاً إلى المحكمة الدستورية العليا، ويراها رجال الأدب ورجال العلوم الطبيعية والإنسانية، للوقوف على مدلولات الكلمات، والعبارات، والأحكام، والنصوص.
ولا يشذ القرآن الكريم عن ذلك، لأنه يتعامل مع الجهة نفسها التي تتعامل معها كل العلوم الإنسانية وهي “الإنسان”، إذ ليس القرآن هو الذي يحتاج إلى الشرح والتوضيح والبيان، وإنما هو الإنسان الذي يتلقى هذا القرآن، الإنسان هو الذي تتفاوت مستوياته في الفهم، وهو الذي يطلب الشرح والإيضاح والتوثيق، وهو الذي كلما تقدم به الزمن، وبَعُد عن زمن المصدر، أو عن بيئة المصدر، ازدادت حاجته لذلك، ومن ثم يتحول التوضيح والشرح إلى اكتشاف قواعد تعتمد لبيان المقصود ولاكتشاف المراد، ثم هو بعد فترة يجمل ذلك كله في قواعد ومناهج محددة، أي يقعد القواعد في التعامل مع هذه النصوص وفهمها.
هذا منهج العقل والعلم، وهو نفسه منهج القرآن الكريم، ومنهج الرسول الكريم، ومنهج الصحابة، وما قاله ابن تيمية يلخص الطريق التي اتبعها المسلمون لفهم كتاب الله وفهم مراد الله فيما جاء به القران الكريم.
تدوين الأحاديث النبوية
وفي خضم إحكام نفيهم للسنة النبوية يقولون إن السنة التي نطالعها لا صلة لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال تنسب إلى رسول الله افتراءً عليه، وإن هذه “السنة” لم تدون إلا في القرن الثالث للهجرة، وإن “أئمة المسلمين”، بدءاً من “عصر الخلفاء الراشدين ووصولا إلى الخلفاء العباسيين”، وضعوا هذه الأحاديث ممالأة للحكام الذين كانوا يبحثون عن شرعية لحكمهم مستمدة من الدين، ثم يضيف هؤلاء إنه لا توجد وثيقة يمكن اعتمادها بشأن المائة وخمسين سنة الأولى من تاريخ الإسلام، وإن كل ما هو موجود قيل عن قال، رواية عن أشخاص لا يعضدها ويدعمها شيء، وبالتالي فإن الرواية مهدورة عندهم.
ويحتجون بأن مدونات الأحاديث “الصحاح والمجاميع والسنن” كلها وضعت بدءاً من ذلك القرن، ويقدمون دليلاً على ذلك أن العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين لم يشهد تدوين الحديث.
وهذه “الحقيقة” التي تبدو وكأنها تاريخية هي “حقيقة مزورة”، سندها في التزوير: التلاعب بالمصطلحات، فلا يفرقون بين: كتابة الحديث، ورواية الحديث، وتدوين الحديث، ومنهج عمل العلماء في تدوين الحديث.
ونحن إذ نسمها بالتزوير فلأن هذه الجماعة تورد جانباً من الحقيقة التاريخية، ثم تعتبر هذا الجانب هو كل الحقيقة، ثم تذهب في تفسيرها المذاهب التي تريد. وحتى نتبين الأمر على جليته نكتفي بتوضيح محدد:
1ـ منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدون الصحابة حديثه كما كانوا يدونون القرآن، وأمرهم بدل ذلك أن يرووا عنه،( فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج) رواه مسلم في الزهد والرقاق، وأحاديث عديدة في هذا الشأن، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، وفي تذكرة الحفاظ للذهبي أن أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، وفي طبقات ابن سعد (أن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها)، وهذا يعني أنها كانت مكتوبة، وروى الذهبي عن عبد الرحمن بن عوف قال: “ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق، عبد الله بن حذيفة وأبا الدرداء وأبا ذر، وعقبة ابن نافع ، فقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله في الأفاق، قالوا: تنهانا ؟ قال لا، أقيموا عندي، لا والله، لا تفارقوني ما عشت، فنحن أعلم نأخذ منكم، ونرد عليكم فما فارقوه حتى مات”.
2ـ تاريخيا بدأ تدوين الحديث في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99ـ 101) الذي تولى الخلافة لسنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، وهو الذي أمر الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب (ت عام 124 هجري) الموصوف بعالم الحجاز والشام بتدوين السنة، “فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء…. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً”، ويروي أخو ابن شهاب الزهري عنه قوله لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها ولا نعرفها ما كتبت حديثاً ولا أذنت بكتابته. ” السنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب”.
3ـ وكان “موطأ الإمام مالك( 93 ـ 179 ) أولَ مصنفٍ فقهي جمع أحاديث رسول الله على منهج محدد، وقد أمر بوضعه أبو جعفر المنصور (ت 158) على منهج حدده له ” يا أبا عبد الله ضع الفقه ودون منه كتباً، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر، وشوارد عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور، وما اجتمع إليه الأئمة والصحابة، لنحمل الناس إن شاء الله على عملك وكتبك ونبثها في الأمصار ونعهد إليهم ألا يخالفوها”، يقول مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ.
4ـ ومن قبل كان هناك عدد من الصحابة يسجلون ويدونون لأنفسهم أحاديث رسول الله، وذكر الدكتور نور الدين عتر في كتابه “منهج النقد في علوم الحديث” أن كتابة الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متاحا لعدد من الصحابة، وأن ما تضمنته صحف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من الحديث ´يبلغ في مجموعه ما يضاهي مصنفا كبيرا من المصنفات الحديثية”، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وله صحيفة فيها مقادير الديات وأحكام الأسير، وعبد الله بن عمرو بن العاص وله الصحيفة الصادقة، وقد أورد الإمام أحمد جزءاً من هذه الصحيفة في مسنده، وسعد بن عبادة، وله صحيفة أورد منها الترمذي في سننه بقوله: “وجدنا في كتاب سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. كذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب لبعض الصحابة حديثه حين أبدى هذا الصحابي حاجته لهذه الكتابة، ونرى أمثلة لذلك في كتب الحديث، ولهؤلاء الصحابة: الخلفاء الراشدين الأربعة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، وغيرهم فقه استند إلى ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فقهوه من القرآن، بحثه العلماء في عصور عدة وصنفوا فيه ” انظر في ذلك، د. محمد رواس قلعه جي، سلسلة موسوعات فقه السلف”
5ـ وقبل ما سبق كذلك هناك مجموعة كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عماله في بيان الكثير من شؤون الاسلام وقضايا المجتمع، عهوده صلى الله عليه وسلم ومنها صحيفة المدينة، وكتبه إلى بعض الصحابة في شؤون معينة، وكل هذا مثبت في الصحاح.
وقد أورد محمد حميد الدين صوراً لبعض “الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة” في كتابه الذي هذا عنوانه، وفي هذا الكتاب أكثر من ستمائة وثيقة منها تسع وثائق من العهد النبوي قبل الهجرة، و368 وثيقة بعد الهجرة، و233 وثيقة من عهد الخلفاء الراشدين.
ووضع الدكتور نورالدين عتر في كتابه المشار إليه لعلوم الحديث سبعة أدوار، وأشار إلى أن الدول الأول الذي يمتد إلى نهاية المئة سنة الهجرية الأولى كان بمثابة دور “نشوء علم الحديث”، وفي هذا الدور كانت هناك قواعد لقبول الرواية عن رسول الله صلى الله عيه وسلم، وشواهد هذه القواعد عديدة نجدها في تعامل الخلفاء الراشدين مع الحديث النبوي، تثبتا وتدقيقا وضبطا.
ثم يأتي الدور الثاني ليغطي القرن الثاني للهجرة وهو دور التكامل وفي هذا الدور اكتملت علوم الحديث وقواعدها، أما الدور الثالث فامتد حتى منتصف القرن الرابع وهو دور التدوين لعلوم الحديث مفرقة، وامتد الدور الرابع وهو دور التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا حتى أوائل القرن السابع، فيما امتد الدور الخامس وهو دور النضج والاكتمال في تدوين فن الحديث إلى القرن العاشر، ثم يأتي دور الركود والجمود حتى مطلع القرن الهجري الحالي حيث ندخل دور اليقظة والتنبه، وفي كلٍ من هذه الأدوار السبعة أعلام من علمائنا ومصنفات من أعمالهم، وجهود بذلوها حفظا وتمحيصا وتنقية للمصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي، ولتاريخ المسلمين وذاكرتهم الحضارية.
لذلك فإن القول إن هناك 150 عاما منذ بدء الرسالة لا نعلم عنها شيء، والقول إن السنة لم تكتب إلا في القرن الثالث الهجري قول تنفيه الوقائع التاريخية.
التدوين الرسمي للسنة ـ أي التدوين بمبادرة من خليفة المسلمين ـ بدأ بلا شك زمن عمر بن عبد العزيز المتوفي( 102 ) هجري، ثم أخذ مكانته في الفقه مع الإمام مالك والموطأ، ويشير الدكتور عتر أن الموطأ هو “أول كتب الصحيح وجودا”، ثم توالت كتب السنة.
لكن كما أشرنا لا بد لنا هنا أن نفرق بين ثلاث مصطلحات:
مصطلح رواية الحديث، ومصطلح كتابة الحديث، ومصطلح تدوين الحديث.
فرواية الحديث كانت شائعة بين الصحابة، وطبيعي أن يكون ذلك ممن كان يعايش رسول الله، ويتلقى منه التوجيهات، والشروح، والأحكام، والأقضية، … الخ،
وكان بعض الصحابة يكتبون الحديث، ورسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر ألا يُكتب الحديث، أمر كذلك أن يكتبَ حديثَه بعضُ الصحابة الذين طلبوا ذلك.
أما تدوين الحديث، فهذه مرحلة لاحقة، كان لها دوافعها، وظروفها، ووضعت لها قواعدها.
دوافع تدوين الحديث
ونذكر من هذه الدوافع ثلاثة:
** الحاجة إلى السنة النبوية، وهي حاجة كانت تزداد كلما مضى الوقت، وكثرت مستجدات الحياة، وازدادت أعداد المسلمين، ودخل إلى الإسلام أقوام وشعوب متعددة الثقافات والإرث الديني والحضاري، فاختلف مستوى فهم الدين، وصار من مستلزمات العصر شرح القرآن وتوضيح مقاصده، وإبعاد الشوائب الثقافية الوافدة عنه.
** الخوف من ضياع السنة النبوية، بوفاة الصحابة الذين حفظت ذاكرتهم أفعال وأقوال الرسول الكريم. وكانوا شهوداً على الوقائع والأحداث في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين.
** الخوف من الدس على أقوال رسول الله، نتيجة الظروف الجديدة في المجتمع الإسلامي، والصراعات التي جرت في جيل الصحابة وفي أجيال التابعين ومن تبعهم، وكانت هذه الصراعات عنيفة ودامية، وكل طرف فيها يريد أن يسند موقفه بقول أو أثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك يشير ابن سيرين فيما نقله مسلم في مقدمة صحيحه ” كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة ” القتال بين علي ومعاوية ” قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فنأخذ حديثهم وإلى أهل البدعة فلا نأخذ حديثهم.
والتدقيق في العوامل الثلاثة المشار إليها تكفي لتفسير لماذا تأخر تدوين ـ وليس كتابة أو روايةـ الحديث.
وهنا نتذكر ما أشرنا إليه من قبلُ بأن القرآن الكريم لم يجمع في عهد رسول الله، وإنما في عهد “أبو بكر الصديق”، وكان الدافع إلى جمعه أولا هو الخوف من ضياع شيء منه، بعد أن استحر القتل بحفاظ القرآن في حروب الردة، وأن نسخ القرآن زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يدفع إليه إلا زيادة الفتوح ودخول بلدان عدة في الإسلام، ما جعل “الحاجة” ماسة لنسخة قرآنية واحدة يتداولها المسلمون في مختلف أمصارهم.
العناية والتحسين في الرسم القرآني
والأمر نفسه في الدافع إلى تنقيط القرآن، ومن ثم تشكيله، والتحسين المتوالي لهذه الخدمة القرآنية حتى صار رسم القرآن على النحو الذي نتداوله.
وتروي الكتب المختصة بتأريخ القرآن الكريم، أن التابعي “أبو الأسود الدؤلي” ( 16 قبل الهجرة ـ 69هجري) “واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني، أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يره، ولم يدخل المدينة إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم”، أول من قام بتنقيط حروف القرآن، بتوجيه من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومن ثم أكمل هذا العمل الخليل بن احمد الفراهيدي ( 100 ـ 170 هجري)، وقيل إن الذي قام بتنقيط القران هو نصر بن عاصم تلميذ الدؤلي ( توفي 89 هجري )، بتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي، وليس في كل هذه الأقوال تناقضا، إذ أن التنقيط لم يكن مجهولا عند العرب، لكننا نتحدث هنا عن استخدامه في القرآن الكريم، واستخدام التشكيل لحروف القرآن، وعلى توالي العصور تم تحسين التنقيط والتشكيل والعلامات التي تساعد على ضبط القراءات على النحو الذي حفظته الصدور، حتى صار شكل كتابة القرآن والعناية برسمه على النحو الذي نراه الآن.
إذن:
الخوف والحاجة كانت الدافع لكل جهد قام به علماء المسلمين لحفظ كتاب الله، وتمكين المسلم من قراءته كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكذلك السنة النبوية، فإن الخوف والحاجة كانت الدافع لنقل السنة من الرواية، والكتابة الجزئية إلى التدوين، وجاءت كل العلوم التي وضعت لضبط تدوين السنة على منهج واضح صارم لهذا الغرض وفي هذا الإطار.
قواعد تدوين الحديث
ولم يأت تدوين الحديث النبوي عشوائيا، وإنما اتبع فيه منهجاً صارماً، واضحاً، نقدوا من خلاله الروايات المنقولة عن رسول الله وغربلوها، ولم يأخذوا إلا ما توفرت فيه الشروط التي وضعوها، وكان عملهم هذا غير مسبوق على مستوى العالم فهو حسب تعبير الدكتور عتر خصيصة للمسلمين، وأكد الدكتور أسد رستم في كتابه مصطلح التاريخ أن “أول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا إلى ذلك اضطراراً إلى الاعتناء بأقوال النبي، وأفعاله لفهم القرآن، وتوزيع العدل، فقالوا ” إن هو إلا وحي يوحى” ما تلي منه فهو قرآن وما لم يتل فهو السنة”، فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا ” (أسد رستم مصطلح التاريخ صفحة أ)
وجاء بحثهم وتنقيتهم لأحاديث الرسول الكريم ـ بدءا من الدور الأول ـ من وجهين السند والمتن، ووضعوا لقبول الرواة شروطا ولصلتهم ببعضهم البعض مستويات، وأفاضوا في بحث عدالة الرواة، وقالوا بضرورة ألا يناقض الحديث صريح القرآن ومدلولاته … الخ، وصنفوا لرواة الحديث أصنافا وجعلوا لهم طبقات، فكانت عندهم ” سلاسل ذهبية ” من الرواة، الذين لا يتطرق الشك في روايتهم. وتحدثوا عن الحديث المتصل والمنقطع والمرفوع، وغير ذلك، وبناء على ما سبق صنفوا الحديث نفسه أصنافا، فكان منها الحديث المتواتر، والحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الضعيف، والموضوع، ونظروا في صلة الأحاديث بالأحكام، واتفقوا على أن المتواتر “وهو الذي نقله جمع عن جمع يستحيل معه التواطؤ على الكذب” يؤخذ به في كل الشؤون، فهو من حيث الحجية كالقرآن، والمتواتر لفظا ومعنى قليل جدا جدا، وقد تراوح عدده ما بين ثمانين حديثا وثلاثمائة وعشرين حديثا، والمتواتر معنى دون اللفظ أوسع من سابقه لكنه قليل كذلك، واختلفوا في حديث الأحاد، هل يؤخذ به في شؤون العقيدة…. الخ.
ولا شك أن أصح كتب الحديث على الإجمال صحيحا البخاري ومسلم.
لكن.
هل كل ما حواه الصحيحان هو كذلك، العلماء منذ القديم بحثوا في هذا الأمر وكان لهم وقفة عند أحاديث معينة.
ونحن حين نقول أصح، فإننا نتحدث هنا على العموم، ويكون من شأن علماء الأمة في كل حين أن يراجعوا ويبحثوا ويدققوا في صحة هذا الحديث أو ذاك، سندا ومتنا، وقد فعل المتقدمون من علماء الأمة ذلك، ووقف علماؤنا منذ زمن بعيد أمام الصحيحين ونقدوا روايات فيهما:
ففي كتابه هدي الساري الذي جعله بن حجر العسقلاني ( 773 ـ 852 هجري)، مقدمة لكتابه المشهور فتح الباري “عد الإمام العسقلاني الأحاديث التي انتُقد فيها البخاري فكانت 110 أحاديث اشترك مسلم معه في رواية 32 حديثا، هذا من أصل 2602 حديث في البخاري بعد حذف المكرر”، يقول الحافظ “وبعضها يسَلم لهم فيها وبعضها لا يسلم”، كما تتبع الدار قطني (ت 385) بعض أحاديث البخاري ومسلم في كتابه “الإلزام والتتبع”، حيث تتبع مائتين وعشرة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية وسبعين حديثا، ومسلم بمائة، والمتفق عليه بينهما باثنين وثلاثين حديثا، وكتب أبو مسعود الدمشقي ت 401 في علل صحيح مسلم، وكتب غيرهم من العلماء في هذا الشأن، واستمر هذا النهج من عدد من علماء الأمة حتى هذا العصر، وهذا باب مفتوح، لمن أراد أن يلجه.
لكن على من يلج هذا الباب أن يتسلح بأمرين اثنين لا غنى عنهما وهما:
1ـ التمكن من أدوات البحث والمعرفة العامة، وكذلك الخاصة بهذا العلم.
2ـ والصدق في التوجه، أي الابتعاد عن الهوى، وعن القصدية.
وما نقوله بشأن الصحيحين لا يطعن فيهما، ولا في منزلتهما باعتبارهما أعلى كتب الحديث منزلة وصحة.
كل ما قلناه هنا عن المناهج الدقيقة والشروط المحكمة التي وضعها أئمة الحديث، لا يعني أبدا أنها منعت وصدت وأسقطت كل الأحاديث الدخيلة، لأن صحة المنهج لا تفترض بشكل قطعي صحة النتائج، هذه قاعدة علمية في العلوم الإنسانية مسلم بها، لأننا نتعامل هنا مع الأنسان، عالما كان أو عاميا. ولكن صحة المنهج تقلل الخطأ كثيرا، وتكشف الكثير من الدس، وتجعل الحكم العام بالصحة حكم سليم يمكن الاستناد إليه، مع الابقاء على ملكة النقد متحفزة، وعلى مشرط التحليل والتدقيق مشرعاً.
قبل أن نختم هذه الاطلالة النقدية على جماعة القرآنيين وهي موجزة لم تتعرض فيها إلا إلى بعض النقاط التي نعتبرها مفصلية في مزاعمهم، لا بد أن نقف أمام ما قاله زعيمهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشأن المسجد الأقصى. وهو فيما قال يزعم أنه يعطي الرسول الكريم ما أعطاه إياه رب العزة، وما جاء في القرآن الكريم، ثم يفتري على المسلمين بأنهم أقاموا قبرا، وقالوا عنه قبر رسول الله، ثم فرضوا الحج إليه، وفي حديثه عن المسجد الأقصى قال كلاما لم يقله مالك في الخمر، وأعطى شروحا لا أساس لها من القرآن ولا من أي مصدر إسلامي آخر.
** نحن المسلمين نقول إن محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم الأنبياء وأفضلهم، وهو من الرسل أولي العزم، وأنه بلغ الرسالة كاملة دون أي نقص، وأنه قام بالتبليغ والتبيين، وأن الله جل وعلا أمرنا أن نصلي على رسول الله ونوقره ونعتبره أسوتنا ونموذجنا الذي نقتدي به، ونظهر له المحبة، وأن الإيمان بهذا النبي الرسول الخاتم جزء لا يتجزأ من إيمان المسلم، وهو يمثل الركن الثاني من أركان الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
**وكل ذلك لا يخرج رسول الله عن بشريته، ولا عن إنسانيته، وأنه وهو رسول الله فإنه أولا وقبل كل شيء عبد الله، وحين يذكر في الشهادة فإنه يذكر بصفته عبد الله الذي أوصل إلينا الرسالة، والكتاب، بلغ وبين، أي أننا نشهد بوحدانية الله كما وصلتنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم.
لم يجعل أحد من المسلمين محمداً صلى الله عليه وسلم في غير هذا المكان، ولم يجعل أحد قبره محجا يُحج إليه، وزيارة مسجد رسول الله، والسلام على رسول الله في قبره ” الذي أسموه بالقبر الرجسي” لا يعدو أن يكون إظهارا للوفاء والتقدير، وامتثالا لأمر الله تعالى بتوقير هذا النبي، وزيارة قبر المصطفى ليست حجا، وليست جزءا من فريضة الحج.
** الله يقول في قرآنه الكريم ” إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما” الأحزاب / 56.
** والله جل وعلا هو القائل في كتابه العزيز” قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم* قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين” آل عمران 31، 32.
** والله عز وجل نعى على الذين يتعاملون مع الرسول كتعاملهم مع بعضهم البعض بأنهم لا يعقلون “إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون” الحجرات / 4، وطالبنا الله جل وعلا أن نميز الرسول الكريم في التعامل معه فلا نجعل تعاملنا معه كتعاملنا مع أي انسان وحذرنا من خلاف ذلك “لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم” سورة النور 63.
** والله عز وجل هو القائل في محكم كتابه” فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل” الاحقاف 35، وبين الله لنا في كتابه ـ على الراجح في التفاسير ـ من هم هؤلاء، وذلك حين أجمل الأنبياء جميعهم ثم أفرد خمسة منهم “واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظاً” الأحزاب /7،
** والله عز وجل الذي قال في محكم كتابه ” قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون” البقرة / 136، وقال في كتابه العزيز أيضا ” تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس …..” البقرة / 253. وجاء التفضيل مؤكدا بلفظ التفضيل وبرفع الدرجات، ولا نفهم من آيات الله البينات هذه إلا أن رسل الله وأنبياءه في مرتبة واحدة هي مرتبة الرسالة والنبوة، هكذا علينا أن ننظر إليهم، لأن الله وضعهم في هذه المرتبة، ثم داخل هذه المرتبة تمايزوا وتفاضلوا، وارتفعت درجات بعضهم عن بعض.
الله في كتابه الكريم يقول: صلوا على رسولكم وعظموه ووقره وقد أعلى الله شأنه وقدره بأن فضله بين الرسل، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين.
وهؤلاء يقولون لنا إن محمداً مجرد رجل ككل الرجال، خصه الله بالرسالة تبليغاً، فإذا أتم ما كلف به، فقد انتهت مهمته وانتهت خصوصيته!.
هذا جانب مما يجب الوقوف عليه بشأن موقف هذه الجماعة من رسول الله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.
أما ما جاء بشأن القدس والأقصى، وما دعوه بالمسجد الضرار، فلا يعود غريبا بعد كل ما قالوه في رسول الله عليه الصلاة والسلام.
** من أين جاءت معلوماتهم بأن المسجد الأقصى ليس هذا الذي نعرفه، وإنما هو هناك في الطور، وأن رسول الله لم يُسرَ به إلى القدس وإنما إلى الطور.
** من قال لهم أن المسجد الأقصى ليس هو ذلك الذي أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهو مسجد إيلياء، وهو مسجد بيت المقدس، وهو الذي بارك الله حوله، والذي فتحه عمر رضي الله عنه في السنة الخامسة عشر للهجرة” (الإمام الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد ت 794 هجري”)!
** ومن قال لهم أن أحداً من المسلمين يعتبر أن المصلى المرواني وقبة الصخرة هي المسجد الأقصى!، إن أي طفل فلسطيني يعلم يقينا أن قبة الصخرة هذه ليست المسجد الأقصى، وأن المسجد الأقصى هو كل هذا الموضع المحاط بالسور ومساحته قرابة 144000 مترا مربعا، أي 14 دونما، وهو محاط بسور عليه مآذن، ويضم داخله الجامع وقبة الصخرة والمصلى المرواني والأروقة والقباب والمصاطب وغير ذلك من مشاهد.
** ومن قال لهم أن أحداً من المسلمين يحج إلى المسجد الأقصى!، وهل يحج المسلم إلى غير بيت الله، لكن فضل المسجد الأقصى أو فضل المسجد النبوي فمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما زيارتهما فهي من الأمور المستحبة.
** ثم كيف يسوغ أحد لنفسه القول بأن المسجد المرواني أقيم مكان الهيكل الإسرائيلي، مع العلم أن الإسرائيليين ما زالوا منذ أول بذرة لهم في فلسطين المحتلة يحاولون أن يثبتوا موضعا للهيكل في فلسطين لكنهم لم يتمكنوا، كل بعثات التنقيب فشلت في إيجاد أي دليل، بل إنهم عجزوا عن إيجاد أي دليل على أن حائط البراق هو ما يدعونه ب “حائط المبكى”، ثم يأتي مثل هؤلاء ليقولوا لهم أن هيكلكم هنا تحت المسجد المرواني، وأن هذا المسجد أقيم على باطل ويجب هدمه!
الختام: عودة على بدء
من المهم في ختام هذا البحث أن نستعيد التذكير ببعض أفكار هذه الجماعة، “جماعة القرآنيين” التي باتت الولايات المتحدة مركزها، وأصبح د. أحمد صبحي منصور ممثلها والشاهد عليها:
1: انكار السنة، واعتبارها تلفيقا على رسول الله
2ـ الاعتقاد بأنه ليس من مهمة الرسول توضيح وتبيين القرآن لأن القرآن واضح بنفسه تفسر آياته بعضها البعض.
3ـ اعتبار صحابة رسول الله كفرة، لأنهم حرفوا في القرآن ومنعوا الرسول من اتمام تبليغ رسالته.
4ـ اعتبار المسلمين كفار عقيدة لأنهم أقاموا الشهادة على عنصرين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقاموا مسجدا ضرار في مسجد المدينة المنورة “المسجد النبوي”، وكذلك المسجد الأقصى في القدس.
5ـ اعتبار الفتح الإسلامي جريمة في حق الإسلام.
6ـ اعتبار المنتج الحضاري لهذه الأمة منتج غير ذي معنى لأنه أقيم على أساس باطل” السنة”
7ـ وينتج عن كل ما سبق إصدارهم لأحكام وفتاوى تنقض ما استقرت عليه الأمة منذ وجود الدين الاسلامي.
8ـ اعتبار أنفسهم أهل الحق والدين القويم، وما عداهم من المسلمين منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى الآن ضُلًالا انحرفوا عن الدين الحق وأقاموا لأنفسهم أديانا أرضية.
بعد عرض أفكار من يدعون بجماعة القرآن أو القرآنيين وتتبع ولادة هذه الجماعة، ورموزهم، ومن ثم نقد تلك الأفكار بما تسمح به حدود المقالة، نقول:
أرسل الله جل وعلا كتابه العزيز هدى للناس، وتعهد بحفظ هذا الكتاب، وبأن يبقى منارة تهدى الناس أجمعين، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملاً تاماً، كما تبلغه، وعلى النحو الذي تبلغه من جبريل عليه السلام، وأقام رب العزة حول هذا الكتاب سبيكة شديدة القوة والتماسك حفظت هذا الكتاب منذ بدأ بنزوله إلى اكتماله، وحتى وصل إلينا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتكونت هذه السبيكة الصلبة من عناصر محددة:
من رسول معصوم يبلغ الكتاب ويبينه للناس، ومن لغة واضحة بينة اختارها رب العزة لتحمل مقاصد الرسالة وألفاظها ومعانيها، وهيأ من حولها رجالا لخدمة هذه الرسالة، ولنشرها، بالفتح، والعلم، والبحث والتأليف، وفتح آفاق المعرفة والفكر أمامها، وقد نتج عن هذه السبيكة التي حفظت القرآن بناء حضارياً إنسانياً عظيماً: دولة ومجتمعاً، قام كله حول كتاب الله.
كل منتج الأمة، كل ما حوته مكتبة الأمة، في مختلف فروع العلم والمعرفة، كل الحضارة قيمها وانجازاتها، أقيم حول هذا القرآن، وكان هذا كله فعل أمة، وليس فعل سلطة، لذلك لم تستطع السلطات التي تعاقبت، وبغض النظر عن وصفنا لها ورؤيتنا لإيجابياتها وسلبياتها، بل لم تستطع حتى سلطات الاحتلال الأجنبي منذ الصليبيين والمغول، وحتى الاستعمار الغربي، وقمته الغزو الصهيوني، أن يؤثر على هذا البنيان العقدي الحضاري. أو أن تخرب هذه السبيكة الصلبة المحيطة والحافظة لكتاب الله، لذلك استمرت هذه الأمة وتمكنت من مواجهة العواصف التي تعرضت لها والزلازل التي ضربتها.
والآن تريد هذه الجماعة التي ولدت في كنف الاحتلال البريطاني للهند، ونمت وترعرعت في أحضان الولايات المتحدة، وفي زمن عربي وإسلامي مشبع بالهزيمة، تريد أن تفك عرى هذه “السبيكة”، لتخرب وتشوه في أمة القرآن، في عقائد الأمة، ومقدساتها، ورموزها، وتاريخها، ولتقف جهارا نهارا إلى جانب أعدائها.
مشهد يحتاج إلى تفكر وتدبر.
الشارقة / 10 / 6 / 2018
ليس بالضرورة أن يعبر هذا البحث عن رأي الموقع