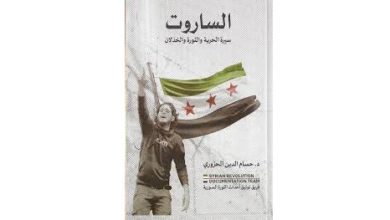بداية، ونحن نبحث في موقف الشعر والشاعر خصوصاً، والفن عموماً من الأحداث المزلزلة الكبري لمجتمعاتنا، لا بد من سؤال مركزي وحاسم هو: إذا لم تحرك كل هذه الزلازل والأعاصير الطبيعية والبشرية التي نشهدها الآن الفنان والشاعر ليتغير ويغير ما حوله، ويضلع في شأن وتغيرات مجتمعه؛ فما الذي سيغيّره وماذا لديه ليخاف أن يخسره؟
“كلّ حِزبٍ بما لديهم فرحون” قرآن كريم.
كل شاعر أو شويعر يقول “شعري أنا”، وشعره معزول في دائرته الضيقة بلا اهتمام وجدية وعمق قراءات، تميز الإبداع والجدة والفروق وتقايس وتوازن مع عام وخاص، وسابق وجديد و.، يقول شعري “أنا” وينسى المحيط الواسع العام العظيم الذي يغرق أكبر السفن والأنظمة حتى تيتانك، ولا يبقي منها إلّا بضع بقايا.
لا شعر أو فن إلا بجدل بين خاص وعام، وحضور للعام في الخاص، والخاص في العام، في قراءات فاردة وفارقة وناقدة. وَمن ينفض يدَه وهمّه عن العام فلا ينتظر إلا البوار.
وحتى لا يقعَ أحدٌ في الوَهم، ويقيسَ نفسه وشعره على درويش وقباني وجبران متوهما أنه مثلهم، أو أكثر أهميةً منهم فإنّ أيّ استطلاع عن الشعر الآن يبين مدى انحسار العام عن الخاص وعن الفنون الجادة، بما فيها شعر قباني ودرويش وغيرهم. لماذا؟ لانزياح الهمّ العام الآن عن الفنون الجادة، وانشغاله بالَمعاش واليومي، وبالمصير أمام حروب إبادة، وبانصراف النقد والنقاد إلى معاشهم وماديّات تثقل كواهلهم.
هنا سيشيع ويعمّم برامج (الشّو)، والطبخ، والتنجيم، ومهرجانات التعري والازياء والعطور، وتفسير الأحلام، وأفلام عادل إمام وهيفاء وهبي، ومسرحيات “مدرسة المشاغبين والعيال كبرت” و”سِك على بناتك”، وأغاني محمد رمضان التافهة المقلّدة لأغاني البوب والراب، وصرعات إعلام يروّج له، وتنتشر برامج المسابقات والمقالب وأفلام الأكشن.، إلخ.
فمن أنتَ أيّها الشاعر الكاسد المريض، المعزول، المغترب والمغرّب عن محيطك ووسطَك إلا من عصابة “حسب الله”، وشلّة صغيرة تطبطب لك، وتقنعكَ أنك أعظَم شاعر في الوجود تماما مثل القائد “العظيم الخالد المؤلّه” والفاقد للروح في آنٍ معا؟
ليتكَ تصحو وتحسّ أنك وحدك، ولا يعني فنّك وشعرُك حتى أسرتَك، ومحيطك، ولا المحيط العام. ولا يغرّنَك جائزة هنا أو مهرجان “كربلائي” أو جنوبي أو شمالي تدعى إليه، ليحنّطوك فيه قبل أن تتلف وتموت، وَما أقاموا مهرجاناتهم الضالّة المضلّلة، إلّا بمال النّهب والسحت والغنيمة.
بِذّات جاهزة وتفصيل
ماذا إذا بقينا كلٌ يكتبُ الشّعرَ على شاكلته ومقاسِه الفردي، ونموذجه الصنمي المقدس وفلسفتِه الواحديةِ العذراء، فلا ننتظرُ ماءَ سماءٍ للشّعرِ ولا للفنّ، ولا يعني ذلك إلا فقدان البوصلة بين الخاص والعام، وأنّ الشعراء، كلّ يغنّي على ليلاه، ولا ليلى كلية وكونية تهم الجميع، وهجس الجميع ليفوزوا بها، ولا براءة لفنان أو شاعرٍ للدخول إلى معبد دلفي العظيم؟
عندها، على الفنون السلام وليس “في الناس المسرّة”. مَجنون من يتعلّق بالمطلق والواقعُ الدامي لشعبهِ وهو أمَامَه يناديه.
وحدة الشاعر والأرض العذراء
“يقولون لا تلوّث ولا زحام ولا ضجيج/ والهواء يمرّ جديدا ولم يتنفسه أحد/ في البلدات التي لم تصبح مدنَ ملاحمَ بعد/ ولا متاحفَ للموناليزا/ ولا حرّاسَ لليل في البيت الأبيض/ أو الوول ستريت/ ولا في قصر المهاجرين المنهوب من خزينة الدولة والشّعب المباح..”.
مدن الزحام
الفردية والذاتية والسأم والملل والقرف والضيق والهم والغم والانتحار، من مفرزات المدن الملاحم ومعامل غاز الكبريت والبشر الأرقام. فمن يكتب الشعر ولمن يكتب الشعر؟ ومن يبدع الفنون ولمن إبداع الفنون؟
الفردية وقطع الرحم
ما نرى الشعر الفردي الذاتي المتشحم والهزيل، وما بين ذلك إلّا من معطيات حضارة غربية تمجد الفردية في كل شيء، وتمحقها في العام، وتمسخها بزعم انتخابات ديموقراطية، والسياسة العليا ومصلحة الدولة كدولة فوق الأفراد، ونظراتهم الضيقة او الواسعة، وهم يجهلون أخبارَ الكوكب، وكوارثَه ونكباتِه، ونهبَه إلا كما تريدها السياسة العليا النفعية البراغماتية، وهي تحصي أنفاس البشر، وتلك السياسات العميقة مرهونة بأيدي السبعة الكبار، أو حكومة الظل الداخلية الموجّهة، والمتحكمة، وأفدح مثال على ذلك في عصرنا الكذبة الكبرى في حرب العراق والادعاء بأنه يمتلك سلاحا ذريا مدمرا، والتي غزت بواسطتها الولايات المتحدة وتحالفها العراق ودمرته بجيوشها هي، وبجيشه وطوائفه هو وبعماء ملله ونحله، وهو ما حصل في سوريا وليبيا واليمن والسودان الآن. هذا أولا.
وخلاصة تلك السياسات على الفنون والأفراد تعني، تمتَّع فرديا وأنتَ حرّ في كل ما تريد من لذات وحياة وموت وانتحار ومثلية، ولا تتدخل في سياسات بلد نحن نرسمها ونتحكم بها، وإن أردتَ المشاركة فانتسب للحزب الحاكم او لحزب من أحزاب المعارضة المسموحة والمرخصة. قد اتخمتنا ثقافات التحديث والحداثة، قياساً بالثقافة الغربية والشعر والنموذج والنمط الغربي الفردي بكل أنواع الكفر بما لدينا، والقطيعة معه، وأصبح كافكا مثالنا بدل أبي العلاء وزكريا تامر والسياب والماغوط…
والذين يطنطنون عندنا بالديموقراطية الغربية والحرية الفردية والثقافة الغربية، وحقوق الإنسان، فهم إما يعرفون كل تلك الحقائق ويتعامون عنها برغبة التحلل من العام وبدعوى فشل السياسات (الشرق- أوسطية)، أو العربية كلها ونتائجها الصفر، وانعدام الحريات، الفردية والجماعية وإبادة الإنسان. أو أنها حقيقة لا يعرفونها لأنهم غارقون في الوهم والضلال والعدمية؛ فكيف يكون الشعر ذاتيا عماويّا ويهز شعرة في مجتمعات مغيبة ومحكومة بإعلام تفاهة وغباء، وفضائيات يصرف عليها المليارات وهيَ بوق لتلك السياسات ولتلك الدول؟
وما كل هراء وسخام وتفاهات وصحافة صفراء، وفضائيات عربية وشرق أوسطية متناسخة كالجراد، إلا نتيجة توشيج علاقات ومصالح كبرى تخدم مراكز الغرب والشرق الناهبة مع مراكز تابعة هنا وهناك ومرهونة لخدمة تلك السياسات (العولمية) بعيدة المدى. والذي لا يرى من الغربال والمنخل أعمى، أو يتعامى ويصير قوّادا وسمسارا رخيصا.
عودة للشعر والشعرية
إذا قيل إن كلّ الشعر العربي وغيره يقوم على الذاتية المتضخمة بـ “الأنا”، والتي لا ترى الكون والوجود والحرية إلا من خلال ذواتها النرجسية المريضة، من طرفة إلى عنترة إلى المتنبي وحتى نزار ودرويش… فهذه التعميمية لا تقل خطراً وسوءاً عن تلك الأوروبية، بإعلاء الذاتية وقطع روابطها العامة والمجتمعية، فما هو المشهد الشعري الآن إذاً؟
صحيح أن الشعر والفنون عامة كلها ذاتية فردية، و”الأنا” الشرقية تختلف عن الأنا الغربية، لكنّها “أنا”. ذلك صحيح، ولكن كلّ شعر ذاتي لا يمسّ العام “بمشتركه الجمعي الأكبر ومفترقه الأصغر” لا يجب التوقف عنده، والذي لا يمس المجتمعات والأمم في أحوالها آلامها، آمالها، وجدانها، وقيم جمالياتها، وذوقها، وبواطن وجدانها العام باستعداداته وقابلياته المفتوحة؛ هو شعرٌ لا يعوّل عليه.
فما قولنا بمن يدعونَ مجتمعاتنا للقطيعة مع ماضيها، وعراقتها، والمثقف للقطيعة مع مجتمعه بالتعالي عليه، وحجة أنها “خرجت للثورة من الجوامع”، وكان على المجتمع أن يخرج للثورة من الخمارات والكابريهات ومن ردهات الفنادق ذات الخمس نجوم؟ وتماما كان على ثورات الربيع العربي أن تكون مصممة ومجهزة، ومرتبة وفق الثورة الفرنسية أو البلشفية، أو ثورة ربيع براغ!
مرة أخرى: ما هو الفن والشعر المعوّل عليه؟
المعول عليه في الفن إذن: هل يكون في الرؤى والمواقف والمعايير الفردية والخاصة أي الفنون المفصلة كالثياب على قدود ومقاسات وقيافات وأذواق أصحابها، وقياس البدلة الشخصية لكل منهم، أو البدلة الجاهزة صينيا والتي تناسب الجميع كبنطلونات الجينز، أم أنه على عكس ذلك فيما يمس العام ويواجهه ويجابهه، ويتمرد عليه، ويتحدّاه ويهدم منه ما تآكل وبليَ وفَسُد، ويذهب معه إلى ما لا يُرى من وجود ومطلق وقلق وجود وموت، وحرية، وحضارة وتواريخ، وعوالم بعيدة ومجهولة كـ (السولياريس) وعوالم فطرية وبكر… حتى عوالم فنون وجماليات بعيدة غارقة أو فاردة؛ موسيقا ومسرح وبانوراما ورقص… ومنوعات، وتشكيلات ورياضات أولمبياد؟
واقع يسبق الشعر والمتخيل
في لحظتنا الفارقة، نجد الآن أن الشعوب والجماعات هي التي تثور وتتمرد، وتجابه، وتغير، وتدفع ضرائب الحرية والدم كما في ثورات الربيع العربي. وتبتكر فنون الأغنية والنشيد والإعلان والملصق، والرقص الجماعي. ونرى على طرف آخر أنّ عموم الفن يدور ويسبح في تهويماته وتمرداته الفارغة، وانزوائها عن أحداث كبرى وتحولات فاصلة محلية وعالمية، ونجد الغرق في اليأس، والإدمان والفوضوية والعدمية عند مثقفين وشعراء ونُخب، كذلك نجد طغيان الفردانية والشخصانية، والانفضاض من الجمعي، بل التنظير له، وقياسه بأمثلة ذاتية وشعاراتية تافهة، فتلك مصيبة أصحابها ووقوعهم في كل ما صدر إليهم من شرق وغرب ليعيشوا على رمقه كالعظام، فمن حق الشعوب عدم الالتفات إلى أشعار لا تهمّ أو تعني إلا أصحاب عاهات ومرضى هلوسة.
الفنون والأشعار ما تزال ترطن بما ألفت، وتكرر ما عرفت، وتدوخ وتتسلطن بشعر مقدس ومحنط وفردي نموذجي، عمودي وتفعيلي ومنبري وصراخي، أكثره لا يهز إلّا أصحابه، ويعني شلة حزب، أو عائلة أو ملهى أو مقهى، أو عصبويات دينية وملل ونحل وكربلائيات… فتلك طامّة عمياء لا تقلّ عن عماء سلطات رازحة تسيّر المسيرات المليونية “العفوية!”، وتدّعي الانتصار على مؤامرات إرهابية وكونية، وتملأ الدنيا طبلا وزمرا وانتصارات. أو نجد نثرا علكا، تبنا وتفاهة وأي كلام، وأي بعثرة “وقال إيه بيحب”!
في المحصلة، كل ذلك هو بمثابة استباحة للفن وقتل للشعر والوجدان والإحساس الذوقي والراقي، فأين النقد وأين حراس الغابة، وأين الأذواق، وأين هيئات ومؤسسات معنية بالهوية وفنون الأمة؟ الأنظمة والسياسات والمؤسسات هي التي حولت الشعوب إلى عبيد لقمة، ومعاش، وأزمات لا حلول لها عبر النهب والتخريب الثقافي والمجتمعي المستمر والممنهج، حتى وصلنا إلى ثورات الربيع العربي العاصفة. فهل مشكلة انحسار الفنون وتسطيحها، وانفضاض الناس عنها، تكمن في أشكال ومضامين ومدارس وأوزان شعر…؟
كل تلك التوصيفات قد تكون من لوازم الشعر لكنْها ليست الشعر مطلقا، ولا الشاعر. وأبداً لا نقول بانقطاع الثقافة والتثاقف مع شرق وغرب وشمال وجنوب؛ بل بانفتاحها، وتلاقحها، على أن تكون لنا هويتنا وشخصيتنا الثقافية والفنية، والفكرية التي لا نفرط بها البتّة أمام أي تيار أو ظاهرة أو موضة وصرعة عابرة يطنطن بها مهووسو شكليات و”مثليات”… إلخ، تحت شعار كاذب وملتبس اسمه “الحرية الشخصية”.
ما العمل إذن؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي وقفة كبرى، وإعادة نظر بالإنسان المعطوب والمنهوب والمسلوب الذي يقول الشعر وهو معطل الإرادة والعقل، والروح إلا من ببغاوية تردد ما يراد لها أن تردد، وتطرب نفسها وأصحابها، وتبقى تؤدي وظيفة “السعدان” لترضي سعيد وسعيدان، بل ذاتية السامري صاحب “لا مساس”[i] ومقولة “أنا شاعر اتركوني”.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا