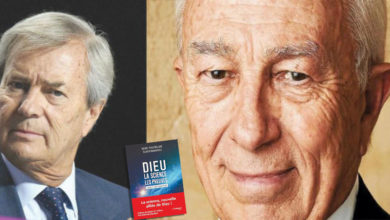مقدمات لإصلاح السياسة
الحوار شقيق الديالكتيك، ينتج حقائق جديدة ليست لأي من المتحاورين، بل لهم جميعاً، لأنها قائمة فيهم جميعاً، ومدخل ضروري الى السياسة، بل لعله المدخل الوحيد، والسياسة في أحد أهم معانيها هي نفي العنف، أو نفي ” الحرب” خارج المدينة، أي خارج الدولة، بما هي تعبير سياسي عن وحدة المجتمع، وفي مستوى متقدم هي نفي الحرب كلياً ونهائياً، السياسة هي نفي الحرب، لأنها، أي السياسة، المعنى الذي تنعقد عليه وحدة المجتمع والدولة ، ووحدة الحكم والشعب ، ووحدة السلطة والمعارضة ، وحدة ” الساحة والقصر”، ووحدة المعارضة أيضا. ولعله من نافل القول ان نؤكد أن الوحدة المعنية وحدة جدلية، تناقضية، هي هوية التعدد والاختلاف والتعارض، السياسة هي المعنى الذي تنعقد عليه وحدة المجال السياسي والمجتمعي ، لأنها تعبيراً عما هو عام ومشترك بين جميع المواطنين وبين جميع الفئات الاجتماعية ، والتعبير العياني عن منطق الواقع ، فالسياسة والمنطق مقولتان تتقدمان معاً وتتراجعان معاً ، والسمة الأبرز للمجتمعات المتقدمة أي المندمجة قومياً واجتماعياً ، هي وحدة مجالها السياسي الذي تتجابه فيه ، وتتقاطع تيارات واتجاهات مختلفة ومتخالفة ، وفي مثل هذا المجال السياسي الموحد تقوم الوحدة الجدلية بين السلطه والمعارضه ، هذه الوحدة التي لا تعرفها ولا تعترف بها النظم الاستبدادية، ويستهجنها سياسيوها ومعظم مثقفيها أيضا هي التي تفضي إلى الاستقرار السياسي الفعلي ، والى التداول السلمي للسلطة ، والاستقرار السياسي ، والتداول السلمي للسلطة من أهم المداخل السياسية للتقدم.
لعله من المستحيل أن يتم تداول سلمي للسلطة ما لم تكن هناك وحدة جدلية بين السلطة والمعارضة ، وإلا كيف يمكن أن يتحول الشيء إلى نقيضه من دون تدمير الوحدة أو تفكيكها، إن مصير السلطة الاستبدادية أن تدمر وحدة المجال السياسي المجتمعي والروابط المجتمعية ، ثم تدمر نفسها ، فليس بوسع السلطة السياسية أن تنفي المعارضة من دون أن تنفي ذاتها ، ومن دون أن تنفي صفتها سلطة سياسية، وكذلك المعارضة.
وليس بوسع الدولة أن تنفي المجتمع من دون أن تنفي ذاتها وصفتها دولة ، أيضاً ، الدولة الاستبدادية هي أي شيء سوى الدولة السياسية ، والسلطة المستبدة هي أي شيء سوى السلطة السياسية ، لأنها بالقدر نفسه استلاب ناجز للمجتمع والشعب.
لقد أوصل الاستبداد شعوبنا ومجتمعاتنا الى مفترق ، إما الإصلاح الديمقراطي وإما الكارثة ، إما الديمقراطية ، وإما التوحش والهمجية ، إما نجاة الجميع ، وإما غرق الجميع ، أما السياسة وإما الحرب.
وقد آن لجميع الذين يحبون الحياة ، ويؤمنون بالكرامة الانسانية أن يعارضوا الحرب بالسياسة ، فجميع البنى والتشكيلات الاجتماعية والسياسية إلى يومنا وساعتنا هي نتاج الحرب ، وكذلك الشقاء الذي يتخبط فيه أربعة أخماس البشرية. فالحرب ليس امتداداً للسياسة بوسائل أخرى كما زعم كلاوزوفيتس بل هي نكوس الى البدائية والتوحش، يقسم العالم والمجتمعات كلاً على حدة إلى غالب ومغلوب وإلى سادة وعبيد تابعين ، وقد كانت العبودية والتبعية ولا تزالان من أسوأ بنات الحرب ففي حالة الخضوع للطغيان ، أي في الحاله الجماهيريه / القطيعية، يتماهى المغلوب مع الغالب ، وتغدوعلاقات القوة محور العلاقات الاجتماعية والسياسية ، ولما كان المغلوب يفتقر لعناصر القوة الفعلية ، فانه يصطنع عناصر قوة وهمية ، هي من القوة والخسة والنزالة والكيد للاخر والاحتيال عليه، الجماهير / القطيعية بنت الطغيان ، وأبرز مظهر من مظاهره ، وهي في الواقع شكل جديد من أشكال العبودية التي أنتجها منطق الحرب ، ولعل البشرية كلها باتت في حاجة ماسة إلى حرب أخيرة على الحرب، كما يقول اريك فروم، والذي سيعلن هذه الحرب ويخوضها حتى نهايتها هو العقل ليس بوصفه الذكاء والحيل والحنكة والدهاء فقط ، وليس ما يتجلى في العلوم الوضعية وفي التقنية فحسب ، بل بوصفه ماهية الإنسان وجوهره ، ومبدأ كليته الذي سيعلن هذه الحرب ويخوضها حتى نهايتها ، والروح الإنساني المتعين في جميع بني آدم المستخلف في الأرض ، والذي يتجلى في العمل الخلاق ، وفي الإنتاج الاجتماعي وفي الإبداع ، وفي جميع مجالات المعرفة ، ولا سيما في الأدب والفن والدين والفلسفة ، وفي جميع مجالات العمل ، وبهذا تتعين المهمه التاريخية الملقاة على عاتق المثقفين وكتلة الانتلجنتسيا، وعلى الشعوب التي تجرعت مرارة الحرب وذل التبعية، وتتعين من ثم، وظيفة الثقافة والتربية والسياسة.
ليس اغتصاب السلطة وإعادة اغتصابها في هذا البلد أو ذاك سوى حرب على المجتمع وانتهاك لمجاله السياسي ، حرب وانتهاك يؤولان بالضرورة إلى احتكار هذا المجال شرطا لاحتكار الثروة والقوة، أياً كان الاسم الذي يطلقه الذكاء البشري على عملية الاغتصاب ، وأياً كانت الذريعة التي يتزرع بها الغاصبون ، فإن ما بني بالسيف بالسيف يهدم، وإن المقدمات التي يقوم عليها أي حكم تظل ثانوية في بناه تنمو وتتعمق ، وتظهر في نتائج سياساته وممارساته وفي علاقته بالشعب الذي يفترض انه مصدر السيادة والشرعية، والسؤال المهم والراهن، اليوم، هو كيف يمكن تلافي النتائج الكارثية، أو غير المرغوب فيها، التي نجمت والتي يمكن أن تنجم عن منطق القوة والغلبة والاغتصاب، أي عن منطق الحرب؟ فالكل في قارب واحد سواء على الصعيد العالمي ، أو على صعيد دولة بعينها ومجتمع بعينه.
العلاقة بين السلطه والمعارضه تعبر، في كل مكان وزمان، عن مستوى الحياة السياسية وعن خصائص المجال السياسي للمجتمع المعني، ومن ثم عن درجة تقدمه وارتقائه، فالتخارج بين السلطه والمعارضه كما هي الحال عندنا، ينم عن مجال سياسي مغلق، أو نسق مغلق، تتطابق حدوده مع حدود السلطة، في حين ينم التداخل والتجادل على مجال سياسي مفتوح تتطابق حدوده مع حدود المجتمع المعني ، وتنفتح على ماهو كوني وإنساني. المجال السياسي المفتوح يتوفرعلى توازن فعال بين القوى الجاذبة إلى المركز والقوى النابذة عنه، وهذه القوى تشبه في فعلها القوى المتعاكسة التي تبقي وتر القوس مشدوداً، لأن كلا منها جاذبة ونابذة في الوقت ذاته، في حين يتسم المجال السياسي المغلق باختلال التوازن الفعال أيضا، بين هذه القوى، فإما أن تغلب فيه عوامل الجذب إلى المركز فيمتص قوة المجتمع ويكثفها في بؤرة معتمة ، فتتحول إلى ما يشبه الثقب الأسود في فضاء السياسة، وإما أن تغلب فيه عوامل النبذ فيتشظى ويتناثر ، مبدداً ما امتصه من قوة المجتمع وطاقته. ذلك لأن القوى المتعارضة أو المتعاكسة تغدو وحيدة الاتجاه وعديمة الوزن . وهذا ما يفسر شلل الحياة السياسية في جميع الأنساق المغلقة . ويلقي الضوء أيضاً على آليات الاستقطاب الإقليمية و الدولية، ولا سيما آليات الاختراق الإمبريالي التي تحول القوى المحلية إلى استطالات لهذه القوة الخارجية أو تلك، وإلى أدوات لسياساتها، أو إلى عناصر في استراتيجياتها الكونية . ومن ثم فإن أهم ما يسم المجتمعات والدول ذات المجال السياسي المغلق هو التبعية ، أو عدم الاستقلال.
الانساق السياسية المغلقة تنتج خطابات سياسية مغلقة ، ولا عقلانية بالضرورة، خطابات تجافي معقولية العالم، وتقف دوما على طرفي نقيض : التصديق التام والتكذيب التام، الحقيقة الكلية الناجزة والباطل المحض، الولاء المطلق والعداوة المطلقة، الرفض المطلق والقبول المطلق، وليس ثمة من مساحة للاختيار، والاختيار من أهم صور الحرية. الرفض المطلق تعبير سلبي عن الحرية ،والاختيار تعبير إيجابي عنها. التعبير عن النسق النسبي يفترض حرية مطلقة وعالماً نقياً من كل شائبة. والتعبير الإيجابي يقوم على إدراك النسبي ، والاقتناع العقلي بأنه لا يمكن استئصال الشر من العالم ، فالشر هو ما يعرف به الخير ، ولكن الاختيار بما هو تعبير إيجابي عن الحرية يمكن أن يكون خطئا، بل انه يخطئ المرة تلو المرة حين يقطع الصلة الضرورية بين المطلق والنسبي ، وبين جزئية الواقع العياني وكليته ، وحين يعلن النسبي مطلقا ، والجزئي كليا ، أو يظنهما كذلك ، هذه الخطابات المغلقة لا تنظر الى الحرب على أنها استمرار للسياسة او امتداد لها فحسب ، بل تنظر الى السياسة ذاتها على أنها حرب تحكمها قاعدة الولاء والعداوة ، السلطة ترى في المعارضة عدواً يجب الإجهاز عليه وأخذه دوما على حين غرة ، ولا مكان له عندها إلا القبر أو السجن أو المنفى ، بل تذهب الى أن كل ما من لا يواليها هو عدو محتمل ، فتتسم علاقتها بالشعب بالريبة والتوجس ، والمعارضة لا ترى في السلطة سوى شر يجب استئصاله وكلاهما خطاب السلطة وخطاب المعارضة متواطئان موضوعيا على بقاء الوضع كما هو عليه. إذ أن القول بأن النظام كله سليم ، مثل القول بان النظام كله فاسد ، ومشكله هذين الخطابين الضدين لا تكمن في عدم إمكانية التقاء القائلين بهما ، وفي عدم إمكانية الحوار بينهم لانهم على طرفي نقيض فقط ، بل تكمن أساساً في أن أصحاب القول الأول لا يرون في النظام شيئا يحتاج الى إصلاح ، وأصحاب القول الثاني لا يرون فيه شيئا يمكن أن يصلح، وكل بما لديهم قانعون. أولئك غارقون في إيجابية خالصة قطعت كل علاقة بين النسبي والمطلق ، وأقامت نسبيتها مطلقاً، وهؤلاء غارقون في سلبية خالصة ، والإيجابية الخالصة سلبية خالصة ، فالطرفان معاً سلبيان إزاء الإصلاح الديمقراطي الممكن والواجب ، وهذه السلبية عقبة أساسية في طريق التحسن والتقدم ، هذه الخطابات المتضادة ، أوالمتناقضة تعادميةً تفصح عن ثلاث حقائق أساسية : أولاها أنها نتاج مجال سياسي مغلق ، والثانية أنها نتاج مجال سياسي متشظ ومتناثر لا مركز له ولا نقطة توازن ، والثالثة أنها نتاج رؤية مملوكية إلى السياسة وإلى المجتمع والدولة والإنسان. والوقائع التي تشير إليها هذه الحقائق هي تخارج السلطه والمعارضه ، وشلل الحياة السياسية وامكانية استيراد العنف والعنف المضاد في كل حين ، فالأنساق المغلقة أنساق مولدة للعنف بالضرورة بحكم طبيعتها ذاتها. وحين لا تتمكن من ممارسته على الآخر ، تمارسه على ذاتها بصيغ مازوشية مختلفة ، لأن الأنساق المغلقة مغلقة على ذات حصرية تنفي ، أي تطرد الاخر من دائرة رؤيتها ، ولا تعترف بالتعدد والاختلاف والتعارض في بنيتها الجوهرية أو ” الماهوية” ٠
مقالة منشورة في الملحق الثقافي لنشرة الموقف الديمقراطي شهر نيسان 2001.