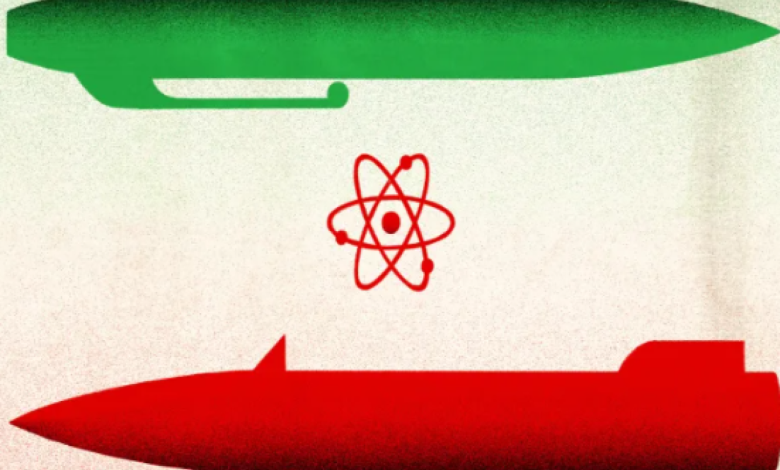
حينما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، بدا مصمماً على إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” JCPOA التي قرر سلفه، دونالد ترمب، أن تنسحب الولايات المتحدة منها بشكل أحادي في عام 2018. لذا، عيّن بايدن بسرعة مبعوثاً خاصاً من أجل بدء المفاوضات مع طهران والقوى العظمى الخمس التي لا تزال تشكّل طرفاً في ذلك الاتفاق، أي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. وفي خطابه الأول أمام الأمم المتحدة، أعلن أن إدارته “مستعدة للعودة إلى الامتثال الكامل” وملتزمة في بذل جهود دبلوماسية لإقناع إيران بأن تحذو حذوها. وسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق جديد. في الواقع، عقد كبار مسؤولي إدارة بايدن وعدد من الخبراء الخارجيين الآمال على عقد صفقة “أطول وأقوى”. ولكن منذ انسحاب إدارة ترمب، أحرزت طهران تقدماً في برنامجها النووي وطلبت ثمناً باهظاً مقابل تقويض ذلك التقدم. في المقابل، أمل بايدن في أن يتمكن فريقه من إيجاد تفاهم جديد من شأنه أن يقلل خطر الانتشار النووي.
وعلى الرغم من التحديات، بدا من المنطقي تماماً أن يحاول الرئيس بايدن إنقاذ الصفقة، إذ كان حريصاً على التخلص من تورط الولايات المتحدة وتدخلاتها في الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر (أيلول). وأراد بايدن أيضاً أن يُظهر للعالم أنه بعد عهد ترمب المليء بالاضطرابات، عادت واشنطن إلى الالتزام بالدبلوماسية. وبالتالي، شكّل إحياء الصفقة أمراً محورياً في خطة بايدن الرامية إلى استعادة الريادة الأميركية عالمياً، وخطوةً ملموسة نحو إصلاح الضرر الذي لحق بسمعة الولايات المتحدة نتيجة تخلي ترمب عن الاتفاق.
ولكن، بحسب كلمات الملاكم مايك تايسون، “كل شخص يملك خطة إلى أن يتلقّى لكمة على وجهه”. وقد تلقّت تطلعات بايدن بشأن إيران ضربات متعددة. حدثت الأولى في فبراير (شباط) 2022، حينما غزت روسيا أوكرانيا وقضت بشكل لا رجعة فيه على التنسيق بين القوى العظمى الذي أتاح إبرام الاتفاق النووي. ثم تعرّضت للكمة ثانية في أغسطس (آب)، حينما بدأت إيران في شحن طائرات من دون طيار إلى روسيا، ما جعل طهران عدواً أكثر بروزاً وضرراً. وفي سبتمبر، تلقّت الضربة الثالثة، حينما اندلعت احتجاجات ضد وحشية الحكومة في جميع أنحاء إيران، أسرت أنظار العالم، وقوضت سيطرة النظام، وأدّت إلى اعتبار أن كل اتفاق قد يزوّد طهران بموارد جديدة ضخمة، سيكون اتفاقاً خطيراً ومنفراً. كل خضّة من تلك الخضّات كانت كافية بحد ذاتها لإبقاء “خطة العمل المشتركة الشاملة” في موقف صعب، أما اجتماعها معاً، فقد شكّل ضربة قاضية.
وعلى الرغم من ذلك، لم تُعِد إدارة بايدن حتى الآن النظر بجدية في سياساتها المعتمدة تجاه إيران. فبعد أن استحوذت الحرب في أوكرانيا والمنافسة مع الصين على كامل تركيزها، سعت الحكومة عوضاً عن ذلك إلى التعامل مع تلك البيئة الجديدة بغموض متعمد. إذ قدمت دعماً رمزياً للمتظاهرين بينما كانت تخفف في الوقت نفسه من مساعيها الرامية إلى إنجاح إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد (لكن، من دون أن تتنصّل من تلك المساعي علانية). قد تمنع هذه الاستراتيجية مؤقتاً حدوث أزمة بشأن إيران، لكنها لا تستطيع تفادي كارثة إلى أجل غير مسمى. في الواقع، قد تؤدي المماطلة إلى وقوع أزمة عبر تشجيع سياسة حافة الهاوية الإيرانية أو استنفاد الصبر الإسرائيلي.
إذاً، فقد حان الوقت لأن تقر إدارة بايدن بأنه لا يمكن إعادة “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وتضع استراتيجية جديدة لا تركّز على القضية النووية فحسب بل على كافة التحديات التي تشكّلها إيران. وفي الحقيقة، لا يمثل انهيار الاتفاق النووي مجرد نهاية لمبادرة دبلوماسية معينة، بل يجسّد أيضاً الفشل النهائي لجهود الأميركية بُذِلَتْ على مدار عقود من أجل التواصل مع إيران. لطالما استندت السياسة الأميركية تجاه إيران إلى القناعة بأن واشنطن يمكن أن تعمل مع كثير من الدول الأخرى، بما في ذلك الخصوم، من أجل تخفيف عداء طهران؛ وأن القيادة الإيرانية مستعدة لخوض محادثات جدية مع الولايات المتحدة، وأن النظام الحاكم يُحكم قبضته على السلطة بشكل ثابت لا يمكن زعزعته. وحتى لو كانت تلك الافتراضات في محلها سابقاً، فمن الواضح أنها لم تعد كذلك الآن. إذ إنّ اللحظة التي نجحت فيها واشنطن وأوروبا في حثّ طهران ربما على تلطيف سلوكها قد ضاعت في طيات التاريخ. اليوم، أصبحت الدولتان اللتان تتمتعان بأكبر قدر من التأثير والنفوذ على إيران هما روسيا والصين، وهما لا تملكان حافزاً كبيراً لزعزعة الوضع الراهن. وربما سعت الحكومة الإيرانية ذات مرة إلى هدنة محدودة مع الولايات المتحدة، لكن النظام تخلى الآن عن فكرة التواصل مع الغرب، وقد رَبَطَ مستقبل إيران بالعلاقات مع الدول الاستبدادية الأخرى. في غضون ذلك، فإن المواطنين الإيرانيين العاديين الذين واجهوا النظام طوال أشهر من احتجاجات ملأت الشوارع، على الرغم من تعرّضهم لمخاطر لا تُحصى، يمهدون الطريق أمام مستقبل مختلف لبلدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تغيير المسار لا يُعدّ أمراً سهلاً على الإطلاق. وبطريقة موازية، فإن استثمار بايدن السياسي والدبلوماسي في “خطة العمل الشاملة المشتركة” يجعل من الصعب للغاية التخلي عنها. في المقابل، لم يعد لهذا الاتفاق أن يوفر مساراً واقعياً للتخفيف من التهديدات التي تشكلها طهران. وإذا كان بايدن يريد تأمين مستوى رؤية أفضل دولياً لأنشطة إيران النووية، فعليه حشد الدول التي تملك تفكيراً مماثلاً [للتفكير الأميركي] من أجل ضمان وفاء تلك الدولة [إيران] بالتزاماتها بموجب “معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”. وإذا كانت واشنطن ترغب في وضع حد لسلوك إيران الخبيث في الداخل والخارج، فعليها أن تحافظ على حيّزٍ للاحتجاجات. وفي الواقع، تمثل تعبئة الشعب الإيراني أفضل فرصة على الإطلاق لإحداث تغيير إيجابي ودائم في دور البلاد عالمياً.
تاريخ قذر
احتلت إيران مكانة مركزية في السياسة الخارجية الأميركية منذ أن أطاحت ثورة 1979 بمحمد رضا بهلوي، آخر شاه للبلاد والشريك الاستراتيجي لواشنطن. ثم سعت الحكومة التي شُكّلت في أعقاب ذلك واتّخذت طابع “الجمهورية الإسلامية”، إلى تغيير النظام الإقليمي من خلال الإرهاب والتخريب، وغرقت في العداء تجاه الولايات المتحدة. في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، استولت مجموعة من الطلاب المتشددين على السفارة الأميركية فكأنّهم يحاولون الإعلان عن عداء إيران الجديد تجاه واشنطن وقواعد العلاقات الدولية. ثم احتجزوا 66 من موظفي الحكومة الأميركية كرهائن، مطالبين واشنطن بمجموعة متنوعة من التنازلات الاقتصادية والسياسية مقابل إطلاق سراحهم.
واستغرق الأمر 15 شهراً من المحاولات غير الناجحة ومهمات الإنقاذ الفاشلة قبل أن تنجح الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات على إطلاق سراح جميع الرهائن. ولكن، بعد الهجوم على السفارة مباشرة تقريباً، وضعت إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر استراتيجية ذات مسارين من شأنها أن تحدد سياسة واشنطن تجاه إيران طوال عقود قادمة. من ناحية، قررت أن تعاقب الولايات المتحدة إيران على سلوكها المزعزع للاستقرار. ومن ناحية أخرى، أبقت الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام المفاوضات. على مدى السنوات الأربعين التالية، اتبع كل رئيس أميركي هذا المسار المزدوج، مهدداً إيران وفارضاً عقوبات عليها، ومتيحاً في الوقت نفسه فرصة للتحدث مع قادة البلاد. حتى ترمب، الذي أعطى الإذن بقتل مسؤول عسكري إيراني كبير في عام 2020، طرح إمكانية لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في عام 2019.
استطراداً، لم تكن تلك الأمور كلها مجدية. إذ جاء سجل الإنجازات الأميركية بشأن إيران متواضعاً في أحسن الأحوال. لقد أبطأت واشنطن وشركاؤها مساعي طهران المستمرة منذ 30 عاماً الرامية إلى الحصول على الموارد اللازمة لبناء أسلحة نووية، وقد أعاقوا نفوذ بعض الوكلاء الإيرانيين. ولكن، لم يحدث سوى عدد قليل من الانفراجات والحلول المجدية أو التحولات والتغييرات المستدامة، على صعيد سياسات إيران الأكثر إشكالية، وغالباً ما أثبت أقرب شركاء واشنطن أنهم مترددون في تعريض علاقاتهم التجارية أو الدبلوماسية مع طهران للخطر. وحتى في بعض الأحيان، أسهمت تصرفات الولايات المتحدة في مساعدة “الجمهورية الإسلامية”. فمن خلال القضاء على عدو رئيس لإيران، أدى الغزو الأميركي للعراق عام 2003 إلى تعزيز قدرة النظام واستعداده لتأجيج حالة عدم الاستقرار والعنف المسيطرة في الداخل والخارج.
والجدير بالذكر أنّ الصعوبة الواضحة في إيجاد حلول للتحديات التي تشكّلها إيران، جعلت البلاد موضع خلاف دائم بين الحزبين الأميركيين. وبلغ الخلاف ذروته في المعركة الضارية حول الصفقة النووية المبرمة في عهد إدارة أوباما عام 2015، التي خففت العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. بالنسبة إلى مؤيديها، برّر ذلك الاتفاق استخدام الدبلوماسية المتعددة الأطراف كأداة لحل حتى أصعب التحديات الناجمة عن طهران. لكن بالنسبة إلى النقاد، فحقيقة أنّ القيود المفروضة بموجب تلك الصفقة قد انقضى أجلها في نهاية المطاف، جعلها تمثل استسلاماً لا يمكن تصوره. وبعد انسحاب ترمب من الصفقة في عام 2018، زادت إيران عدوانها الإقليمي وانتهكت عدداً من مبادئ الاتفاق.
واستطراداً، سعت إدارة بايدن إلى التراجع عن الإجراءات التي اتخذها ترمب. وسرعان ما تعرقلت جهودها الرامية إلى إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة”. إذ رفضت طهران التعامل مباشرةً مع الدبلوماسيين الأميركيين، ما أجبر واشنطن على التفاوض من خلال شركائها الأوروبيين. وأصرت إيران على أن تضمن إدارة بايدن عدم انسحاب أي رئيس مستقبلي من الاتفاق، وهو مطلب لا يملك بايدن السلطة لتحقيقه. وكلما اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق، رفعت طهران سقف مطالبها وسعت إلى الحصول على تنازلات إضافية، مؤجّلة باستمرار عقد أي تسوية.
وعلى الرغم من ذلك، ففي السنة الأولى من رئاسة بايدن، أمل الدبلوماسيون الأميركيون في أن يتمكّنوا من كسر الجمود في النهاية. وبعد كل شيء، استغرق التوصل إلى الصفقة الأصلية حوالى سنتين. ثم حصل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ما أدى إلى تغيير البيئة الدولية الحاضنة التي ساهمت في صمود تلك الصفقة. في الواقع، اعتمد الاتفاق النووي الأساسي على التعاون الغربي مع موسكو، التي وجدت مصلحةً لها في البنية التحتية النووية المتوسعة لإيران، وبالتالي امتلكت القدرة على تشجيع طهران، وتملقها، وابتزازها من حين لآخر، كي تتوصل إلى تفاهم مع الغرب. ولم تؤدّ الحرب إلى إلغاء رغبة روسيا في التعاون مع الولايات المتحدة فحسب، بل منحت موسكو حافزاً لإبطال الصفقة تماماً. وأي تخفيف للعقوبات على إيران سيسمح لطهران ببيع النفط مرة أخرى في الأسواق العالمية، ما يقلل عائدات روسيا من النفط. على النقيض من ذلك، فإن إطالة أمد الأزمة النووية الإيرانية يساعد على دفع طهران بقوة أكبر إلى فلك الكرملين.
ويبدو أن القيادة الإيرانية قد أجرت حسابات مماثلة. إذ سافر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو قبل أسابيع قليلة من الغزو، ووصف رئيسي ومسؤولون اخرون الزيارة بأنها “نقطة تحول” في العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين، باعت إيران لموسكو آلاف الطائرات المسيّرة التي استخدمتها روسيا في تدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. إضافة إلى ذلك، تساعد إيران في تدريب الجنود الروس ونقل أنظمة إنتاج الطائرات من دون طيار إلى روسيا. ووفقاً لإدارة بايدن، فقد تبدأ بعد ذلك في مدّ روسيا بصواريخ باليستية. في المقابل، وعدت موسكو إيران بمروحيّات وأنظمة دفاع جوي جديدة وطائرات مقاتلة. وسبق أن بدأ الطيارون الإيرانيون يتدربون على تشغيل طائرة مقاتلة روسية من طراز “سوخوي سو-35” Sukhoi Su-35 وهي في طريقها إلى بلادهم. وأشارت موسكو أيضاً إلى أنها ستستثمر 40 مليار دولار في تطوير النفط والغاز الإيراني (على الرغم من أن هذا التعهد يبقى عرضة للشكوك)، ووعدت بأن تنشئ بين البلدين ممرات تجارية وآليات مالية محمية من العقوبات.
ويجسّد قرار إيران بالانحياز إلى الحرب الروسية أكثر من مجرد انتهازية قصيرة المدى. إذ يمثّل دليلاً على تطور دراماتيكي في مواقف النخبة الحاكمة ومصالحها في “الجمهورية الإسلامية”. فقبل عشر سنوات، اعتبر النظام الإيراني أنّ الوصول إلى الأسواق والأنظمة الغربية، على غرار خدمة تبادل الرسائل الخاصة بالمعاملات المالية “سويفت” SWIFT ومقرها أوروبا، بمثابة الأمر الحيوي للغاية بالنسبة إلى اقتصاد البلاد واستقرار النظام لدرجة أنهم تجاوزوا أكثر من 30 عاماً من النفور وانتقلوا إلى مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وعلى غرار ما ذهب إليه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نفسه في عام 2015، “شكّل رفع العقوبات السبب وراء دخولنا في المفاوضات وتقديم بعض التنازلات”. لكن اليوم، لم يعد النظام يرى الغرب كوسيلة ضرورية، أو حتى مجدية، في تحقيق المنافع الاقتصادية. وفي خطاب ألقاه خامنئي في نوفمبر الماضي إحياءً لذكرى الاستيلاء على السفارة، أشار إلى أنه “اليوم، لا تُعتبر الولايات المتحدة القوة المهيمنة في العالم”. وتابع، “يعتقد عدد من المحللين السياسيين في العالم أن الولايات المتحدة تتراجع. إنها تتلاشى تدريجياً”. وعوضاً عن ذلك، يرى خامنئي وغيره من القادة الإيرانيين أن مركز القوة العالمي الجديد ينتقل نحو الشرق. وبابتهاج، عبّر خامنئي عن ذلك، “ستصبح آسيا مركز المعرفة، والاقتصاد، والسلطة السياسية، والقوة العسكرية”. وأضاف، “نحن موجودون في آسيا”.
في سياق متصل، حاول صناع السياسة الإيرانيون وضع رؤية خامنئي موضع التنفيذ من خلال نسج علاقات أوثق مع دول آسيوية عدة، خصوصاً الصين. وفي ذلك الإطار، أبرمت بكين وطهران صفقة اقتصادية ضخمة في يوليو (تموز) 2021 بقيمة 400 مليار دولار. في العام التالي، وافقت طهران على الانضمام إلى “منظمة شنغهاي للتعاون” Shanghai Cooperation Organization، وهي مجموعة تربط الصين والهند وروسيا وعدداً من دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا. واحتفلت صحيفة “كيهان” الإيرانية البارزة والمؤثرة بهذه الخطوة ووصفتها بأنها تشكّل تقارباً جديداً بين “القوى العظمى الثلاث”، الصين وروسيا وإيران. وعلى الرغم من أنه يصعب التصور أن بكين أو موسكو تنظران إلى إيران على أنها توشك أن تصبح نظيراً لهما، إلا أنهما تريان بعض الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية في التعاون التكتيكي معها. وخلافاً للولايات المتحدة أو أوروبا، نادراً ما تربط بكين وموسكو العلاقات التجارية أو الدبلوماسية بالمعايير الليبرالية للسياسة الداخلية أو الخارجية. وبالنسبة إلى الثيوقراطيين الإيرانيين، فإن هذا النوع من العلاقات أكثر ملاءمة لهم.
وبعد أن استمد القادة الإيرانيون مزيداً من الجرأة بسبب وجود رعاة أقوى، أظهروا استعداداً أكبر للانخراط في السلوك الخبيث. إذ زرع النظام الإيراني ووكلاؤه الرعب في نفوس جيرانهم، خصوصاً العراق ودول الخليج، بالصواريخ والطائرات من دون طيار، وساعدوا في تأجيج التمرد والحروب الأهلية في سوريا واليمن. ووفقاً لتقارير صحيفتي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، سعت إيران إلى اغتيال المعارضين والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة. جاءت تلك الأفعال أعلى صوتاً وأشد وقعاً من خطاب طهران المشاكس، وكذلك فإنها لم تُشر إلى أن القيادة الإيرانية مستعدة للتوصل إلى تسوية تاريخية مع خصمها الأقدم.
تحت الضغط
في سبتمبر 2022، اعتقل عناصر من شرطة الأخلاق في البلاد مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً، زاعمين أنها ارتدت الحجاب الإلزامي بشكل غير لائق. وبحسب تقارير عدة، تعرضت أميني بعد ذلك للضرب والتعذيب على أيدي قوات الأمن الحكومية إلى أن فقدت وعيها. ونُقلت إلى مستشفى في طهران، حيث بقيت في غيبوبة لمدّة يومين قبل وفاتها. وفضح أفراد عائلة أميني ما حدث بشجاعة على الرغم من ضغوط الحكومة لجعلهم يقبلون التستّر على الحقيقة.
واندلعت الاحتجاجات على الفور تقريباً. وفي غضون أسبوع امتدت الاضطرابات إلى 80 مدينة في جميع أنحاء البلاد. وطالب كثير من المتظاهرين بإلغاء قواعد اللباس الإيرانية الخاصة بالنساء وحلّ شرطة الآداب. ولكن سرعان ما تصاعدت الاحتجاجات إلى حد المطالبة بإسقاط النظام. وعلى غرار احتجاجات سابقة، ردت قوات الأمن بقمع وحشي. واعتقلت أكثر من 19 ألف متظاهر وقتلت أكثر من 500، وفرضت سلسلة من الإعدامات المجحفة بصورة مرعبة تهدف إلى ترويع السكان المستائين بشكل كبير. ولم يوقف القمع الانتفاضة. ومنذ وفاة أميني، شهدت إيران وتيرة ثابتة من التظاهرات الصغيرة والإضرابات العمالية والمواجهات بين الناس العاديين وكبار المسؤولين.
في المقابل، يميل المراقبون المخضرمون من متابعي الشأن الإيراني إلى الاستخفاف باحتمالات التغيير السياسي المجدي والفعلي. وعلى ما يبدو، فقد عانت “الجمهورية الإسلامية” كل أنواع الأزمات التي يمكن تخيلها، من حرب أهلية، وغزو، وإرهاب، وزلازل، وجفاف، ووباء، وفترات روتينية من الاضطرابات الداخلية، بيد أنّ النظام الحاكم، ما زال صامداً. وهناك أسباب كثيرة تجعل هذه الموجة من الاضطرابات تنحسر، من بينها عدم وجود أي قائد محدد أو منظمة مركزية أو رؤية تصحيحية للمستقبل.
وفي المقابل، يبدو أنّ هناك شيئاً مختلفاً بشأن اندلاع الاضطرابات الداخلية الأخيرة، ربما تجسّده تلك الشجاعة غير العادية التي تحلّت بها المرأة الإيرانية في تحدي الحجاب الإلزامي وفي تحفيز التحركات، أو المشاركة غير العادية لمجموعة واسعة من الفئات العرقية والطبقات الاجتماعية، أو الوحدة الجديدة بين شرائح السكان ذوي الأيديولوجيات المتباينة. واستطراداً، ربما تصل جهود المحتجين الأخيرة الرامية إلى تسخير تكتيكات تذهب إلى ما هو أبعد من التظاهرات، إذ تشمل إضرابات عمالية وهجمات إلكترونية على البنوك الحكومية ووسائل الإعلام. ومن الواضح أن المحتجين ينتابهم اليوم خوف أقل من ذاك الذي شعر به المتظاهرون في الماضي. وباتوا يعودون إلى الشوارع مراراً وتكراراً على الرغم من معرفتهم بالتأكيد بأنهم معرضون لخطر الاعتقال والموت. كذلك، فإنّ الرياضيين الإيرانيين المشهورين ومخرجي الأفلام والممثلين وغيرهم من الشخصيات الثقافية البارزة، تحدّوا التهديدات كي يعبّروا عن دعمهم للانتفاضات، حتى بعد سجن بعض زملائهم.
وهكذا، أسرت الحركة الشعبية الانتباه والدعم في جميع أنحاء العالم. في نوفمبر، أطلق “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة تحقيقاً مستقلاً في أفعال النظام. وفي ديسمبر (كانون الأول)، اتخذ “المجلس الاقتصادي والاجتماعي” التابع للأمم المتحدة خطوة غير عادية بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. وبطريقة موازية، أعربت حكومات في القارات كلها عن تأييدها للتظاهرات. ويُعتبر هذا الدعم ضروري ومهم، بيد أنّه زاد من تقويض “خطة العمل الشاملة المشتركة”. لقد أصبح النظام الإيراني محاصراً أكثر من أي وقت مضى. وصار يرى بنيته التحتية النووية على أنها ضرورية بشكل متزايد من أجل تحمل الضغط المحلي والدولي. وبما أنّ الحكومة تصبّ معظم تركيزها على البقاء صامدةً، فمن غير المرجح أن تمارس كثيراً من الدبلوماسية، خصوصاً مع الغرب. وفي ذلك السياق، أوضح خامنئي أخيراً إن التظاهرات حدثت نتيجة ” تخطيط الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الزائف الغاصب والمرتزقة التابعة لهما”. لذا، من العسير أن نتصوّر كيف أن النظام الذي يلوم واشنطن على أزمته الوجودية سيصادق على إبرام أي نوع من الاتفاق مع صانعي السياسة الأميركيين.
وفي سياق مغاير، يعبّر بعض المحللين الأميركيين والأوروبيين عن رأي مخالف. ومن وجهة نظرهم، قد يؤدي الاضطراب الداخلي الإيراني إلى مرونة جديدة على طاولة المفاوضات لأن إحياء الاتفاق النووي من شأنه أن يخفف من الضغوط الاقتصادية وبالتالي يمكن أن يكون طوق النجاة لللحكومة. كذلك، يسلّط أولئك المحللون الضوء على تظاهرات إيران في عام 2009، حينما خرج الناس إلى الشوارع بأعداد كبيرة بسبب عملية إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد المتنازع عليها. وعلى غرار مسار الأمور حاضراً، تضامن العالم مع صرخة الإيرانيين من أجل الحرية. في ذلك الوقت أيضاً، على غرار مسار الأمور الآن، ألقت الحكومة الإيرانية باللوم على الولايات المتحدة. وفي الأشهر التي أعقبت ذلك، على الرغم من الصعوبات، انتصر القمع الحكومي وأُنهكت المعارضة. في المقابل، إنّ شبح الاضطراب الشعبي والضغط الاقتصادي الشديد الناتج من العقوبات المتعددة الأطراف، ساعد في إقناع قادة إيران بأن يتقبّلوا على مضض مفاوضات مع واشنطن كان من المستحيل حدوثها سابقاً.
ومن البديهي أن تكون فكرة وجود محور إيراني آخر يتسم بالبراغماتية تحت الضغط فكرة جذابة، لكن التحولات داخل إيران وفي النظام الدولي تستبعد هذا الاحتمال. ففي العقد الماضي، خفّت الانقسامات بين الفصائل داخل النظام؛ وازداد الإجماع المتشدد تصلّباً. واستطراداً، تضاءلت الشرعية المزعومة التي تستند إليها الحكومة بسبب الفساد والمحسوبية، وتبيّن أنّ وعودها بمستقبل أفضل كانت عقيمة. وهكذا، لم يعد لدى الإيرانيين العاديين أي أوهام بإصلاح تدريجي يؤدي إلى تقدم ملموس. قبل عقد من الزمان، شكّلت المفاوضات مع الغرب السبيل الوحيد كي تتجنّب طهران العقوبات الكارثية، لكن طهران ترى اليوم أن الصين وروسيا تقدمان بديلاً جذاباً. ومن دون تعاون بكين وموسكو، لا تستطيع واشنطن ممارسة ضغوط كافية على طهران من أجل إقناع قادتها بتقديم تنازلات.
واستكمالاً، أثارت الاحتجاجات أسئلة جديدة حول قيمة الاتفاق النووي. حتى لو نجحت الدبلوماسية في إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة”، فليس من الواضح على الإطلاق إذا كانت فوائد ذلك الأمر ستفوق التكاليف. في الواقع، إن إنعاش تلك الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى حصول النظام على كميات هائلة من الموارد، ما يعزز النظام الحاكم في إيران على حساب أولئك الذين يتحدّونه في الشوارع. وكذلك، فإنّ الإيرانيين الشجعان الذين خاطروا بحياتهم وسبل عيشهم على أمل إحداث التغيير، سوف ينظرون إلى الإتفاق بوصفه خيانة. وبحسب كلمات المدافعة الإيرانية الأميركية عن حقوق الإنسان، رويا حكاكيان، في أكتوبر (تشرين الأول)، “إن أفظع ما يمكن أن نرتكبه نحن، الولايات المتحدة، في الوقت الحالي هو الجلوس جنباً إلى جنب مع نفس الأشخاص الذين يطلقون النار على المتظاهرين، المتظاهرين السلميين، في الشوارع”.
في الحقيقة، فمن شأن إحياء “خطة العمل الشاملة المشتركة” الآن أن يقوض أحد الأهداف الأساسية للصفقة المتمثل في دفع طهران للتخلي عن سياساتها الأكثر شراً. لقد أصر الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن اتفاق 2015 “لا يراهن على إحداث تغيير في إيران”، لكنه أعلن أيضاً أن تحقيق هذا التغيير “قد يكون في نهاية المطاف نتيجة ثانوية مهمة لهذه الصفقة”. في منحى مقابل، أعرب آخرون عن هذا الأمل بشكل أكثر صراحة ووضوحاً. ووفقاً لفيليب هاموند، وزير خارجية المملكة المتحدة خلال المراحل الأخيرة من مفاوضات الاتفاق النووي، فإن “المكاسب لم تقتصر على إنهاء سباق التسلح النووي هذا أو أي طموح نووي إيراني، بل تعدّت ذلك كي تشمل إعادة تأهيل أوسع للعلاقة بين إيران والغرب”. وبالتالي، إن أي اتفاق يُبرَم اليوم، في الوقت الذي ينخرط فيه النظام في فظائع هائلة في الداخل ويساعد روسيا في شن هجوم وحشي على أوكرانيا من خلال تزويد موسكو بطائرات مسيّرة، سيكون بمثابة مكافأة لطهران على التجاوزات التي ارتكبتها وسيجعل من الصعب منع ارتكاب مزيد منها.
أفضل الخطط الموضوعة
لن يكون من السهل على إدارة بايدن إلغاء الجهود المبذولة على جميع الأصعدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بعض كبار مسؤولي السياسة الخارجية كانوا من المهندسين الرئيسيين للاتفاق الأصلي. يعرف أولئك المسؤولون، أن “خطة العمل الشاملة المشتركة” اعتُبرت إنجازاً تاريخياً في الوقت الذي أُبرمت فيه الصيغة النهائية منها. إذ إنّها كانت المرة الأولى منذ عقود التي تحدث فيها مفاوضات مستمرة ومباشرة ورفيعة المستوى بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين. وكذلك فقد شكّلت حالة نادرة توصلت فيها الدولتان إلى تفاهم حول قضية حيوية تتعلق بالأمن القومي. ومن أجل إتمام الصفقة، توجب على المسؤولين الأميركيين كسب معركة استمرت على مدار سنوات ضد المعارضين في واشنطن وعدد من شركاء الولايات المتحدة الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى صانعي السياسة هؤلاء، استحقت تلك المعركة العناء لأن الاتفاق حمل وعداً بأن يجد حلاً لأحد أكبر التحديات في العالم، مشدّداً في الوقت نفسه على أهمية الالتزام باستخدام الوسائل السلمية.
وازدادت قيمة الاتفاق بسبب عدم وجود أي بديل أفضل. وفي ذلك الصدد، إن توجيه ضربة عسكرية إلى منشآت إيران النووية من شأنه أن يخاطر بتصعيد إقليمي باهظ التكلفة وفي أحسن الأحوال فلن يوفر سوى استراحة مؤقتة من خطر ظهور دولة إيرانية نووية. واستكمالاً، يُعدّ البرنامج النووي الإيراني متقدماً للغاية لدرجة أنّه لا يمكن القضاء عليه بشكل قاطع بالضربات الجوية، خصوصاً في ظل وجود منشآت مهمة صُمّمت بشكل يجعلها محصنة وتقع بالقرب من المراكز السكانية الرئيسة. في أكتوبر 2022، أشار روبرت مالي، المسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد أوباما والمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران في الوقت الراهن، “لا يوجد حل مستدام طويل الأجل غير الحل الدبلوماسي”. وفي شهر ديسمبر، أوضح مالي لإذاعة أوروبا الحرة Radio Free Europe أنه “مهما حدث في الأشهر القليلة الماضية، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لضمان منع إيران من حيازة سلاح نووي، تكون عبر صفقة نووية”. والجدير بالذكر أنّ شركاء واشنطن الأوروبيين يعبّرون عن تلك الآراء نفسها ويردّدونها.
في مسار مقابل، إن غياب حل بديل واضح لا يعني أن المسار الحالي ممكن. وفي الواقع، لا مجال لإنكار الحقائق. فبين الاحتجاجات، والحرب في أوكرانيا، والتعنت الإيراني العام، بات من المتعذّر إنقاذ الاتفاق. وقد وعد بايدن بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي خلال ولايته، وإذا كان ينوي الوفاء بهذا التعهد، فسيتعين على إدارته إيجاد حل آخر.
كبداية، يمكن للإدارة أن تحاول التوصّل إلى توافق مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل، بشأن منع طهران من اتخاذ خطوات قد تجعلها على شفا التسلّح النووي. وتشمل تلك الخطوات تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بنسبة 90 في المئة، وإنهاء عمليات التفتيش التي تقوم بها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” في المنشآت الإيرانية أو إعاقتها بشكل جدّي، والانسحاب من “معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”، واستئناف التسلح أو الأنشطة المتعلقة بالتسلح، على غرار توسيع إنتاجها لمعدن اليورانيوم. جنباً إلى جنب مع الشركاء الأوروبيين، يجب على إدارة بايدن تحديد العواقب الاقتصادية والسياسية والعسكرية الوخيمة التي تنتظر إيران إذا تجاوزت هذه الخطوط. ويجب أن تشمل تلك التداعيات مزيداً من الإجراءات العقابية التجارية والمالية واستعداد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها لاستخدام القوة من أجل إضعاف البنية التحتية النووية الإيرانية. كذلك، ينبغي أن تُبلَّغ طهران بهذه الخطوط الحمراء وما يترتب على تجاوزها، بكل هدوء وعلى أعلى المستويات، ومن خلال عدد من المحاورين الموثوق بهم؛ بغية تعزيز وحدة الهدف الذي يرمي هذا التحالف إلى تحقيقه والمتمثل في منع الانتشار النووي الإيراني.
واستطراداً، يجب تعزيز هذه الرسالة من طريق إجراء تدريبات عسكرية مشتركة سريعة الوتيرة في المنطقة بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية، من شأنها أن تبيّن قدرة تلك الدول على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، على غرار تلك التي أجرتها القوات الأميركية مع إسرائيل في نوفمبر 2022 ومرة أخرى في يناير 2023. وينبغي أن يواصل البنتاغون تعزيز التخطيط والتنسيق الأمني المتعدد الأطراف الحديث العهد الذي تعهدت به إسرائيل ودول الخليج، والاستثمار في تقوية نظام دفاع جوي إقليمي متكامل كوسيلة في التأكيد على جهوزية الولايات المتحدة واستعدادها لتنفيذ التزام بايدن المعلن بضمان عدم حيازة إيران أسلحةً نووية.
وبطريقة موازية، يتوجّب على ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً التخطيط للطريقة والوقت المناسبين لتفعيل ما يسمى بآلية “سناب باك” [إعادة إطلاق] ضمن “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهي آلية تمكّن أي طرف في الصفقة من إعادة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران ثم عُلِّقَتْ تعليقها بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتجدر الإشارة إلى أنّ الخطر في تلك الآلية يكمن في حصول تصعيد إيراني، لكنها ستنهي الغموض بشأن إمكانية إحياء الصفقة، وستسلّط الضوء مجدداً على القوة الرمزية التي تتمتّع بها عقوبات الأمم المتحدة، وستلغي انتهاء صلاحية الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على عمليات بيع الصواريخ الباليستية الإيرانية التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام.
واستكمالاً، لا تتمثل بنود “سناب باك” في الضغط الاقتصادي وحده، الذي قد تمارسه هذه الدول على طهران. في الواقع، اعتبرت دول أخرى كثيرة أنّ التجارة والاستثمار في إيران يشكّلان وسيلة نفوذ مهمة، وبالتالي فقد عارضت في الغالب معاقبة إيران إلا خلال فترة تسبق المفاوضات النووية. لطالما اعتمدت إيران بشكل كبير على العلاقات التجارية والمصرفية مع دبي. وحتى أواخر عام 2022، احتفظت ألمانيا ببرنامج ائتمانات التصدير وغيرها من عمليات الترويج التجاري من أجل تحفيز التعاون الاقتصادي مع طهران، على الأقل من الناحية النظرية. في المقابل، أدى الدور المدمر الذي أدّته إيران في أوكرانيا إلى زيادة التشدد في وجهات النظر الأوروبية تجاه النظام، وفق ما اتضح من قرار البرلمان الأوروبي في يناير المتعلّق بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية. ومثلاً، تستطيع الدول الأوروبية أيضاً، استهداف أصول طبقة “أغازاده” [أي أبناء المسؤولين الأغنياء] الإيرانية من الرأسماليين المحسوبين على النظام، على غرار استهدافها ممتلكات الأوليغارشية الروسية [عقب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا].
في مسار مغاير، قد لا تتأثر إيران بإجراءات الغرب وحده، نظراً لاعتقادها بأن وضع الولايات المتحدة وحلفائها يشهد تراجعاً وتدهوراً. نتيجة لذلك، يجب على واشنطن وشركائها الضغط بقوة من أجل الحصول على تعاون الصين التي تزعم طهران بشكل أحادي أنها أحد شركائها والمشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وفي الواقع، سيكون ذلك تحدياً فريداً. تاريخياً، لعبت بكين دور المنتفع بالمجان في الدبلوماسية النووية مع طهران، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن القادة الصينيين مستعدون لتحمل مسؤولية أكبر في منع إيران من حيازة أسلحة نووية، خصوصاً مع ازدياد التوترات بين بكين وواشنطن ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة. لكنّ الصين ليست روسيا، وبالتالي، لا يزال بإمكانها عقد صفقات مع الغرب. ويعتمد اقتصاد الصين على الطاقة من الخليج العربي، ما يمنح الرئيس الصيني شي جينبينغ حافزاً قوياً للتعاون في أي مبادرات من شأنها منع حدوث أزمة في المنطقة، قد يؤدّي السلاح النووي الإيراني بالتعجيل في وقوعها. وقد أدّت بكين دوراً مهماً للغاية في الحفاظ على الاقتصاد الإيراني من خلال استيراد أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني يومياً على مدار السنوات الماضية، في تحدٍ مباشر لـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” التي كانت الصين طرفاً فيها. لذا، يجب على إدارة بايدن إقناع الصين بالحد من تلك الواردات من طريق التوضيح بأن واشنطن ستفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تواصل شراء النفط الإيراني، وتلك خطوة لم تتخذها الولايات المتحدة إلا بشكل متقطع وانتقائي.
إنّ عالماً خالياً من مسار دبلوماسي يرمي إلى إحباط الطموحات النووية الإيرانية سيتطلب يقظة أكبر من جهة الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا والشرق الأوسط وحتى المناطق الأخرى. وسيؤدي الواقع الجديد إلى إحباط رغبة إدارة بايدن في إخراج الولايات المتحدة من الصراعات المدمرة في الشرق الأوسط من أجل التركيز على التحدي الاستراتيجي الملح الذي تفرضه الصين، بيد أنّ الرؤساء لا يتمتعون بصلاحية تجاهل أزمات تلوح بوادرها. ووفق ما تبيّن بجلاء مع الحرب في أوكرانيا، فمن خلال البصيرة والتنسيق الماهر وحسن القيادة، يستطيع العالم الذي يعاني انقساماً أن يتّحد بطرق فعالة للغاية من أجل مواجهة العدوان.
اعرف حدودك
ثمة طريقة أخرى يمكن أن تسهم فيها الولايات المتحدة في وقف طموحات إيران النووية، وبقية التصرفات الخبيثة الصادرة عن النظام. وقد لا توافق الحكومة الإيرانية الحالية مطلقاً على التنازل عن برنامجها النووي أو التوقف عن تأجيج الصراعات في جميع أنحاء العالم. لكن المتظاهرين الإيرانيين أوضحوا أنهم يريدون حكومة ديمقراطية تركز على حاجات شعبها لا على المغامرات السياسية في الخارج. ومن شبه المؤكد أن مثل تلك الحكومة ستكون أقل اهتماماً في امتلاك أسلحة نووية أو تعزيز حركات التمرد. وبالتالي، ينبغي على واشنطن أن تبذل ما في وسعها من أجل مساعدة المتظاهرين على تحقيق أهدافهم.
في ملمح مغاير، من المؤكد أن هناك حدوداً فعلية لقوة واشنطن. إذ لا تملك الولايات المتحدة سوى تأثير هامشي في أروقة السلطة الإيرانية وليس لها نفوذ يذكر في الشوارع. إذاً، سيعتمد مستقبل إيران في النهاية على الإيرانيين أنفسهم. في المقابل، يمكن لصناع السياسة في الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء بهدف ضمان أن يسلّط المجتمع الدولي الضوء على الجهود البطولية التي يبذلها المحتجون الإيرانيون، ويكشف عن القمع الذي تمارسه طهران، ويجد طرقاً مناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية من خلال العمل عن كثب مع بعثة تقصّي الحقائق التي أنشأتها الأمم المتحدة في نوفمبر من أجل التحقيق في حملة القمع، والضغط على الشركاء في جميع أنحاء العالم لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران.
استكمالاً، تستطيع الولايات المتحدة أيضاً مساعدة الشعب الإيراني من خلال توسيع وصوله إلى المعلومات والاتصالات. وقد زادت إدارة بايدن بالفعل من تعاملها مع شركات التكنولوجيا من أجل مساعدة الإيرانيين على التواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي. ويتوجب على تلك الإدارة أن تعمل أيضاً مع مزودي الخدمة لإنشاء وتوزيع مجموعة كبيرة من أدوات الاتصال، بتمويل من الحكومة الأميركية عند الضرورة، وتوسيع وصول الإيرانيين إلى الشبكات الخاصة الافتراضية التي يمكن أن تبقيهم على اتصال بالإنترنت المفتوح. وعلى نحو مماثل، يمكن لواشنطن أن تساعد من خلال الاستثمار في قدرات البث باللغة الفارسية من أجل تقويض احتكار النظام لوسائل الإعلام.
بالنتيجة، لا يعني دعم المحتجين أن الولايات المتحدة يجب أن تغلق جميع سبل التواصل مع إيران، وفق ما اقترح بعض النشطاء. وينبغي ألا يؤدي الابتعاد عن “خطة العمل الشاملة المشتركة” إلى منع التوصل إلى علاقات دبلوماسية. لذا، يجب أن تستمر إدارة بايدن في الحديث مع إيران حول القضايا المنفصلة التي يمكن للبلدين تحقيق بعض الإنجازات فيها، بما في ذلك عن طريق مواصلة الجهود الهادئة المبذولة للإفراج عن الرعايا المزدوجي الجنسية والأجانب المحتجزين لدى طهران كرهائن. وبطريقة موازية، يجب ألا تفعل الولايات المتحدة شيئاً يثبّط المناقشات الجارية بين إيران وجيرانها الخليجيين. في الواقع، من غير المحتمل أن تؤدي تلك المحادثات إلى أي شيء غير السلام البارد، لكن الدبلوماسية المباشرة قد تساعد في منع أي احتكاك من أن يتفاقم ويتحوّل إلى أزمة.
في نهاية المطاف، قد يكون منع الأزمات هو أفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة في الوقت الحالي. ففي المستقبل المنظور، لا توجد حلول جذرية يمكن للغرب أن يبتكرها أو يفرضها على إيران، وستظل البلاد تشكل تهديداً عميقاً وغير متوقع للاستقرار الإقليمي، ومصالح الولايات المتحدة، والمواطنين الإيرانين. في المقابل، يجب أن تبعث الاحتجاجات الأمل في العالم. فللمرة الأولى منذ جيل، يبدو أن الثيوقراطية [نظام الديكتاتورية الدينية] في خطر. ولكن، بانتظار أن يسقط النظام، لن يكون هناك حل سحري يوقف سلوك إيران السيئ.
سوزان مالوني، نائبة الرئيس ومديرة “برنامج السياسة الخارجية” في “معهد بروكينغز”.
المصدر: اندبندنت عربية







