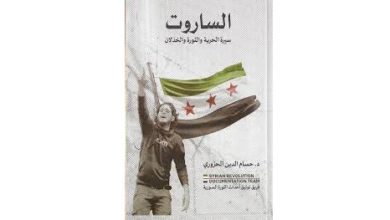بتكاسل ملحوظ، ولجا عربة القطار القديمة، ومن غير اهتمام، ركنا حقيبتيهما على رفّ معدني لا يزال يحتفظ بشيء من القدرة على التحمل..! كوّما نفسيهما وتعبهما فوق مقعدين كبيرين متلاصقين..!
التعب المتراكم وجد فرصته ومداه، فتغلغل في مجاهل الجسدين الناحلين، وأخذ يفعل فعله التخديري السريع..! فتهدّلت بعض الأجفان ومالت إلى الارتخاء والذبول.. لكنّ صفير القطار المؤذن بالرحيل، دوّى في آذان الركاب جميعاً، فانتبهوا إلى أنفسهم وتعويذاتهم..!
ضجيج عجلات القطار وضغطها القاسي على القضيبين المعدنيين المشدودين إلى الأرض، طغى على اللغط المرتفع الذي يكثر، في العادة، لدى بعض المسافرين، قبل أن تقتحم سلاطنة النوم ممالك أجسادهم، فتجعل من رؤوسهم كرات صمّاء تترجرج على رؤوس أكتافهم أو أعلى صدورهم..!
– همس الأول، كأنما لنفسه:
– لقد ولجنا البوابة الأخيرة..! فماذا بعد؟ بتثاقل انفرجت شفتا الثاني، فسأل:
– أية بوابة..؟
– البوابة التي صرنا خلفها منذ حين..!
– تقصد العربة.
– لا، أقصد البوابة الأخيرة..!
– لا أفهم عليك.
– بل تفهم..!
– عربتنا، اليوم، باردة، وضوؤها باهت..!
– هي، في جميع الأحوال، أفضل من البوابة التي ولجناها..!
يقترب ناظر القطار، يطلب بطاقات السفر، فيسأله أحدهما، لعلّه الأوّل، عن حال العربة البائس، يبتسم الناظر، ويطمئنهما وهو يتأمّل البطاقتين:
ـ كل شيء سيتحسن بعد قليل.. النور والدفء يأتيان مع تزايد حركة القطار وسرعة جريانه، ومشواركما، على كلّ حال، ليس بعيداً..!
مع تعالي أنين السكة، يتبادلان الآهات المتناغمة، ويعود الأول إلى التساؤل الهامس، كأنّما، لنفسه:
– الحركة..! من أين تأتينا الحركة، ما دمنا قد دخلنا البوابة الأخيرة..؟!
– لا أفهم عليك.. أية حركة تعني.؟
ـ لعلك لا تريد أن تفهم..! وبخاصة بعد سماعك رأي الناظر وهو يشير إلى العلاقة ما بين الحركة والدفء والضوء.؟
– وماذا يعني الناظر..؟
ثمة رجل في المقعد المنفرد المجاور، يتتبع بأذنين واسعتين حديث الاثنين هادئاً صامتاً.
امرأة تخطر في الممر المجاور، تثير بعطرها النافذ، وخطواتها المميزة بلبلة في المقاعد المختلفة! يتململ الجسدان اللذان كادا أن يهجعا بفعل تحلل التعب، تختلج الأجفان التي مالت قبل لحظات إلى الارتخاء والذبول..
-ـ لم تجبني عن سؤالي..!
– أيّ سؤال لقد نسيت؟
– بهذه السرعة؟
– لا، الحقيقة، لم أنس، لكن، اتركني الآن.. ألم تر إلى المرأة التي مرّت من هنا؟
– بلى، ولكن ما لك ولها؟
– ألم تنتبه إلى إيقاع قدميها..؟ أما هزّت أغصانك نسائمها العطرة..؟
– أراك صرت شاعراً..؟
– نعم، ذلك ما صرته بالضبط يا صاحبي، تلك المرأة أخذتني إلى عالم آخر.. لعبت في ميزاني..!
– أيّ ميزان..؟
« الرجل في المقعد المنفرد المجاور، ما يزال يصغي إلى حديث الاثنين بانتباه شديد، ويحافظ، في الوقت نفسه، على هدوئه وصمته..!»
– أتعلم أين يذهب العطر والصورة والصوت بعد أن تعبر مساراتها، أقصد بعد عبورها الأنف والعين والأذن؟
– لا، لا أعرف، أظنها تتغلغل داخل الرأس..!
– صحيح.. بدأت تفهم عليّ..!
– الحمد لله..!
– أتعلم، إن بعض النساء.. يلعبن في موازين الرجال، ألم يحصل أن لعبت امرأة في ميزانك..؟
– قبل الزواج أم بعده..؟
ـ لا يهم..؟
ـ ذات يوم، يا صاحبي، دهمتني امرأة، علمت فيما بعد أنّها دهمتني, كنت طالباً تشغلني الدراسة والكتب، كنت وحيداً في غرفتي التي على السطح، فوجئت بامرأة تحمل سلّماً وتقتحم عليّ غرفتي، كانت غرفتي مفتوحة على السطح مباشرة، قالت المرأة:
– تعال يا غزال.. كانوا يلقبونني بالغزال.. تعال أسند لي السلّم، سأصعد لأسوّي وضع الغسيل..
الغسيل كان على الحبال، ولم يكن بحاجة إلى أيّة تسوية، كان يستقبل الدفء والهواء، ويتخفف، على مهل، من رطوبته الزائدة..!
أنا لم أجد ما يمنعني من تلبية رغبة المرأة، كانت أكبر مني قليلاً، وكان لسانها ناعماً ودوداً.. فنهضت، وتبعتها إلى حيث حبل الغسيل.. أمسكت بالسلم من الجهة المقابلة للمرأة، صار السلّم بيننا، صرنا، أقصد، وجهينا متقابلين ضمن إطار واحد، شكلته اثنتين من درجات السلم، قالت المرأة:
– ذوقه حلو ذلك الذي لقبك بالغزال..! خجلت فنقلت الحديث إلى الغسيل:
– لا حاجة لتحريك الغسيل، أظنّه قد نشف..!
ـ لا، يجب أن تأتيه الشمس من جوانبه كلّها، وحشرت المرأة نفسها في الفجوة الصغيرة التي بيني وبين السلّم، ثم رفعت رجلها اليمنى، لتضعها على درجة السلّم، في تلك اللحظة بالذات شعرت، يا صديقي، بهذا الذي تتحدث عنه، أعني باختلال الميزان في رأسي، لكن المرأة لم تنتبه إلى ما حصل لي، واستمرت في صعودها خفيفة رشيقة..! صارت قدماها على تماس مع رأسي، قدماها صغيرتان تنتهيان بأصابع دقيقة، رؤوسها ملونة بالأحمر، اللون الأحمر زاد في نسبة الاختلال في رأسي.. ارتفعت المرأة بقدميها وبجسمها كلّه عن مستوى رأسي، صارت أعلى قليلاً.. كانت خفيفةً مثل عصفورة، وأظنّها كانت متحررة من ثيابها الداخلية، أنا لم أمعن النظر إليها كثيراً.. لكن كيف أحكي لك يا صاحبي؟
« يتململ الرجل الذي على الكرسي المنفرد المجاور، لكنّه يظل محافظاً على صمته وهدوئه»
ـ أنا لا أحسن وصف ما رأيت، وأنا في الحقيقة، لا أقدر على التركيز في مثل هذه المواقف.. صحيح أنني، في حياتي، لم أر سيقان نساءٍ كثيرةً، لكن ما رأيته كان خاصاً جداً، أو هكذا بدا لي في ذلك الوقت، ما رأيته، كان فوق الوصف، الألوان فيهما تتماوج..! الأحمر يتداخل مع الأبيض، يمتزج به، هل رأيت الورد في نعومة أوراقه، وحسن ألوانه؟ هما الورد بعينه، وكفى.. أو أقول لك:
تخيّل أجمل سيقان امرأة في الدنيا كلّها؟ ستراهما لوناً وشكلاً، ولكن اتركني الآن أكمل لك ما حصل معي تماماً..
– هات أكمل..
– قالت المرأة، وقد شعرت بأن السلّم أخذ يهتز بين يديّ:
– انتبه يا غزال، لا تنظر إلى أعلى, امسك السلم جيداً، راقب قدميّ فقط، نبهني إن انزاحتا عن الدرجة.. قلت:
ـ حاضر.. لكنّ السلّم لم يستمع إلى أحد منّا، بل زاد من حركته الاهتزازية! غير مكترث بالقوة والعزم اللذين كانا لي تلك الأيّام.. المرأة أيضاً لم تكترث بحركة السلّم، ولعلّها وثقت بقوّتي، إذ قالت لي:
– لك عندي مفاجأة يا غزال.
– ما هي؟
– انظر إلى الأعلى.. وفتلت ساقها قليلاً، لأرى في المكان الذي يلي الركبة من الجهة العليا رسماً يشبه التفاحة، فهو، أي الرسم، عبارة عن خطوط حمراء دائرية الشكل من اللون نفسه الذي على رؤوس أصابع قدميها.. قلت:
– هذه تفاحة..
ـ لا هذا قلب.. المسه، إن أردت.. مددت يدي إلى الرسم، فأخذ السلّم في الارتجاج الشديد، واختل توازنه إلى درجة أنني فقدت السيطرة عليه كليّاً, وما عدت قادراً على المتابعة، فماذا تراني قد فعلت يا صاحبي؟
– ماذا فعلت؟
– تركت السلّم وهربت، نعم هربت، حتى إنني لم أنتبه إلى المرأة وهي تقع والسلّم معها على السطح الحجري القاسي.. كان حلقي جافاً وكنت غير قادر على الكلام, أعترف أنني أخطأت حين تركت المرأة تقع على الأرض, إذ لم يخطر ببالي أنّها ستتأذى من السقوط على بلاط السطح.. وأنّ ذلك السقوط سيسبب لها جروحاً وأوجاعاً..! لجأت إلى غرفتي، جلست على طرف مقعد مركون جانب أحد الجدران، تناولت كتاباً، فتحته، حاولت القراءة، لكنني، بالطبع، لم أفهم شيئاً..! بعد ذلك، رأيت المرأة تحمل جروحها وأوجاعها وتدخل إلى الغرفة، فداريت وجهي عنها بالكتاب الذي بيدي.
سألتني بالصوت الناعم الودود نفسه:
– لماذا فعلت بي هكذا..؟
بقيت صامتاً، حتى إنني لم أفكّر بالاعتذار، أو لعلّي لم أقو عليه، كلّ الذي فعلته أنّني ظللت مختبئاً في جلدي مثل أرنب خائف.. المرأة اقتربت مني أكثر.. جلست أمامي.. أبعدت الكتاب عن وجهي.. ثمّ رفعت ثوبها قليلاً لتريني كيف تأذّت ساقها الوردية، وكيف سال خيط الدم الأحمر من قلب التفاحة تماماً، أقصد من قلب القلب الذي رسمته.. ثم مدت يدها إلى ساقي وقالت وهي تضغط عليها برفق:
– ماذا تفعل لو أحد فعل بك ما فعلت بي؟!
في ذلك الوقت رغبت في تجفيف الدم، ومداواة الجرح النازف، لكني لم أفعل ذلك أيضاً.. فقد تبلدت مثل حمار.. عندئذ مدّت المرأة يدها نحو الكتاب، فنزعته من يدي، ثم قذفت به في وجهي.. ومضت.
ساد صمت قصير قبل أن يسأل الراوي صاحبه:
– لماذا، في ظنّك، فعلت بي المرأة ما فعلته؟
ابتسم الصاحب وهمّ بالجواب، لكن الرجل الذي كان طوال الوقت يجلس على الكرسي المنفرد هادئاً صامتاً، هبّ مستبقاً جواب الصاحب وقال:
– لأنك أجدب ومسكين وما في قلبك شيء لله..!
حلب /24/2/2006