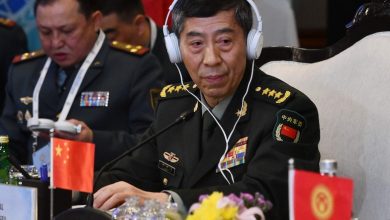قبل أيام معدودة من بدء انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وقف “وانغ إي”، وزير الخارجية الصيني، في استقبال “عبد الغني برادر”، القيادي بحركة طالبان الأفغانية، في مدينة “تيانجين” الصينية المتاخمة للعاصمة بكين، والتقطا صورة شبه رسمية معاً قبل أن تبدأ المحادثات بين الطرفين(1). فبالتزامن مع رغبة طالبان في حيازة الشرعية الدولية من الدول الأثقل إقليميا ودوليا، وعلى خلفية التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ارتأت بكين أن تغتنم فوضى الانسحاب الأميركي والغربي من أفغانستان لتُسجِّل بعض النقاط.
أولها نقطة على الصعيد الجيوسياسي بحيازة حليف جديد يشاركها حدودا دولية تمتد بطول 76 كيلومترا، وهي حدود قصيرة لكنها مفتاحية؛ إذ تفصل أقصى شرق أفغانستان عن أقصى غرب الصين، وتصل في الوقت نفسه بين كشمير الباكستانية وطاجيكستان، ومن ثَم تجعل من كابول بالنسبة إلى الصين لاعبا محوريا في مبادرة الحزام والطريق إذا ما أرادت بكين للمبادرة أن تصل إلى غرب آسيا بنجاح، وتجعل منها أيضا ورقة مهمة في تعزيز التحالف الصيني-الباكستاني المناوئ للهند، لا سيما بالنظر إلى التحالف المعروف والكائن بالفعل بين طالبان وباكستان، ما يعزِّز في النهاية وضع الصين الإقليمي-الآسيوي (في مواجهة غريمها الهندي)، وكذا وضعها الدولي (في مواجهة الولايات المتحدة).
وثانيها نقطة على صعيد محاربة الجماعات المسلحة المؤيدة لقضية الأويغور المسلمين، إذ إن العلاقة القوية مع طالبان تعني وجود شريك مهم مُحاذٍ لولاية “شينجيانغ” (تركستان الشرقية) الصينية، وعلى دراية جيدة بخارطة الجماعات الإسلامية في آسيا الوسطى، ما يعني قدرته على تزويد الصين معلوماتيا بالكثير في صراعها الدائر مع جماعات الأويغور. وثالثها ورقة اقتصادية بفتح الباب أمام النفوذ التجاري الصيني في البلد الأكثر تعدادا في آسيا الوسطى (حوالي 40 مليون نسمة، أي أكثر من ثلث سكان المنطقة)، لا سيما أن نجاح طالبان -بمساعدة الاستثمارات الصينية- في جلب نوع من الاستقرار والتنمية داخل أفغانستان سيُعَد نقطة قوية لصالح دعاية الصين لنموذجها التنموي، بالنظر إلى فشل الغرب المتكرر في إحراز أي تقدم في هذا الملف بأفغانستان.
واثقا بإمكانية إحراز تلك النقاط، صرَّح وانغ على خلفية لقائه ببرادر في يوليو/تموز الماضي أن انسحاب الولايات المتحدة وحلف الناتو “يكشف فشل السياسات الأميركية، ويمنح الشعب الأفغاني فرصة مهمة لتحقيق الاستقرار والتنمية في بلده”، ثَم أردف أن الصين تحترم استقلال أفغانستان، وأنها لا تتدخَّل في شؤونها الداخلية(2)، في إشارة ضمنية إلى ما يُميِّز -حتى اللحظة- السياسة الخارجية للصين بالمقارنة مع واشنطن، وهي بُعدها عن تصدير أنماط سياسية أو إدارية بعينها للدول المحيطة بها، على عكس الأجندة السياسية لغريمها الأميركي صاحب الباع الطويل في نشر الديمقراطية وأفكار حقوق الإنسان. ولذا تبدو أجندة حُسن الجوار والاستثمار خالية الدسم السياسي تلك قد بدأت تجذب دولا شتى تتراوح من النظام العسكري في ميانمار وحتى حركة طالبان في كابول.
بيد أن نسج تحالف بين قُطب دولي، مثل الصين، قام من ثنايا تجربة شيوعية ثورية من العيار الثقيل (وعلى أنقاضها في الوقت نفسه)، وبين حركة إسلامية ذات بُعد قبلي وإثني لم يستتب لها الأمر تماما في بلد شهد بالكاد استقرارا سياسيا ونموا اقتصاديا على مدار أربعة عقود، ولم يدخل بَعْدُ في طور الدولة الحديثة بمعناها الشامل؛ سيكون أمرا شديد الصعوبة على عكس ما يظن الطرفان، وهي صعوبات بدأت تكشف عن نفسها بالفعل داخل أفغانستان.
فراغ الجهاد
الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، اهتزت أركان مسجد خاص بالأقلية الشيعية (الهزاره) في محافظة قُندوز الأفغانية على وقع انفجار نفَّذه تنظيم “الدولة الإسلامية-ولاية خراسان (ISK)” ترك وراءه أكثر من سبعين ضحية. وقد أعلن التنظيم سريعا مسؤوليته في بيان نُشِر على الإنترنت، بل وذكر صراحةً اسم منفِّذ العملية “محمد الأويغوري”، مضيفا أن الهجوم استهدف “الروافض” (في إشارة إلى الشيعة)، وكذلك حكومة طالبان بسبب نيتها ترحيل الأويغور من أفغانستان تجاوبا مع مطالب أتتها من الصين بذلك. وقد أشار موقع “ذا ديبلومات” أن تلك أول مرة يصرِّح فيها التنظيم بهوية شخص أويغوري شارك في عملياته(3).
ليس التصريح عبثيا بطبيعة الحال، إذ إن ملف الأويغور تحديدا أطل برأسه في دعاية التنظيم لاستقطاب “مجاهدين” جدد من رحم الفراغ الذي خلَّفته طالبان بعد صعودها إلى السلطة، ومواءماتهما المستمرة للتحوُّل من جماعة مسلحة إلى نظام حاكم، وهو تحوُّل يبدو مهمًّا لها ولحلفائها الدوليِّين الجدد، بيد أنه تحوُّل عصيب ومحفوف بالمخاطر على الحركة الإسلامية بعد سنوات طويلة من استنباتها بذور الجهاد العالمي داخل الساحة الأفغانية، وتتجلى مخاطره تلك على عدة مستويات.
أولا، على المستوى التكتيكي، تعرف طالبان جيدا كيف تقض مضاجع السلطات المركزية وتعطِّل سير الحياة في المدن الكبرى، إذ تمرَّست لعقدين ونيف في تلك الأساليب التي عانى منها الأميركيون طيلة احتلالهم أفغانستان، لكنها بانتقالها إلى مربِّع السلطة تعاني اليوم عجزا كبيرا في مواجهة منتهجي تلك الأساليب، فكما كتب “توماس غيبونز-نِف” و”سامي سَهاك” و”تيمور شاه” في صحيفة “نيويورك تايمز”، استطاعت “داعش-خراسان” استغلال عجز طالبان عن حماية المدن والبنايات المزدحمة والتجمُّعات البشرية الكبيرة لتكثيف هجماتها على مدار العام الحالي(4). وقد أتى الهجوم الأبرز والأصعب قبل أيام حين استهدف التنظيم مستشفى “سردار محمد داوود خان” العسكري في العاصمة كابول عبر تفجير انتحاري وهجوم قاده مسلّحون.
“لقد تعاملت الحكومة المدعومة غربيا مع تلك الحوادث باستخدام قواتها الخاصة الذين دعمتهم في معظم الأحيان قوات العمليات الخاصة للناتو على الأرض… (أما) طالبان، فإن الدعم والخبرة لديها قليلان حين يتعلَّق الأمر بأحداث كهذه”، هكذا أشار مراسلو الصحيفة الثلاثة من أفغانستان، لافتين النظر إلى أن جنود الحكومة الذين حاربوا طالبان ومقاتلي طالبان أصيبوا معا في الهجوم، وسرعان ما توزَّعوا على أسرة المستشفى لتلقي العلاج، بينما انتظر زملاؤهم في الخارج للاطمئنان على حالتهم(4).
ثانيا، على المستوى السياسي والاجتماعي، لا تعتمد طالبان أساليب حديثة صُلبة في تنظيم صفوفها، بل اعتمدت باستمرار على مزيج من الدعايات الجهادية-الشعبوية لشحذ الشباب من القبائل والمناطق الريفية كي يحاربوا معها ويدينوا لها بالولاء، وقد تشكَّلت سلطتها القوية في أفغانستان عبر قبول أيديولوجيتها الإسلامية من قبل قطاعات واسعة، ورفعها راية الجهاد ضد الغرب، أما في اللحظة الراهنة، فإن الطبيعة الرخوة للحركة كمظلة مقاتلين لا تنظيم صلب أخذت تكشف عن مكامن ضعفها بعد تحوُّلات خطابها وتجاوبها الدبلوماسي مع الغرب تارة ومع روسيا والصين تارة أخرى، ما يعني أن ثمة “فراغا جهاديا” سرعان ما سيجد من يملؤه في ظل النسيج الاجتماعي اللامركزي لأفغانستان، والمفتوح على مصراعيه للخطابات الجهادية.
بين كابول وبكين
في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، جلس مسؤولون من حركة طالبان مع نظراء لهم من الصين في أروقة العاصمة القطرية الدوحة للتباحث حول عدد من الملفات المهمة للطرفين، بيد أن أنباء الاجتماع سرعان ما وصلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما كتب “لوكاس وِبِر” لموقع “أوراسيا نِت”، فأمسك أنصار “داعش-خراسان” بطرف الخيط وشنُّوا حملة عبر تطبيق “تليغرام” اتهموا فيها رجال طالبان بأنهم “بغايا” للصين، ونشروا تسجيلا مصوَّرا لـ”أمير خان متقي”، وزير خارجية طالبان، وهو يقدم مكسرات الصنوبر لنظيره الصيني وانغ أثناء الاجتماع، متهمين الحركة بخيانة مسلمي الصين(5).
ليس وجود الأويغور في أفغانستان وليد البارحة، فقد بدأت أولى موجات نزوحهم من الصين أثناء خمسينيات القرن العشرين بسبب السياسات القمعية للحزب الشيوعي آنذاك، وتفرَّقت بهم السُّبل بين من اختار أوروبا والولايات المتحدة، ومن اختار تركيا بسبب الجذور الثقافية المشتركة معها، غير أن البعض لم يحالفه الحظ سوى في عبور الحدود الصينية فحسب، ومن ثَم حطَّت المئات من عائلات الأويغور رحالها في أفغانستان مطلع الستينيات، لا سيما أن أفغانستان كانت بلدا مألوفا للكثيرين منهم بسبب قرون طويلة من قوافل التجارة والحج التي مرت عبر جبالها من الصين إلى الشرق الأوسط(6).
توجد أكثر من مئة عائلة من الأويغور داخل أفغانستان اليوم، ويُقدَّر تَعدادهم بنحو ألفي شخص، وبينما يلتزم أغلبهم بالدين الإسلامي دون اعتناق لأي أيديولوجيات متطرفة، فإن قلة منهم ترى في الانتماء الجهادي ملجأ لها، وبالأخص مع تزايد الحملات القمعية ضدهم داخل الصين، وتخوُّفهم من ممارسة حكومة طالبان للقمع أو الترحيل بحقهم بعد سنوات من استيعابهم من قبل الحكومة الأفغانية المدعومة أميركيا حتى سقوطها(7). للمفارقة، تلك هي الأسباب نفسها التي تدفع عددا ضئيلا من الأويغور الموجودين بمخيم الهول على الحدود السورية-العراقية للتمسُّك بأفكار داعش، علَّ تُهمة التطرُّف تطيل بقاءهم في أسر قوات سوريا الديمقراطية وترحمهم من أسرٍ أشد قسوة إذا ما رُحِّلوا إلى الصين.
منذ أن انفتحت أبواب الدبلوماسية بين بكين وكابول، استشعر الأويغور في أفغانستان موقفهم الحرج، وانتشر الذعر في أوساط الأويغور العاديين من قبضة طالبان المتشددة تارة، واحتماليات الترحيل تارة أخرى. ووفقا لما نقله موقع “بي بي سي”، فإن عددا من الأويغور بمدينة “مزار شريف” مترددون حيال التوجُّه نحو كابول والخروج نحو بلد آخر بالطيران خشية أن توقفهم نقاط التفتيش التابعة لحركة طالبان بسبب بطاقات هوياتهم(7).
هذا الذعر في صفوف الأويغور يأتي هدية على طبق من ذهب بطبيعة الحال لـ”داعش-خراسان” التي كثَّفت مؤخرا حملاتها الدعائية لاستقطاب مقاتلين منهم، ولزعزعة ثقة المقاتلين المتشددين عموما في طالبان وسياساتها “اللينة” تجاه القضايا الإسلامية. وليس أدلَّ على ذلك من عملية قندوز التي دبَّرها متشددون أويغور عملوا سابقا تحت مظلة طالبان قبل أن يخرجوا منها، وهو سيناريو متكرر في الآونة الأخيرة مع مجاهدين عديدين قدموا من دول آسيا الوسطى للانضمام إلى طالبان أو الحركات الجهادية المرتبطة بها قبل أن يغادروها نحو “داعش-خراسان”، احتجاجا على انفتاحها على بكين وموسكو وكذلك على بعض دول آسيا الوسطى الاستبدادية، مثل أوزبكستان صاحبة التاريخ الطويل في قمع الحركات الإسلامية(8).
مُعضلة الأويغور
في خضم سعيها لإعادة صياغة الحُكم في أفغانستان، تجد طالبان نفسها وجها لوجه مع تحديات من أجل خلق توازن بين ضرورة الاستقرار وتوفير الموارد الاقتصادية بشتى الوسائل لشريحة معتبرة من الأفغان، مع تدبير حد أدنى من العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع الأطراف الإقليمية والدولية، دون أن تتنازل عن الكثير من مضمون أيديولوجيتها الإسلامية التي لا تزال ارتكاز شرعيتها الأساسي. غير أن طالبان تواجه -للمفارقة- معضلة التعامل مع النسيج الاجتماعي الحاضن للحركات الجهادية التي كان لها نصيب الأسد في صناعتها، والذي بات البوابة الرئيسة لتنظيم “داعش-خراسان” في الآونة الأخيرة.
لا يهدّد “داعش-خراسان” مشروع طالبان السياسي والاقتصادي فحسب، بل ويهدِّد صفوف الحركة نفسها، وهي صفوف رخوة على الأرض لم تجمعها سوى راية الجهاد الأيديولوجية وآلة اقتصادية-مالية هشة مليئة بتناقضاتها هي الأخرى. في هذا الصدد، أفاد “معهد دراسة الحرب” في تحليل له نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن هناك مجموعات من المقاتلين خرجت من رحم طالبان وانضوت تحت لواء “داعش-خراسان”، وأشار إلى أن المقاتلين المرتبطين سابقا بزعيم طالبان المنشق “المُلا عبد المنَّان نيازي” في “هِرات” انضموا إلى التنظيم، ما سبّب جولة اقتتال بين الطرفين في المدينة مؤخرا، مضيفا أن محاولات طالبان الانفتاح النسبي على أعدائها السابقين قد تصُب في مصلحة استقطاب المزيد من المقاتلين الأكثر تشدُّدا في صفوفها إلى “داعش-خراسان”(9).
بينما تنتقل الحركة الإسلامية من مربِّع الجهاد الصلب إلى مربع الحُكم العصيب بالنسبة إليها، فإنها ستحتاج وقتا طويلا من أجل بناء دولة واقتصاد جديدَين، وهو وقت يصُب في صالح آلة العنف التابعة لتنظيم “داعش-خراسان”، التي تعمل بكفاءة منقطعة النظير منذ انسحاب الولايات المتحدة، وقد تنجح في أن تحل محل آلة الجهاد الطالبانية إذا ما صبَّت طالبان أنظارها أكثر من اللازم على معادلة الحُكم والدبلوماسية على حساب شرعيتها الإسلامية في الداخل.
يبدو خيار طالبان التضحية بالأويغور براغماتيا ومنطقيا بالمقارنة مع الظفر بحليف دولي مهم مثل الصين يستطيع أن يقدِّم الكثير سياسيا واقتصاديا، بيد أن الأويغور في أفغانستان ليسوا محض لاجئين أو ضيوف، وإذا كانت التضحية بالأويغور ستفتح بابًا أمام تقليص شرعية طالبان في الداخل وزعزعة صفوف الحركة وتقويض الاستقرار في أفغانستان، فإن الخيار بين بكين والأويغور سيصبح أصعب وأكثر تعقيدا، ولعل طالبان تتراجع عنه نسبيا لحماية قبضتها في الداخل.
وحدها الأيام ستكشف عن مدى نجاح طالبان من عدمه في تسيير دفة خياراتها الصعبة تلك، إذ تصل مُعضلة البحث عن تلك “الشعرة” بين الشرعية في الداخل والخارج إلى أشد حالاتها صعوبةً حين يتعلَّق الأمر بالعلاقة مع الصين وملف الأويغور. من جهة بكين، تمثِّل أفغانستان اختبارا صعبا أمام سياسة الصين الخارجية التي طالما نجحت معادلتها التنموية الخالية من السياسة، وعلى الأرجح، ستضطر بكين للوقوف أمام تعقيدات السياسة وجها لوجه في نهاية المطاف بعد عقود من تنحيتها لصالح الاقتصاد في دبلوماسيتها، وستضطر إلى مواجهة الخيارات الصعبة والثقيلة نفسها التي حملتها القوى الكبرى من قبلها، لا سيما في أفغانستان، ولا سيما في لحظة بدأت فيها فعلا بالبحث عن دور سياسي وعسكري أكثر بروزا، على الأقل في آسيا.
—————————————————————————————
المصادر
- Wang Yi Meets with Head of the Afghan Taliban Political Commission Mullah Abdul Ghani Baradar
- China’s ties to Taliban warm ahead of US leaving Afghanistan
- Why Is the Islamic State in Afghanistan’s Propaganda Targeting China?
- Dozens Killed in ISIS Attack on Military Hospital in Afghanistan’s Capital
- Perspectives | Islamic State using China to vilify Taliban
- SEARCHING FOR A PATH TO FREEDOM
- Afghanistan’s Uyghurs fear the Taliban, and now China too
- Implications of ISIS-Taliban Rivalry for Central Asian Jihad
- AFGHANISTAN WARNING UPDATE: IS-KP IN AFGHANISTAN IS EXPANDING FASTER THAN ANTICIPATED
المصدر: الجزيرة. نت