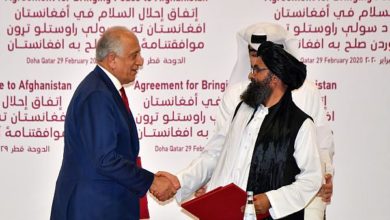كما حجارة الدومينو سقطت كل المواقع في أفغانستان بيد طالبان، ودخل مقاتلو الحركة العاصمة كابول، وباتت هي صاحبة الكلمة الوحيدة الفصل في الوضع الأفغاني، وظهر مشهد نقل الطائرات الأمريكية والفرنسية للهاربين من قوات طالبان مشهدا ذا دلالة لا تخفى، وهو يستدعي على نحو ما مشهد المروحيات الأمريكية وهي تنقل ما استطاعت من المتعاونين معها من ساحة السفارة الأمريكية في سايغون عاصمة فيتنام الجنوبية السابقة، وتخلف وراءها المئات ممن لم تستطع نقلهم لمصيرهم المنتظر.
ولقد كان مخجلا للإدارات الأمريكية المتعاقبة أن يقف الرئيس جو بايدن ليعلن أنه تفاجأ بانهيار القوات الحكومية الأفغانية التي جهزتها أمريكا على مدى عشرين عاما بكل عناصر القوة من سلاح وعتاد وتدريبات، وقد تجاوز تعدادها ثلاثمائة ألف جندي أمام قوات طالبان التي لم يتجاوز تعدادها في أحسن الحالات خمسة وسبعين ألف مقاتل، ويعتبر تسليحها غير ذي شأن.
وليس مرد الخجل هذا الموقفُ المهين لرئيس أكبر دولة في العالم، وهو يشهد انسحابا مذلا لقوات بلاده من أفغانستان، وإنما مرده أنه لم يدرك هو كما أسلافه، أن قوة الجيوش لا تستند على التسليح والتدريب، وإنما على العقيدة، والإخلاص، وهو ما يولد الاستعداد للقتال وللتضحية حتى الرمق الأخير حتى ولو لم توجد بارقة نصر.
كل التحليلات والقراءات التي بدأت العديد من محطات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي تنضح بها متحدثة عن تنازل أمريكي لطالبان مقابل اتفاقات سرية تخص “ثروات طبيعية أفغانية” سيمنح للشركات الأمريكية لاحقا، وعن دور لطالبان في مواجهة روسيا والصين، وعن مقايضات من ” تحت الطاولة”، لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع الحرب النفسية لمواجهة الحقيقة الصارخة والمرعبة التي يقدمها النموذج الأفغاني، والتي تختصر بأن ” الإرادة الشعبية هي التي تنتصر في نهاية المطاف”، وأنه في ساحة الصراع الحقيقية “العقيدة أهم من التسليح والتدريب والحشد العددي، وأكثر تأثيرا وصمودا”، وأن “المحتل والغازي والمعتدي لا يمكن له أن يصنع أو يبني قوة محلية يمكن لها أن تواجه إرادة التحرر مهما جهد في ذلك ومهما تكلف في سبيل ذلك”، ومن يقف مع المحتل لا يعدو أن يكون عميلا وبالتالي فهو فاسد مرتزق لا يلبث أن يرحل مع المحتل، أو يكون صاحب حاجة ضاقت به الحيل، وبالتالي فإنه لا يملك إرادة الدفاع عن المحتل، ولا يلبث أن يستسلم أمام تقدم قوات المقاومة.
وهذه الحقيقة ثلاثية الأبعاد لم تسطع وتظهر نتيجة انتصار طالبان في أفغانستان فحسب، وإنما هي حقيقة ثابتة أكدتها كل حروب الاستقلال: الجزائر في مواجهة المحتل الفرنسي، وفيتنام في مواجهة المحتل الأمريكي، وأفغانستان في مواجهة المحتل الأمريكي، وبالتالي فإنها الحقيقة المتجددة التي تبقي الأمل حاضرا لدى كل قوى المقاومة والتحرر في كل مكان من العالم.
نحن نرى بأم أعيننا انتصار طالبان وهزيمة أمريكا، وفرار العملاء، واستكمال السيطرة على البلاد، ونرى بأم أعيننا كيف أن: وحدة جبهة المقاومة، وقوة العقيدة، والصبر على التضحيات، ورفض التنازلات تحت أي ذريعة، هي سبيل النصر المؤكد.
وبانتصار طالبان تكون حركة طالبان قد أنهت مرحلة مقاومة المحتل بنجاح يعتز به ويبارك لها، ودخلت مرحلة جديدة، متطلباتها جديدة، وتحدياتها جديدة، وقواعد العمل فيها جديدة، وتجارب دول عديدة قاومت المحتل وانتصرت عليه انتصارا باهرا تشير إلى أن هذه القوى فشلت في إدارة المرحلة التالية، بل وإنها بفشلها هذا حققت من أهداف قوى الاستعمار ما عجزت هذه القوى أن تحققه بوجود قواتها وجبروت هذا الوجود.
وإذا كان لنا أن نستعير من مأثوراتنا ما يلخص لنا أهمية هذه المرحلة الجديدة، فإننا نجده في القول المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم” رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر”.
وليس هناك في أفغانستان اليوم جهادا أكبر من الجهاد ل”إقامة دولة العدل والتقدم والحرية والكرامة للمواطنين جميعا”.
ومما لا شك فيه الناس، وبالتالي القوى السياسية، يختلفون في تصور هذه الدولة، “دولة العدل والتقدم والحرية والكرامة”، يختلفون باختلاف مشاربهم وعقائدهم وتصوراتهم، وإذا كانت طالبان تتحدث عن “دولة إسلامية نقية” ستقيمها في أفغانستان، فإنها تكون قد وضعت نفسها في موضع لا تحسد عليه، لأن الادعاء ببناء ” دولة إسلامية نقية”، هو ادعاء يضع الفكر الديني الذي تمثله طالبان بموضع الدين نفسه، وهذا خطأ وخطر، وهو ادعاء لا سابقة له، ولم تستطعه سلطة أو دولة في التاريخ الإسلامي.
كانت الدول التي أقامها المسلمون في كل مراحلهم منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي “اجتهاد بشري” لإقامة دولة تتوفر فيها السمات العامة التي جاء بها الإسلام، وقد نجحوا فيما نجحوا فيه، وفشلوا فيما فشلوا فيه، ويكاد الاتفاق أن يكون تاما بين الدارسين أن الدولة الإسلامية افتقدت بشكل جزئي أو كلي سمتي ” العدل ـ والشورى” على الأقل منذ العهد الأموي.
ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم، حين أقام دولة المدينة أقامها على “وثيقة” أي على اتفاق قانوني مكتوب، وثيقة تظهر فكرا اجتماعيا وإنسانيا ومؤسساتيا، لم يسبق إليه أحد في ذلك الزمان، قائما على أساس “الولاء التام” لهذه الدولة الجديدة من كل أبنائها وهم في ذلك الوقت “المسلمون، واليهود، والمشركون من قبائل المدينة”، واستهدفت الوثيقة فيما استهدفت “تأمين الداخل”، أي تأمين مجتمع المدينة من أي تدخل خارجي أو ثغرة داخلية، وعبًر مفهوم “الولاء” في ذلك الزمان عن المعنى نفسه الذي يعبر عنه مفهوم ” المواطنة ” في هذا العصر.
أصبحت طالبان أمام امتحان جديد، هل تكون في سلوكها، كما كانت قبل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وهو ما سيفجر بالحتم صراعات داخلية جديدة، ويقدم نموذجا متخلفا لفكر ديني تمثله هذه الحركة، أم أنها ستستفيد من تجربة عشرين عاما وتقدم شيئا مختلفا على مستويات عدة.
هل ستتمكن الحركة من إدارة أفغانستان بتنوعها العرقي والمذهبي والطائفي والقبلي، أم أنها ستفرض نظاما على الجميع لا يحقق ” ولاء الجميع ” لهذه الدولة.
هل ستتمكن الحركة من أن تبني دولة تصد – بتعاضد والتحام أبنائها- إمكانية تلاعب دول الجوار بالبنية الداخلية للمجتمع الأفغاني بحكم التنوع المشار إليه، وفي مقدمة دول الجوار التي نشير إليها دولة “ولاية الفقيه” في إيران، وهي دولة ترى نفسها بحكم “تكليف إلهي مزعوم” وصية ومسؤولة عن كل الشيعة في العالم، وعن إعادة كل المسلمين إلى حظيرة فكر ونظام “ولاية الفقيه”، وبالتالي فإنها مهيئة للتدخل في الشأن الداخلي الأفغاني، كما فعلت وما زالت تفعل في العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول عدة أخرى.
ويدخل في إطار تلاعب دول الجوار بالوضع الداخلي الأفغاني محاولة استنبات وتقوية حركة “داعش” الأفغانية، لتكون أداة تخريب وإشغال داخلية، وهذا أيضا من وسائل دولة “ولاية الفقيه” المنظورة والمجربة في منطقتنا.
طالبان تنتهي الآن من الصراع مع المحتل الخارجي، وهي القوة المسيطرة بلا منازع على أفغانستان، لكنها ليست القوة الوحيدة في هذه البلاد، فالتنوع العرقي والطائفي والديني والقبلي يفرز دائما قوى متعددة، ومن الطبيعي أن تكون رؤى على التنوع لمستقبل البلاد مختلف.
مهم لمستقبل أفغانستان، بل ولمستقبل طالبان، أن يؤخذ هذا التنوع في الاعتبار دائما، وأن ينظر إليه باعتباره تعبيرا على الاختلاف والتباين، بل والصراع الاجتماعي السلمي الطبيعي في كل مجتمع.
ولن يتم قيادة هذا “التفاعل والاختلاف والصراع”، أي قيادة الحراك الإيجابي للمجتمع إلا من خلال طرح الحركة لبرنامج سياسي واجتماعي ينهض بالبلاد ويشكل خارطة طريق لكافة القوى الأفغانية.
وإذا كان لنا أن نتصور عناصر خارطة طريق تحتاجها أفغانستان وتفرض نفسها على طالبان ـ بعد تأمين الوضع الداخلي إزاء التدخلات والمخاطر الخارجية ـ فإن من أهم هذه العناصر:
** العدل الاجتماعي: فلا يكون تميزا في توزيع الثروات بسبب اختلافات الولاء أو الاختلافات العرقية والطائفية، والدينية، والقبلية، والجنسية.
** التنمية الاجتماعية: لكل أفغانستان، فلا يكون العدل توزيعا للفقر والعوز، ولا تكون التنمية عمليا وهميا قائما على استنزاف خيرات البلاد الطبيعية.
** الحريات الأساسية وفي مقدمتها الحرية السياسية وحرية العقيدة. وحرية الصحافة وتداول المعلومات.
** بناء وحدة وطنية عابرة للانقسامات الطائفية والمذهبية، والعرقية. وحدة وطنية توفر التزاما وولاء للدولة والمجتمع عابرا لكل أشكال الانقسامات الدينية والعرقية والقبلية.
** الموقف من حقوق الانسان باعتباره الإنساني، والموقف من المرأة والطفل، تعليما وصحة ورعاية، باعتبارهما الأضعف في المجتمع
** التزام آليات واضحة في محاربة الفساد، وذلك من خلال إعمال الآليات العامة المشهود لها في مكافحة الفساد وفي مقدمتها القضاء المستقل والصحافة الحرة.
** الانتقال من الشرعية الثورية التي امتلكتها بفعل مشوار الجهاد ومقاومة المحتل إلى الشرعية السياسية والقانونية القائمة على الاختيار الشعبي، أي اختيار الشعب الأفغاني.
يجب على حركة طالبان أن تجيب على كل النقاط السابقة لأنها تشكل في مرحلة التحرر من الاحتلال التي بدأتها التحدي الحقيقي لها، أو الجهاد الأكبر الذي ستواجهه، وقليل من حركات التحرير من نجح في هذا الاختبار، وكما أشرنا فإن أمامنا شواهد عن ولادة أنظمة ديكتاتورية فاسدة ومتخلفة، بل وقاتلة، أفرزتها حركات التحرير في مرحلة بناء الدولة، وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه في ظل هذه الأنظمة تم استنبات أسوأ الأمراض والنماذج والقوى التي كانت قوى الاحتلال تعمل على استنباتها سابقا.
إنه التحدي الكبير الذي يواجه طالبان، بل يواجه أفغانستان بكل تكويناتها، أفغانستان التي أحدثت بنصرها قوات الاحتلال فرقا في خارطة المنطقة، وبإمكانها أن تحدث فرقا في مستقبلها.