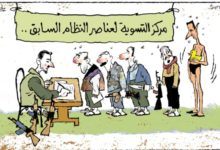بعد تسع سنوات، نجد أنفسنا، نحن السوريين، أمام ثورةٍ تحطمت تحت آلة بطش وحشية، كما تحطمت غيرها ثورات كثيرة عبر التاريخ. ولكن ما يثقل على نفوس السوريين الذين خرجوا على نظام الأسد أن ثورتهم تحطمت من داخلها أيضاً، وتاهت عن هويتها السياسية، إلى حد أنها انقلبت إلى هوية مضادّة سياسياً (غلبت عليها سياسات مستبدّة في العلاقة مع الشارع، وأظهرت تبعية وارتهانا متزايدا لمصالح دول تعلو على مصالح الشعب السوري وثورته) وهوية مضادة فكرياً (سيطرة الفكر الإسلامي ــ الجهادي العدمي). لا يغير في الأمر أن تكون الثورة قد تحطّمت من الداخل، تحت تأثير القمع، أو تحت تأثير تناقض القوى المكونة لها، أو للسببين معا، كما نرجح. المهم أن الثورة لم تحافظ على هويتها، وراحت تتخذ طابعاً لا ثورياً أكثر فأكثر، وتستهلك بتسارع كبير القيمة الأخلاقية السامية للثورة.
من الخطأ الاعتقاد أن استمرار المواجهة العسكرية مع نظام الأسد يكافئ استمرار الثورة، ذلك أن الفصائل العسكرية التي أتيحت لها سبل الصمود والاستمرار، وتولت هذه المواجهة، كانت، في الواقع، أقل عداء لنظام الأسد من عدائها لقوى الثورة، القوى ذات المضمون الديمقرطي التي تهدف إلى تغيير فعلي في آلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فقد تعايشت هذه الفصائل مع نظام الأسد في فترات الحصار عبر عملاء تجاريين ومعابر مأجورة أثرت من خلالها النخبة الفاسدة والمتحكّمة على رأس هذه الفصائل التي “تصالحت” تالياً مع نظام الأسد، فدخل بعضها في عداد قواته، فيما خرج بعضها الآخر، ممن رفض المصالحة، إلى مناطق إدلب مكرهاً، ليجد نفسه محكوماً بالعموم، إما لجبهة النصرة أو للدولة التركية. وفي المقابل، لم تستطع هذه الفصائل التعايش مع العناصر الديمقراطية العلمانية الموجودة في مناطق سيطرتها، فكان مصير هذه العناصر الإذعان أو الاغتيال أو السجن أو الفرار، تماماً كحالها في مناطق سيطرة نظام الأسد. استمرار المواجهة العسكرية، والتقدّم هنا والتراجع هناك، صار تعبيراً عن صراع من نوع آخر، لا علاقة له بالصراع الثوري الأول الذي اندلع لدوافع تحرّرية، مختلفة تماماً عن الدوافع التي راحت تغذّيها الفصائل الإسلامية وداعموها الإقليميون (صراع مصالح بين دول تستثمر في الانقسام الطائفي).
لا يخرج ما سبق من عرض عن السياق العام للثورات التي تدفعها عوامل مختلفة إلى اتخاذ مسارات عدمية، غير أن الفارق السوري يكمن في أن تاريخ الثورة السورية لم يعرض علينا تمايزاً يفرز بين الهويتين، الثورية التي جرى إقصاؤها بتدريج متسارع والإسلامية الجهادية المضادة للثورة التي سيطرت على الضفة المواجهة لنظام الأسد. وكان من شأن غياب هذا التمايز أن جعل “أهل الثورة” يتحمّلون أخلاقياً وزر جرائم “أهل الثورة المضادة”، أو بكلام آخر، سمح لهؤلاء الأخيرين بأن يرتكبوا جرائمهم باسم الثورة. وسوف يثقل هذا التداخل على تأريخ (كتابة تاريخ) الثورة، كما أثقل على تاريخها نفسه.
يمكن رد التداخل، أو عدم وضوح التمايز بين الهويتين، الثورية والمضادة للثورة، إلى عاملين: الأول، الصعوبة النفسية لدى أهل الثورة السورية في رؤية التبدل الجوهري في طبيعة الصراع، وخروجه عن كونه صراعاً ثورياً إلى كونه صراعاً عدمياً، أي لا ينطوي على قيمة ثورية، ولا يفضي إلى تغيير فعلي في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بقول آخر، الرفض النفسي لدى أهل الثورة برؤية احتضار ثورتهم، وتحوّلها إلى صراع مصالح إقليمية ودولية مستقلة أصلاً عن مصلحة الثورة. هذه الصعوبة النفسية جعلت أهل الثورة يقحمون رغباتهم الثورية في المادة الإسلامية غير الثورية المسيطرة على الصراع العسكري ضد نظام الأسد، لا سيما أن كثيرين من عناصر الفصائل الإسلامية الجهادية كانوا هم أنفسهم عناصر فاعلة ونشطة في مرحلة الثورة الأولى. ولتأمين هذه الحاجة النفسية، اجتهد الوعي في حجب الطبيعة المضادة للثورة (جرائم القتل الوحشي والتمثيل بالجثث، والبطش بالعناصر الديمقراطية والعلمانية، سياسات التمييز الطائفي والعشائري وبروز النزعات القومية الشوفينية) بوصفها “نتائج ثانوية” للثورة، وليست متن ثورة مضادّة. كانت غاية الوعي هي الوصول سلفاً إلى النتيجة المرغوبة، أن الثورة مستمرة.
العامل الثاني هو الروح الانتقامية العصبوية والوحشية التي لا حدود لها، والتي تتعامل بها قوات نظام الأسد وحلفائه مع المناطق التي يستردّون السيطرة عليها، الأمر الذي يدفع السوريين، بشكل عفوي ومفهوم، إلى مساندة الفصائل التي تواجه قوات النظام، وتمنعه من إعادة السيطرة على مناطقها. تكرست بالتالي حقيقة تقول إن هذه الفصائل هي “الامتداد الطبيعي” للثورة التي خرج إليها السوريون ضد نظام الأسد. هذا المآل الثقيل الذي صار إليه أهل الثورة دفعهم إلى محاججاتٍ دفاعية، مثل أن أصل الشرور هو نظام الأسد، وأنه لا تجوز المساواة بين الضحية والجلاد.. إلخ.
الواقع أن غالبية القوى الديمقراطية السورية المقهورة ساندت القوى العسكرية الإسلامية فقط لأنها تواجه نظام الأسد، على الرغم من أن القوى الإسلامية ساهمت في سحق الديمقراطيين، وجعلت من نفسها “أنظمة” قمع، كل حسب قدرته، ومن مناطق سيطرتها مناطق طاردة لطيف من التنوع السوري، الديني والقومي. النتيجة هي غياب (أو شحوب) التمايز بين معسكرين سياسيين وفكريين سوريين متمايزين في العمق. يترتب على هذه النتيجة أن صورة الثورة الأولى، بما هي مسعى تغيير سياسي عميق ينسجم مع مصالح المحكومين وأدنى إلى قيم الحداثة والأخلاق الإنسانية، تداخلت أو ضاعت في صورة الصراع الطائفي المرتهن للخارج وغير الثوري الذي ابتلع الثورة. وقد حرمت هذه الحقيقة الثورة السورية من بلورة علوها الأخلاقي ورمزيتها الثورية المتمايزة وإبرازهما، الأمر الذي حرمها، بالتالي، من تحقيق انتصار معنوي وأخلاقي صريح، على الرغم من هزيمتها المادية أو العسكرية، الانتصار الذي يشكل سنداً روحيا للثائرين المهزومين، ويشكل خميرة ورصيدا معنويا لثورات قادمة. وهو انتصارٌ لا يمكن لأي قوة، مهما توحشت، أن تمحوه. خسارة أهل الثورة السورية هذا السند المعنوي لا تقل ثقلاً وألماً عن خسارتهم المادية.
المصدر: العربي الجديد