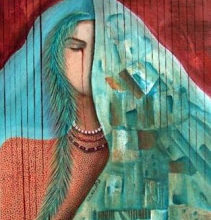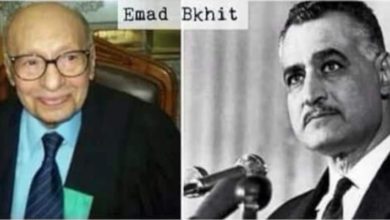شرع السوريون منذ انطلاقة ثورتهم (آذار 2011) بالحديث عن سوريا المستقبل، ولعلها ظاهرة طبيعية بل واجبة، إذ إن التغيير المنشود يوجب العمل على إيجاد البديل. بل ربما بات الحديث عن الدولة السورية المتخيَّلة أو المنشودة هو الأثير على نفوس شرائح المثقفين والمنظّرين أكثر من التفكير أو الانشغال بمسائل نضالية ذات صلة بالواقع الميداني.
ووفقاً لذلك، وعلى مدى أربع عشرة سنة، بات المشهد السوري مكتظّاً بالندوات وورشات العمل والحوارات البينية حول مسائل تتعلق بشكل الدولة المستقبلية وقضايا الديمقراطية والمواطنة وفصل الدين عن الدولة واللامركزية والنظام الرئاسي والبرلماني، وسوى ذلك كثير، موازاةً مع استحداث العديد من مراكز الدراسات التي كرّس بعضها جلّ نشاطه حول الشأن السوري. هذا عدا عن مجمل الحراك الذي تمارسه الأحزاب والمنظمات التي أخذت بالنشوء حديثاً آنذاك، سواء عبر لقاءات فيزيائية أم عبر منصات التواصل. وقد أفرز هذا الحراك بالمجمل كمّاً هائلاً من الوثائق والدراسات، فضلاً عمّا كان يُنشر في وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئية من مقالات بهذا الخصوص.
لذلك، من الخطأ اتهام السوريين بافتقادهم الرؤى والتصورات التي يمكن أن يتقوّم عليها مشروع وطني سوري يتبيّن من خلاله شكل الدولة التي يطالب بها السوريون، ولكن من الصحيح أيضاً أن ذاك المُنتَج السوري الهائل من الوثائق والتصورات المستقبلية لم يُفضِ إلى أن يكون مشروعاً وطنياً سورياً. أعني أن الجهود المبذولة والمنجز النظري لم يلتئم ليشكّل بمجموعه مشروعاً وطنياً سورياً، بل ظلّ متفرّقاً. والصحيح أن كل جماعة ظلّت تحتفظ ببضاعتها لنفسها، ولا تقبل أن يكون منجزها جزءاً من كلّ موحّد، علماً أن معظم ما صدر من وثائق وأوراق وتصورات – وخاصة عند القوى التي تصنّف ذاتها في عداد القوى الديمقراطية أو اليسارية – تكاد تتشابه إلى حدّ التطابق، ولكن على الرغم من ذلك ترفض الوئام والاندماج مع مثيلاتها. فما تحقق بالفعل هو الوفاق الكلي على التناسخ، إذ لا ضير عند الجميع في هذا التماثل بالرؤى والأفكار والتطلعات، ولكن ثمة رفض شبه مطلق للتوحّد أو الاندماج.
القبول بالتناسخ ورفض الاندماج قد حال دون قيام مظلة سياسية جامعة أو تجمع أو تيار يمكن أن يكون إطاراً جامعاً للقوى الوطنية الديمقراطية. إذ إن تماثل الأفكار والمواقف، الذي يصل إلى حدّ التطابق أحياناً، كان سرعان ما يتحوّل إلى خلاف ينمو بالتدريج موازاةً مع البحث والحوار في التفاصيل، تلك التفاصيل التي غالباً ما ينأى بها أصحابها عن الواقع المعاش، مولّين بها عقولهم وعواطفهم صوب التاريخ.
قد فات الأمويون الجدد أن مفهوم “الدولة الإمبراطورية” الذي وسم الدولة الأموية قد مضى إلى غير رجعة، وأن الدولة التي ينشدها السوريون وبذلوا من أجل الوصول إليها تضحياتٍ هائلة هي دولة المواطنة و”التعاقد الاجتماعي“.
والتاريخ لن يكون حاضراً من دون حمولاته بكل ما فيها من تعقيدات وإشكالات. وهكذا بات النقاش أو الحوار حول أي استحقاق راهن أو مستقبلي يُحال إلى جذره التاريخي، ليس بدافع التأصيل كما تقتضي مناهج البحث العلمي لأصحاب الاختصاصات، بل لأن الارتباط بالتاريخ موثّق لدى هؤلاء بعُرى أيديولوجية – دينية أو طائفية أو عرقية – يصعب التفلّت منها. وبناءً عليه، يصبح الاتفاق بين طرفين متماثلين أو أكثر حول مسألة (علاقة الدين بالدولة)، على سبيل المثال لا الحصر، مرهوناً بالاتفاق على أعقد المسائل في الموروث التاريخي العربي والإسلامي.
ولعله من غير المستغرب في هذه الحال أن يبدأ صاحب الفكرة أو التصور حديثه عن الديمقراطية والمواطنة وأسس الدولة الحديثة، لينتهي في نهاية حديثه مدافعاً شرساً عن الطائفة أو العرق أو المذهب.
معركة ردع العدوان التي انطلقت (27 تشرين الثاني 2024) وأفضت إلى سقوط نظام الإجرام الأسدي في (8 كانون الأول 2024) كان قد واكبها خطاب سياسي يبعث على المزيد من الطمأنينة، فضلاً عن كونه خطاباً وطنياً جامعاً ينطوي على ما يجمع ولا يفرّق. وكان من المنتظر أن يتعزّز هذا الخطاب بمواقف وسلوك ليتحوّل إلى قوانين ناظمة، إلا أن هذا التطلّع قد اصطدم مبكراً بمواقف وسلوكيات صادمة لكثيرين، وربما في الوقت ذاته مُرضية لكثيرين أيضاً، وهذا يعني أنها ليست جامعة، بل باعثة على الانقسام.
لعل من أول تلك المواقف ما جاء على لسان وزير الثقافة حين طرب له كثيرون لما سمعوا “دمشق لنا إلى يوم القيامة”، علماً أن الرجل استدرك موضحاً ما معناه أن الضمير (نا) لا يعني عرقاً أو ديناً محدداً، ولكن ربما كان للتوضيح مفعول عكسي في إثارة بعض الارتياب لدى كثيرين.
ولعل ما عزّز هذا الارتياب ظهور خطاب “الأموية” الذي بدأ يشيع تزامناً مع أحداث الساحل والسويداء، وكذلك تزامناً مع سفور التراشق الطائفي بين المكونات السورية. وهكذا تحوّلت “الأموية” من حيّزها التاريخي الحضاري الجامع إلى خطاب عصبوي يحيل إلى مبدأ الغلبة والشوكة والاستقواء على الآخر.
وقد فات الأمويون الجدد أن مفهوم “الدولة الإمبراطورية” الذي وسم الدولة الأموية قد مضى إلى غير رجعة، وأن الدولة التي ينشدها السوريون وبذلوا من أجل الوصول إليها تضحياتٍ هائلة هي دولة المواطنة و”التعاقد الاجتماعي” التي تتساوى فيها الأعراق والأديان والطوائف في إطار الوطنية السورية.
ما هو مؤكد أن الإغارة على التاريخ بغية العبث به أو تشويهه أو تحريفه، لا بدوافع علمية للتصويب، بل بدوافع أيديولوجية، إنما هي من سمات الوعي المأزوم الذي يخفق في مواجهة استحقاقات الواقع.
ومما لا ريب فيه على الإطلاق أن أنماط الخطاب الأخرى، سواء أكانت تتمثل بـ”الدولة الباشانية” التي يطالب بها الهجري، أو كيان “روج آفا” الذي تطالب به قسد، أو الحكم الذاتي الذي يطالب به “غزال غزال” في الساحل السوري، جميعها خطابات مستمدّة من وعي عصبوي بالتاريخ، يدّعي التحرر من أثقاله، ولكنه لا يستطيع الانفكاك من حمولاته العقدية.
ولعل غير بعيد عن هذا السياق ما أقدمت عليه وزارة التربية في الحكومة الانتقالية من تغيير في مادة التاريخ لطلاب المرحلة الإعدادية، حين جعلت من شهداء السادس من أيار مجموعة من المتمردين أو الخونة، وذلك في خطوة تبدو نافلة جداً، وليست موجبة، ولا تحمل أي جانب من المشروعية أو الوجاهة. إذ ما الفائدة في اتهام مجموعة من الرموز الوطنية والثقافية السورية، بات لهم حضور تاريخي وثقافي في الوجدان السوري، بالخيانة؟ هل فقط لأنهم انتفضوا ضد سياسة جمال باشا السفاح؟ علماً أن سياسات جمال السفاح وسلوكه ومواقفه السياسية هي محط إدانة ونقد من جانب العديد من مثقفين وشرائح تركية مختلفة.
ما هو مؤكد أن الإغارة على التاريخ بغية العبث به أو تشويهه أو تحريفه، لا بدوافع علمية للتصويب، بل بدوافع أيديولوجية، إنما هي من سمات الوعي المأزوم الذي يخفق في مواجهة استحقاقات الواقع، فيجد المخرج باستعارة حمولات تاريخية لها مفعول قادر على بعث النشوة والخدر في الذات، ولكنه مفعول خادع لا ينمّ إلا عن عجز وإفلاس.
وكما كان للمتخيَّل التاريخي دور سلبي في عدم لقاء السوريين من أصحاب الاتجاهات المتماثلة قبل تحرير سوريا، كذلك فإن المناخ السائد أيضاً بعد التحرير يبدو أنه جاذب لهكذا نزوع، طالما أن وعيَ التاريخ – معرفياً واجتماعياً – لم يُفضِ، كما هو مفترض، إلى “تحرير الإرادة” وفقاً لعبد الله العروي، بل إلى مزيد من الاستلاب.
المصدر: تلفزيون سوريا