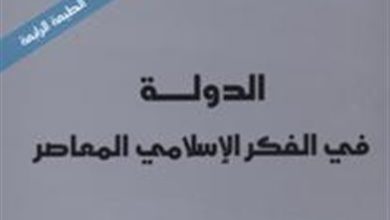لا يُوجد في العالم كلّه مجتمعٌ من لونٍ واحد، أو من رأي واحد، أو من مكوّن اجتماعي- ثقافي- سياسي واحد، فالمجتمعات قائمة على التعدّد والتنوع تبعاً لتعدّد المصالح والأفكار والمنابت الاجتماعية والدينية والعرقية. والمجتمع السويّ هو الذي تتعايش فيه هذه المكوّنات المختلفة بسلام، تعايشاً لا ينفي الاختلاف والتناقض أحياناً بين تلك المكوّنات، لكنّه يؤمن إدارة هذا التناقض وفق قواعد التسامح والجدال بالتي هي أحسن، وليس سوى المؤسسات التمثيلية الديمقراطية وسيلة لتأمين هذا التعايش والإدارة الرشيدة للتناقضات أو اختلاف المصالح، ففي هذه المؤسّسات، من قبيل البرلمانات والمجالس المنتخبة ذات الصلاحيات الفعلية والنقابات والاتحادات الجماهيرية المستقلة عن الدولة، يعمل أصحاب الآراء المختلفة ويتعلمون بالمراس والتدريب أهمية الوصول إلى التوافقات والمشتركات، لكن يظلّ أنّ الدولة مطالبة بأن تقوم بدورٍ وسطي، ولا نقول محايداً بالضرورة، لأنّ المسألة نسبية، في أن تكون ناظماً لتعايش مختلف الآراء والأفكار وأنماط السلوك والمعيشة. وكلّما نجحت الدولة في أداء هذا الدور تعافى المجتمع وتطوّر بسلاسة نحو المستقبل، فتجربة الحكومات الشمولية التي فرضت رأياً واحداً وفكراً واحداً وحزباً واحداً وأسلوب معيشة واحداً، قادت وتقود، كما ترينا التجربة، إلى الخراب. ولسنا في حاجةٍ إلى تعداد الأمثلة والنماذج، فهي ساطعة فاقعة للأعين.
الخلل المزمن الذي انتاب أداء الدولة دورها المتوازن، في مجتمعاتنا العربية، وميلها إلى الاعتماد على تحالفاتٍ طارئة أو ثابتة، وبحثها عن الأمان في إطار ضيّق، فئوي أو طائفي أو حزبي، وانغلاقها عن المكوّنات الأخرى في مجتمعاتها التي تتوطّد لديها مشاعر التهميش والعزلة، قاد، وسيقود في المستقبل أيضاً، إلى أزماتٍ وانفجاراتٍ اجتماعية، خصوصاً في ظروف الاستقطابات السياسية الإقليمية الحادّة، راهناً، فتكتشف الدولة ضيق القاعدة الاجتماعية الملتفّة حولها بالقياس إلى ما في المجتمع من رحابة وتنوّع، ويغدو ما اعتبر دائماً عامل قوّة ونُصرة عامل ضعف.
حين تميل الدولة إلى محاباة هذه القوّة أو تلك، وعزل هذه القوة أو تلك لأسبابٍ براغماتية، فإنّها تضرّ بالدور المطلوب منها، الذي يعني، في ما يعني، التوازن والعدالة في تقديم الخدمات الاجتماعية تجاه مواطنيها قاطبةً الذين لا يصحّ تقسيمهم، لأنّ الأوطان ينبغي أن تتسع للجميع الذين من حقّهم على دولهم بأن تؤمّن لهم الحياة الحرّة الكريمة التي تتساوى فيها الفرص، وتُحترم فيها الخصوصيات الثقافية والدينية والعرقية، بإشاعة ثقافة التسامح وغرسها في الأذهان من خلال البرامج التعليمية والتنشئة المجتمعية، ليصبح ذلك قاعدةً ينطلق منها المجتمع، وعليها ينمو ويتطوّر. وخلاف ذلك، المجتمعات عرضة للانقسام بين “نحن” و”هم”، حين يصبح قسم من المجتمع يُعرّف نفسه أمام أفراده بـ”نحن” ويومئ إلى القسم الآخر بـ”هم”، والعكس صحيح بطبيعة الحال. وكما يذهب أمين معلوف، يقدّم جماعة “نحن” في هذه الحال أنفسهم في مظهر الضحايا والأبرياء، أما “هم” فإنّهم مذنبون، حتى لو كشفت المعاينة التاريخية أو الراهنة أنّ كلا الفريقين على خطأ، أو أنهما يتقاسمان هذا الخطأ بالتساوي أو بنسبة تزيد هنا وتنقص هناك تبعاً لواقع الحال الملموس.
يمكن لمؤسّسات المجتمع المدني الحديثة، العابرة في تشكيلها ووجهتها للطوائف والقبائل، والمُجسّدة الوحدة الوطنية لمجتمعاتها أن تلعب دوراً مؤثراً في تجاوز هذا “التقسيم” أو “الانقسام”، فالمجتمع المدني، من حيث هو مقابل للدولة، ومستقل عنها، وليس ملحقاً بها، عليه أن يكون أكثر جذرية من الدولة في انحيازه لقيم الحداثة والتقدّم والحقوق الديمقراطية، حازماً في نضاله من أجل بناء الدولة الحديثة والعصرية، التي عليها أن تتحرّر من ثقل الولاءات والتعاضديات التقليدية السابقة لها، عبر تعزيز مفهوم المواطنة المتساوية للناس، وإخضاعهم، جميعاً للقانون، حقوقاً وواجبات، ونبذ كل أشكال التمييز والمحاباة وفق أيّ من تلك الولاءات، وأن يعكس (المجتمع المدني) رؤية ومصالح الشرائح الحديثة المُغيبة عادةً عن مواقع صنع القرار، وهو إذ يتخذ لنفسه موقعاً مقابلاً أو معارضاً للدولة، فإنّما بهدف حملها على مزيد من تدابير وإجراءات تجذير الممارسة الديمقراطية والشراكة مع المجتمع، في اتجاه تطوير بناه هيكلياً، صوب الحداثة وإقامة دولة القانون والمؤسّسات، العابرة للولاءات السابقة لبنية الدولة، التي تعمل على النقيض من آلياتها، بل وتنجح، في حالات كثيرة، في جعل الدولة خاضعة لها.
المصدر: العربي الجديد