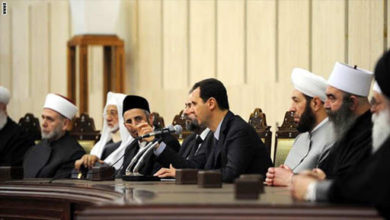في بلد مثخن بالجراح مثل سوريا، لم تعد الجريمة حدثًا فرديًا معزولًا عن سياقه، بل أصبحت انعكاسًا لمنظومة قيم مشوّهة تشكّلت تحت ضغط عقود من الحكم الشمولي، ثم انفجرت مع الحرب والانقسام.
أصبحت الأفعال لا تُقاس بميزان القانون أو الأخلاق، بل بميزان “من نحن” و”من هم”، لم يعد القتل مجرد اعتداء على حياة إنسان، بل قد يُرفع إلى مرتبة الواجب إذا خدم الجماعة الضيقة؛ ولم يعد النهب سرقة، بل قد يُسوَّق كاسترداد حق مسلوب.
إن هذه الفلسفة الجديدة للجريمة لم تولد فجأة عام 2011، بل حريٌّ بنا الاعتراف أن لها جذور ممتدة في بنية الدولة والمجتمع السوري، فالنظام السياسي الذي حكم البلاد لعقود رسّخ فكرة أن الولاء للنظام، أو للحزب، أو للفئة الحاكمة، هو فوق الولاء للقانون، وفي ظل هكذا واقع، كان من الممكن لمرتكب الجريمة أن يفلت من العقاب إذا عرف كيف يستخدم ولاءه لتحقيق مكتسبات، في حين يُسحق المخالف حتى لو كان بريئًا، وهكذا مهدت هذه المعايير المزدوجة الأرضية لانفجار أخلاقي بعد سقوط النظام وزوال الخوف.
بدأت تبرز آليات التبرير أمام الآخرين فمن خطاب المظلومية بتصوير الجماعة كضحية دائمة ما يبرر أي رد فعل ضد “الآخر”، إلى شيطنة الخصم ونزع صفة الإنسانية عمن تُرتكب بحقه الجريمة.
قبل الحرب، كان السوري يعرف جيدًا أن القانون ليس هو الحكم النهائي، بل تختلف العاقبة بحسب علاقاته ونفوذه وانتمائه، والأمثلة كانت كثيرة في بيئة السلطة أو المنتفعين والمتنفذين، وهو ما أنشأ شعوراً عاماً بأن الجريمة ليست فعلًا معيباً أخلاقيًا بقدر ما هي عرض إظهار تفوق بالقوة والسلطة.
أعادت الحرب خلط المعايير وبدأت تختلف أحكام القيمة الأخلاقية حول الأفعال المنافية للقانون بشكل آخر، فوُلدت مبررات جديدة للجريمة، فما دمتَ تخدم جماعتك، فأنت محق، حتى لو خرقت كل قانون إنساني.
انشغال السلطة الحاكمة في القتال وتغوّل النظام من أجل الحفاظ على السلطة، جعل المؤسسات الحكومية تغيب عن المشهد لتظهر زعامات جديدة على السطح فانتشرت ثقافة الثأر، وأصبح السلاح هو صاحب السطوة، ومع هذا التحوّل صار الفرد يحدد أفعاله بناءً على رضا الجماعة، لا على مبادئ الحق العام وهذا نتيجة متوقعة للسياق الذي عاش فيه السوريون طوال سنوات، إنه السياق الذي لا يُرفع فيه شأن القانون ولا يُعاقب المجرم.
بدأت تبرز آليات التبرير أمام الآخرين فمن خطاب المظلومية بتصوير الجماعة كضحية دائمة ما يبرر أي رد فعل ضد “الآخر”، إلى شيطنة الخصم ونزع صفة الإنسانية عمن تُرتكب بحقه الجريمة، حتى يصبح قتله أو إيذاؤه أمرًا عاديًا، كل ذلك أدى إلى قلب المعايير والحقائق بتحويل الاعتداء إلى دفاع، والنهب إلى تعويض، والخطف إلى ضغط مشروع.
في واقع الأمر لم تكن هذه الآليات مجرد حجج، بل هي بنية فكرية تغذيها وسائل إعلام موجهة وصفحات التواصل، بحيث يقتنع بها الجاني والمحيط معًا.
وحين تصبح الجريمة مبررة، فإن الضحية نفسها قد تُصوَّر كجانية، بخلق سرديات تمنع التعاطف، وتخلق قطيعة عاطفية بين مكونات المجتمع، والأخطر أن الأجيال الجديدة سوف تكبر في مجتمعات ترى فيها هذا المنطق سائدًا، فتتعلم منذ الصغر أن الانتماء أهم من الحق، وأن الظلم مقبول إذا خدم جماعتك، وهذا يهدد أي إمكانية مستقبلية لبناء دولة قانون، لأن فكرة “الحق العام” تكون قد تآكلت تمامًا.
لقد اشتغل نظام الأسد على هذه النقطة عقوداً طويلة، جعل فيها من الانتماء الضيق مصدراً للأمان في ظل غياب سلطة القانون وفي ظل انشغال الدولة في قمع أبنائها ومحاولة ترويضهم، الأمر الذي عمّق فلسفة الجريمة، لأن الناس ترى أن القانون نفسه أداة بيد الجماعة الأقوى، لا ميزانًا محايدًا للجميع.
لا يعني ذلك أن الارتداد للهويات ما قبل وطنية أصبح هو الحالة العامة، لكنه مع الأسف الأكثر وضوحاً فلا صوت يعلو فوق أزيز الرصاص، لقد سجل السوريون وقفات حقيقية ضد الانتقام الطائفي، وفرضوا حماية على جيرانهم المختلفين في الانتماء وفي بعض المدن، عملت منظمات محلية على فض النزاعات بطرق سلمية، مستندة إلى قيم إنسانية مشتركة.
ليس جديداً أن ذلك الغضب العارم الذي انفجر ببعض السوريين هو جزء من منظومة كاملة، عبثت بقيم السوريين وأفرغت حياتهم من مضمونها، زينت لهم الجريمة وغلفتها بقالب السلطة والامتيازات وزرعت الكره تجاه الآخر المختلف في الدين أو المذهب أو البيئة والمنبت، لكن تأخر تطبيق العدالة الانتقالية كان بمنزلة الشعرة التي قصمت ظهر البعير إذ جنح بعضهم للأخذ بالثأر واستيفاء الحق باليد.
إن فلسفة الجريمة السورية لن تتغير من تلقاء ذاتها ولا بالقوانين وحدها، بل بإعادة تعريف الانتماء، يوم يصبح الانتماء للإنسانية والمواطنة قبل الطائفة، وللحق قبل الجماعة.
لم تعد الجريمة دائمًا جريمة بوصفها المجرد، صارت أحيانًا واجبًا، بطولة، أو حتى فخرًا في عيون جماعة ما، وأصبح الفعل لا يُقاس بميزان القانون، بل بميزان الدم والقرابة والانتماء، قتيل الأمس قد يصبح “شهيدًا” أو “خائنًا” بحسب الراوي، والفاعل قد يُكرَّم أو يُلعن بناءً على لون رايته لا على فعل يده.
لم تولد هذه الفلسفة من فراغ، عشرات السنين من حكم مركزي شديد الصرامة، جعل الولاء أهم من العدالة، وتفجرت الانتماءات الصغيرة، وأصبح كل حيّ، كل قرية، كل طائفة، كيانًا قائمًا بذاته، يوزّع صكوك الغفران أو الإدانة.
إن المعركة الحقيقية التي علينا أن نخوضها كسوريين ليست تجاه بعضنا بعضًا وإنما تجاه أنفسنا، باجتثاث مخلّفات تلك الحقبة البائسة التي كنا شاهدين عليها، ومحاولة كسر هذه الحلقة حتى لا تنتقل العدوى إلى أبنائنا، وذلك عن طريق التعليم بإدخال مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج، والإعلام بإنتاج سرديات مضادة لخطاب الكراهية والقانون بإعادة بناء جهاز قضائي مستقل فعليًا.
لا تبدو أثار الجريمة هنا آنية فحسب بل إن الأخطر منها، هو اغتيال فكرة الحق العام ما يفتت ويقتل فكرة العدالة نفسها، لأننا بذلك نخاطر ببناء جيل يؤمن أن الانتماء أهم من الحق، وأن الظلم قد يكون فضيلة إذا وُجّه ضد الآخر العدوّ، وفي هذا المناخ، يمكن للضحية أن تتحول إلى جانٍ في رواية الآخر، وتصبح دماؤها وقودًا لمظلومية جديدة فتتوارث الأجيال الكراهية، وتتكرر المآسي.
إن فلسفة الجريمة السورية لن تتغير من تلقاء ذاتها ولا بالقوانين وحدها، بل بإعادة تعريف الانتماء، يوم يصبح الانتماء للإنسانية والمواطنة قبل الطائفة، وللحق قبل الجماعة، فالجريمة التي نشهدها في سوريا اليوم ليست مجرد انحراف فردي، بل هي انعكاس لبنية مجتمعية وسياسية انهارت فيها فكرة الحق العام وتحطمت فيها فكرة الحقوق والواجبات الفردية، وبإدراك أنه ما لم يحدث تحوّل ثقافي عميق يعيد تعريف الانتماء على أساس الإنسانية والمواطنة لا على أساس الجماعة الضيقة، ستظل الجريمة تجد ألف مبرر، وسيظل القاتل بطلاً في عيون جماعته.
ومن نافل القول أن ذلك يتطلب كسر هذه الحلقة وشجاعة جماعية للاعتراف بما حدث، ونزع القداسة عن الانتماءات المغلقة، وإعادة الاعتبار للقانون كحامٍ للجميع بلا تمييز، يومها فقط، يمكن لسوريا أن تتجاوز فلسفة الجريمة، وتبدأ رحلة طويلة نحو عدالة حقيقية.
المصدر: تلفزيون سوريا