
لم يعد سؤال الديمقراطية في العالم العربي مجرّد شعار سياسي أو طموح نخبوي، بل تحوّل في السنوات الماضية سؤالاً معرفياً بنيوياً، يعكس عمق المأزق الذي تعانيه أنظمتنا السياسية بعد تعثّر تجربة الربيع العربي، وتحوّلها في حالاتٍ عديدة نكسةً لا تقلّ في آثارها عن التي أصابت مشاريع التحديث في القرن العشرين. من هنا، بات من الضروري إعادة التفكير في الديمقراطية، لا هدفاً سياسياً فقط، بل إشكاليةً فكريةً وتاريخيةً، تتطلّب أدوات تحليل مركّبة، وفهماً نقدياً للتجارب العالمية والسياقات الخاصّة بالعالم العربي.
في هذا السياق، يُعدّ كتاب “مقالات مرجعية في دراسات الانتقال الديمقراطي” (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2023)، مرجعاً محورياً، فهو لا يجمع بين دفتيه مقالات تأسيسية لكبار منظّري التحول الديمقراطي فقط، بل يُمثل منعطفاً في تطوير إدراك عربي جماعي لمفهوم التحوّل الديمقراطي (Democratic Transition) وترسيخ الديمقراطية (Democratic Consolidation)، بما يتيح تفكيك كثير من الافتراضات المسبقة التي سيطرت على التفكير السياسي العربي عقوداً، خصوصاً ذلك الانبهار غير النقدي ببعض النماذج الغربية.
لم تتجه بلدان آسيوية وعربية ذات مستويات عالية من التنمية نحو الديمقراطية، ما أدّى إلى انكشاف محدودية فرضية أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تؤدّي بالضرورة إلى نشوء الديمقراطية
من بين المدارس الأساسية التي يتناولها الكتاب، مدرسة التحديث السياسي، التي سادت في خمسينيّات القرن الماضي وستّينياته، وارتكزت على فرضية أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تؤدّي، بالضرورة، إلى نشوء الديمقراطية. وهي الفرضية التي تبناها مفكّرون مثل سيور ليبست ولوسيان باي، وارتبطت بنموذج الحداثة الغربي، لكنّها اصطدمت لاحقاً بحقائق ميدانية عديدة، منها تجارب بلدان آسيوية وعربية ذات مستويات عالية من التنمية لم تتجه نحو الديمقراطية، ما أدّى إلى انكشاف محدودية هذا التفسير الحتمي. جاءت مدرسة “الانتقال الديمقراطي” في الثمانينيّات ردّاً على هذه المحدودية، وأبرز منظّريها غيرمو أودونيل وفيليب شميتر. ظهرت هذه المدرسة في سياق دراسة التحوّلات في أوروبا الجنوبية وأميركا اللاتينية، وأطلقت موجةً من الأبحاث ركّزت في العامل السياسي أكثر من البنيوي، وفي دور النُّخب، والقرارات السياسية في لحظات التحوّل، ومفهوم التفاوض السياسي بين النُّخب القديمة والجديدة. وهي نقطة تحوّل مركزية في الفكر الديمقراطي، لأنها أسقطت أوهام “الحتمية الديمقراطية”، وربطت عملية التحوّل بالسياقات المركّبة والقرارات الفعلية للنُّخب والمؤسّسات، لا بمجرّد توافر شروط اقتصادية.
من المساهمات المفصلية أيضاً مقالة ألفريد ستيبان بشأن العلاقة بين الدين والديمقراطية، والتي تنقض الأطروحة الكلاسيكية لمدرسة التحديث التي تربط الديمقراطية بالعلمنة. يقدم ستيبان هنا مفهوم “التسامح المتبادل” مبدأً تأسيسياً للنظام الديمقراطي، ويوضّح من خلال تجارب تاريخية (مثل السنغال والهند) أن وجود الدين في المجال العام لا يتناقض، بالضرورة، مع الديمقراطية، بل يمكن أن تُدار نماذج التعدّد الديني ديمقراطياً عبر إطار من التسامح والمؤسّسات. وتكتسب هذه المقاربة أهميةً خاصّة في السياق العربي، إذ كثيراً ما يُطرح الدين مشكلةً أو عائقاً في وجه التحوّل الديمقراطي، بينما الأجدى هو التركيز في بنية العلاقة بين الدين والنظام السياسي، لا في وجود الدين نفسه.
يضمّ الكتاب أيضاً مقالة مهمة لستيفن ليفيتسكي ولوكان واي عن السلطوية التنافسية، وهي الأنظمة التي تسمح بوجود انتخابات وتعدّدية حزبية وإعلام نسبي، لكنّها تفتقر إلى المعايير الجوهرية للديمقراطية مثل استقلال القضاء، وتداول السلطة، وضمان الحريات. ما يميز هذه المقالة كشفها طبيعة النظام السياسي الذي يقدّم واجهةً ديمقراطيةً فيما يرسّخ البنية السلطوية عبر تحكّم خفي بالمؤسّسات وآليات القرار. وأسهم ريتشارد سنايدر في تحليل نمط “الدكتاتوريات النيوبتريمونيالية”، أي الأنظمة التي تقوم على الزبائنية وتوزيع المنافع داخل شبكات الولاء الشخصي. نجد هذا النموذج في أنظمة عربية عديدة، حيث تغيب الدولة المؤسّسية ويحلّ محلّها نمط من الحكم الشخصي يعيد إنتاج الاستبداد تحت غطاء بيروقراطي هشّ. وللمقالة التأسيسية لدنكوارت روستو قيمة استثنائية، لأنها كانت من أولى المحاولات لتحديد مراحل الانتقال الديمقراطي. شدّد روستو على أن الوحدة الوطنية شرط مسبق للانتقال، وميّز بين ثلاث مراحل: التمهيد، التفاوض، والتنفيذ، وهي نظرية ما تزال تحتفظ براهنيتها، بخاصّة في المجتمعات التي تعاني من انقسامات حادّة على أسس طائفية أو إثنية، كما هو الحال في عدة دول عربية. أمّا صموئيل هنتنغتون، فقد قدّم إضافة نوعية في كتابه عن “الموجة الثالثة للديمقراطية”، حين أشار إلى أن الديمقراطية تنتشر في موجات مرتبطة بتحوّلات دولية وإقليمية، وأنّ التحوّل لا يكون دائماً نتيجة تطوّر داخلي فقط. ركّز أيضاً في أهمية المؤسّسات السياسية في إنجاح التجربة الديمقراطية أو إفشالها، وهو ما تقاطعت معه لاحقاً أطروحات فرانسيس فوكوياما.
يكتمل العمل النظري بحثاً في التحوّل الديمقراطي من دون مشروع عربي جماعي يراجع تجربة العقد الماضي
ما يميّز الكتاب أنه لا يكتفي بعرض النظريات، بل ينخرط في نقدها، ويفتح الباب أمام تطوير مقاربة عربية عقلانية للانتقال الديمقراطي، تستفيد من التجارب العالمية من دون أن تُسقطها إسقاطاً غير نقدي. وهذا ما فعله أيضاً عزمي بشارة في كتابه “الانتقال الديمقراطي وإشكالياته … “(2022)، حين قدّم مراجعةً شاملةً لتجارب “الربيع العربي” من خلال زوايا متعدّدة، أبرزها: العلاقة بين الدين والدولة، ودور الجيش، والعامل الخارجي، وضعف الثقافة الديمقراطية، وأزمة الدولة الريعية، وهشاشة التكوينات الحزبية.
لم يكتف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بهذا الكتاب، بل أنتج خلال السنوات الماضية مكتبةً متكاملةً في هذا الحقل، منها “الديمقراطّية والتحوّل الديمقراطي” لغيورغ سورسن، و”محدّدات التحوّل الديمقراطي” ليان تيوريل، و”موت الديمقراطيّة”، فضلاً عن دراسات حالة عن تونس ومصر وسورية وليبيا، ودور الشباب في التحوّل السياسي، ما يتيح بناء تراكم معرفي حقيقي في هذا الميدان. لكن هذا العمل النظري كلّه لا يكتمل من دون أن يقترن بمشروع عربي فكري جماعي (أدعو المركز العربي إلى تبنّيه) يراجع بعمق تجربة العقد الماضي، لا بروح اليأس أو التبرير، بل بدافع الفهم والتأسيس، في ضوء السؤال القديم الجديد: لماذا تأخّر العرب في التحوّل الديمقراطي مقارنة بغيرهم؟ ما الذي يفسّر نجاح الديمقراطية في بلدان تعاني من تحدّيات اقتصادية أو طائفية أو أمنية مماثلة؟ وهل آن الأوان لبناء نموذج عربي، لا يُقلّد الآخرين، بل يستفيد منهم وينتج مقاربته الخاصّة؟ ويضعنا أمام مسؤوليّتنا التاريخية في إعادة بناء السؤال الديمقراطي عربيّاً من الداخل.
المصدر: العربي الجديد






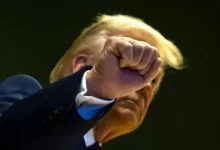
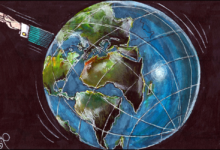
قراءة جميلة لكتاب “مقالات مرجعية في دراسات الانتقال الديمقراطي” وهو يجمع بين دفتيه مقالات تأسيسية لكبار منظّري التحول الديمقراطي في الوطن العربي ويُمثل منعطفاً في تطوير إدراك عربي جماعي لمفهوم التحوّل الديمقراطي، فراءة واستعراض الكاتب “محمد ابو رمان”.