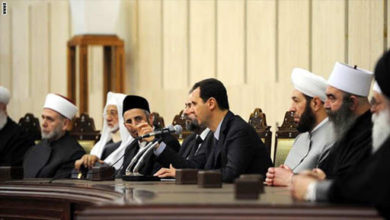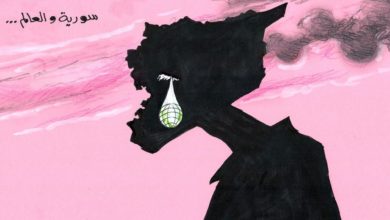في اللحظة التي انزاحت فيها قبضة النظام السوري عن المدن والبلدات، لم يكن التغيير سياسيًا فقط، بل كان عميقًا في وجدان السوريين أنفسهم.
فقد شكّلت عقود القمع والتخويف الممنهج بيئة من الصمت العام، ساد فيها الخوف من الكلمة، والريبة من الآخر، وانكفأ الناس على همومهم الخاصة. لكن مع التحرير، بدأت تتكشف تحوّلات عميقة في الوعي والسلوك، وخرج المواطن السوري من عباءة الخوف، وانخرط شيئًا فشيئًا في الشأن العام، مشاركًا، ومبادرًا، وصاحب رأي.
لم يكن القمع في عهد نظام الأسد مجرد تكميم للأفواه السياسية، بل كان مشروعًا ممنهجًا لاغتيال الموهبة، وتجفيف منابع التفكير الحر. فقد سيطر الخوف على عقول السوريين منذ نعومة أظفارهم، وتشرّب جيلٌ كامل ثقافة الصمت والخضوع، لا في السياسة فقط، بل في شتى ميادين الإبداع والمبادرة.
السوري الذي كان يخشى أن ينطق بكلمة خارج “الخط الأحمر” حتى في بيته، أصبح اليوم يكتب، يناقش، ينتقد، ويقترح.
كانت المدارس تخرّج حفظة لا مفكرين، والجامعات تُنتج موظفين لا مبادرين، والبيوت تُعلّم أبناءها الحذر في الكلام لا الجرأة على السؤال. أما الفنون، فخضعت لرقابة صارمة، فكانت النتيجة مجتمعًا يعجّ بالعقول اللامعة والطاقات المدفونة، لكنها لا تجرؤ على الظهور.
لقد قتل نظام الأسد ما هو أكثر من الحياة الجسدية للسوريين؛ قتل الحيوية المجتمعية ذاتها. ولذلك، فإن التحرير لم يكن فقط تحررًا من سلطة سياسية، بل كان أيضًا تحررًا من قيد نفسي عميق، استلزم وقتًا ليدرك السوريون بعده أنهم باتوا أحرارًا فعلًا.
مع سقوط النظام، انكسرت بوابة كبيرة من السدود فجأة، فبدأ السوريون يتحدثون، يكتبون، يغنّون، يرسمون، ينظمون مهرجانات، ينشئون صحفًا، يطلقون مبادرات. انفجرت مكبوتات سنوات طويلة دفعةً واحدة، وتنفس السوريون الصعداء.
لكن هذا الانفجار، على الرغم من كونه ظاهرة صحية في جوهره، لم يكن منظمًا. ولم تكن ثمة تقاليد ديمقراطية، ولا وعي كافٍ بإدارة الخلاف، ولا بنية فكرية مسبقة للحوار. ولهذا، وبدلًا من أن تتكامل هذه الأصوات، بدأت تتصادم.
انقسم الناس بسرعة بين رؤى متباينة حول المستقبل: هل نريد دولة مدنية أم إسلامية؟ هل الأولوية لإعادة الإعمار أم للمحاسبة؟ من يُمثّل الثورة؟ ومن له الحق في الحديث باسمها؟ فكل فرد كان يرى نفسه الصوت الحقيقي، بعد أن سُلب منه حق التعبير طيلة عقود.
هذا الفيض من التعبير قاد إلى حالة من التخبط في الأداء العام. فالمؤسسات الناشئة اصطدمت بسوء التنسيق، وغياب الخبرة، وتضارب الأجندات، وبدأ يظهر صراع سوري – سوري، لا بالسلاح فقط، بل في الفكر والاتجاه.
جزء من هذا الصراع يعود إلى عمق الجرح؛ فالسوري الذي خُدع عقودًا لا يثق بسهولة، والذي ذاق الظلم لا يصفح سريعًا، والذي عاش تحت رقابة فكرية صارمة، يندفع أحيانًا إلى نقيضها، إلى التطرّف أو الشعبوية.
كما أن القوى الخارجية استغلت هذه الفوضى الداخلية، فدعمت بعض الأطراف على حساب أخرى، وعمّقت الانقسامات، مما زاد من تعقيد المشهد. فأصبح الصراع السوري – السوري في جزء منه انعكاسًا لصراعات خارجية، لكنه في جوهره كان صراعًا على هوية جديدة لم تولد بعد.
لكن وسط هذا التشظّي، هناك نضج بدأ يتكوّن. فما يحدث في سوريا المحررة اليوم هو أشبه بما يحدث لأي إنسان خرج من قفص مظلم إلى فضاء مفتوح: يركض أولًا بلا اتجاه، يصطدم، يتعثر، ثم يبدأ بالتمييز بين الطريق والصدى، بين الحرية والفوضى، بين الصوت والصراخ.
من مظاهر التحوّل برزت الجرأة المتزايدة على التعبير عن الرأي. فالسوري الذي كان يخشى أن ينطق بكلمة خارج “الخط الأحمر” حتى في بيته، أصبح اليوم يكتب، يناقش، ينتقد، ويقترح. كذلك شهدت منصات التواصل الاجتماعي المحلية واللقاءات المجتمعية ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط الشعبي، حيث بدأ المواطنون ينظمون حلقات نقاش، وورش تفكير، بل ومبادرات إعلامية محلية تُعنى بشؤونهم، وتسلّط الضوء على المشكلات من دون خوف من الرقابة أو البطش.
لقد حان الوقت لينشأ جيل جديد من السوريين، لا يعرف الخوف من الصوت العالي، بل يراه وسيلة طبيعية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق. هذا التحوّل لا يمكن اعتباره مجرد ردّة فعل مؤقتة على زوال القمع، بل هو مؤشر على بناء ثقافة جديدة تقوم على المشاركة والمساءلة.
لم يكن ما بعد التحرير مجرد خروج من حكم مستبد، بل كان ولادة جديدة لمواطن سوري طالما حلم بأن يكون شريكًا في وطنه، لا تابعًا.
لم يقتصر التحوّل على الجرأة الفردية، بل شمل أيضًا استعادة الحس الجمعي وروح المبادرة. ففي مرحلة ما بعد التحرير، بدأت تتشكّل لجان أهلية، ومبادرات تطوعية تهدف إلى معالجة قضايا مثل التعليم، وإعادة الإعمار، ومساعدة المهجرين، وتنظيم الحياة الاقتصادية. إن هذه التجارب، وإن كانت متفرقة، إلا أنها ترسم ملامح لثقافة سياسية ناشئة تعتمد على المبادرة لا التلقين، وعلى المسؤولية لا الخضوع.
أحد الأوجه اللافتة في هذه المرحلة هو صعود قيادة مدنية من القاعدة المجتمعية، وليس من النخب السياسية التقليدية. حيث أصبح المعلّم، والطبيب، والمهندس، وحتى ربّ الأسرة، يملكون شرعية مستمدة من الفعل اليومي في خدمة مجتمعهم.
لقد تشكّل نمط من القيادة الناشئة يعتمد على الكفاءة، والاستقامة، والتواصل المباشر مع الناس. وهو ما غاب طويلًا في ظل هيمنة النخب المرتبطة بالسلطة، أو البعيدة عن الواقع المعاش. إن بروز هذه النماذج يعكس تحوّلًا في مفهوم الشرعية الشعبية، وينذر بإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة على أسس جديدة، قوامها الخدمة لا السيطرة.
وعلى الرغم من غياب مؤسسات حكم وطنية جامعة حتى الآن، إلا أن المشاركة السياسية بدأت تأخذ أشكالًا جديدة. فالمواطن السوري لم يعد ينظر إلى السياسة كـ”تابو”، بل بات يتفاعل معها يوميًا من خلال القرارات التي تتخذها المجالس المحلية، والنقاشات التي تدور حول الحوكمة والعدالة والتعليم.
قد تكون هذه المشاركات محدودة النطاق، لكنها تمثل تمرينًا ضروريًا على المواطنة الفاعلة. ذلك أن المواطن الذي كان يُقصى لعقود عن أي قرار يخص حياته، بدأ اليوم يمارس سلطته بشكل مباشر، ما يؤسس لثقافة ديمقراطية حقيقية، قابلة للنمو والتطور.
لا تخلو المرحلة، بالطبع، من تحديات جدّية. فالتحرر من الخوف لا يعني بالضرورة تجاوز آثار القمع. ما زال بعض الأفراد يخشون الإفصاح عن آرائهم في بعض القضايا الحساسة، أو يترددون في الدخول في العمل العام، خوفًا من التجربة الماضية.
كما أن غياب بنية قانونية ومؤسسات ضامنة يترك فراغًا قد تستغله قوى أمر واقع، أو جماعات أيديولوجية، لفرض وصايتها من جديد. من هنا، تبدو الحاجة ماسّة إلى بناء عقد اجتماعي جديد، يضمن الحريات، ويضع حدودًا واضحة لأي سلطة، ويصون حق المواطن في المشاركة.
كذلك يشكّل التفاوت في مستوى الوعي بين المناطق، وبين فئات المجتمع المختلفة، تحدّيًا في توحيد الرؤية حول المستقبل. فبينما قطعت بعض المناطق شوطًا كبيرًا في التنظيم المدني والمشاركة السياسية، ما زالت مناطق أخرى ترزح تحت ثقل العادات الأبوية، أو تحت تأثير قوى متشددة.
من أجل ترسيخ هذا التحوّل، لا بدّ من الاستثمار في التربية المدنية، وإعادة بناء الثقة بين الأفراد والمجتمع، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، في المدارس، والجامعات، والمراكز الثقافية، التي يجب أن تلعب دورًا محوريًا في هذا المشروع.
لم يكن ما بعد التحرير مجرد خروج من حكم مستبد، بل كان ولادة جديدة لمواطن سوري طالما حلم بأن يكون شريكًا في وطنه، لا تابعًا. هذا التحوّل من الصمت إلى المشاركة، من الخوف إلى الجرأة، من الانكفاء إلى المبادرة، هو جوهر الثورة الحقيقية، التي لا تكتمل بتحرير الأرض فقط، بل بتحرير الإنسان من داخله.
المصدر: تلفزيون سوريا