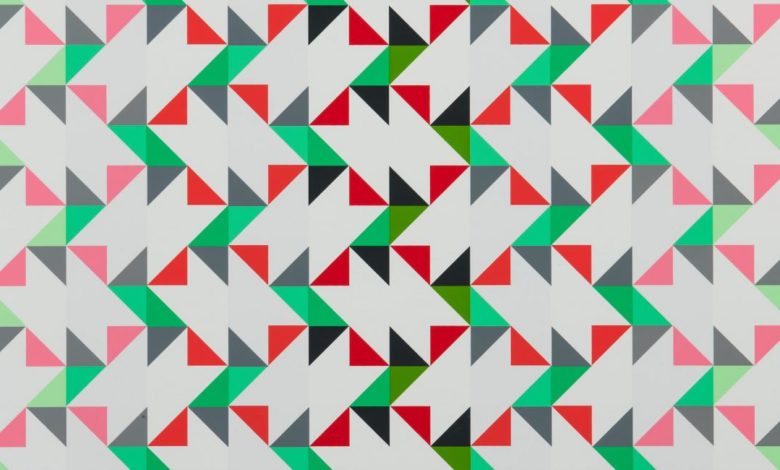
طالب عبد الفتّاح السيسي باستخدام المساجدِ مدارسَ للتعليم العام. ولأنّ كلّ ما ينطق به يتحوّل فوراً خططَ عملٍ وقوانينَ وإجراءاتٍ تنفيذيةً، ثمّة ضرورة لتأمّل تلك الدعوة مليّاً، واستشراف النتائج المتوقّعة حال تنفيذها.
ربّما لا يعلم كثيرون أن المصريين يطلقون على المسجد اسم “جامع”، في استحضار لمفهوم المسجد الذي “يجمع” داخله ساحة الصلاة وأماكن للتعلّم والمُدارسة وحلقات الذكر وجلسات النقاش، وغيرها من أنشطة. فكان المسجد (الجامع) أقرب إلى مجمّع تعليمي وتربوي. ومع خروج مصر من عباءة الدولة العثمانية، وتحوّلها تدريجياً إلى النماذج الغربية في السياسة والثقافة والاقتصاد والقضاء، تأثّراً بالاحتلالَين الفرنسي ثمّ الإنكليزي، تراجعت الكتاتيب (المدارس الدينية)، وأُفسح المجال للتعليم العامّ غير الديني، لتتبلور في عهد جمال عبد الناصر ثنائية الديني/ العام في التعليم، فباتت مؤسّسات ومعاهد، ولاحقاً جامعات التعليم الديني، تابعةً للأزهر، بينما جرى تعميم ونشر أشكال وأنماط التعليم الأخرى كلّها برعاية السلطة الحاكمة. وحرصت السلطة على تحجيم دور الدين في الحياة العامّة، فأُلغي القضاء الشرعي واكتُفي بالقضاء “المدني”.
بالطبع لا تهدف دعوة السيسي إلى إحياء التعليم الديني، بل على العكس، هي خطوة إضافية لترسيخ فصل الدين عن الدولة، بل تغيير صورته في الذهنية العامّة، من محرّك للحياة الإنسانية وضابط لها إلى حصر وجوده وتأثيره في قوقعة قصيرة المدى محدودة المساحة، هي أوقات الصلاة وطقوسها الحركية. أمّا الهدف المُعلَن، فهو تحويل الأبنية والمساحات المتاحة داخل بعض المساجد فصولاً دراسيةً لاستيعاب الأعداد المتزايدة دائماً من تلاميذ التعليم العام وطلّابه.
تحيط بهذه الفكرة إشكالياتٌ عدّةٌ لا يمكن إغفالها، أولاها إشكالية مبدئية، فقد اقتصر كلام السيسي على المساجد حصراً، بينما المفترض أن يسري مبدأ الاستفادة من مساحات وأماكن دور العبادة لأغراض التعليم على مختلف دور العبادة والمنشآت الدينية، بما فيها الكنائس وقبلها الأديرة. فهي جميعاً ذات مساحات ضخمة وأبنية شاهقة، وهي مفتوحة دائماً، على خلاف المساجد التي تفتح أبوابها فترةً قصيرةً في أوقات الصلوات فقط. وتضمّ الكنائس قاعاتٍ مشابهةً لتلك التي تضمّها المدارس النظامية، بل هي مُخصّصة فعلياً لأنشطة تربوية وتعليمية عامّة تقدّمها المؤسّسة الدينية المسيحية لـ”شعب” الكنيسة وأبنائه. وإذا كانت السلطة في مصر قادرة على فتح المساجد قسراً للمنخرطين في العملية التعليمية، من دون فرز أو تمييز لمسلم عن مسيحي، فثمة غموض كبير حول إمكانية فتح الكنائس والأديرة أمام تلاميذ ومدرّسين وإداريين وعمّال مسلمين.
وهناك معضلات تنفيذية كفيلة بإفساد الفكرة وإخراجها من سياقها. منها مثلاً، في الجانب التنظيمي والإداري، هُويَّة أو طبيعة الجهة التي ستتولّى إدارة (وتنظيم) تلك المدارس أو الفصول الدراسية حال تدشينها. وطبعاً المفترض أن تتولّى وزارة التعليم تلك المهام كاملةً، ما يعني تشتّت الأدوار وتداخل الصلاحيات وتنازع الاختصاصات، وهي مسائل ستؤدّي إلى أزمات كثيرة، بسبب تقاطع مواقيت الصلاة مع فترات التعلّم، وتعارض سلوكات المتردّدين من تلاميذ ومدرّسين وأولياء أمور، مع آداب وقدسية دور العبادة، وغير ذلك من محفّزات توتّر، وربّما دواعي فتنة.
بافتراض أن فكرة استغلال المساحات والأماكن المتاحة في نشاط تعليمي (وهي غير مجهّزة له) قابلة للتنفيذ، فأمام السلطة في مصر أماكن كثيرة أخرى، غير المساجد، ملائمة وأكثر قابليةً للتأهيل. منها ملاعب الأندية وساحات المحاكم وقاعات الاجتماع في المؤسّسات الحكومية ومكاتبها، التي تكتظّ بالموظفين والمتردّدين نهاراً خمسة أيام أسبوعياً، وتحويل تلك الملاعب والساحات والقاعات فصولاً دراسية ليلية، أو تشغيلها طوال يومَي العطلة الأسبوعية. وأما الاستيلاء على دور العبادة والعبث بكينونتها، فسيشوه طبيعتها ويُضيّع هيبتها ويُفقدها هُويَّتها، إسلاميةً كانت أم مسيحيةً.
المصدر: العربي الجديد







