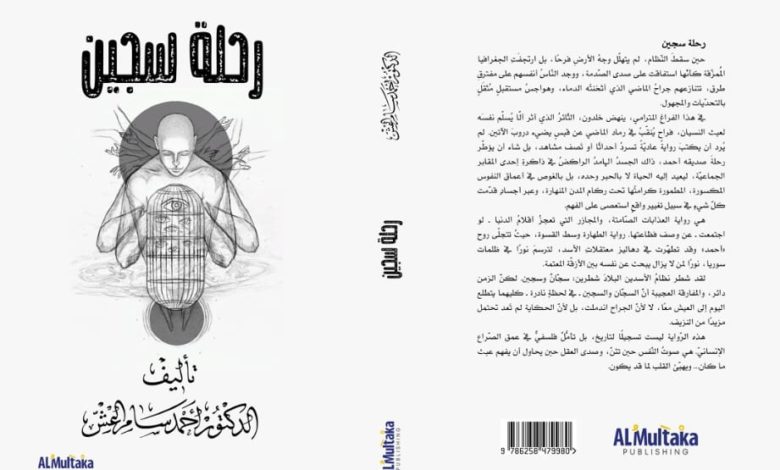
إهداءٌ إلى صَديقي الشَّهيدِ الحَيِّ خَلدونَ مَكِّي الحَسَنِي الجَزَائِرِي، وإلى كُلِّ مَن سَقَطَ شَهيدًا حَيًّا في مُعتَقَلاتِ سُورِيَا مُنذُ أربعةٍ وخَمسِينَ عامًا، وإلى رُوحِ كُلِّ مَن تَوارَى جَسَدُهُ فِي غَيَاهِبِ القُيُودِ، وَظَلَّ صَوتُهُ يَصدَحُ بِالحَقِّ فِي عَالَمِ الأَحْيَاءِ.
مقدمة
لا يَبقى في الذّاكرةِ سوى ما نُريدُ نِسيانَهُ، هذا يُجسِّدُ عُمقَ التَّناقُضِ بينَ الذّاكرةِ والإرادةِ، فَنَحنُ – بأغرَبِ ما فينا – نَصبو للنِّسيانِ، لكنَّ الذّاكرةَ تأبَى أن تُفرِّطَ بِما يُؤلِمُ. إنَّها كَبِئرٍ لا قَرارَ له، كُلَّما هَمَمْنا بِإخفاءِ آلامِنا في أعمَاقِه طَفَحَ منه ما حاوَلْنا دَفنَه، كأنَّ في ذلكَ عِتابًا خَفيًّا مِنَ الذَّاتِ إلى الذَّاتِ.
فَذَاكرةُ الإنسانِ لا تُطيعُ قانونَ الإرادةِ، إنَّها تَعملُ في الظِّلِّ، تَحفَظُ لنا ما نَخشى مُواجَهَتَهُ، وتُعيدُه كُلَّما حاوَلْنا المُضِيَّ قُدُمًا، كأنَّها قُوَّةٌ تُعاكِسُ الزَّمَنَ، تُعيدُنا لِوُجوهٍ وذِكْرَياتٍ تَرَكْناها وَراءَنا، لِتُعيدَ تَشكيلَ آلامِنا على هَيئةِ صُوَرٍ تَتَسَلَّلُ إلى وَعْيِنا.
“مِن وحيِ أفكارِ الكاتبِ الروسيِّ فيودور دوستويفسكي.”
الفصل الأول: سقوط النظام وتجدد الأمل
كان أولُ يوم بعد سقوط النظام يومَ ولادة جديد لخلدون، أحسَّ بحاجته إلى الصراخ؛ كي يفرغ هذا الحجم الهائل من الضغوط التي تراكمت على صدره لخمسين عاماً، لقد كان بحق بحاجة إلى صرخة الحياة التي يُطلقها الوليد حين يخرج من رحم أُمِّه، لكنه عجز عن الصراخ، فما يزال لا يصدق ما تشاهده عيناه، كيف لنظام أقسم إنه سيبقى إلى الأبد يرحلُ بتلك البساطة. نعم البساطة هنا تعني أكثر من مليون قتيل وأكثر من نصف مليون مغيب واثني عشر مليون مشرد في أصقاع الأرض نصفهم في خيام داخل ما اصطلح على تسميته وطنهم “سوريا”.
كان خلدون يتابع أخبار إطلاق سراح المسجونين في معتقلات صيدنايا وأقبية أفرع الاستخبارات التي لا يذكر عددها، نعم فصديقُه أحمد لم يسمع عنه شيئاً منذ أن اعتقل عام 2012، لقد حضر حفل زفاف أخته منذ عدة شهور، فهو يعدهم كعائلته، لم يكن يفترق عن صديقه أحمد منذ أن تعرف عليه في الجامعة، كانا يحلمان سوياً بسوريا أخرى غير تلك التي عرفوها طوال حياتهم .
انتظر لأسابيع دون خبر عن صديقه، على ما يبدو أنه يقبع في إحدى المقابر الجماعية التي كانت تتكشف تباعاً، دون قدرة على تمييز الرفات وتفريق الأجساد المتراكمة عن بعضها، أجساد تكدست فوق بعضها بعضاً، دون أمل في تحديد هوية أصحابها وإرجاعهم إلى أسرهم كي يدفنوهم بالشكل اللائق، الأمر كما أخبره شخص من الذين يعملون في هذا المجال يحتاج إلى جهود جبارة وميزانيات ضخمة، والأمر غير متوفر حالياً، فعلى ما يبدو أن عائلة الأسد أخذت على عاتقها أنها لن تغادر سوريا دون إنهائها للمهمة الموكَلة إليها، وهي ببساطة تحطيمُ كلِّ شيء فيها من حجر أو بشر أو حياة، في واحدة من أعرق الحضارات وأطهر الأمصار، نعم فالدولة الحالية عاجزة، والبشر استُهلكوا تماماً جسدياً وروحياً، ربما كان التحرير، آخر جرعة حياة ضُخَّت في هذا الجسد المهترئ والمتآكل ألماً وظلماً، لكن إلى متى ستُبقي هذه الجرعة تلك الأجسادَ حية أو على الأقل في غرفة الإنعاش؟! لا أحد يدري، وخلدون أعجزهم عن الإجابة!
مباشرة بعد التحرير، بدأ صراع الأيديولوجيات والأفكار والرؤى من أشخاص صنعوا التغيير في أدمغتهم فقط دون واقعهم لأكثر من خمسين عاماً، فأصبحوا متوحدين مع رؤيتهم المتفردة لسوريا خارج سيطرة العائلة والطائفة والأيديولوجيا الزائفة. خلدون لا يراهن كثيراً على مَن عرفهم طوال حياته؛ لأنهم يعيشون على هوامش الحياة وأطراف الحقيقة أو بالأحرى في قلب الوهم، أما الثائرون الحقيقيون، فقد فقدهم الواحد تلو الآخر طوال الأربع عشرة سنة الفائتة، كانت مصائرهم مختلفة منهم من استشهد ومنهم من اعتقل ولا يُعرف مصيره إلى الآن، وآخرون صنعوا معاركهم الخاصة، فانتصروا وانهزموا في معارك لا تمت إلى ما خرجوا من أجله بصلة. كان خلدون قد أقسم عند اعتقال أحمد على أن يكمل المسيرة، يئس أحياناً كثيرة، انهزم وتراجع في العديد من المرات، وانتصر وتقدم في معارك عابرة على نفسه وفي مواضع عدة لكن دون فائدة .
زار والدَ أحمد فوجده كالعادة صابراً محتسباً، ولكنه أحسَّ -بعد فقدانه لآخر شعاع أمل في عودة ابنه، وقد تولد في داخله شعور غريب- بفداحة ما أقدم عليه ابنه، فلأول مرة يلقي خلال لقائه معه بالملامة على سوء تدبير ابنه ورميه بنفسه إلى التهلكة دون طائل، والنتيجة يقول واضحة للعيان: جثة هامدة لا يُعرف مكانها مكدسة بين الآلاف من الجثث، بين تلك الأجساد التي بحق أصبحت متساوية في كمية الظلم والنكران الإنساني، يبدو أنه لم يكن للنظام إلا هذه العدالة الوحيدة التي عرفت عنه.
شَكَّل تغيرُ موقف الأب صدمةً لخلدون رغم أن سقوط النظام تحقق، ونضال أحمد لم يذهب سدىً، لكن لا يستطيع خلدون أن يجلس مكانه ليدرك حجم الصراعات والآلام التي تجول في داخله وتتلاعب بكيمياء دماغه. ربما كان الأمل في لقاء ولدِه هو ما كان يبقيه صامداً! حقيقة لم يكن خلدون يدري، ربما عليه فقط ترك الأمور كما هي، دون تلك الفلسفات السخيفة والتحليلات السفسطائية. عند الألم، لا تسأل شخصاً ما: لماذا تصرخ أو تبكي أو حتى تصمت؟ لأنه بالتأكيد سيكون أسخف سؤال عرفته البشرية، والأكثر تأكيداً أنه لن يقدم أو يؤخر شيئاً.
عندما كان يتنقَّل في دمشق، كان يخاف من الحواجز، واللا-متوقع والأخطر منهما الإحساس بالمجهول، فكل احتمالات الكوارث واردة في عالم العصابات الذي تكشَّف وجهُه الحقيقي بعد الثورة، لكنَّ خوفه الآن صار أكبر وأشد وهو يتجول في الشوارع المظلمة، ليس خوفاً من الخطف أو الاعتقال، لكن من المستقبل الذي يبدو أكثر قتامة من شوارع دمشق الموحشة الباردة والخالية من الكهرباء.
كان كثير ممن حوله يتقاطرون إلى دمشق، وفي جعبتهم الحلُّ السحري لكل مشاكل سوريا حاضراً ومستقبلاً، كان يُدعى إلى حوارات كثيرة، فيها من صراع الأفكار والرؤى والمطامع والرغبة الدفينة في تقاسم كعكة النصر الشيء الكثير، انتابه شعور غريب من أن أربع عشرة سنة من المآسي التي يعجز اللسان والعقل عن وصفها أو تخيلها، أحدثت انزياحاً طفيفاً في الأشخاص، لكن الأرواح ما زالت متشبثة بالأوهام المريحة والأجساد ما فَتِئْت متثاقلة إلى الأرض، عندما ذهب إلى الغرب قديماً بغرض الدراسة والعمل، صار يُدرك أن البيئة هي من تصنع العقول، بينما تعجز العقول عن تغيير البيئة دون فواتير ضخمة، وتضحيات كبيرة. لقد وجد أن أغلب الذين ينخرطون الآن سواء في النقد أو التحليل أو حتى العمل الحذر، كانوا من الصامتين لفترات طويلة خوفاً من أن تتلوث رؤيتُهم وأفكارهم المحنطة بالتغييرات الشديدة في المشهد من حولهم.
لم يكن سعيداً بمن استلموا زمام الحكم، فهو في أعماقه يكره تصلب أفكارهم، ويعرف تاريخهم جيداً، ويدرك أن تغيير العقول أمرٌ لا يدركه إلا الندرةُ من بني البشر، داخلياً أدرك أن الخطاب المختلف ينم عن براغماتية مفروضة بحكم الواقع أو بشيء ما خارجي يجهله، ولكنها ليست أصيلة في نفوس هؤلاء، فالجماعات المغلقة لا تقبل من خارج أسوارها بغض النظر عن إخلاصه أوحكمته، فالأمر يتعلق بالأسوار أكثر مما هو في داخلها وخارجها. لكنه أدرك أن التحكم في المشهد لا يستقيم دون وجود المتغلب؛ لأن الكلَّ مستنفرٌ تجاه الكل، وإزالة الخوف من قلوب من حُكموا به لسنوات لا يستقيم بعده العقل والمنطق والنوايا الحسنة، فالرؤى والخطط بعدد أفراد الشعب! لا بل تزيد. بل إنه شاهد بأم عينه أشخاصاً ممن يحبون تصدر المشهد مَن يملك رؤيتين -في الوقت نفسه – واحدة فردية للخواص، وأخرى جماعية فيها تنازلات كبيرة بغرض الانسجام مع التيار السائد والرغبة الملحة في اكتسابه شعوراً بالانتماء إلى مجموعة بغض النظر عن مدى قناعته بها.
علم أن الأمور لن تكون بيد أيٍّ من هؤلاء سواء من الحكام أو المحكومين، فاللعبة الدولية ومعركة الأدوات على ما يبدو أكبر من الجميع؛ والأحداث أثبتت ذلك. فالعالم فيه من الفوضى حالياً ما يُعجز أولي القوة والبأس، فما بالك بالذين في غرفة الانعاش، وسوريا بلداً وشعباً بالتأكيد منهم!







