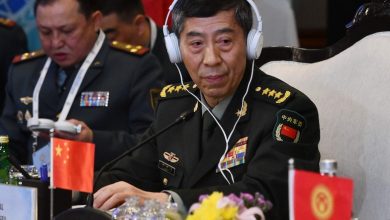ببساطة، ينسى الكثيرون أن الصين شيوعية. ليس هذا مجرد توصيف سياسي، بل إنه تحليل. الصين أولاً، تحت سيطرة حزب لينيني، ذلك الإبداع الأعظم في تاريخ الأنظمة الشمولية. ثمة العديد من سلطويات الحزب الواحد، لكن الحزب اللينيني وحده الذي يدخل في نسيج الدولة والمجتمع، طولاً وعرضاً، وينزرع بكل منظمة، ليبتلع الدولة ويصير هيكل الاقتصاد والمجتمع المدني. بل يمر حتى أصغر المناصب من الثقب الضيق للخلية الحزبية، بما في ذلك بالطبع، في الجامعات. وبذلك يمسك الحزب الشيوعي الصيني بتلابيب مستقبل الحياة الشخصية لكل الأفراد.
والصين ثانياً، دولة أيديولوجية، تعزز المكوّنات العقائدية للماركسية اللينينية، وتدرّسها في المدارس والتجمعات الحزبية والعمالية الخاصة والعامة، وحتى المتاحف بالطبع.
شغلت الصين في القرن التاسع عشر ما يقارب 19% من الدخل القومي العالمي، ولكن بفضل ثورتها انخفض دخلها ليصير 1.5%-2% إبان الثورة الثقافية. وللخروج من هذه البئر العميقة، لم يكن من الممكن إلا القفز نحو الغرب. وكانت المقايضة واضحة.
إثر الحرب العالمية الثانية، ولأول مرة في التاريخ، لم تعد الدول الكبرى قادرة على إدارة حويصلات عولمية متصارعة على الموارد والتجارة (فرنسا، بريطانيا، هولندا، الخ..)، بل أسست الولايات المتحدة في 1954، منظومة كونية في بريتون وودز لعولمة مفتوحة لجميع حلفائها، بضمان قوتها البحرية، مقابل أن تقف هذه الدول معها ضد الشيوعية السوفياتية، وليكون الدولار عملة هذه السوق. لتكون هذه أكبر رشوة تاريخية لجمع الأنصار ضد الشيوعية.
قبلت الصين بهذه المقايضة وقبضت ثمنها وانقلبت.
ولكن كيف لك أن تبني اقتصاداً رأسمالياً في دولة شيوعية. وابتدع دينغ شياوبينغ المخرج اعتقاداً بإمكان الإصلاح الاقتصادي ومن ثم الانتقال نحو التشاركية والانفتاح السياسي. وكانت حيلته لتجنب مسار كارثي، أن قسّم البلاد إلى ساحل رأسمالي تزدهر فيه شراكات مع الغرب، وداخل اشتراكي، فيه أكثر من 75% من السكان، ويزوّد الاقتصاد بقوته العاملة الرخيصة.
أثمرت حيلة دينغ الفصامية أعظم معجزة حضارية في التاريخ البشري على الإطلاق، ليتضاعف مدخول الفرد في الصين مئات المرات على مدى أربعين عاماً، وليدخل مئات ملايين البشر حضارة القرن. وكانت المعجزة محكومة بشرطين: الاندماج في منظومة التجارة العالمية لضمان تدفق رأس المال والمعرفة، والأسواق. والثاني، حل مشكلة الفصام تدريجياً وتنمية الطبقة المتوسطة، والنهوض بالسوق وبالمجتمع كما خطط دينغ.
فما الذي وصلنا إليه الآن؟ بعد ما يزيد على أربعة عقود على المعجزة الصينية الكبرى، أصبح لدى الصين اقتصاد هائل يعتمد على التصدير، وتحسّنت معيشة مئات الملايين، لكن نمت مع هذا الرفاه، جملة من المعضلات الكبرى.
المعضلة الأكبر هي المعضلة الديموغرافية الاجتماعية. فبعد أربعة عقود من سياسة الطفل الواحد، تدخل الصين مرحلة التداعي الديموغرافي، وإذ تعترف الصين بأنها زادت تعدادها عن طريق “الخطأ” بمقدار مئة مليون نسمة، تنحدر كأسرع دولة نحو الأزمة الديموغرافية، حيث وصلت الشيخوخة ونقص الولادات إلى حد كارثي قد يكون غير قابل للارتداد لجهة تعويض القوة العاملة.
الأخطر، أنه إذ يرفع الرئيس شي راية العدالة العزيزة علي قلب الشيوعيين، تتفاقم الآثار الخطيرة للفصام بين الريف الداخلي والمدينة الساحلية، إذ يقيم في المدن 260 مليون مهاجر غير شرعي من الريف. إنهم محرومون من الخدمات الأساسية والتعليم والصحة والتقاعد وتأمين البطالة، لأنهم يفتقرون إلى تصريح (هوكو) للإقامة الحضرية. وفي الريف يشكل أطفال الهوكو 70% من الأطفال حيث هم عرضة لتأخر التعليم والنمو والصحة وسوء التغذية، بعدما غادرهم آباؤهم للعمل في المدن، وهم لن يحصلوا على (الهوكو) الحضري، بل سرح أخيراً الملايين منهم من دون أي حقوق من الدولة الشيوعية.
وكي تصبح الصين من الدول العالية التقنية والنمو، يتطلب الأمر إعادة تأهيل 60% من السكان، الأمر الذي سيستغرق ما لا يقل عن أربعين سنة، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي محتوم. كل ذلك يقف إلى جانب حزم من المشكلات القومية والاجتماعية التي ليس المجال لحصرها هنا.
تلك نبذة بسيطة عن حجم المعضلات التي تشتعل بفضلها حرب خلاسية في الحزب والبيروقراطية بين “المخلصين” و”المحرفين”. بل هي تنعكس ليس علي الخيارات الداخلية، بل الاستراتيجية الدولية أيضاً.
الأهم أنه في محاولة لمجابهة هذه المعضلات، يعزز الحزب تغلغله الحثيث في الشركات الخاصة. فحين تصبح الدولة الشيوعية ثرية، يا سبحان الله، يصبح الشيوعيون أثرياء، وتنتقل بعض ملكياتها إلى جيوبهم لينشأ نموذج هجين لا يمكن أن يستقر أبداً، في صراع بين الشيوعية ونمط جديد من الشمولية اليمينية.
لا تكمن المخاطر في حالة الاضطراب الشديدة في الاقتصاد نتيجة التدابير التدخلية وإعطاء ميزات تفضيلية للشركات العامة، فعلى عكس فترة النهوض الكبرى السابقة، يسود منطق أن استعادة سيطرة الدولة هي الوسيلة لتصعيد التنمية وحل المعضلات. هذا في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية وعالمية ومعقدة.
يتم ذلك في ظل احتمال تزعزع نواة الصفقة التاريخية مع أميركا، إذ تسير الأمور في اتجاه المواجهة، ويتم السعي إلى إضعاف منظومة الدولار، وتفكيك منظومة بريتون-وودز الأميركية. لكن ذلك يفاقم الخطر، فالصين بنت معجزتها على هذه المنظومة بالذات، حيث يشكل التصدير 49% منها، وتزيد حصة الولايات المتحدة عن نصف الصادرات الصينية. فيما لا يشكل التصدير إلى غير المكسيك وكندا، أكثر من 6% من مجمل الدخل الأميركي. فمع أزمة كوفيد وأزمة أوكرانيا وأزمة سلاسل الإنتاج وأزمة الغذاء والانكماش العالمي، تضيق الخيارات بالقيادة الصينية.
الصين بجبروتها الاقتصادي قادرة على حل أزماتها بحق. لكن المشكلة تكمن في حسم الخيارات المؤجلة منذ رحيل الزعيم ماو. ولعل الأخطر هو استمرار التردد أو المضي في سياسات تصعيدية على الصعد الجيو-استراتيجية، أو الداخلية، أو الاقتصادية.
فلئن أفلحت حيلة دينغ في انجاز المعجزة الكبرى، فإنها في نهاية الأمر اشترت الوقت، ليبقى الجمر تحت التراب، ويبقى مأزق الشيوعية ماثلاً، وليبقى شبح غورباتشوف في أحلام اليقظة للشيوعيين الصينيين. فهل تسمح الظروف للصين بأن تتردد طويلاً بين التدحرج نحو النموذج الروسي الأوليغارشي أو التدرج نحو النموذج الياباني. النموذج الشمولي اليميني ليس خطراً على آسيا وحدها، بل قبل كل شيء، على الصين ذاتها.
المصدر: النهار العربي