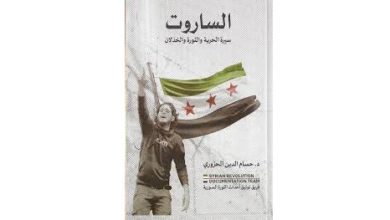باب الجنان أو “باب جنين” كما يلفظه الحلبيون، حيّ تجاري يقع في القلب من مدينة حلب اكتسب اسمه من الباب الذي كان يفضي إلى البساتين الغنّاء المحيطة بالمدينة القديمة والتي كان يمرّ بها نهر قويق وتنتشر فيها الينابيع وأشجار الفستق الحلبيّ.
ما زالت صورة الرجل تملأ رأسي وتحتلّ مقعدها في مسرح ذاكرتي المحتشدة بالصور، لطالما تساءلت عمن يكون ذاك الشيخ الطاعن في العمر والألم، وما سيؤول إليه مصير هذا الكائن الشبحيّ الغريب. أذكره حمّالاً ينقل بضائع التجار بين دكاكين وخانات باب الجنان، لكنّه لم يكن كأيّ حمّال، طريقته الفريدة في نقل البضائع صادمة تبعث على الأسى والأسف، وترسم كثيراً من علامات السؤال والتعجب، فهو يحيط جبهته بسوار معدنيّ مربوطٍ بحبال خشنة إلى مقابض عربة مكونة من قضبان حديدية ذات دواليب عرجاء تالفة، لم يكن يدفع بها كما هي عادة الحمّالين، بل كان يمسك بالحبال ويجرّ العربة بأحمالها المستّفة عليها بيديه النحيلتين وبرأسه المنهكة وباندفاعة صدره وجسده المقوّس للأمام، ثمّ يمضي بها إلى الزبون بحركات اهتزازية عشوائية قافزة تفتقد للثبات والتوازن.
عيناه المضطربتان ناشفتان كلوزتين متيبستين، وقد تضاءلتا كجسده الضامر، تلوبان في محجريهما بارتياب ونزق كبندول ساعةٍ خشبية متشققة، عنقه النعاميّ معروقٌ ومستدق ّيتلوّى يمنة ويسرة مع التفاتات رأسه المضطربة، صدره غائر مكشوف إلى منتصفه إذ لا تكاد الأسمال الحائلة المهترئة تغطي سوى جزء من كتفيه وتلك المساحة الممتدة من أعلى بطنه إلى ركبتيه، مظهره البائس ولون بشرته البرونزي وما تبقى من شعره الأشيب المنفوش وملامحه المغبرّة كل ما سبق يوحي كما لو أنه من منسيّي سكان الكهوف أو أنه خارج لتوّه من المتحف الطبيعي للتاريخ.
لقد أثارت هذه الشخصية أسئلة لا تنتهي في عقول من صادفها أو عرفها، أحدٌ ما لم يجرؤ على استيقافه وسؤاله، فبقي لغزاً محيّراً ومقلقاً نسجت حوله حكايات وأساطير وخرافات تبدأ من افتراضات مبعثها العطف والإشفاق على الفقير المعوز ولا تنتهي بإسباغ صفات الدروشة عليه وبأنّه آثر الزهد على متاع الدنيا الفانية، فهو رجل مبروك من أهل الخطوة يغرف من بحر الحكمة ويسعى لخير الناس ، ثمّة أيضاً من كان يشكك في هيئته الغريبة ويتساءل عن حقيقته وعن طبيعة مهامّه السرّية، من جنّده، وما هي الأهداف من زرعهِ في هذه المنطقة انطلاقاً من إيمان عميق بنظرية المؤامرة وبقدرة أجهزة المخابرات المعادية على الاختراق والتمويه.
لم يبق للصاعد أدراج السماء إلاّ باب أنطاكية وموج البحر. اندثر باب الجنان وغاب باب الفرج، جفّ النهر واختفت البساتين ليحلّ محلها الأسواق والخانات والضجيج، لم تبق إلاّ الروائح المقزّزة لمخلفات باعة الخضار والسمك واللحوم الرخيصة، كذلك اختفى هذا الحمّال اللغز، لم يعد يرى هذا المسكين أو الدرويش أو ربما عميل الموساد والسي آي إي.
الآن فقط وبعد كتابة هذه السطور رأيته، كنت قد نهضت لشربة ماء ولكي أزيل آثار الملح عن وجهي المتعرّق، كان متكوّراً على نفسه في حفرة عميقة من الخزف مثل هيكل عظميّ لجنينٍ في وضعه الرحمي، كومة من عظام تتفتت وترتفع من جرنها، يعلو نثارها الضبابيّ فتدفعه ريح خفيفة إلى المرآة، كيما تتشكل على بللورها المصقول ملامح صورة ما.
أؤكد لكم: رأيته وكان كالمذهول بينهم.. كأني أتمتم بكلمات لا أريد لبشرٍ أن يسمعها، كثيرون هم بياقاتهم المنشّاة ونياشينهم المعمّدة ببرك الدم، متشابهون بسحناتهم الملوّنة وأفواههم الممتلئة بالقيح والبارود، يلتفتون عن الوجع الآدميّ باشمئزاز وقرف، يدورون كحلقة من النار حول لوحة خضراء مؤطرة بزمرّد الحلم.
اكتمل المشهد. من عمق اللوحة نبق وجه مكتمل القسمات، رأيته وأعرفه، إنه أنت، بل أنا وأنت، لا يمكن أن أخطئ بالتعرف إلى صورتنا:
جبهة مرصعة بالقهر، عينان من خزف أحمر، فم جعّدته الصرخات، أخاديد عميقة في الوجنتين، ودم يابس في مجرى الدمع، وجه سوريّ الملامح طاعن في العمر والخيبة والألم.
المصدر: اشراق