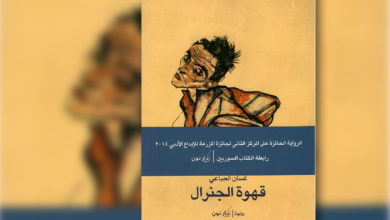تصدّرت فضائح وملفات «إبستين» منذ أوائل عام 2024 واجهة القضايا الكارثية التي عصفت بالمجتمع الأميركي بادئ ذي بدء، قبل أن تتوسّع جغرافيًا هذه الفضائح والانتهاكات القانونية والممارسات الإجرامية التي ترقى، في كثير من الحالات، إلى مستوى استرقاق النساء والفتيات، بما في ذلك القاصرات، والاتجار بهن، بل وحتى التلذذ السادي بتعذيبهن وقتل بعضهن، وإدماجهن في شبكات إغواء لاستهداف نظيرات لهن بغية إيقاعهن في هذا الشرك المخيف والمخزي.
تشكل هذه الوثائق إدانةً صارخة لقيم وآليات وأنظمة النفوذ العالمي اليوم، الذي يتمحور في غالبيته حول الولايات المتحدة، تلك التي صدعت رؤوس العالم بحديثها المتبجح عن «القيم الأميركية» و«نمط الحياة الأميركية» و«الأمة الأميركية»، التي بُنيت أصلًا على جماجم ملايين السكان الأصليين (الهنود الحمر).
تم الإفراج عن وثائق إبستين مطلع عام 2026، وقد كشفت تلك الوثائق عن عطبٍ عميق في البنية الأخلاقية والسياسية لدى أشهر المتنفذين في ماكينة السياسة العالمية، حيث تتحول الثروة إلى حصانة، وتغدو السلطة أداة للقمع الممنهج. وقد ابتكرت العقلية التبريرية الأميركية ما يمكن تسميته بـ«حصحصة العدالة».
إذ نصّت اتفاقية عدم الملاحقة في قضية «جيفري إبستين»، المبرمة في ولاية فلوريدا عام 2008، على الاعتراف بالذنب، وهو ما فعله إبستين بشكل جزئي حين اعترف بجريمتين فقط من بين مئات الجرائم والانتهاكات والقضايا التي أعدّها مكتب التحقيقات الفيدرالي. ونال عقوبة شكلية لم تتجاوز ثلاثة عشر شهرًا في سجن عالي الرفاهية، مع إمكانية قضاء اثنتي عشرة ساعة يوميًا في مكتبه الخاص لإدارة شبكاته وأعماله، فضلًا عن منحه الحصانة لجميع المتآمرين المحتملين، مع الحفاظ على سرية هذه الاتفاقية، في خرقٍ فاضح لمبادئ العدالة والشفافية، إذ حُرم الضحايا من حق الاعتراض.
هذه التسوية بحد ذاتها يمكن تصنيفها كفضيحة العصر. ففي النموذج الأوروبي، استغل إبستين في الحالة الفرنسية «مفهوم الحياة الخاصة»، وفي النموذج الألماني تآكلت سيادة القانون أمام سلطة الثروة، ما أفرز ما يمكن تسميته بـ«العدالة المُخصخصة»، عبر خلق نظام قانوني موازٍ يستند إلى جيوش من المحامين المأجورين.
في أغسطس/آب 2019، وُجد جيفري إبستين منتحرًا شنقًا بملاءة السرير، رغم وجود العديد من المؤشرات التي تعزز فرضية قتله وإسكاته؛ فقد انتهى دوره وأدى وظيفته على أكمل وجه. كما أن توقيت موته، سواء كان انتحارًا أو اغتيالًا، بعث برسالة تهديد واضحة لأشخاص ضالعين في هذه الجرائم.
ولو استعرضنا المشهد البانورامي، لوجدنا ضلوع محورين من أكبر المستفيدين من الشبكات التي كان يديرها إبستين باحترافية عالية، مستخدمًا أجهزة تصوير وتنصت فائقة التقنية تسجل كل فعل وكل كلمة يتفوه بها ضيوفه من علية القوم. هذان المحوران هما: إسرائيل، عبر جهازها الاستخباري «الموساد»، الذي بنى جانبًا كبيرًا من سياسته الدولية على الابتزاز والتحكم بالمتنفذين السياسيين والاقتصاديين من خلال إغرائهم بالمال والجنس؛ وكذلك الأجهزة الروسية التي تحرص على تقويض البنية الأخلاقية والقيمية للمنظومة الغربية، بما يسهّل عليها إعادة ترتيب تموضعاتها الجيوسياسية التي فقدتها عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.
هل ما نُشر وسُرّب من وثائق قضية إبستين، والتي بلغ عددها ملايين الصفحات، هو كامل الحكاية؟ من المستبعد جدًا ذلك في عالمٍ مراوغ، لا تظهر فيه الحقائق إلا بعد انقضاء زمن فاعليتها، حين تصبح مجرد ماضٍ لا يفضي إلا إلى فضح بعض المشاركين، مع إخفاء أو طمس الأهم بينهم. من الواضح أن إبستين لم يكن سوى واجهة لعملية استخبارية واسعة النطاق، نُسجت خيوطها بتقانات عالية التفوق، أوقعت في مصيدة الابتزاز آلاف المتنفذين وقادة الرأي في دول متباعدة. ومع ذلك، يبقى الشك حاضرًا وموازيًا للاعتقاد بصحة ما ورد: هل كل ما تضمّنته تلك التقارير صحيح ودقيق؟ لا يمكن الجزم بذلك إلا عبر تحقيقات واستقصاءات قد تمتد لسنوات طويلة، وهو ما يبدو أنه كان مقصودًا من قِبل ناشري تلك الوثائق، بحيث تختلط الحقيقة بالمزاعم، ويصعب، بل يستحيل أحيانًا، التمييز بينهما، فيبقى الجمهور رهينة للتشويش الذي تديره «الدولة العميقة».
هل سيتمكن قضاء نزيه من محاسبة جميع المتورطين على قدم المساواة؟ يبدو ذلك حلمًا بعيد المنال. وهذا بالضبط ما تلجأ إليه بعض الأنظمة القمعية وزعماء العصابات، كما فعل بشار الأسد، عبر توسيع دائرة المنغمسين في الجريمة إلى حدّ يستحيل معه تطبيق العدالة بالشكل الذي تقتضيه.
هذا التصعيد الإعلامي العالمي يدفعنا للتساؤل: إلى ماذا يهدف هذا الضجيج؟ وهل تُمرَّر، في ظل هذا الانشغال الكوني، صفقات ومؤامرات مشبوهة؟ في الواقع، يبدو أن هذا الحدث، الذي جرى التحضير له منذ زمن غير قريب، يمكن لصانعيه استثماره في اتجاهات متعددة، ليس أولها الابتزاز، ولا آخرها العبث بالانتخابات السياسية، وإعادة رسم خرائط عالم جديد، وإحكام القبضة على رقاب من يمسكون بزمام السلطة والمال، ليغدوا عبيدًا مطيعين بفعل الصور والوثائق التي سُرّب بعضها، وربما صُنّع بعضها الآخر باستخدام تقانات تتجاوز الذكاء الاصطناعي المتاح لعامة الناس.
وهل وثائق إبستين محصورة بالعالم الغربي؟ أليس عالمنا العربي مليئًا، بل متخمًا، بإمبراطوريات الفساد التي تكدس الثروات، وتنهب المقدرات، وتترك شعوبها فريسة للفقر والعوز والأزمات المتلاحقة؟ وهل بات الفساد اليوم محصورًا في رقعة جغرافية واحدة، في عالم نعيش فيه، كبشر، داخل قرية كونية ضيقة إلى حدّ الاختناق؟
لقد لعب الإعلام دورًا بارزًا في تسليط الضوء على هذه الفضائح، وربما لعبت أجهزة استخبارات دورًا خفيًا في نشرها وإتاحتها للإعلام. يصعب الجزم بأي الاحتمالين أرجح، لكن، ومن مختلف الزوايا، يبقى للإعلام دور محوري في تعزيز الشفافية التي يخشاها الفاسدون.
يجدر بنا توصيف وثائق إبستين، وما يشابهها من وثائق وفضائح كُشف عنها أو ما يزال ينتظر الكشف، بوصفها مرثية لعصر الثقة العمياء بالمؤسسات والكيانات السلطوية والمالية. وإن هذا الانكشاف ليس سوى بداية حرب ينبغي أن تكون علنية بين غيلان السلطة والتسليع في أسواق النفوذ العالمي، وبين المدافعين عن استعادة الإنسان وتحريره، والساعين إلى عالم بلا أسرار.
المصدر: تلفزيون سوريا