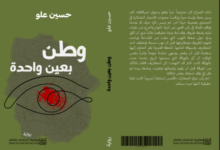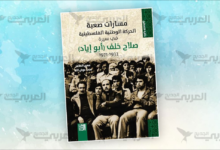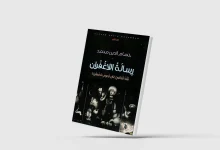في الصفحات الأولى من كتابه المهم “لا مستوطن ولا مواطن: صنع أقليات دائمة وتفكيكها” (نقله إلى العربية عبيدة غضبان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 2023)، كتب الأكاديمي والمفكّر محمود ممداني إهداءً إلى ابنه: “إلى زهران، لقد علمتنا كيف نشتبك بالعالم في أوقات عصيبة. لعلك تلهم بالكثير وتنير المسير”… والأربعاء الماضي، فاز زهران ممداني (34 سنة)، المهاجر المسلم الحاصل على الجنسية الأميركية قبل سبع سنوات فقط، بمنصب عمدة نيويورك، أهم مدن الولايات المتحدة، وإحدى أهم مدن العالم، ما مثّل حدثاً كبيراً في السياسة الأميركية، قارنه بعضهم بفوز باراك أوباما بالرئاسة ليكون أول رئيس أميركي ملوَّن. لا أحد يعلم على وجه اليقين، ما إذا كان ممداني سيلهم بالكثير وينير المسير، كما توقّع والده في كتابه (صدر بالإنكليزية في 2020).
يبدي زهران دعماً واضحاً للأقليات والمهاجرين، ويتحدّى اليمين المتطرّف وجماعات الضغط الرأسمالية، وقد وعد الناخبين بسياسات اجتماعية. ويعتقد كثيرون أن العمدة الشاب الذي سيتسلم مهام منصبه بداية العام المقبل سيكمل طريقه في المسار الذي خطّه لنفسه، بينما يخشى بعضهم أن يبدّل قناعاته، ويخالف تلك المبادئ، تحت ضغوط الواقع السياسي، أو نتيجةً لسطوة الشخصيات الرأسمالية، وفي مقدمتها الرئيس دونالد ترامب، أو حتى طمعاً بالبقاء في السلطة. ولأفكار محمود ممداني تأثير كبير في طريقة تفكير ابنه، عمدة نيويورك الجديد، وخصوصاً أن مُنتَجه الفكري يركّز عموماً على تفكيك الخطاب الاستعماري، ومناقشة نظريات القوميين واليمين المتطرّف، والدعوة إلى إرساء المواطنة الكاملة، والحقوق المتساوية للبشر كافّة.
كتاب محمود ممداني استقصاء عن الحداثة السياسية بشكليها الاستعماري وما بعد الاستعماري
وتشكّل أطروحات ممداني الأب، وخصوصاً في “لا مستوطن ولا مواطن”، الأساس الفكري لمقاربة زهران للعدالة الاجتماعية، إذ تؤثّر رؤية الأب، حول محدودية الليبرالية في معالجة إرث الدولة الاستعمارية، في الابن، فيدفع زهران باليسار إلى ما هو أبعد من مجرّد “سياسة التمثيل”، وصولاً إلى الاهتمامات المادّية الملموسة، مثل تجميد الإيجارات. ويشترك زهران مع والده في التزام قضايا ما بعد الاستعمار والعدالة العالمية، ويتجلّى ذلك في مواقفه المؤيِّدة للقضية الفلسطينية، ووصفه إسرائيل بدولة فصل عنصري، وهو موقفٌ يتوازى مع تحليلات والده في “لا مستوطن ولا مواطن”، الذي يركّز على النموذج الإسرائيلي حالةً مستمرّةً للاستعمار الاستيطاني.
يصف محمود ممداني كتابه بأنه “استقصاء عن الحداثة السياسية بشكليها الاستعماري وما بعد الاستعماري، وبحث في جذور العنف المفرط الذي ابتُليت به المجتمعات ما بعد الاستعمارية”. وهو يدحض افتراض أن القومية سابقةٌ على الاستعمار، مؤكّداً أن الاستعمار والقومية وجهان لعملة واحدة، وأن الدولة القومية تؤدّي، بالضرورة، إلى تشكّل أقليات محكومة ببنية قائمة على سلب الحقوق والحرمان من المواطنة الكاملة. ويقدّم الكتاب قراءةً مغايرةً للتاريخ الاستعماري عبر ربطه بالحداثة السياسية، كذلك يمثّل إطاراً نظرياً لفهم العنف السياسي في المجتمعات المعاصرة استناداً إلى تجارب تاريخية، ويمكن أيضاً اعتباره دعوةً إلى التفكير النقدي في مفاهيم الدولة والوطنية والمواطنة، إذ يطرح أسئلةً جوهريةً بشأن طبيعة العدالة والتاريخ والذاكرة في عالم ما بعد الاستعمار، ويقدّم مساهمةً مهمة في فهم ديناميكيات القوة والهُويَّة في عالمنا المعاصر.
وبينما يشهد العصر الحالي صعوداً للقوميات المتطرّفة، واستمراراً للصراعات الاستعمارية، وتبعاتها، مثل اللجوء، يقدّم الكتاب إطاراً نظرياً وتاريخياً لفهم هذه الظواهر، وللتفكير في بدائل أكثر عدالة وإنسانية تقوم على مواطنة شاملة تتجاوز الهُويَّات العرقية والدينية، في ديمقراطية تشاركية حقيقية.
في الكتاب أيضاً، يرفض محمود ممداني السردية التقليدية التي تحدّد بداية الدولة الحديثة بتوقيع “معاهدة وستفاليا” في عام 1648، التي يُقال إنها أنهت الحروب الدينية في أوروبا، وأرست مبدأي التسامح الديني داخلياً وضمان السيادة المتبادلة خارجياً. بينما يُرجع الكاتب اللحظة المُؤسِّسة للدولة الحديثة إلى 1492، العام الذي شهد ولادة الدولة الأمّة في شبه الجزيرة الأيبيرية، بالتزامن مع بداية عمليات التطهير العرقي للمسلمين واليهود، وشهد كذلك غزو الأميركيَّتَين وبداية عصر الاستعمار الأوروبي. ويؤكّد ممداني (الأب) أن الدولتَين، القومية والاستعمارية، خلق بعضهما بعضاً، وأنهما وجهان لعملة واحدة، وليستا متعاقبتَين تاريخياً كما يفترض بعضهم عادةً، وأنهما بُنيتا بشكل متبادل عبر التاريخ من خلال تسييس أغلبية دينية أو عرقية على حساب أقلية مصنوعة.
كذلك يقدم الكتاب مفهوماً جديداً لوصف الاستراتيجية الاستعمارية الحديثة، “عرّف تسد”، بدلاً من الصيغة الرومانية القديمة “فرّق تسد”. فالإمبراطورية البريطانية دفعت الاستراتيجية خطوة إلى الأمام من خلال التصنيف الاستعماري المُنتِج للعنف، فتعرّف الهُويَّات بشكل جامد، ومن ثمّ استخدامها أدواتٍ للسيطرة. ويشدّد ممداني على أن “الدولة القومية ليست حلّاً للتنوع، بل هي المشكلة، إذ تنتج أغلبيات وأقليات دائمة”. ويؤكّد أن ثنائية المستوطن/ المواطن الأصلي، فئتَين متصارعتَين، بناء سياسي وليست حقيقة طبيعية، وأنها صُنِعتْ لتبرير السيطرة. بينما فكرة الدولة التي تمثّل أمّةً واحدةً متجانسةً عرقياً أو دينياً فكرةٌ خيالية.
ويناقش الكتاب، في فصله الخامس، إسرائيل نموذجاً للعنف الاستعماري الاستيطاني المستمرّ، فبينما ينظر الصهاينة إلى أنفسهم سكّاناً أصليين عائدين، يشكّل اليهود العرب تحدّياً للصهيونية، التي تفترض أن الهُويَّة العربية واليهودية متعارضتان. وينتقد الكتاب “حلّ الدولتَين” لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن “الحكم الاستعماري غير المباشر” هو أصل فكرة “حلّ الدولتَين”، قائلاً: “المشروع الصهيوني استلهم النموذج الأميركي في التعامل مع السكّان الأصليين، فإمّا الإزالة المادّية وإما الإزالة القانونية من خلال إنكار الحقوق السياسية”. وهو يطرح مفهوم “البقاء” بديلاً من تصنيف “المستوطن/ الأصليين”، وهو مفهوم استوحاه من تجربة جنوب أفريقيا.
فيما ترى الباحثة مريم الهاجري أن هناك إشكالاً صريحاً في محاولة ممداني إعادة إنتاج الحلّ في جنوب أفريقيا ضمن السياق الفلسطيني، المنطلق من تجاوز عنف الدولة القومية عبر المساواة بين الجاني والضحية، من دون أيّ محاسبة أو معاقبة. وكتبت الهاجري في تحليلها (“عمران”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد الـ38، نوفمبر/ تشرين الثاني 2021): “رغم فكرة أن القومية التي ولدت، ظاهرةً ومفهوماً، في سياق أوروبي، تقوم في الأساس على العنف، فإن النتائج التي يخلص إليها المؤلّف انطلاقاً من هذه الحجّة إشكالية، خصوصاً أننا نستعملها في سياق دولة استيطانية استعمارية، إذ تشير، عن قصد أو من غير قصد، إلى أن المجتمعات المُستعمَرة لم تكن لديها سلطة أو رأي في تطوير هُويَّتها، وعلاوة على ذلك، فإنه لم يتطرّق إلى أن الجماعات المُستعمَرة استخدمت القومية التي فرضتها عليها الحداثة، وسيلةً للتحرّر والمطالبة بتقرير المصير والسيادة في عالم ينتظم على نحو متزايد حول الدولة القومية”.
يذهب الكتاب إلى أن الدولة القومية ليست حلّاً للتنوع، بل هي المشكلة، إذ تنتج أغلبيات وأقليات دائمة
يناقش ممداني أيضاً فكرة خلق “أقلّيات دائمة”، وأنها ليست مجرّد مجموعاتٍ صغيرة عددياً، بل مجموعات مُنحت هُويَّةً سياسيةً تجعلها دائماً في وضعية الضعف والتهديد، ومُستبعَدة من مفهوم “الأمّة”، ومن أمثلة هذه الأقليات يهود أوروبا، والسود والهنود الحمر في الولايات المتحدة، والمسلمون والهندوس في شبه القارّة الهندية، والعرب في فلسطين مثالاً معاصراً صارخاً على تحوّل الفلسطينيين “أصليين” محرومين من الحقوق، وتحوّل اليهود “مستوطنين” يحظون بالحقوق كلّها.
ويشرح كيف أن الدولة القومية الحديثة تعمل، في أحيانٍ كثيرة، “دولة مستوطنين” بالنسبة إلى بعض سكّانها، و”دولةً أمّةً” بالنسبة إلى الآخرين الذين تحرمهم من الحقوق. ويشدّد على أن هذا التناقض مصدر العنف المستمرّ. ويضرب مثالاً الحالة السودانية، وكيف أن سياسات الحكم غير المباشر البريطانية عمّقت الفجوة بين العرب في الشمال، والأفارقة في الجنوب، ما أدّى إلى حروبٍ أهلية طويلة، ثمّ انفصال جنوب السودان. ويرى أن المواطنة المتساوية هي البديل لتحويل الجميع مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات تحت مظلّة دولة مدنية واحدة. ويقول: “المشكلة ليست في وجود أناس من خلفيات مختلفة في أرض واحدة، بل في تحويل هذا الاختلاف إلى أساس للتمييز السياسي والحرمان من الحقوق”.
المصدر: العربي الجديد