
تعالت الأصوات في المغرب، أخيراً، للتحذير من نهاية بائسة للسياسة. وتعدّدت توصيفات الساسة والباحثين هذا الحال، وفي بيانات مراكز التفكير، وجزء مهم من الطبقة المثقّفة. وإذا كان السياق الحالي يبعث على ذلك باعتبار أنه يساير دعوة العاهل المغربي، محمد السادس، من أجل النظر في المنظومة الانتخابية الحالية، فإن الشعور بأن السياسة في البلاد تتدحرج نحو الأسفل، حتى على لسان الأكثر تفاؤلاً وفي أوساط المثقّفين صنّاع الرأي العام، وضمن المفكّرين الدستوريين والديمقراطيين من الذين ساهموا في كتابة وثيقة الدستور الجديد، المنبثق عن فورة “الربيع المغربي” قبل 14 سنة. وقد استأثر عبد الله ساعف باهتمام كبير في أوساط النشطاء السياسيين لما عبّر عنه من آراء صادمة. وهو شخصية تؤخذ آراؤها بكلّ جدية، باعتباره مناضلاً يسارياً واضحاً، وأحد الساسة الذين يحظون بالاحترام، ووزير سابق، وكان أحد الذين كتبوا وثيقة الدستور في الجانب المتعلّق بالسياسة مجال الحكامة.
وقد استيقظ جزءٌ من الفاعلين على صيحته في نهاية الأسبوع، أن السياسية تتدنّى إلى أسفل درجاتها في “ترتيب الجدّية” في المغرب، وأن البلاد تعيش بالحدّ الأدنى منها. وأن زواج المال والسلطة فتح شهية جديدة لقضم الديمقراطية في الحكامة… وما إلى ذلك من آراء تُتداول باهتمام. وفي الوقت نفسه، يتحدّث المدافعون عن مزيد من الديمقراطية والشفافية والمحاسبة عن دورة سياسية جديدة، وإن لم نقل عن “نموذج سياسي جديد”، يقطع مع عثرات ما تراكم منذ التصويت على المسار الدستوري الجديد. والذي لم يلقَ بعد التطبيق المتوخّى في إصلاح الأعصاب الوطنية. وما يحيل على خلفية مضمرة في الشعور الجماعي بأن الرهان السياسي يتضاءل في الفضاء العمومي، وأحد تمظهراته انصراف الرأي العام عن النقاشات الدائرة في الرقعة السياسية، بالرغم من أهمية دعوة الملك إلى مناقشة المنظومة الانتخابية، التي من نتائجها أنها “تختار” للملك الشخصية السياسية التي ستشاركه السلطة وتنفيذ الدستور وإدارة جزءٍ مهمٍّ من مؤسّسات الدولة وأذرعها.
الطعن السياسي في الانتخابات يكاد يكون لازمةً تطارد التعددية المغربية الناشئة
ومن دون التوقّف مطوّلاً عند تفاصيل كل واحدةٍ من مراحل المغرب الحديث، يمكن أن نُسطّر على أهمية الرهانات السياسية للانتخابات، في بلادٍ كانت التمثيلية فيها تخضع لنوعٍ من التعيين الذي يقوم به القصر بناء على تمثلات سوسيومهنية متنوّعة (قبيلة، زاوية، تجّار، فلاحون، شرفاء، قضاء، رجال دين… إلخ)، ونسطّر على أهمية الانتخابات في بناء الشرعية الديمقراطية للنظام السياسي، النابعة من تعاقد بين الحركة الوطنية والملكية على قاعدة معركة الاستقلال (في الأربعينيّات) أو على قاعدة استكمال الوحدة الترابية (سبعينيّات القرن الماضي واسترجاع الصحراء)، وما تفرَّع منه من مواقف وتوقّعات سياسية، همّت بالأساس الصراع على طبيعة الدولة التي يجب بناؤها بعد الاستقلال ودور المشاركة الشعبية فيها.
وبهذا المعنى، شكّلت الانتخابات دوماً لحظة صراع حادّ، حتى أن القوى المنبثقة عن الحركة الوطنية سمّتها “المعركة” عوض الموعد الديمقراطي العادي. وهو صراعٌ لم يكن يدور فقط بين الدولة والحركات السياسية (سيّما المعارضة منها ممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحزب الشيوعي المغربي، وحزب التقدّم والاشتراكية حالياً)، بل دار أيضاً بين فصائل المعارضة نفسها داخل المدرسة السياسية الواحدة، كما حصل في أوساط القوى التقدّمية مثلاً، ما تولد منه يسار راديكالي يتوخّى العنف في التغيير، وقوى الإسلام الحزبي لاحقاً. وقد استأثرت القضية بالنقاش الأيديولوجي والسياسي ذي الصلة بشرعية النظام من عدمها، وفيه استنفدت قوى اليسار والإسلام الحزبي مثلاً جزءاً من عمرهما في النقاش بشأن المشاركة من عدمها. وكان الداعون إلى المقاطعة يعلّلون مواقفهم بأن الانتخابات تعطي للنظام شرعية هو ليس أهلاً لها!
في الموازاة، جرت استحقاقات سياسية مُتعبة وصعبة، تميّزت إدارة الدولة لها بالتدخّل المباشر، والتزوير العملي لنتائج الاقتراع، وإقامة الأحزاب باعتبارها امتداداً للإدارة في معالجة الصراع، ومن ذلك إنشاء حزب التجمّع الوطني للأحرار، التي ترأّسه صهر الملك، أحمد عصمان، في منتصف السبعينيّات، كما ولدت أحزاب من بعد في الثمانينيّات من قبيل حزب الاتحاد الدستوري، الذي تزعّمه قيادي سابق في المعارضة الراحل المعطي بوعبيد. وتناسلت الأحزاب التي نعتتها المعارضة بالأحزاب الإدارية، وهو نعتٌ قدحيٌّ للقول إنها تولد في مختبرات الدولة، وتتلقّى الدعم الكامل منها، بما في ذلك استجلاب المرشحّين ومن يتقدّمون باسمها، وقد تجاوز عددها 30 حزباً.
ويمكن القول إن إجراء الانتخابات في هاته المراحل اقتضى إنشاء أحزاب في كل موعد انتخابي يسبق تشكيل الحكومة. وطوال هذا المسار المعقّد والمتشابك، كان الطعن السياسي في الانتخابات يكاد يكون لازمةً تطارد التعدّدية المغربية الناشئة الطامحة إلى تأسيس ديمقراطيةٍ مقبولةٍ من الجميع. ولم يتم تجاوز هذه المعضلة، إلا بعد الترتيبات السياسية لمجيء المعارضة إلى الحكم أو المشاركة فيها عن طريق حكومة التناوب التوافقي (المبني على توافق بين الملك الراحل الحسن الثاني والمعارضة سيّما الاشتراكية، ممثلة في عبد الرحمن اليوسفي)، من دون الاحتكام الكلّي لحكم صناديق الاقتراع.
وكان رهان انتخابات 1997المعنية بهذا الترتيب، وقتها إيجاد عتبة لتوافق سياسي لإخراج المغرب من السكتة القلبية التي كانت تتهدّده، باعتراف الملك الراحل نفسه، ما أعطى لها رهاناً جوهرياً، يقوم على إخراج البلاد من خطر السكتة، ويهيئ الظروف لانتقال الحكم إلى الملك محمّد السادس.
وكانت أولى انتخابات في العهد الجديد (2002) لحظة حاسمةً في ضرورة إصلاح سياسي يدور حول الانتخابات بالذات، فقد كانت نتائجها لصالح الحزب الذي يقود التناوب التوافقي بزعامة الفقيد اليوسفي (الاتحاد الاشتراكي)، ولكن الترتيب السياسي المستند على حقّ دستوري للملك، بمقتضي دستور1996 المصادق عليه بالإجماع للمرّة الأولى في تاريخ الدستورانية المغربية منذ الاستقلال، ذهب الى إسناد مسؤولية الحكومة لرجل تكنوقراطي من خارج التنافس السياسي الانتخابي، هو إدريس جطّو. وعليه، أصدر الحزب الذي ضاعت منه شرعية صناديق الاقتراع بلاغاً (بياناً) أصبح تاريخياً، كتبه الشاعر والروائي محمد الأشعري، يعلن رفضه “الخروج عن المنهجية الديمقراطية” في تعيين الوزير الأول. وهو المصطلح الذي لخّص وقتها معضلة الدستور في علاقته بالفعل السياسي الشعبي. وذهبت تحاليل كثيرة إلى القول بموت السياسة بهذا التعيين، وترتّب من ذلك لحظة نفور انتخابي كبيرة، تبين أثرها داخل البلاد. وارتفعت الدعوات إلى تجاوز لحظة العجز الديمقراطي الذي دخلته البلاد، وما مسّ جدوى الاستحقاق الانتخابي.
وبالرغم من تراكم التطوّرات الإصلاحية الكبرى في البلاد، ظلّت تنتظر لحظة تقويم هذا العجز، وحدث ذلك في دستور 1102، الذي تزامن مع الفصل المغربي من “الربيع العربي”. ومنذئذ، اتخذت الانتخابات طابع الرهان السياسي المركزي في الحياة الوطنية. بل كان الدستور عربوناً لحدوث قطيعةٍ في دلالة الانتخابات، نظراً إلى “الإكراهَيْن” اللذين فرضهما: إكراه يقوم على احترام المنهجية الديمقراطية من الملك وضرورة الامتثال لها، وإكراه يخصّ الطبقة السياسية التي لم يعد بإمكانها الوصول إلى فضاء السلطة ومواردها إلا عبر الانتخابات.
ومن الرهانات الكبرى للانتخابات المنظّمة تحت مظلته، كان الرهان السياسي المرافق لها يتمثل في استيعاب الإسلام الحزبي ممثلاً في حزب العدالة والتنمية، وتسيير تطبيعه داخل حقل سياسي ظلّ محكوماً بثنائية تاريخية (أحزاب الحركة الوطنية تمثّل المجتمع وأحزاب الإدارة تمثّل الدولة وهي أدواتها في الصراع وضبط الحقل السياسي). هذا العنصر الذي جاءت به موجات “الربيع” واحداً من أشكال التعبير المجتمعي، أصبح التعامل معه مطروحاً على أجندة النخب وأجندة الدولة بشكل مباشر في سياسي توتري عارم.
وانبنَت معادلاتٌ كثيرة حول وجوده إمّا بالصراع أو بالتوافق. وظلّ رهانه حاضراً خلال دورتَين انتخابيتين ( 2011 و2016)، ومع سقوط ممثله حزب العدالة والتنمية في 2021، تغيّرت معطيات الرهان السياسي للانتخاب. ولعلّ المتتبع، وكذا الفاعل الحزبي الملتزم، يطرح سؤال الرهان السياسي للانتخابات الذي أعطى الملك انطلاقة التحضير لها في خطاب العرش أخيراً، عندما طلب من وزارة الداخلية فتح مشاورات سياسية موسّعة مع المعنيين بالاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
وقد وقف كثيرون عند تغيير العرف المعتمد في مثل هاته الأوضاع عبر تعيين وزير الداخلية بمهمة سياسية في جوهرها، سيّما أن الطبقة السياسية اعتادت إسناد الإشراف إلى رئيس الحكومة (عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني في وقت سابق، إذا اقتصرنا على آخر استحقاقيْن). ولم يصدُر أي موقف من الحزب الذي رأس الحكومة للدفاع عن “المنهجية الدستورية”، مثلاً في الحفاظ على هذا العرف السياسي، كما لم تعلّق الأحزاب السياسية على القرار، وانخرطت في المشاورات.
ويختلف سقف الانتظارات والمطالب بين الإصلاح التقني للانتخابات وسقف التغيير الجوهري في وظيفتها وطريقة تنظميها. كما يختلف النقاش حول مصداقيّتها، ونجاعتها، في غياب رهانات سياسية واضحة، مثلما جاء أعلاه. تجاوز الطعن الأخلاقي الذي أشهره الفاعلون السياسيون، ومنهم حزب المعارضة الأول، الاتحاد الاشتراكي، نظراً إلى ما تم تسجيله من حالات فساد انتخابي فاقت الأوضاع السابقة، وأدّت إلى اعتقالات واسعة وسط المنتخبين، ونظراً إلى حضور المال الفاسد فيها، والاتهامات التي طاولت بعض رجال السلطة في ترتيب النتائج. أمّا الخوف من ديمقراطية الأثرياء وزواج السلطة والمال بطريقةٍ لا يطاولها القانون، فأصبح يهدّد الديمقراطية نفسها، وضمور الوازع المبدئي والفكري والسياسي في تحريك منافساتها، يهدّد بقتل الأحزاب نفسها وتفويض تسيير التعدّدية لأصحاب المال (أصحاب الشكارة عند المغاربة)، وبلغة السؤال: هل ستقبل الأحزاب بقتل نفسها من أجل مقاعد تحصل عليها بلاعبين لا يربطها بهم أي رابط سياسي أو فكري أو مشروع مجتمعي أو تعاطف أخلاقي؟
أحد رهانات النقاش السياسي اليوم إعطاء الانطلاقة لدورة سياسية جديدة، تجاري الأفق المغربي للسنوات المقبلة
هناك نفور وعزوف كبير، فقد أصبح من الصعب، إِنْ لم نقل من المتعب جدّاً، إعادة ربط الالتزام السياسي بالعملية الانتخابية. وإذا كان من البديهي في الذهنية العامة أن الفصل بينهما في بلاد عرفت أزيد من 12 اقتراعاً انتخابياً، وستين سنة من التعدّدية والانتخابات، أمر مستغرب، فإن واقع الأمر يظهر جلياً أن هناك قطيعة بين الوعي (ومن ثمّة الفعل السياسي) وصيغته الانتخابية أو الانتخابات صيغةً لممارسة الالتزام السياسي، هاته القطيعة متعدّدة الوجوه وعميقة ومقلقة. وهناك فصل بين المواطن والناخب، هناك يد للداخلية فيها لوضع مسافة بين المواطن، الذي هو كائنٌ سياسي بالقوة قبل الفعل، والمواطن السياسي بالقوة والفعل: عدم اعتماد بطاقة التعريف الوطني، التي تثبت المواطنة كاملة في التصويت الأوتوماتيكي. وهو دعم للفتور أو النفور الانتخابي بالرغم من سقوط مبرّرات عدم تعميمها في التراب الوطني. ولعل أبرز عنصر تواجهه النخب، دولةً ومجتمعاً، هو العزوف الكبير عن ممارسة هذا الحقّ السياسي المتوافق عليه دولياً.
ما سبق ذكره، وإن كان محدوداً يعيد طرح تفسير الدور المركزي للانتخابات في الحياة السياسية، وفي التعبير عن السيادة الوطنية (وليس الشعبية فقط). كما أنه يسلّط الضوء على أن أزمة النظام الحزبي مرتبطة باختلالات التمثيل الانتخابي، وهو يعاني كثيراً، حتى أن الأحزاب نفسها صارت تطالب بـ”كاستينغ” لائق ومقنع، ونخبة في المستوى. ولعلّ النفور الشبابي بالخصوص صار يتهدد اللعبة برمتها، بديمقراطية من دون مستقبل ديموغرافي مضمون.
وإذا سلّمنا بأن التمثيلية الديمقراطية، والحرص على جودتها، يفرض على السلطة أن “تفكّر نفسها”، فقد صار من الملحّ أن تدفع باتجاه منظومة انتخابية نهائية وقارّة، لا يمكن أن تتغيّر مع كل موعد انتخابي، فلن تُوفّر شروط النضج الديموقراطي من دون قواعد لعب قارّة، والمغرب قد قضي 60 عاماً من الانتخابات، وفي كل انتخابٍ يغيّر قواعد اللعب والتنافس الانتخابي، على عكس ما يتم في كل الديمقراطيات المتعارف عليها.
ولعلّ أحد رهانات النقاش السياسي اليوم هو بالفعل إعطاء الانطلاقة لدورة سياسية جديدة، تستطيع مجاراة الأفق المغربي للسنوات الست المقبلة برهاناتها: خمسون سنة من النزاع حول الصحراء والمونديال 2030 وتقييم حصيلة النموذج التنموي الجديد بأفقه المتزامن مع تاريخ المونديال، من دون الحديث عن طموحات المغرب في التموقعات الخارجية التي لها ارتباطٌ جدليٌّ قويٌّ بالأوضاع الداخلية.
المصدر: العربي الجديد







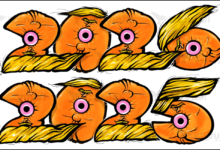
هل تشهد المملكة المغربية نهاية شهر عسل الديمقراطية الذي بدأ من الربيع العربي ، الطعن السياسي في الانتخابات ليكون لازمةً تطارد التعددية المغربية الناشئة ، ما دور التدخل الصهيوني بالشأن السياسي والإقتصادي والعسكري المغربي بنهاية الديمقراطية ونشوء شريحة الموالاة وتغيير قواعد العملية والتنافس الانتخابي، بعكس كل الديمقراطيات المتعارف عليها.