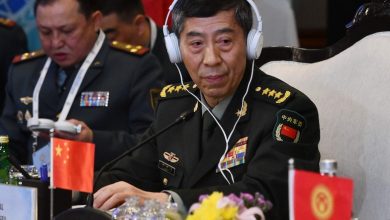في عرض مهيب نُظم في الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحرير البلاد من الاستعمار الياباني، قدّمت الصين احتفالاً عسكرياً خطف أنطار العالم، بحضور زعماء دول حليفة، مثل بوتين روسيا، وكيم يونغ أون الكوري الشمالي، ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي، إلى جانب مسؤولين كبار من مختلف الدول ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو). فبالرغم من أهمية الحضور السياسي المشارك في العرض، كانت الرسالة العسكرية أكبر أهمية، لكونها أظهرت مدى ما وصلت إليه الصناعة العسكرية الصينية: كشف النقاب عن أحدث التقنيات الصاروخية القادرة على حمل الرؤوس النووية المعروفة بـDF41؛ أنظمة صواريخ ليزر قادرة على إسقاط الأقمار الصناعية وأسراب الطائرات المسيّرة؛ وصواريخ أخرى ضد حاملات الطائرات. وتلقى الرئيس الصيني شي جين بينغ تحية عسكرية من وحدات جيش التحرير الشعبي الموجودة في ميدان تنيمان، مخاطباً إياهم عبر مكبرات الصوت المركّبة على سيارة مكشوفة الغطاء. وقال في خطابه: “العالم يجب أن يختار ما بين السلام والحرب”، وندّد بعقلية الحرب البارة، والتكتلات المتواجهة، والممارسات التنمرية، وأردف: “فقط عندما تعامل جميع بلدان العالم بعضها بعضاً بالمساواة، وتتعايش بالسلام، وتدعم بعضها بعضاً، حينها يمكن الحفاظ على الأمن المشترك، والقضاء على الأسباب الجذرية للحرب”.
شاع أخيراً استخدام مصطلح “فخ ثيوسددس”، حيث صار سلعة رائجة في التحليلات السياسية الخارجية
تختلف آراء المحللين والمراقبين تجاه القوة الحقيقية لجيش التحرير الصيني، ومدى جاهزيته لخوض معركة حقيقية تتجاوز الحروب المماحكة، لأن آخر معركة خاضها كانت قبل 50 سنة، بينما يرى آخرون أن العروض العسكرية ليس القصد منها إظهار الترسانة الفعلية لبلد ما، بقدر ما هي إبهار العدو، وردعه نفسياً. من جهة، لدى الجنرال مايك هارتلينغ رأي مخالف لبعض محللي السياسات الدفاعية حول قدرات الجيش الصيني، محذراً من الوقوع في الوهم الذاتي، ومنوهاً في الوقت نفسه بأن ما خفي لدى الصين أعظم مما تبرزه في العروض المنظمة بين الفينة والأخرى، ويؤكد أنه عندما زار الصين في عام 1998 طالباً في الكلية الحربية مع وفد من العسكريين والدبلوماسيين بعثتهم الكلية، كانت أمنيته آنذاك أن يكون ضمن الوفد الذاهب إلى الصين ليقف على التقدّم الذي وصل إليه الجيش الصيني. وذكر أنه تلقى إحاطة من طلاب الكلية الحربية عن الخطط التحديثية للجيش. قال: “في مساء هذه الليلة كنا نشرب البيرة في حانة فندقنا، وكل واحد منا، الأميركيين، كانت لديه الفكرة نفسها: أهدافهم كانت طموحة جداً، ولكن لن يتمكّنوا من تحقيقها في أسرع وقت”.
ومن جهة أخرى، يقر جنرال هارتلينغ بأن حكمهم لم يكن صائباً، بدليل أن العقدين الأخيرين شهدا تطوّراً وتحديثاً ملموسين في القدرات العسكرية، وتحقيقاً للهدف والخطط الموضوعة، ما فاق توقعات المحلّلين والخبراء العسكريين. ويذكر هارتلينغ أن الصين لم يكن لديها أي حاملة طائرات في 1998، في حين أنها قطعت شوطاً كبيراً في سعيها إلى غلق الهوة بينها وبين الولايات المتحدة بشأن هذه القطع البحرية. ويعزي هذا إلى الميزانية المهولة التي خصصتها الصين من أجل تعزيز القدرات العسكرية لجيشها الذي يعد أكبر جيش في العالم من حيث عدد الأفراد في الخدمة الفعلية. ويقدّر حجم الميزانية العسكرية للصين بحوالي 250 بليون دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة عالمياً. وعلى النقيض من ذلك، تفيد تقديرات أخرى بأن الحجم الفعلي للميزانية العسكرية الصينية تجاوز 700 بليون دولار، متساوية مع الميزانية العسكرية للجيش الأميركي.
المرجّح أن العالم مقبل على فترة بالغة الخطورة، بسبب الاصطفاف والتكتلات الناشئة، والتباين الحاد في الرؤى
قبل هذه الاحتفالية المهيبة، اختتمت أعمال قمّة منظمة تعاون شنغهاي في مدينة تيانجين الساحلية، حيث اجتمع فيها رؤساء عدة دول لتباحث قضايا ذات أهمية اقتصادية لدول العالم الجنوبي، وكشف النقاب في هذه القمة عن مبادرة جديدة سمّيت “مبادرة الحوكمة العالمية”، وتعتبر عموداً من خطة عريضة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، وجعله أكثر ديمقراطية. وذكر وونج يأوي، مدير معهد الشؤون الدولية التابع لجامعة رنمين في بكين: “لا تركّز مبادرة الحوكمة على الأمن وحده وإنما تشتمل على الجانب المالي، مثل نظام السويفت، والعقوبات، والتجارة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وحوكمة المحيطات، وتغير المناخ العالمي… كما نحتاج أن يكون للعالم الجنوبي كلمة في الأمم المتحدة”.
والنظام المالي العالمي القائم حالياً شكّلته الدول الغربية المنتصرة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية في الاتفاقية المعروفة “ببرتن ووذز”، في أعالي ولاية نيويورك، وصارت المؤسّسات المنبثقة عن هذه المعاهد (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، اتفاقية التجارة العامة) أداة في أيدي الغرب لصناعة نطام مالي مرتبط بالدولار الأميركي، وتبعية اقتصادية على منهج النظام الاقتصادي الكولونيالي، وخنق كل من تسول له نفسه الخروج من هذه الخطة المرسومة، عن طريق فرض عقوبات مدمرة، أو الانقلاب على النظام الحاكم. ويرى المراقبون أن مبادرة شي تعنى باستقطاب الدول التي تشعر بالضغط من نظام دولي، يرونه مهيمناً بشكل غير عادل من الغرب، ومساندة الصين في تبديد قوة الولايات المتحدة بعدة محاور، عبر إشراك هذا المسعى بدول صديقة للصين.
كان الهدف من تنظيم الحدثين التؤامين، قمّة منظمة شنغهاي والعرض العسكري، إرسال رسالة قوية مفادها: بينما تبني الصين قوتها الناعمة عبر تحشيد الدول النامية والممتعضة من النظام القائم على الهيمنة الغربية، فإنها أيضاً تمدّد عضلاتها العسكرية لدعم هذا النظام الناشئ إذا اقتضت الضرورة. ترجم هذان الحدثان في منظار الدول الغربية بأنهما تحدٍّ صارخ تجاه الغرب عامة، والولايات المتحدة بصفة خاصة، ووصل بهم الحال إلى إبداء ردات فعل متباينة، لا تخلو من نبرات تهديدية، موجهة إلى بعض الدول المحسوبة ضمن الفلك الغربي مثل الهند، وزعم الاقتصادي النمساوي، غونثر فهلنفر جان، المقرّب من دوائر صنع القرار في حلف الناتو، بتغريدة في حسابه على منصة إكس، أنه يجب تقسيم الهند إلى عدة دويلات، وضرورة دعم دولة خالستان (من مطالب حركة السيخ المناهضة للهند)، ما دفع السلطات الهندية إلى حظر الولوج إلى حسابه داخل الهند، كما أثار كلامه زوبعة في الوسط الإعلامي الهندي.
إلى جانب ذلك، وقّع الرئيس الأميركي، ترامب، مرسوماً تنفيذياً بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، مما يعني أن المرحلة المقبلة تنذر بصدام محتمل بين القوة السائدة والقوة الصاعدة. وقال ترامب خلال مراسم توقيع المرسوم التنفيذي إن الولايات تعد أقوى دولة، وليس من دولة أخرى تقترب منها من حيث بناء الصناعات الدفاعية والآليات العسكرية الحديثة المتوفرة لجيشها. وعندما سئل عن العرض العسكري الصيني قال: “شاهدت العرض، وكان جميلاً جداً تنظيماً وعرضاً وأداء، والغرض منه كان أن أشاهده… وكان على الرئيس شي الاعتراف بدور أميركا، لأنها ساعدت في تحرير الصين، كما ساهمت في نهضتها الاقتصادية”.
تفيد تقديرات بأن الحجم الفعلي للميزانية العسكرية الصينية تجاوز 700 بليون دولار، متساوية مع الميزانية العسكرية للجيش الأميركي
وقد شاع أخيراً استخدام مصطلح “فخ ثيوسددس”، حيث صار سلعة رائجة في التحليلات السياسية الخارجية، وصاغه السون غراهام، عالم السياسة بجامعة هارفارد، لأول مرة في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز عام 2012، ثم طوّره لاحقاً في كتابه الصادر عام 2017 “مصير الحرب Destined for war”. وتشير العبارة إلى جملة للمؤرخ اليوناني القديم ثيوسيديدس، وكتب في كتابه “تاريخ الحروب البيلوبونسية”: “كان صعود أثينا والخوف الذي بثه ذلك في أسبارطة هو ما جعل الحرب حتمية”. وهذه الحتمية هي ما جعلت محللي السياسة الخارجية يطرحون السؤال الصعب، ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين تتفاديان الوقوع في هذا الفخ، كما لم تنج أثينا وإسبارطة، والمملكة المتحدة وألمانيا في الحرب العالمية الأولى قبل قرن. وفي معظم حالات التنافس، انتهت النتيجة بدمار الدولتين، وهذا ما توصلت إليه دراسة تحليلية لسجلات التاريخ، أجراها فريق بحثي تابع لألسون غراهام في مركز بلفر، خلاصتها “أن 12 من أصل 16 حالة على مدى خمسمائة سنة كانت النتيجة حرباً، وأن الحالات التي حصل فيها التجنّب من مصادمة حربية كانت تتطلب تعديلات هائلة ومؤلمة من المواقف والسلوك، ليس فقط من القوة السائدة، بل أيضاً من القوة الصاعدة”.
ولكن شيوع المصطلح، وسوء استخدامه، جعلاه شبه قانون في السياسة الدولية: عندما تبرز قوة في الساحة، يتملّك الخوف على عقلية الدولة المهيمنة، فتندلع شرارة الحرب. حتى إلسون نفسه لم يزعم حتمية الحرب، وإنما تحدّث عن احتماليتها عند تنافس قوتين كبيرتين في مسرح العالم. وفوق هذا كله، لا يمكن اعتبار دراسة ثيوسيديدس، الذي حارب في الحرب البيلوبونيسة، إلى جانب أثينا، حجّة على حتمية الحرب، بل محاولة لفهم طبيعة الإنسان المتصفة بالضعف، وسوء التقدير السياسي، والانحطاط الأخلاقي، الذي يورد إلى مورد الهلاك.
الخلاصة، يقلق صعود قوة الصين الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، القوة العظمى المتربعة على عرش قيادة العالم، كما بدا جلياً في ردات الفعل تجاه العرض العسكري، وانعقاد قمّة منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي في تيانجين. ولكن السؤال المطروح هل هذان، العرض العسكري والقمة، كافيان لإعلان تغيير النظام العالمي واستبداله بنظام آخر تقوده الصين؟ من السابق لأوانه الجزم بهذا الحكم، لأنه ليس من الهين أن تزاح قوة جيو- استراتيجية، مثل الولايات المتحدة من قيادة العالم، من دون أن يحدث هذا بسبب أمر جلل يغيّر من موازين القوة في العالم. ولكن المرجّح أن العالم مقبل على فترة بالغة الخطورة، بسبب الاصطفاف والتكتلات الناشئة، والتباين الحاد في الرؤى، بشأن إصلاح بعض المنظّمات الدولية، والامتعاض المتزايد تجاه النظام العالمي المهيمن عليه من الغرب، وأن كل ما يحتاجه كي يحدث الصدام أو المواجهة بين قوتين عظميين حماقة السياسيين وتهورهم أو حدث عابر، كحادثة اغتيال وريث الإمبراطورية الأسترية-الهنغارية، الأمير فرنز فرديناند عام 1914، التي فجرت الحرب العالمية الأولى، وأدَّت إلى بروز نجم قوة عالمية جديدة وأفول نجم قوة أخرى.
المصدر: العربي الجديد