
ارتبط الكيان الصهيوني، نشأة وتطوّرا، بالقوى الغربية المهيمنة على النظام الدولي. ولأن بريطانيا كانت تتولى قيادة النظام الدولي، حين ظهرت الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر، كان من الطبيعي أن تلعب الدور الأهم في المرحلة التأسيسية للمشروع الصهيوني، وهو ما اتضح بجلاء حين اصدرت وعد بلفورعام 1917، ثم حين أصرّت على أن تصبح الدولة المنتدبة على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى التي انتهت بانهيار الإمبراطورية العثمانية. وحين بدأ الدور البريطاني في النظام العالمي يتراجع بعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت مهمّة رعاية المشروع الصهيوني إلى الولايات المتحدة، وهو ما ظهر بوضوح إبّان مناقشة المسألة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، ثم بصورة أوضح منذ حرب 1967. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى مسألة هامة، أن جميع القوى الفاعلة في النظام الدولي ثنائي القطبية، بما فيها الاتحاد السوفييتي نفسه، ظلّت، في مجملها، متعاطفةً مع المشروع الصهيوني في مراحل تطوّره الأولى، لأسبابٍ كثيرة، ربما كان أهمها المحرقة التي تعرّض لها اليهود في ظل الحكم النازي.
يرى كثيرون أن الكيان الصهيوني مجرّد أداة في يد القوى التي أوجدته، ما يعني عدم تمتّعه بأي قدر من الاستقلالية التي تتيح له هامشا ولو ضئيلاً للحركة خارج حدود الدور “الوظيفي” المرسوم له، غير أن هذه الرؤية ليست دقيقة تماماً، رغم استنادها إلى شواهد تضفي عليها قدراً كبيراً من المصداقية، فالسياسة الخارجية للكيان ظلت، ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسه، محكومةً بعاملين رئيسيين: الأول، إحساس طاغ بأنه يواجه تهديداً وجودياً يدفعه إلى الاعتماد على قواه وقدراته الذاتية، بصرف النظر عن طبيعة (وعمق) تحالفاته مع القوى الدولية التي أوجدته. الثاني: حاجة ملحّة للتوسّع خارج الحدود المعترف بها دوليا، من منطلق إيمانه الراسخ بأنه ما زال مشروعا في طور التكوين لم يصل إلى غاياته النهائية بعد، تحتّم عليه أن يسعى، بشكل دائم، إلى ضبط إيقاع طموحاته الخارجية مع مصالح القوى العالمية الداعمة له. ولأن قصة الكيان الصهيوني مع السلاح النووي تلقي أضواء ساطعة على شكل (وطبيعة) العلاقة التي تربطه بالقوى المهيمنة على النظام الدولي، فربما من المفيد أن يُشار هنا إلى بعض أبعادها المثيرة.
لم يُعرف عن رئيس الوزراء المؤسس، بن غوريون، انشغاله بقضيةٍ تعادل حرصه على امتلاك الكيان السلاح النووي في أسرع وقت ممكن. صحيحٌ أنه خرج منتصراً من حربه الأولى مع الدول العربية المجاورة (1948 – 1949)، بل وتمكّن خلالها من توسيع مساحته الأصلية بأكثر من 50%، إلا أنه خرج منها مقتنعاً بأن الكيان يواجه تهديداً وجودياً لا سبيل للتغلب عليه إلا بامتلاك السلاح النووي، ما يفسّر حرصه على التواصل المبكّر مع علماء الذرة اليهود في مختلف أنحاء العالم، وقراره إنشاء هيئة للطاقة الذرية عام 1952. ولأن الولايات المتحدة بدت، في ذلك الوقت، مشغولةً بالترتيبات التي تتيح لها محاصرة الاتحاد السوفييتي، فقد سعى بن غوريون إلى توثيق العلاقة مع قوى الاستعمار التقليدي، وبالذات مع فرنسا التي كانت في صراع حاد مع نظام جمال عبد الناصر في مصر، بسبب دعمه القوي الثورة الجزائرية، والتي زوّدته بالفعل عام 1957 بأول مفاعل نووي كبير جرى تركيبه في منطقة ديمونة.
حين بدأ الدور البريطاني في النظام العالمي يتراجع بعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت مهمّة رعاية المشروع الصهيوني إلى الولايات المتحدة
رغم كل الإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت لضمان سرّية البرنامج النووي للكيان، إلا أنه سرعان ما تكشّف أنه برنامج تسليحي وليس سلمياً، ومن ثم بدأ يتعرّض لضغوط أميركية، خصوصا بعد وصول كيندي إلى السلطة، بل وراحت هذه الضغوط تتصاعد إلى درجة دفعت بن غوريون إلى تقديم استقالته في يونيو/ حزيران عام 1963. وجاء اغتيال كينيدي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963) بعد شهور قليلة من تسلم بن غوريون منه خطاباً شديد اللهجة لإخضاع مفاعل ديمونة للتفتيش وإلا تعرّض الكيان لعقوبات. ثم راح البرنامج النووي الإسرائيلي يتطوّر بمعدّلات متسارعة منذ ذلك الوقت، إلى درجة أن الكيان أصبح قادراً على تجهيز قنبلة بدائية قابلة للاستخدام الفعلي، حين بدأت رياح الحرب تهبّ على المنطقة قبيل منتصف 1967، وبدأ يفكّر في وضع استراتيجية هدم المعبد على من فيه، المعروفة باسم “خيار شمشون” (راجع كتاب سيمور هيرش “خيار شمشون … إسرائيل وأميركا والقنبلة”، 1991). … صحيحٌ أن مسار حرب 1967 أكّد عدم الحاجة لاستخدام السلاح النووي، بعد أن تحقّق بالسلاح التقليدي ما فاق أكثر طموحات الكيان جنوحاً، إلا أن هذه الحرب شكّلت نقطة تحوّل كبرى في طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي بدأت تربط الكيان بالولايات المتحدة فحسب، خصوصاً وأن الأخيرة بدأت تتعامل مع الكيان، منذ ذلك الوقت، باعتباره قوة نووية بحكم الأمر الواقع، ومرغوبا فيها. فعلى الصعيد الاستراتيجي، أدّى الانتصار الضخم الذي تحقق على عدة دول عربية إلى تغيير رؤية الولايات المتحدة الكيان أداةً لا غنى عنها في مكافحة تمدّد النفوذ السوفييتي في المنطقة. وبعد أن كانت حريصةَ قبل الحرب على عدم الظهور بمظهر المورّد المباشر للسلاح إلى الكيان، مراعاةً لمشاعر الدول العربية الحليفة، أصبحت تتفاخر علناً بعدها بأنها أكبر مورّد للسلاح إلى الكيان وأكثر الدول حرصاً على ضمان تفوّقه العسكري على كل الدول العربية مجتمعة. وقد التزمت جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة، الجمهورية منها والديمقراطية، بهذه الاستراتيجية، حتى بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وعلى صعيد الانتشار النووي، عقد الرئيس الأميركي، نيكسون، لقاء سرّيا مع رئيسة وزراء إسرائيل في حينه، غولدا مائير، في سبتمبر/ أيلول 1969، جرى فيه اعتماد استراتيجية “التعتيم النووي” التي تعني موافقة الولايات المتحدة على عدم عرقلة مسيرة البرنامج النووي للكيان، رغم علمه التام ببعده التسليحي وإصراره على مراكمة المعارف النووية التي تسمح له بتصنيع كل ما يستطيع من رؤوس نووية، وعدم ممارسة أي ضغوط لحمله على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو استقبال خبراء أميركيين للتفتيش على المفاعلات النووية التي راحت أعدادُها تتزايد باضطراد، مقابل التزام الكيان بعدم التصريح علنا بامتلاكه السلاح النووي، وأيضاً بعدم إجراء تجارب نووية يمكن رصدها. وفي حين التزمت الإدارات الأميركية المتعاقبة بهذا الاتفاق غير المكتوب التزاماً صارماً، لم يتردّد الكيان الصهيوني في انتهاكه بطرق وأشكال مختلفة، حين اقتضت مصالحه ذلك، بدليل إقدامه على التعاون مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى حد الإقدام على إجراء تفجير نووي مشترك. بل وصلت به الجرأة إلى حد الإقدام على سرقة يورانيوم عالي التخصيب من الولايات المتحدة نفسها (حادث منشأة “أبولو” في بنسلفانيا). وفي ظلّ “ميثاق الصمت” الذي ترسخ بين هذين البلدين المتواطئين، أعطى الكيان لنفسه حرية العمل العسكري في مواجهة أي دولة في المنطقة تسعى إلى تأسيس برنامج نووي لديها، حتى ولو كان سلمي الطابع، بدءا بالعراق مروراً بسورية وليس انتهاء بإيران. بل وصل التواطؤ بين البلدين إلى حد إقدام الولايات المتحدة على المشاركة مع الكيان في هجوم مسلح على المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن لإيران الحقّ في تخصيب اليورانيوم على أراضيها لاستخدامه في الأغراض السلمية، باعتبارها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي.
رغم كل الإجراءات الاحترازية التي اتُّخذت لضمان سرّية البرنامج النووي للكيان، إلا أنه سرعان ما تكشّف أنه برنامج تسليحي وليس سلمياً
لم تكن العلاقات المتنامية بين الولايات المتحدة والكيان، والتي راحت تزداد التصاقاً قبيل حرب 1967 وإبّانها وعقبها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه، مدفوعة فحسب بالرغبة المشتركة في التصدّي للمد السوفييتي في المنطقة، لأن الأمر لو كان كذلك لبدأ التحالف العضوي بين البلدين في التصدّع عقب سقوط الاتحاد السوفييتي، فهناك عوامل أخرى كثيرة ساعدت على تغلغل مقولةٍ راحت تترسخ بسرعة لدى الرأي العام الأميركي، مفادها أن كل ما يفيد الكيان الصهيوني يحقّق مصلحة أميركية بالضرورة، منها: قوة اللوبي الصهيوني المتغلل في كل مراكز صنع القرار الأميركي، انتشار “المسيحية الصهيونية” في الأوساط البروتستانتية، تصاعد نفوذ اليمين بمختلف روافده السياسية والأيديولوجية. وقد أصبح الكيان الصهيوني المستفيد الأول من هذا التطور النوعي في طبيعة العلاقة، استغله نتنياهو أسوأ استغلال، بنجاحه في تخريب اتفاقية أوسلو وإجهاص كل الفرص التي أتيجت لنزع فتيل الصراع الممتدّ في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن وصلنا إلى “طوفان الأقصى” الذي استغله لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً وإقامة إسرائيل الكبرى، متسلّحا باستراتيجية “خيار شمشون”، المعتمدة من كل من تعاقب على حكم الكيان منذ حرب 1967، ما يضع الولايات المتحدة في مأزقٍ يصعُب الفكاك منه.
كان بمقدور الولايات المتحدة تبرير التحامها العضوي بكيان قابل للتسويق “واحة للديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي” و”ضحية للمحرقة النازية”. أما وقد سقط القناع وظهر الوجه الحقيقي لكيانٍ لا يتورّع عن منع الحليب عن الأطفال، وقتل وجرح مئات آلاف من المدنين، والتجويع الممنهج للملايين من البشر المحاصرين، وتدمير المستشفيات والمدارس والمخيمات، واغتيال الصحافيين والإعلاميين، فلم يعد أمام الولايات المتحدة أي مبرّر لحمايته والدفاع عنه والتغاضي عن جرائمه ضد الإنسانية. لذا من الطبيعي أن ينظر الرأي العام العالمي إلى الولايات المتحدة، التي ما تزال تهيمن منفردة على النظام الدولي، باعتبارها الفاعل الأصلي والمجرم الذي يستحق العقاب، خصوصاً في مرحلةٍ يتجه فيها هذا النظام نحو تعدّدية قطبية ترفض الهيمنة المنفردة من حيث المبدأ. ولأن الكيان الصهيوني هو الإفراز الطبيعي للأيديولوجيا الصهيونية، ببعديها التوسعي والعنصري، لن يكون بمقدور النظام الدولي الراهن أن يتحوّل إلى نظام متعدّد الأقطاب إلا بعد هزيمة هذه الأيديولوجيا التي أصبحت مرادفاً للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري و”الهولوكوست الفلسطيني”. تلك هي الحقيقة التي ينبغي أن تدركها كل القوى الطامحة إلى تأسيس نظام دولي متعدّد القطبية، خصوصاً روسيا والصين والهند والبرازيل.
المصدر: العربي الجديد


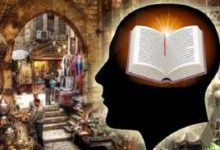

لم تكن الدويلة الوظيفية “إSرائيل” إلا لتنفيذ أجندة الدول الإستعمارية الإمبريالية، وبعد إنتهاء الدور البريطاني بقيادة العالم إنتقلت الرعاية لأمريكا، ولتكون عين وإذن ويد الإدارة الأمريكية بالمنطقة، ولإعادة بناء نظام عالمي جديد متعدّد القطبية لا بد من إنتهاء هذه الدويلة الوظيفية، وخاصة بعد أن كشف القناع عن دورها بحرب غزة، دولة إرhابية مجرمة تمارس الإبادة بحق شعبنا بغزة.