
تحتل لجان التحقيق الوطنية مكانةً مميزةً ضمن البنية المؤسسية للعدالة الانتقالية ومسارات الحوكمة الديمقراطية، حيث تُعدّ من الآليات التي تلجأ إليها الدول للتحقيق في الإخفاقات المؤسسية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقضايا ذات الاهتمام العام.
وتُجسّد هذه الهيئات التحقيقية، التي تلتقي عندها الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية، توترًا متأصلًا يكمن في طبيعة وجودها: فهي مبادراتٌ برعاية الدولة، إلا أنها في الوقت نفسه مُكلّفةٌ بالتحقيق في إخفاقات وانتهاكات نُسبت إلى الدولة ذاتها، وهو ما يُشكّل ما يُمكن تسميته “مفارقة الشرعية” التي ترافق تصميمها وآليات عملها.
وقد شهدت سوريا عام 2025 تشكيل ثلاث لجان وطنية رئيسية جاءت استجابةً للتطورات الأمنية والاجتماعية في منطقتي الساحل والسويداء. ففي آذار من العام ذاته، صدر قرارٌ رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث العنف الطائفي والانتهاكات الجسيمة التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، في أعقاب تصاعد العنف في هذه المناطق. وبالتزامن مع تشكيل لجنة التحقيق، أُنشئت لجنة عليا للسلم الأهلي تهدف إلى احتواء التوترات وتعزيز التماسك المجتمعي في المنطقة. وفي تموز، ومع تفاقم الأحداث الدامية في محافظة السويداء، جرى تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في ملابسات هذه التطورات، وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة آثارها على المجتمع والدولة.
ولكي تتمتع لجان التحقيق الوطنية بالمصداقية والقبول المجتمعي، ينبغي أن تستند إلى مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية التي أثبتتها التجارب التاريخية والدراسات القانونية. وفي هذا المقال، الذي يأتي في جزأين، نؤكد على أنه من دون الالتزام بهذه المبادئ والخطوات الإجرائية، تفقد هذه اللجان جزءًا كبيرًا من مصداقيتها، مهما بلغ مستوى الجهد والمهنية خلال عملها.
اللجان التي تتمتع بميزانية مستقلة مع صلاحيات إنفاق تقديرية تُبدي كفاءةً وفعاليةً تحقيقيةً أكبر مقارنةً باللجان التي تعتمد على تمويل حكومي دوري.
المبادئ الأساسية لتصميم لجان التحقيق الوطنية: الاستقلالية، التمثيل، وضوح التفويض
الاستقلالية المؤسسية:
يشير الاستقلال الهيكلي إلى وجود نصوص دستورية أو تشريعية تؤسس اللجنة ككيان مستقل عن السلطة التنفيذية، وتحصّنها ضد أي شكل من أشكال التدخل السياسي. إلا أن هذا الاستقلال القانوني لا يُعد كافيًا بحد ذاته في غياب استقلالية تشغيلية فعلية، أي امتلاك القدرة العملية على إدارة التحقيقات بحرية، وتخصيص الموارد اللازمة، وإصدار النتائج بشفافية، من دون قيود أو ضغوط مباشرة أو غير مباشرة من السلطة التنفيذية.
تشكّل السيادة المالية جانبًا أساسيًا من جوانب الاستقلالية التشغيلية، ولا تقتصر على توفير ميزانية كافية فحسب، بل تشمل أيضًا الاستقلال في اتخاذ قرارات الإنفاق وتخصيص الموارد. وقد أظهرت التجارب السابقة أن اللجان التي تتمتع بميزانية مستقلة مع صلاحيات إنفاق تقديرية تُبدي كفاءةً وفعاليةً تحقيقيةً أكبر مقارنةً باللجان التي تعتمد على تمويل حكومي دوري. ومن الضروري إنشاء إطار مالي مستقل ومضمون منذ البداية، لأن المحاولات اللاحقة لضمان استقلالية مالية بعد انطلاق التحقيقات عادةً ما تواجه مقاومة سياسية قوية، لا سيما إذا ظهرت نتائج قد تكون مثيرةً للجدل.
تُشكّل الأطر القانونية التي تحدد صلاحيات التحقيق ركيزةً أساسيةً أخرى في ضمان استقلالية اللجان، ومن أبرز هذه الصلاحيات: سلطة استدعاء الشهود، وتوفير الحماية لهم، والوصول إلى الوثائق الرسمية والسرية. ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الصلاحيات مُرسّخة في الدستور أو التشريع، وليست خاضعةً لتقدير أو تدخل السلطة التنفيذية. ويُطلق فقهاء القانون على هذا الإطار القانوني مصطلح “مناطق الاستقلالية”، التي تمنح اللجان مساحةً آمنة للعمل بعيدًا عن التدخلات القضائية أو السياسية المحتملة. وفي السياقات العملية، فإن قدرة اللجان على الوصول إلى الحقيقة تعتمد بشكل كبير على كيفية تعاملها مع التشريعات القائمة، مثل قوانين أسرار الدولة أو الامتيازات الخاصة بالسلطة التنفيذية، التي غالبًا ما تشكّل عقبات كبيرة أمام كشف الانتهاكات الجسيمة.
كما تبرز عملية تعيين أعضاء اللجنة كمفارقةٍ أساسية: فاللجنة تحتاج إلى تفويض وموارد من الدولة كي تتمكن من أداء مهامها، إلا أن شرعية عملها تعتمد بشكل كبير على استقلالها عن السلطات نفسها التي قامت بتشكيلها. وتشير الدراسات المقارنة إلى أن عمليات التعيين التشاركية والمتعددة الأطراف توفر الحل الأمثل لهذه المفارقة، عبر إشراك المجتمع المدني والهيئات البرلمانية ومختلف القوى الاجتماعية والسياسية في إجراءات اختيار أعضاء اللجنة. وتتميز عمليات التعيين الشفافة – التي تشمل آليات واضحة للترشيح، والتدقيق، والمشاورات العامة، وبناء التوافق – بمستويات ثقة مجتمعية أعلى بكثير مقارنةً باللجان التي تُعيَّن بقرار تنفيذي منفرد. ويقوم هذا النهج التشاركي بوظيفة مزدوجة؛ فهو من جهة يعزز شرعية اللجنة، ومن جهة أخرى يخلق دوائر مجتمعية حريصة على الدفاع عن استقلاليتها ضد أي ضغوط أو تدخلات سياسية محتملة.
لا يقتصر التنوع الجندري والعرقي والمناطقي على الالتزامات الرمزية بقيم الشمولية فحسب، بل يُعد ضرورةً عملية لضمان تحقيقٍ فعّال، وللحدّ من النزاعات المحتملة.
الشمولية التكوينية والتنوع المعرفي
يتجاوز تكوين اللجان مجرد التمثيل الديموغرافي ليشمل التنوّع المعرفي، أي احتواء طرق متعددة لمعرفة وفهم الظواهر موضوع التحقيق. فشرعية اللجان لا تُستمد من التمثيل الوصفي فقط (أي أن يكون أعضاء اللجنة مشابهين ديموغرافياً للفئات المتضررة)، بل تستمد أيضًا من التمثيل الجوهري (أي قدرة الأعضاء على التعبير بفاعلية عن مصالح ووجهات نظر مجتمعية متنوعة). تستوجب هذه الرؤية معايير اختيارٍ تعطي الأولوية للتوازن بين الخبرة المهنية والقدرات التحليلية.
ويبرز في هذا السياق توتّرٌ مستمر بين ضرورة توافر الخبرة الفنية من جهة، وبين أهمية الشرعية المجتمعية من جهة أخرى، إذ تشير تجارب لجان التحقيق السابقة إلى أن هيمنة الخبراء الفنيين على عضوية اللجان تؤدي عادةً إلى تحدياتٍ في كسب الثقة المجتمعية وإشراك الجمهور، في حين يؤدي التركيز على التمثيل المجتمعي على حساب الخبرة الفنية إلى نتائج تحقيقية ضعيفة قد تفتقر إلى المصداقية القانونية والدقة العلمية. ويبدو أن أفضل الحلول هو تشكيل هجينٍ متعمّد يجمع بين ذوي الخبرة الفنية والمعرفة التجريبية والقبول المجتمعي في آنٍ معًا. تُمكّن هذه التعددية اللجان من التحرك بسلاسة بين أنظمة المعرفة المختلفة، ما يضمن دقة التحقيق والشرعية المجتمعية في آنٍ واحد.
كما تتجاوز مشاركة المجتمع المدني في اللجان مجرد الدور الاستشاري، لتصبح قوةً دافعةً تؤثر جوهريًا في نتائج التحقيق، فقد بيّنت تجارب عديدة أن منظمات المجتمع المدني الوطنية تمتلك خصائص لا غنى عنها في هذا الإطار، أهمها: الروابط المجتمعية التي تعزز مشاركة الضحايا، والخبرة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والسلطة الأخلاقية التي اكتسبتها من العمل الحقوقي المستمر. ويضمن إشراك ممثلي المجتمع المدني كمفوّضين يتمتعون بصلاحيات كاملة وليس كمجرد مستشارين، وجود داعمين داخليين للنهج القائم على
مركزية الضحايا، ويوفر ذاكرة مؤسسية قادرة على ردم الهوّة بين الإجراءات الرسمية وتجارب المجتمع المحلي. ويسهم هذا النهج التشاركي في إضفاء طابع ديمقراطي على عملية إنتاج المعرفة، ويحدّ من التراتبية التقليدية التي تُفضّل المعرفة الرسمية على المعرفة المجتمعية والتجريبية.
ولا يقتصر التنوع الجندري والعرقي والمناطقي على الالتزامات الرمزية بقيم الشمولية فحسب، بل يُعد ضرورةً عملية لضمان تحقيقٍ فعّال، وللحدّ من النزاعات المحتملة. وتؤكد الدراسات المتعلقة بلجان تقصي الحقائق وجود علاقة وثيقة بين التكوين الشامل والمتنوع للجنة، وبين نجاحها في تخفيف التوترات الاجتماعية بعد مباشرة عملها. إذ يعمل التنوع عبر آليات متعددة، فهو يعزز قدرة اللجان على إشراك مختلف الفئات، ويرفع شعور الفئات المتأثرة بعدالة الإجراءات، ويضمن أن تعكس نتائج التحقيق وجهات نظر متعددة تجاه الأحداث محل الخلاف. وتفرض الطبيعة المتداخلة للهوية (intersectionality) ضرورة الانتباه لكيفية تقاطع عوامل مثل النوع الاجتماعي، والعرق، والطبقة، والانتماء الإقليمي، في تحديد أنماط الضحايا وتوقعاتهم للعدالة.
صلاحيات التحقيق يجب أن تكون متناسبة مع مدى التفويض، بحيث إن التفويضات الواسعة تتطلّب صلاحيات قانونية قوية.
وضوح التفويض وتحديد الحدود الزمنية
يتطلّب تحديد صلاحيات لجان التحقيق التعامل مع التوتر بين خصوصية التفويض (أي درجة دقته وتحديد نطاقه بوضوح)، وبين المرونة اللازمة التي تسمح بمتابعة الخيوط الجديدة والأنماط الناشئة في أثناء التحقيق، لذا يُعتبر وضوح صلاحيات اللجنة أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يوفر للمفوّضين توجيهًا دقيقًا، ويضع توقّعات واضحة لدى الجمهور بشأن نطاق التحقيق وحدوده، ويمنع تجاوز اللجان لصلاحياتها أو التقصير في مهامها. وفي الوقت نفسه، فإن التحديد المفرط لصلاحيات اللجنة قد يقيّد قدرتها على تتبع الأدلة وكشف الأنماط المنهجية التي قد تمتد خارج حدود التفويض الضيقة.
أما تحديد الحدود الزمنية لعمل اللجان فهو أمرٌ بالغ التعقيد، إذ يتطلّب موازنة دقيقة بين ضرورة إنجاز تحقيق شامل، وبين مراعاة القيود العملية من حيث الوقت والموارد ومدى اهتمام الجمهور، وتؤكد التجارب أن الحدود الزمنية المثلى تكون نابعة من تقديرات واقعية لمدى تعقيد التحقيق، مع ضرورة تجنب الجداول الزمنية المفتوحة التي من شأنها تبديد الزخم وإضعاف المشاركة العامة. ومن هنا فإن وضع مواعيد نهائية واضحة مع إمكانية تمديدٍ محدودة، يولّد ضغطًا إيجابيًا يدفع نحو تحقيقٍ فعّال، مع تجنّب الإطالة التي قد تقوّض الثقة العامة. مع ذلك، يجب أن تأخذ الحدود الزمنية بعين الاعتبار الطبيعة التكرارية للبحث عن الحقيقة، خاصة في حالات التحقيق في الانتهاكات المنهجية التي قد تشمل جهاتٍ متعددة ومؤسسات مختلفة.
كما يجب أن تكون الصلاحيات القانونية مضبوطة بعناية بحيث تتلاءم مع طبيعة التحقيق ومقتضياته، مع تجنّب كلٍ من نقص التحديد (الذي يُضعف قدرة اللجان على إلزام الأطراف بالتعاون)، أو المبالغة في التحديد (التي تجعل الإجراءات شبه جنائية من دون توفير الضمانات الإجرائية اللازمة). فصلاحيات التحقيق يجب أن تكون متناسبة مع مدى التفويض، بحيث إن التفويضات الواسعة تتطلّب صلاحيات قانونية قوية، تشمل عادةً: سلطة استدعاء الشهود والوثائق، وإمكانية إجراء عمليات التفتيش والمصادرة تحت الإشراف القضائي، إضافةً إلى توفير تدابير حماية الشهود والضحايا. ويجب أن تحكم ممارسة هذه الصلاحيات قواعد إجرائية واضحة تضمن التوازن بين كفاءة التحقيق وحماية حقوق الأفراد، مما يمنح اللجان ما يمكن وصفه بـ “سلطة تقديرية مقيدة”، أي مرونة في العمل ضمن حدودٍ قانونية واضحة.
في الجزء الثاني من هذا المقال، سوف نستكمل مناقشة ديناميات عمليات التحقيق، مع التركيز على مشاركة الضحايا، والعدالة الإجرائية، وآليات تنفيذ التوصيات.
المصدر: تلفزيون سوريا


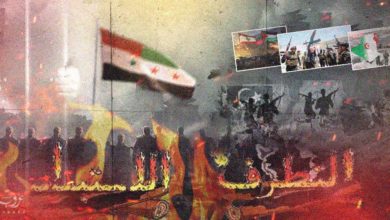





قراءة موضوعية دقيقة من مختص حول عمل لجان التحقيق الوطنية برعاية الدولة، لجان التحقيق أساسية بمؤسسات العدالة الانتقالية ومسارات الحوكمة الديمقراطية، للتحقيق في الإخفاقات المؤسسية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقضايا ذات الاهتمام العام. يجب أن تتمتع بميزانية مستقلة مع صلاحيات إنفاق تقديرية والاستقلالية، ووضوح التفويض وتحديد الحدود الزمنية، مع صلاحيات قانونية قوية.