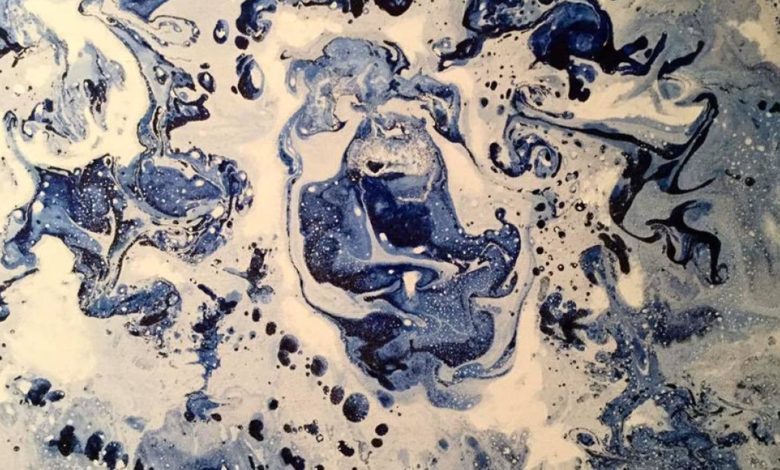
بعد سنوات من فقدان الأمل في التغيير، أُسقِط من تسبّب في إحدى أكبر المآسي الإنسانية في القرن الحالي. نذكّر أن الصورة، حتى أشهر قليلة، كانت تقول إن النظام السوري سوف يعاد استيعابه في المنظومتين، الدولية والإقليمية، بعد موجة تحرّكات ومصالحات. كانت دول كثيرة، من بينها دول كانت تدعو في السابق إلى إسقاطه، تفكّر في التعامل مجدّداً مع من كانت تصفه بديكتاتور دمشق.
المفارقة أن لحظة الفرح هذه، التي تشارك فيها السوريون المخلصون، كانت بالنسبة لفئاتٍ من السياسيين العرب بمثابة الكارثة. لا تضمّ هذه الفئات فقط قوميين مهووسين بنظرية المؤامرة، التي تجعلهم يصدّقون أن النظام السوري الآفل كان جادّاً في مقارعة الكيان، ولكنّها تضمّ أيضاً إسلاميين دولتيّين، أيّ إسلاميين مرتبطين بالدولة ومقدّسين مؤسّساتها، كما هو الحال مع بعض إسلاميّي السودان، الذين أثّر تماهيهم مع الدولة، في سنوات حكم الرئيس البشير، في نظرتهم إلى الواقع.
بالنسبة لهؤلاء جميعاً، في إزاحة بشّار الأسد صدمة، لأنّه يمثّل، بشكلٍ ما، أحد أركان النظام العربي الكلاسيكي. يربط هؤلاء بين إسقاط النظام في دمشق وإسقاط سورية، ويرون أن الشعب، الذي كان يتوق إلى الحرّية، على خطأ، لأن لا شيء يستحقّ أن يفكّك لأجله “الجيش الوطني” ومؤسّسات الدولة، التي لا ضمان لبقائها واستقرارها سوى ذلك الشكل السياسي، الذي يجمع بين الاستبداد وحكم العائلة.
يُخوّف السوريون من حكم “إرهابيين”، ألم يكن استهداف النظام مجموعات سكّانية كاملة بالصواريخ والبراميل المتفجّرة إرهاباً؟
تجمع كتابات هؤلاء “الدولتيّين” على التقليل من حجم مساوئ النظام البعثي، والتعظيم من حجم الكوارث المحتملة،التي يمكن أن تواجه الشعب السوري في الفترة المقبلة، بسبب إسقاط من كان يكفل (بزعمهم) حماية ووحدة سورية.
في مقابل هذا المنطق المختلّ، يظلّ من حقّ الشعوب العربية أن تتساءل عن جدوى بقاء الدولة التي تقهر شعبها، أو جدوى الحفاظ على المؤسّسات التي تتعامل مع مواطنيها بتمييز واحتقار، بما في ذلك الجيش الذي لا يتقوّى ولا يستخدم القوّة المفرطة إلا ضدّ أبناء بلده.
هل سمع أولئك المنتقدون فرحة السوريين بسقوط سجن صيدنايا، الذي يضمّ أعداداً لا يمكن حصرها من المعتقلين الذين قضى بعضهم عقوداً من عمرهم داخله؟ هل يعلمون أنه، وفي مدى أيام، كانت المحاولات مستمرّة للبحث عن الزنازين المخفية، والأقبية تحت أرضية، وطرائق الفتح المعقّدة للحفر والمعتقلات؟ هل سمع المنتقدون، والمحذّرون من المستقبل، ومن سيطرة الجماعات الإسلامية المتهمة بالإرهاب، حكايات المعتقلين وما تعرّضوا له من تعذيب كانت نهايته، في كثير من الأحيان، الموت أو الإعاقة أوالجنون؟
الشعب السوري، الذي عانى عقوداً من الظلم والقهر واستخدام أساليب تتنوع بين الاعتقال والتعذيب والاغتصاب، وقتل كلّ مشكوك فيه، يُخوّف الآن من حكم “مجموعة إرهابية”، أي أن كلّ ما سبق، بما فيه مآسي استهداف مجموعاتٍ سكّانيةٍ كاملة بالصواريخ والبراميل المتفجّرة، لا يُعدُّ في نظر أولئك إرهاباً.
لا نعلم المستقبل ولا ننوي الدفاع عن قيادات التغيير الجُدد، لكن ما نشهد عليه أن هذه المجموعات، التي أسقطت النظام، تعاملت حتى يومنا هذا بقدر كبير من المسؤولية، فلم تلجأ إلى التخريب ولا الانتقام ولا بدأت محاكمات ميدانية لعناصر النظام، بل ظلّت تدعو الجنود السابقين إلى وضع السلاح والانشقاق والانضمام إلى الثورة. تمكن مقارنة ذلك بالحوادث البشعة والانتهاكات الجسيمة التي كانت تمارسها مليشيات “محور المقاومة” التي كان ينظر إليها “حرّاس الدولة” بإعجاب وتقدير.
بالنظر إلى ما عاناه كلّ سوري، خاصّة أولئك المنخرطين في الثورة والنضال المستمرّ، فإن السيطرة على غريزة الانتقام كانت أمراً مثيراً لإعجاب المراقبين، ومحبطاً للذين كانوا ينتظرون حدوث جرائم بشعة من أجل تأكيد منطقهم وتحذيراتهم.
كان قادة الحركة الثورية الجديدة على وعي بأن العالم يراقب تحركاتهم كلّها، لذلك ظلّوا يتعاملون بحذر، ويوحون بأنهم منفتحون على الجميع وعازمون على بناء سورية جديدة تحترم التنوع والتعايش المشترك. مع ذلك، لم يغيّر مراقبون نظرتهم إلى هذه الوجوه بوصفها وجوهاً إسلاميةً، وبالتالي إرهابيةً.
تكافح الحكومة السودانية لإقناع المجتمع الدولي بتصنيف قادة مليشيا الجنجويد (المتمرّدة) جماعةً إرهابيةً استناداً إلى ارتكابها كلّ ما يؤهّلها لهذا التوصيف
علّمتنا خبرة السنوات الماضية أن الوصف بالإرهاب لا ينبع من طبيعة الفعل، ولكن من هُويَّة فاعليه. وفق هذا المنطق، إطلاق نار بواسطة مسلم في الغرب عمل إرهابي، ولكن الفعل نفسه من أوروبي غير مسلم مُجرَّد جريمة. هذا هو المنطق نفسه الذي يرفض أن يدين الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإرهاب، على الرغم ممّا يرتكبه، وهو نفسه الذي كان يغضّ الطرف عن جرائم نظام الأسد وغيره من أنظمة القمع والقهر العلمانية، فيما يبالغ في تشويه صورة نظام طالبان الأفغاني مثلاً.
في السودان، تكافح الحكومة، منذ أكثر من عام، لإقناع المجتمع الدولي بتصنيف قادة مليشيا الجنجويد (المتمرّدة) جماعةً إرهابيةً استناداً إلى ارتكابها كلّ ما يؤهّلها لهذا التوصيف من جرائم، بدءاً من القتل على الهُويَّة ونهايةً بالاستعباد الجنسي والتهجير والإبادة الجماعية. وقد بادر قائد هذه المليشيا (قوات الدعم السريع) محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي فهم كيف تسير الأمور في هذا العالم، منذ أول يوم، إلى إعلان نفسه محارباً ضدّ الإسلاميين وعدوّاً للإسلام السياسي. كان الرجل يعلم أن موضعة نفسه في هذه الخانة تمنحه حصانةً، لأن تهمة الإرهاب لا توجّه إلى أمثاله.
تكتفي معظم الدول المنخرطة في الأزمة السودانية بالنظر إلى الأمر باعتباره صراعاً على السلطة، أو مُجرَّد تمرّدٍ عسكريٍّ بانتهاكات حرب متوقّعة. ترفض هذه الدول أن تنظر إلى المليشيا نظرتها إلى الجماعات الإرهابية، فقوات حميدتي لا ترفع شعارات الجهاد، ولا تتسمّى بأسماء إسلامية، بل ترفع شعار البحث عن الديمقراطية، وتدخل في تحالفٍ مع مجموعات يسارية مدعومة من الغرب. أخذ هذه الحقائق بالاعتبار مهمّ، وعلينا أن نتذكّر أن هذه التصنيفات ليست موضوعية أو منهجية، وإنما هي مُجرَّد لافتات متأسّسة على المصلحة.
المصدر : العربي الجديد







