
تعدّ رئاسة الجمهورية مؤسّسة حيوية فاعلة داخل الاجتماع السياسي في تونس، قبل الثورة وبعدها، فقد ساهمت، عقوداً، في رسم معالم السياسات العامّة للبلاد، ومدّ جسور التواصل مع الخارج، رافعة شعار تعزيز مقولة السيادة الوطنية، وتأمين الوحدة الداخلية، فضلاً عن تولّيها قيادة القوّات المسلّحة. وتمتّع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة زمن حُكم الحبيب بورقيبة، وخلَفه زين العابدين بن علي، في ظلّ هيمنة نظام رئاسي مطلق. وتراجع نفوذ رئيس الدولة نسبياً خلال عشرية الانتقال الديمقراطي (2011 ـ 2021)، بسبب محدودية صلاحياته في ظلّ نظام برلماني مُعدّل. ومع صعود حركة 25 يوليو/ تموز (2021)، بقيادة قيس سعيّد، تزايد نفوذ رئيس الجمهورية، الذي غدا محور النظام السياسي السائد، وقوام السلطة الحاكمة، وبيده جُلّ مفاتيح إدارة البلاد.
والثابت أنّ الانتخابات الرئاسية، منذ الاستقلال (1956)، شهدت إقبالاً شعبياً مكثّفاً لدراية الناس بأهمّيتها الوظيفية، وقدرتها التغييرية، ولقيمة الرئيس الاعتبارية والرمزية في وعي جمعي ما انفكّ يستبطن فكرة الرئيس/ الأب، والزعيم/ الراعي، والقائد/ المُخلّص. وستشهد تونس في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل (2024)، تنظيم الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية عشرة منذ قيام النظام الجمهوري، والثالثة بعد الثورة. وسيختار الناخبون الرئيس الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدّتها خمس سنوات. وتكتسب الرئاسيات المقبلة أهمّيتها من دورها في تحديد معالم النظام السياسي خلال السنوات المقبلة، ورسم طبيعة العلاقة بين القصر الرئاسي والقُوى المُعارِضة.
ويتبيّن الدارسُ حركةَ الاجتماع السياسي الراهن في تونس تباين المواقف من جهة المشاركة في انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اقتراعاً وترشيحاً، أو مقاطعتها أو العزوف عنها. ولكلّ موقفٍ جمهوره وخلفياته وأهدافه. ويمكن التمييز منهجياً بين ثلاث شرائح انتخابية. الأولى، أنصار الرئيس قيس سعيّد والأحزاب الموالية له. والثانية المُعارِضون له ولمسار “25 يوليو” ومخرجاته. والثالثة فئة صامتة، لا تُدين بالولاء للرئيس ولا لخصومه.
عملياً، يُعتبر أتباع الرئيس قيس سعيّد في طليعة الداعين إلى التصويت بكثافة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، فقد أعلن سعيّد ترشّحه للتنافس على كرسي قرطاج من جديد، وأنّه فعل ذلك “استجابةً لنداء الوطن”، وردّاً سابقاً على سؤال بشأن اعتزامه الترشّح لولاية ثانية، قائلاً: “لستُ مُستعدّاً لأن أُسلّم وطني لمن لا وطنية لهم. هي قضية مشروع وليست أشخاص. القضية هي كيف نُؤسّس مرحلةً جديدةً في التاريخ التونسي”. وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ الرجل حريصٌ على السلطة، معني بالاستمرار في الرئاسة، ومشغول بالتأسيس لمشروع سياسي على طريقته، مشروع قوامه، بحسب مراقبين، فكرة البناء القاعدي، وإلغاء الوسائط التمثيلية بين الرئيس/ القائد وشعبه، وتجميع كلّ السلطات والصلاحيات بيده في ظلّ نظام رئاسي مُطلق. ويقتضي استمرار ذلك المشروع تحشيد الدعم الجماهيري له، والتفاف الناس من حوله حتّى يكتسب شرعية شعبية على كيف ما. لذلك، تكثّفت حملات الدعاية للرئيس عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وجدّ أشياعه في دعوة الناس إلى التظاهر دعماً له، وحثّهم على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والتصويت له حتّى يواصل ما يسمّونه مساره “الإصلاحي” ومشروع “تصحيح الثورة”، من وجهة نظرهم. وقد دخل سعيّد منذ شهور، بحسب مراقبين، في حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال تعريضه بخصومه السياسيين، وقيامه بزيارات فجائية لمؤسّسات عمومية، ولمناطق طَرَفية، حتّى يظهر في صورة الرئيس القريب من الناس، الحريص على التفاعل مع مشاغلهم، الميّال إلى فتح ملفّات الفساد والواعد بتحسين أوضاع الفئات والجهات الهشّة. ويجد هذا النهج الشعبوي هوىً لدى طيف من الناس، الذين ما انفكّوا مسكونين بهاجس الرئيس/ الراعي والقائد/ الحنون، الذي يقترب منهم، ويقدّم لهم الوعود الجميلة بغد أفضل في ظلّ قيادته. ومن ثمّ، فالتوجّه نحو صناديق الاقتراع يندرج بالنسبة إلى هذه الفئة في سياق الانبهار بشخص الرئيس، والعمل على تحويل مقولاته حول السيادة، واستقلالية القرار الوطني، وحرب التحرير، واسترداد الأموال المنهوبة، وتحسين الخدمات الإدارية، وتطوير البنى التحتية، وتشغيل الشباب، من حلم إلى واقع. فالمشاركة بالنسبة إلى هذه الشريحة هي محاولة لتركيز مشروع سعيّد وإتاحة أفق زمني جديد له في ظلّ تعثّر خطواته التغييرية خلال عهدته الرئاسية الأولى. ويجد أنصار سعيّد صعوبةً في إقناع الناس بالتصويت لمرشّحهم ثانية، لأنّ أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والحقوقية بعد حركة 25 يوليو لم تتحسّن، بل زادت سوءاً، بحسب مراقبين. لكنّ ذلك لا يمنع من أنّ طيفاً آخر من التونسيين يصرّ على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ترشّحاً وترشيحاً واقتراعاً، باعتبار ذلك حقّاً مواطنياً يكفله الدستور، ولا يرون حرجاً في اختيار قيس سعيّد أو غيره لحكم البلاد. بل الفيصل في نظرهم برنامج المُترشّح للرئاسيات وصدقيته، ومدى قدرته على التغيير. فهذه الفئة ترى في الانتخاب فعلاً واعياً/ مسؤولاً، وفرصة للتعبير عن الذات والمشاركة في صناعة القرار. ولسان حالها يقول “أنا أنتخب إذن أنا موجود”. وهي تحتاج فقط إلى ضمانات قوية بشأن شفافية الاستحقاق الانتخابي، بحسب ملاحظين.
أمّا القوى السياسية المُعارِضة الوازنة (جبهة الخلاص الوطني، والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، والحزب الدستوري الحرّ)، فلا تقف على قلب رجل واحد من جهة موقفها من رئاسيات 2024. فلئن التقت سابقاً عند مقاطعة الاستشارة الإلكترونية الرئاسية، والاستفتاء على دستور 2022، وقاطعت انتخابات مجلسي النواب والجهات، ونجحت في تقليص نسبة المشاركة الشعبية في تلك المحطّات الانتخابية، فإنّها اختلفت بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويشقّها في هذا الخصوص موقفان. الأوّل، يذهب إلى الاستمرار في تبنّي قرار المقاطعة (حزب العمّال، شقّ من جبهة الخلاص الوطني بقيادة نجيب الشابي)، ويعتبرها حركة احتجاج ضدّ منظومة 25 يوليو ومُخرَجاتها، وضدّ المسار الانتخابي وما شابه من خروقات من قبيل اعتقال قيادات حزبية مُعارِضة وازنة، ومنعها من الترشّح للسباق الرئاسي، ومن سحب بطاقة التزكيات، وتقييد حرّية التعبير بموجب المرسوم 54، وفرض البطاقة عدد 3 على المُترشّحين، وتعديل القانون الانتخابي بطريقة أحادية. والمقاطعة عندهم رفض لإضفاء الشرعية على سياسات سعيّد، واعتراض على ما يعتبرونه مساراً انقلابياً لا تصحيحاً للثورة. والثاني، موقف داعٍ إلى حتمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي. إذ يحثّ بعض المُعارِضين (قيادات سابقة في حركة النهضة و”قلب تونس”، مثلاً)، للنظام القائم الناسَ على المشاركة في رئاسيات 2024 بغاية استئناف المشروع الديمقراطي الذي دشّنته ثورة 2011، وتأمين تداول سلمي على السلطة، وتمكين الشعب من اختيار من يحكمه بالاحتكام إلى صندوق الاقتراع. ويرى هؤلاء أنّ المقاطعة، على أهمّيتها، في إقناع العالم بسردية اعتبار ما حصل بعد 25 يوليو 2021 انقلاباً، وفي تقليص الحاضنة الشعبية للنظام، فإنّها لم تُفلح في الحدّ من تمدّد مشروع قيس سعيّد واستئثاره بالسلطة. واللافت أنّ معسكر المُعارَضة التونسية لم ينجح في اختيار مرشّح توافقي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب خلافات أيديولوجية ومصلحية وحزبوية ضيّقة. فتعدَّد المُعارِضون المتسابقون على الفوز بكرسي قصر قرطاج (عبد اللطيف المكّي، منذر الزنايدي، عماد الدايمي، مراد المسعودي، وغيرهم)، ومعلوم أنّ ذلك سيشتّت أصوات القاعدة الانتخابية، ويقلّل حظوظ المُعارَضة في كسب الرهان الرئاسي.
ويعدّ موقف العزوف عن الحدث الانتخابي، ولزوم الحياد واللامبالاة إزاء الرئاسيات المقبلة، وعدم التفاعل معها بالمشاركة أو المقاطعة، موقفاً تتبنّاه كتلة صامتة مُعتبَرة من التونسيين، ما انفكّت تتمدّد من استحقاق انتخابي إلى آخر بعد الثورة، ومعظمها من الشباب. وتعتري هذه الفئة من المواطنين حالةٌ من اليأس والإحباط من الفاعلين السياسيين عموماً، لأنّ الحاكمين والمُعارِضين على السواء لا يلتفتون إلى معاناة الناس، ولا يبذلون الجهد الكافي لاجتراح حلول واقعية لأزمات تونس المُتعدّدة. بل ينخرطون في صراع مُحتدِم على السلطة، ويبيعون لجمهور المُهمشين والفقراء والمُعدَمين في المواسم الانتخابية وعوداً وهمية، خلّابة، لا تُسمن ولا تُغني من جوع. وعندهم أنّ النظام الرئاسي لم يُؤسّس جمهورية تقدّمية عادلة منذ الاستقلال حتّى اللحظة. فجُلّ الرؤساء الذين عرفتهم البلاد قبل الثورة وبعدها كانوا يبحثون عن مجد شخصي، ونفوذ أحادي، وعن رفاه الثروة، وأبّهة الشهرة. لذلك يرون أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تصلح ما فسد، ولن تكون بوّابةً لنهضة شاملة. فتغيير الحال من المُحال في نظرهم. لذلك يرون أنّ أصواتهم لن تُغيّر في المشهد السياسي شيئاً. وبناء عليه، اختاروا لزوم صمت احتجاجي على كيف ما.
ختاماً، مثّلت غيبة النزاهة، وهيمنة الحزب الحاكم والرئيس المُتنفّذ، وكثرة الوعود الكاذبة، علامات واسمة لرئاسيات الدولة الشمولية في تونس بعد الاستقلال. ومع اندلاع الثورة أسست عشرية الانتقال الديمقراطي لتنافس سلمي نزيه على كرسي رئاسة الجمهورية. وسيكون مدى احترام المعايير الدولية للانتخابات من قبيل تكافؤ الفرص، وتوازن الدعاية الانتخابية، واعتبار حقوق الناخبين والمُترشّحين، عوامل أساسية في تحديد مدى صدقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدى إقبال الناس عليها أو عدم التفاتهم إليها.
المصدر: العربي الجديد



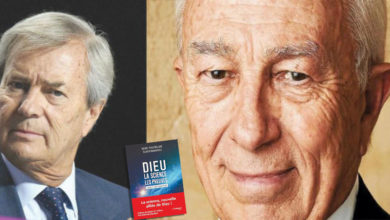




غيبة النزاهة، وهيمنة الحزب الحاكم والرئيس المُتنفّذ، وكثرة الوعود الكاذبة، علامات واسمة لرئاسيات الدولة الشمولية في تونس بعد الاستقلال، وما تشهده الرئاسة الحالية تمثل قمة هذه الوعود الكاذبة وغياب النزاهة، لذلك ستشهد مقاطعات للإنتخابات.