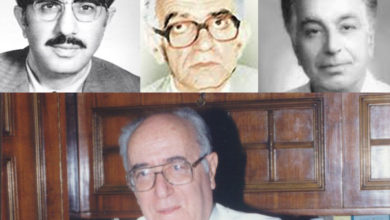مدخل:
أفضَت حالة الاستعصاء السياسي وانسداد الأفق أمام حلّ سياسي لقضية السوريين، وكذلك تعاظم النفوذ الدولي والإقليمي وتعدّد سلطات الأمر الواقع على الجغرافيا السورية، إلى انشطار واضح في الرأي، بين النخب السياسية والفكرية ومجمل العاملين في الشأن العام؛ إذ يرى شطرٌ من هؤلاء أن مفاتيح القضية السورية لم تعد بيد السوريين، بل باتت مرهونة بيد الدول النافذة في الشأن السوري، أي إن أي حل سياسي لا بدّ ان يكون وافدًا من الخارج. أما الشطر الثاني، فإنهم يرون أن أيّ حل سياسي منصِف للقضية السورية ينبغي ألّا يكون بعيدًا عن إرادة السوريين، مع إقراره بدور العوامل الدولية وسطوة القوى الخارجية على المشهد السوري. ومن ثم، يوجب على القوى السورية أن تعمل باستمرار لاستعادة المبادرة الوطنية، ولتكون شريكًا ندّيًا ومساهمًا فعّالًا في صياغة مصير بلادها ومستقبلها. ولعلّ وثيقة المناطق الثلاث انبثقت بناءً على هذا التصوّر[1].
وثيقة المناطق الثلاث
هي مبادرة أطلقها مثقفون وأكاديميون وسياسيون سوريون، صبيحة الثامن من آذار/ مارس الماضي، وتتضمن دعوة السوريين للانضمام إليها، لاعتقادهم بأنها تجسّد مدخلًا صحيحًا لاستعادة المبادرة الوطنية، وهي تمهّد “للإمساك” بالمستقبل السوري، وتكون خطوة نحو “ابتكار سياسة وطنية سورية جديدة أكثر عقلانية ونجاعة”، وتتضمن الوثيقة خمسة مبادئ أو محدّدات:
1 – يحيل أولها على أحقّية السوريين باستعادة السياسة (تأميمها)، ممّن احتكرها أو اغتصبها أو عدّها امتيازًا خاصًا به من دون الآخرين، وبما أن الثورة هي مُنتج شعبي سوري عام، فإن تحرير المصير إنما يتزامن مع تحرير القرار والمبادرة وأدوات العمل من مغتصبيها أيضًا، سواء أكان المغتصِبُ جماعة أم حزبًا أم ميليشيا أم دولة. والمسعى نحو تحرير السياسة هو تجسيد لشعار السوريين: (سوريا لينا وما هي لبيت الأسد) وفقًا لنص الوثيقة.
2 – ويحيل المبدأ الثاني على التأكيد أن (الحياة والحرية والأمان والكرامة….. حقوق مصونة للسوريين جميعهم)، كما أن طبيعة المواجهة بين الشعب ونظام الحكم في سورية هي صراع بين النزوع إلى الحرية والكرامة والأمان، وبين الإصرار على ممارسة القتل وامتهان الحقوق من جانب نظام الحكم القائم، فهو صراع ذو طابع وجودي بين الحياة بكل ما فيها من قيم الحق والخير، وقوى التسلّط والشر. ومن هنا، تكون الدعوة إلى مناهضة (كل فعل أو خطاب يدعو إلى الكراهية أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتها بالاستقرار) هي في مركز تفكير السياسة السورية، وفقًا لما جاء في الوثيقة.
3 – يؤكّد المبدأ الثالث مفهوم الوحدة الوطنية الذي لا يتحقق إلّا حين تكون سورية لجميع السوريين، فسورية فوق الطوائف والملل والأيديولوجيات، و(إن السعي إلى تقسيم سورية عمل غير مشروع، أيًّا كانت ذرائعه، ويجب مناهضته بكل السبل الممكنة).
4 – ويؤكّد المبدأ الرابع أهمية التنسيق والحوار بين السوريين، كوسيلة مثلى للعمل والتفاهم المشترك، وكما كانت (التنسيقية) هي الإطار المشترك للتواصل بين السوريين في بداية الثورة، فلتكن عودة السوريين أيضًا إلى مزيد من التنسيق القائم على نواظم إنسانية تتجاوز الهوّيات الفرعية التي لا تكتسي بُعدها الإنساني إلّا بانضوائها تحت المظلة السورية الجامعة.
5 – ويؤكّد المبدأ الخامس ضرورة تعزيز الثقة بين السوريين بوصفها (أداة تأسيس سياسية تؤطر اجتماعنا الوطني، وتعيد بناء رأس مال اجتماعي وطني، يمهد الطريق للوحدة في الكثرة، واحترام التعددية وترسيخها قناعةً وعملًا، ويمهّد الانتقال للديمقراطية فكرًا وسلوكًا)، بحسب نص الوثيقة.
في دلالة زمان ومكان الإعلان عن الوثيقة:
اختار القائمون على الوثيقة[2] يوم الثامن من آذار/ مارس للإعلان عنها، وهو ما يتطابق مع التاريخ نفسه من العام 1920، يوم إعلان استقلال سورية، وذلك في سعي من أصحاب الوثيقة إلى إيجاد حالةٍ من التماهي مع الدلالة الرمزية للاستقلال وتقاطعها مع ما جاء في مضمون الوثيقة من نزوع واضح نحو استعادة القرار والمبادرة الوطنية.
أما من حيث المكان، فيمكن التأكيد أن الأمكنة التي انطلقت منها المبادرة تختزل دلالات رمزية لا تقف عند حدود الجغرافيا، وإنما تستهدف الإرث النضالي السوري، فالقريّا هي مسقط رأس سلطان باشا الأطرش، ومنطلق الثورة السورية الكبرى، وريف حلب الشمالي يحيل ضمنًا على بلدة (كفر تخاريم)، وهي مسقط رأس إبراهيم هنانو، أحد رموز النضال الوطني ضد المستعمر الفرنسي، أما (درعا البلد) فقد كانت منطلق الشرارة الأولى لثورة السوريين. ولكن على الرغم من توضيح ما ترمي إليه دلالة المكان، فإن مسألة النزعة (المناطقية) قد تبقى ملقية بظلالها لأول وهلة، لدى أي قراءة للمبادرة، سواء أكان ذلك بقصد من القائمين عليها أم من دون قصد.
في المحدّدات الفكرية والسياسية للمبادرة:
لا بدّ من الإشارة أولًا إلى أن إعلان المبادرة المذكورة قد جاء مخالفًا للطرائق التقليدية المألوفة؛ إذ إن إعلان وثيقة المناطق الثلاث لم يتضمن إعلانًا موازيًا عن أسماء القائمين عليها، ولم يُعرف منهم أحدٌ في حينه سوى الشيخ أحمد الصياصنة، لكونه هو الذي قرأ نصّ الوثيقة في مقطع فيديو بُث وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. وربما كان الدافع إلى تقديم مضمون الوثيقة مجرّدةً من الأسماء هو حرص أصحابها على أن تكون الأولوية لأفكار الوثيقة أولًا، لكونها لم تصدر من جهة حزبية أو أي إطار سياسي أو مدني آخر، أضف إلى ذلك أن الوثيقة هي أقرب ما تكون إلى دعوة موجهة إلى السوريين للتفكير بطريقة جمعية وفقًا لمحددات وطنية أرادت الوثيقة بلورتها، وهذا ما سنعود إليه لاحقًا. في أي حال، ثمة في الوثيقة ما يوجب الوقوف عنده:
1 – لم يأتِ إعلان (وثيقة المناطق الثلاث) تعبيرًا عن موقف سياسي راهن أو تجسيدًا لرؤية آنية حيال حدث طارئ، بل يمكن التأكيد أن المبادرة المذكورة هي تجسيد سياسي لجملة من المفاهيم والأفكار، كانت محورًا لنقاشات وحوارات بين كتاب ومثقفين سوريين منذ أواخر عام 2021، أعني منذ أن نشر الباحث مضر الدبس -وهو أحد القائمين على المبادرة- مجموعة من المقالات في موقع (العربي الجديد)[3]، تستلهم بمجملها الوعي السوري الجديد الذي بدأت إرهاصاته تتبلور بعد ثورة 2011. ولعل أبرز تلك المقالات التي تحيل عليها وثيقة المناطق الثلاث جاءت بعنوان (تأميم المعارضة السورية.. المهمة اللازمة)، إذ يؤكّد الكاتب في المقال المذكور فكرة (تأميم السياسة) التي تعني أن تكون السياسة ملكًا لجميع السوريين ولا تقبل الخصخصة، ما يعني تحرير التمثيل السياسي من مغتصبيه، سواء أكان نظام الأسد أم سواه، سعيًا إلى استعادة السوريين قرارَهم أو مبادرتهم الوطنية، وهي الفكرة ذاتها التي يتضمنها البند الأول من وثيقة المبادرة. ومن الأفكار التي تضمنتها المقالة المذكورة، التأكيد أن حياة المواطن السوري وأمنه وكرامته هي ما يجب وضعه وصونه (في نطاق تفكير السياسة السورية المركزي)، وبذلك تغدو (مناهضة كل خطاب يدعو إلى القتل أو إلى التضحية بالنفس أو إلى أي فعل يحتفي بالموت) أمرًا منافيًا لمبدأ الحفاظ على الحياة والأمان والكرامة والحرية. ولعل هذه الفكرة قد جاءت أيضًا في تضاعيف المبدأ الثاني للمبادرة. ولم تخلُ المقالة المذكورة من الإشارة إلى ضرورة تعزيز الثقة بين السوريين، وذلك من خلال (العودة إلى الثقة الكلاسيكية المتجذرة في المجتمعات المحلية السورية، والارتقاء بها خطابيًا إلى المستوى السياسي، لاستثمارها في زيادة مراكمة رأس مال اجتماعي وطني، واستثمارها في أنظمة أكثر ملاءمة للزمان وللمشروع الوطني….). وهذه الفكرة نراها مُتَضمّنةً بوضوح في البند الخامس من وثيقة المبادرة.
لعلّ بناء الرؤى والتصورات السياسية، على حوامل فكرية تستلهم قيم الحداثة وحقوق الإنسان، هو أمرٌ توجبه الحالة القائمة في ظل التشعّب المزمن واستمرار معاناة السوريين، فكلّما ازداد المشهد السوري تأزّمًا ومأسويةً، باتت الحاجة إلى التفكير الهادئ الرصين أكثر جدوى من الركون إلى ردّات الفعل والمواقف المؤسَّسة على مجرّد النزق، ولعلّ هذا ما حاولت المبادرة تجسيده، من خلال توجهها إلى مخاطبة عقول السوريين المتمثلة في شرائح المثقفين والساسة والناشطين، وفي الوقت نفسه حاولت الابتعاد عن لغة التجييش والشحن العاطفي، ولعلّ هذا الأمر هو ما يجعل المبادرة أكثر استجابة للحوار والنقاش.
2 – يؤكد البند الرابع من نص الوثيقة ضرورة أن (يدبّر البشر العاديون خلافاتهم بالحوار لا بالعنف، وهذه الإنسانية العادية جوهر حريتنا وتجسيد كرامتنا ومصدر ذواتنا السياسية الوطنية)، تستوقفنا في المقبوس السابق عبارة (الإنسانية العادية)، إذ تحيل على مفهوم حظي باهتمام الباحث مضر الدبس في أكثر من مقالة، ونعني مفهوم (الإنسان العادي) الذي يحمل أكثر من توصيف، بحسب الدكتور مضر، إذ هو الإنسان غير المؤدلج تارةً، وهو المنتمي بفكره ووعيه إلى ما بعد عام 2011 تارة أخرى، وهو كذلك الإنسان الذي لا ينتمي إلى النخب الحاكمة والمتسلطة، وهو أيضًا الحامل لمشروع الثورة والتغيير. ولعل هذا الأمر دفع البعض إلى تعقّب مصطلح (الإنسان العادي) لدى عالم الاجتماع الألماني يورغن هابرماس 1929 الذي طرح مفهوم (الفضاء العمومي) كمساهمة في إنقاذ الحداثة الغربية من جرّاء انكفاء الأفراد عن المشاركة السياسية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن محاولة الدكتور مضر الدبس استثمار مفهوم (الفضاء العمومي)، في معرض تركيزه على المعنيين بعملية التغيير في سورية، هي استثمار موفق وفي مكانه، ذلك أن أصالة أي فكرة أو مفهوم إنما تكمن في إمكانية تحوّله إلى مشروع، وعندئذٍ لا يغدو هذا المفهوم أو تلك الفكرة أسيرة مرجعياتها الفلسفية، بل تكون في متناول الجميع.
3 – لم تبشّر المبادرة المذكورة بإعلان ولادة كيانٍ سياسيٍّ جديد، إذ هي لم تستبق الأفكار بالتأطير التنظيمي، وربّما كان ذلك تأكيدًا للخروج عن التجارب النمطية التي ثبت عقم كثير منها طوال السنوات السابقة، بل يمكن الذهاب إلى أنّ مشروع المبادرة يتقوّم على دعوة الآخرين إلى خريطة تفكير جديد، من شأنها أن تكون في المستقبل حاملًا لكيان سياسي يكتسب قوته وقدرته على الصمود من صلابة حوامله الفكرية، وقدرة المفاهيم الناهضة به على أن تكون مقنعة للسوريين وقادرة على رفد المشهد السياسي السوري بما هو نوعي ومفيد.
4– لعلّ كونَ المبادرة المذكورة مُنجزًا سوريًّا منبثقًا من تفاهمات وتوافقات بينية سورية بعيدًا عن أي إملاءات أو أجندات خارجية، من دون الوقوع تحت هيمنة التمويل والارتهان لمصادر الدعم بمختلف أشكاله، إنما يمنح المبادرة مزيدًا من الصدقية، بل ربما يكون المصدر الأساس لمشروعيتها، فضلًا عمّا يجسّده من انسجام مع أهم طروحاتها الرامية إلى استعادة القرار والمبادرة الوطنية والاستقلال عن أي نفوذ خارجي، مع التأكيد أنّ هذا النزوع نحو تحصين الذات لا يعني الانعزال أو الانطواء وعدم التفاعل مع المؤثرات والأطراف الدولية، بقدر ما يعني تحسين شروط الذات الوطنية لتكون أكثر ندّية في التعاطي مع الآخر الخارجي.
5 – لعل نشر الوثيقة مجرّدةً من خريطة طريق وفق جدول زمني يُفقِدها كثيرًا من حيويتها وقدرتها على الإقناع؛ إذ إن المطّلع على نص الوثيقة لا يمكنه معرفة الخطوة التي يمكن أن تكون تالية لنشر الوثيقة، ولعل هذا ما دفع القائمين على المبادرة إلى استدراك هذا الجانب، وذلك بتوضيح يبيّن الخطوات التالية لنشر الوثيقة، وفي ما يأتي تلك الخطوات أو المراحل، كما جاءت في التقرير الأول الذي أصدره القائمون على الوثيقة، بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2024:
المرحلة الأولى: إعلان الوثيقة استنادًا إلى رمزية المناطق الثلاث، وكان الهدف منها إطلاق المشروع والتعريف بنيّاته وأدواته ومقارباته، وتحقيقه أكبر انتشار ممكن. والثانية: توسيع انضمام مناطق جديدة إلى الوثيقة، وتدارس سبل التطوير ومكامن الضعف، ورصد التفاعل معها، وما يزال العمل جاريًا فيها حتى الآن. والثالثة: العمل على بناء تصور لآلية منظمة للتنسيق المشترك بين المناطق، تشارك فيه جميع المناطق المنضمة، بالتعاون مع القوى السياسية السورية التي أعلنت تأييدها.
تزامن إطلاق المبادرة مع استمرار الحراك السلمي في السويداء:
ما من شك في أن انطلاقة الحراك السلمي في مدينة السويداء في شهر آب/ أغسطس من العام الفائت، كموجة ثانية من حراك الثورة السورية، قد أحدثت منعطفًا نضاليًا بالغ الأهمية في سيرورة الثورة السورية المتعثرة على العموم، ولعل أهم علائم هذا المنعطف هي عودة فكرة الثورة إلى الأذهان من جديد، بعد أن راهن كثيرون على موتها أو اندثارها، وكذلك أسهمت تظاهرات السويداء في تبديد ركام الإحباط واليأس الذي أوشك أن يتحوّل إلى حالة عامة لدى السوريين، وذلك بفعل عوامل عدة، منها ما له صلة بالإرادات الدولية وانحيازها إلى مصالحها وأولوياتها السياسية، ومنها ما له صلة بحالة العطالة والبؤس السياسي الذي وَسَم أداء الكيانات الرسمية للمعارضة السورية، وعدم قدرتها على تحقيق أي منجز حتى في المستوى الإنساني في ما يخص قضايا النازحين في الداخل السوري. وفي غمرة هذا الركود، جاء حراك جبل العرب ليؤكّد أن قدرة نظام الأسد على قتل السوريين والتنكيل بهم، بارتكاب المجازر والاعتقال والتهجير، لا تعني أبدًا أنه قادر على إطفاء جذوة الثورة التي يمكن أن تعود إلى الاشتعال متى وجدت الظروف المؤاتية.
وما من شك أيضًا في أن مجمل المطالب التي تصدّرت خطاب المتظاهرين والشعارات التي رفعوها قد جسّدت رسائل مهمّة وشديدة الوضوح إلى المجتمع الدولي، تؤكّد تمسّك الحراك بطابعه السلمي ورفضه أي شكل من أشكال العنف، وذلك في مقابل المستوى العالي للتوحّش لدى قوات الأسد.
ولكن بالمقابل، لا بدّ من مواجهة السؤال الذي بدأ يتكرر بإلحاح في أذهان كثيرين، ومنهم أصحاب حراك جبل العرب أنفسهم: ما هي المآلات الفعلية لهذا الحراك السلمي؟ ولا سيما في ظل قدرة نظام الحكم على محاصرته وتطويقه ومنع انتشاره إلى مدن ومناطق سورية أخرى، ولئن كان من الصحيح أن حراك السويداء استطاع أن يحظى بتعاطف محلّي ودولي، فإن هذا التعاطف لم يُترجم إلى خطوات إجرائية فعلية، لا من جهة القوى السياسية في سورية وفي مقدمتها الائتلاف، ولا من جهات دولية أخرى اكتفت بالدعم المعنوي الإعلامي للمتظاهرين فقط، ومن هنا يمكن الاعتقاد بأن مبادرة (وثيقة المناطق الثلاث) ربما جسّدت جزءًا كبيرًا من الإجابة عن السؤال السابق، ولكن كيف؟ ولماذا؟
حضور الثورة وغياب السياسة
لعل الإشكالية التي تواجه الحراك السلمي في السويداء هي ذاتها الإشكالية التي واجهها الحراك السلمي السوري العام في الأشهر الأولى لانطلاقة الثورة، ولئن استطاع المتظاهرون آنذاك، في سائر المدن والبلدات السورية، أن يهزموا الهيبة الأمنية للسلطة الحاكمة، ويفرضوا حضورهم السلمي في الساحات والشوارع، ويؤكّدوا مطالبهم المشروعة بالتحرر من طغيان السلطة وحقّهم في التغيير نحو دولة القانون والكرامة والحريات، فإن هذا الحضور بحدّ ذاته هو مُنجَزٌ ثوري عظيم، ولا يمكن مطالبة المتظاهرين أو الشارع الثائر بأكثر من ذلك، ولكن القيمة الجوهرية لهذا المنجز الثوري أو الثمرة الفعلية لهذا المنجز إنما تكمن في إمكانية تحوّله إلى مواقف سياسية، أي بانتقاله من طور الثورة إلى طور السياسة، وهذا الانتقال مرهون بوجود قوى سياسية فاعلة على الأرض من جهة، وقادرة على التنسيق مع قوى الحراك الميداني من جهة أخرى، ولعل هذا الضرب من التكامل ما بين (الثوري والسياسي) هو ما كان غائبًا عن المشهد السوري في أطواره السلمية، ولعل هذا الاختلال في التكامل كان أحد الأسباب التي عزّزت البون الواسع بين التضحيات العظيمة للسوريين وضحالة المنجز السياسي الذي لا يرقى إلى تلك التضحيات.
ولعلّ ما هو راجح أن معظم هواجس الخوف والقلق على مستقبل الحراك في جبل العرب إنما تنبعث من الشعور بوحدانية الحراك وافتقاره إلى التمثيل السياسي الفاعل الذي يحظى بقبول أهل الحراك، ولعله من الصحيح أن المرجعيات الدينية في السويداء تقوم بدور شديد الأهمية، وتثبت كفاءة عالية في إدارة الحراك وتوجيهه، حيث نجحت تلك المرجعيات الدينية حتى الآن في الحفاظ على النهج المتوازن في التعاطي مع سيرورة الأحداث، وتحصين الحراك من جميع الاختراقات، ولكن في النتيجة لا بدّ من تمثيل سياسي يتجسد بأطر تنظيمية تحظى بقبول الحراك وتعبّر عن تطلعاته. وما دامت هذه الأطر غائبة في حدود ما هو معلوم، فيمكن الذهاب إلى أن أحد البواعث الكامنة وراء إطلاق (وثيقة المناطق الثلاث) هو شعور القائمين عليها بالمسؤولية عن هذا الغياب من جهة، وبالحاجة الشديدة إلى استدراك هذه الثغرة، سعيًا إلى رفد الحراك الثوري بمقوّمات استمراره ونجاحه من جهة أخرى. أضف إلى ذلك -وربما هو الأهم- سعي القائمين على الوثيقة إلى إعادة الوشائج الثورية، بين حراك جبل العرب ومعظم أشكال الحراك الثوري في البلدات والمدن السورية، أي التعاطي مع انتفاضة السويداء بوصفها امتدادًا لثورة السوريين من جهة، والعمل في الوقت ذاته على قطع الطريق أمام المساعي الرامية إلى اختراق الحراك، من خلال اتهامه بالمناطقية والطائفية من جهة أخرى، فما هي مقوّمات النجاح في مسعى وثيقة المناطق الثلاث حيال هذا الهدف؟
وثيقة المناطق الثلاث في مرآة القوى والجماعات السورية
سبقت الإشارة إلى أن وثيقة المناطق الثلاث تجسّد دعوة للتفكير الجمعي ضمن محدّدات معرفية ووطنية معيّنة، أو هي خطوة لبناء (رأس مال اجتماعي وطني، تنبثق منه مقاربات وطنية تشاركية ومتماسكة للقضايا الوطنية الكبرى)، بحسب تعريف القائمين على الوثيقة في ملحق توضيحي أعقب صدور الوثيقة. أطلق هذه المبادرة مثقفون وأكاديميون وناشطون، ولم تكن دعوة سياسية ذات برنامج محدد يطلقها حزب أو جماعة سياسية، وهذا يعني أن السمة الطاغية على الوثيقة هي السمة المعرفية، وإنْ كانت تتضمّن -بحكم توجهها- أهدافًا سياسية، ولعله من الطبيعي في هذه الحال أن تلقى الوثيقة اهتمامًا لدى القوى والأحزاب والكيانات السياسية وقطاع النخب من مثقفين وناشطين، أكثر مما تلقاه في أوساط العامة التي غالبًا ما تأخذها المبادرات ذات التجليات الفعلية المباشرة أكثر مما تجذبها الوثائق المعرفية، وبناء على هذا المعطى، يمكن القول: إن نسبة التعاطي أو التفاعل مع الوثيقة تُظهر حضورًا إيجابيًا، يمكن تلمّسه بانضمام عدد من الكيانات والتجمعات السياسية إلى المبادرة المذكورة، وفي ما يأتي أسماء الكيانات السورية التي أعلنت انضمامها إلى وثيقة المناطق الثلاث حتى تاريخ 30 نيسان/ أبريل 2024:
السويداء: الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني – تيار السلام الديمقراطي – تجمع (هدف) – بلدة الكفر – مجموعة من نساء السويداء.
الجولان: الحراك الوطني الديمقراطي، عبرَ بيان منشور بتاريخ 21 آذار/ مارس 2024.
الساحل السوري: تجمع العمل الوطني، عبر بيان منشور بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2024.
إدلب: (مجموعة من السوريين الوطنيين في إدلب) وفقًا لنص بيان منشور بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2024.
الحسكة: الهيئة السياسية لمحافظة الحسكة، عبر بيان منشور بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2024.
حمص: مجلس محافظة حمص – نقابة مهندسي حمص – مجموعة من الشخصيات المدنية والسياسية. عبر بيان منشور بتاريخ 28 نيسان/ أبريل 2024.
القوى والكيانات السياسية التي أبدت موقفًا إيجابيًا مؤيدًا للوثيقة:
(الهيئة الوطنية السورية، حزب اليسار الديمقراطي، التحالف السوري الديمقراطي، الحركة التركمانية الديمقراطية السورية، حزب الشعب الديمقراطي السوري: الهيئة القيادية، مجلس سوريا الديمقراطية، مجموعة من الأكاديميين والمثقفين السوريين)، علمًا أن تأييد (مجلس سوريا الديمقراطية) للمبادرة قد أثار ردات أفعال لدى أطراف عدة، الأمر الذي دفع البعض إلى اتهام الوثيقة بأنها ربما تذهب باتجاه (الفدرالية)، نتيجة تأييد (قسد) لها، ولعل هذا ما دفع القائمين على المبادرة إلى التنبيه إلى هذا الأمر في التقرير الذي صدر لاحقًا لنشر الوثيقة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن عددًا من السوريين، منهم أفراد ومنهم كيانات أو جماعات سياسية أو اعتبارية، كانوا قد أبدوا تأييدهم ودعمهم لمضمون الوثيقة وما تمثله من توجهات عبر مراسلات وأقنية خاصة، وذلك لأسباب أمنية لوجودهم إما في مناطق سيطرة قوات الأسد، أو في مناطق أخرى تسيطر عليها سلطات أمر واقع ليست أقلّ استبدادًا ومصادرة للرأي الآخر من نظام الأسد. بل إن بعضًا ممّن تجرأ على إبداء موقف إيجابي وصريح من الوثيقة قد تعرّض لتحذيرات قاسية، وربما تعرّض البعض لتهديد مباشر بالسلاح، من جانب جهات عسكرية نافذة في بعض المناطق والمدن، وذلك وفقًا للقائمين على الوثيقة.
في نقد الوثيقة والاعتراض عليها:
أثار صدور الوثيقة جملةً من ردات الفعل، راوحت ما بين مُرحّبٍ ومُقدِّر لمسعاها، لكنه ناقد لبعض جوانبها في الوقت ذاته، ورافض لها بالمطلق، إذ لا يرى فيها ما يقدّم للحالة السورية أي جديد، وفي ما يأتي أبرز أوجه الاعتراض:
1 – ثمة من يرى في (وثيقة المناطق الثلاث) محاولة جدّية لمواجهة المشهد السوري القاتم، ومسعًى مخلصًا لإيجاد اختراق نوعي للحالة الراكدة، ولكن نبل المقصد لا يعني بالضرورة سلامة المسعى، ولعل أبرز ما جسّد هذا الاتجاه مقالة الأستاذ علي العبد الله، في موقع العربي الجديد[4]، وهي منشورة بتاريخ (1 – 5 – 2024)، إذ يرى فيها أن (العبرة في النهاية ليست في الإعلان عن القدرة على تحقيق الهدف، بل في توفير شروط تحقيقه، خصوصًا شرطي المعقولية….. والعملية، أي إن تكون المبادرة قابلة للتنفيذ في الشروط والتوازنات القائمة)، وبناء عليه يأخذ أصحاب هذا الرأي أولًا أن عدم الإفصاح عن أسماء القائمين على المبادرة يفتح بابًا للشك ولمزيد من التساؤلات التي لا تلقى جوابًا، وكان الأحرى -وفقًا لأصحاب هذا الرأي- أن تكون الوثيقة نتيجة حوارات شفافة وواسعة بين شخصيات معروفة السيرة بين الجمهور العام، الأمر الذي يضفي نوعًا من الصدقية على نص المبادرة. مع التأكيد أن الإفصاح عن مطلقي المبادرة، ولو كان عددهم محدودًا جدًا، لا يعيب المبادرة ولا يتنقص من قيمتها، باعتبار أن المبادرات غالبًا ما تكون نتيجة جهد عدد من الأفراد ثم تُعمم. ويأخذ أصحاب هذا الرأي على الوثيقة نزوعها (النخبوي والتجريدي)، الأمر الذي يجعل قبولها ورفضها متساويًا….. كما يجعل نجاحها شعبيًا موضع تساؤل). ويقف أصحاب هذا الاتجاه عند المناكفات التي حصلت بين وثيقة المناطق الثلاث، والوثيقة التي تلتها من جهات أخرى، وتدعى بوثيقة المبادئ الخمس، وكان الأجدى أن يتم التفاهم بين القائمين على الوثيقتين لدمجهما معًا والخروج بوثيقة واحدة، بدلًا من حساسية التنافس التي لا تصبّ في مصلحة الوثيقتين معًا.
2 – أما الطرف الرافض للوثيقة رفضًا كلّيًا، فيرى فيها نزعة مناطقية من شأنها أن تسهم في تكريس حالة التشظي القائمة في البلاد السورية، ومنهم من رأى أن الوثيقة تعزز نزوعًا انفصاليًا بدأته (قسد)، وربما تتلوها محاولات أخرى، ومنهم من اتهم الوثيقة بأنها تحمل نزعة ثقافوية لن تملك القدرة على إحداث أي تغيير في الواقع السوري. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل أشكال الرفض وصيغه هذه جاءت عبر وسائل التواصل، ومن خلال منشورات أو مواقف مختصرة، ولم يلجأ أصحابها إلى التعبير عن رفضهم عبر مواقع أو صحف ذات طابع رسمي.
3 – تجدر الإشارة إلى أن مجمل المواقف، سواء المؤيدة أم الرافضة لنص الوثيقة، إنما انبثقت من شرائح وقوى سياسية ومدنية سورية، هي جميعها من خارج الأطر الرسمية للمعارضة، أمّا مؤسسات المعارضة كالائتلاف أو هيئة التفاوض أو الحكومة المؤقتة، فإن أيًّا منها لم يُصدر أي ردّ أو موقف أو تعليق، والأمر ذاته ينطبق على فصائل (الجيش الوطني) وقادته.
خلاصة
لعلّه من الصعب الوصول إلى مقاربة دقيقة ومُنصفة لمبادرة (وثيقة المناطق الثلاث)، من خلال الاعتماد على معايير أحادية الجانب تختزل فحوى المبادرة بنتائجها الحسية المباشرة فحسب، ومن غير المقبول أن يكون تقييم المبادرة خاضعًا لمعايير ثقافوية، لا تأخذ بالحسبان فداحة المأساة السورية، وحاجة السوريين إلى ما يُسهم في وقف النزيف واختصار الألم. ووفقًا لذلك، فإن الذي يتوقع أو يطالب بمردود عملي يشبه المُنتج السحري لهذه الوثيقة هو بالتأكيد واهم، وأما الذي لا يرى في الوثيقة سوى نزعة ثقافوية نخبوية فهو غير منصف، ذلك أن واقع القضية السورية وما يشهده من تعقيدات، في المستوى السياسي والميداني، لا يمكن اختراقه أو إحداث تغييرات نوعية في بنيته من خلال جهد أحادي الجانب تبادر به جماعة ما أو كيان ما، بل يحتاج إلى جهد دؤوب وتراكمي، يعمل على إنشاء نواة عمل وطني يمكن أن تكون أساسًا لمشروع وطني يأخذ بالاتساع ويحظى بمساهمة أطياف وطنية على امتداد الجغرافيا السورية. وبالنظر إلى مضمون الوثيقة؛ نجد أنها تنطوي على محدّدات جوهرية تتقاطع مع تطلعات معظم السوريين الذين ما يزال يحدوهم الأمل بالتغيير، فضلًا عن سعيها إلى استعادة الثقة بين السوريين، والدعوة إلى الإخلاص لصوت الحراك الشعبي السلمي الذي يمكن أن يكون الوسيلة النضالية الأقوى التي لم يستطع نظام الأسد مصادرتها أو الإجهاز عليها. ولئن كان من طبيعة الثورات في العموم أنها ذات سمة إبداعية في سيرورتها، فإن أحقية السوريين بمواكبات إبداعية لثورتهم يغدو ضربًا من الواجب، ولا أعتقد أن استمرار التفكير في مبادرات وطنية والسعي لتطويرها -كصنيع هذه المبادرة على سبيل المثال- يبتعد كثيرًا من أن يكون استجابة إبداعية يمليها الواجب الأخلاقي، قبل أي وازع آخر.
[1] أعلنت وثيقة المناطق الثلاث في مقطعَي فيديو: الأول بصوت وصورة الشيخ أحمد الصياصنة من درعا البلد، والثاني بصوت وصورة عدد من الناشطين من بلدة القريّا في السويداء.
[2] أصدر القائمون على الوثيقة تقريرًا مفصلًا عن سيرورة عملهم، في 30 نيسان/ أبريل 2024، يتضمن مزيدًا من الإيضاحات ذات الصلة بالوثيقة، فضلًا عن الجهات التي انضمت إلى الوثيقة أو أيدتها وتفاعلت معها.
[3] من المقالات التي استندت إليها الوثيقة:
– مضر الدبس، تأميم المعارضة السورية.. المهمة اللازمة، العربي الجديد، 21 – 10 – 2021 الرابط https://2u.pw/XR4CXvWO
– مضر الدبس، السوري العادي والسوري المقلوب، العربي الجديد، 25 – 4 – 2022 الرابط https://2u.pw/0Gqm7
[4] علي العبد الله، وثيقة المناطق الثلاث.. قراءة نقدية، العربي الجديد، تاريخ النشر 1 أيار 2024، شوهد في 10 أيار 2024، الرابط: https://2u.pw/Q09FlBDl
المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة