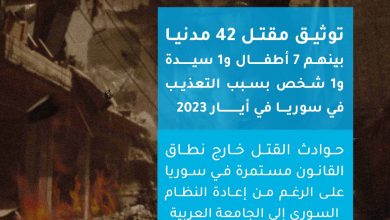منذ أغسطس/آب 2023، تشهد محافظة السويداء مظاهرات منتظمة تطالب بتغيير نظام بشار الأسد. تأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد مرور اثني عشر عاماً على الانتفاضة الشعبية التي تحولت إلى حرب أهلية، من طرف الطائفة الدرزية التي حرصت حتى الآن على الحفاظ على حيادها.
عندما طلبت مني إدارة موقع “أوريان 21”، كتابة مقال لتسليط الضوء على ما يحدث في محافظة السويداء السورية، وشرحه لقارئ أجنبي غير متخصص (ذلك أن المقال سيُترجم بالفرنسية)، شعرتُ بالسعادة. إذ لطالما كتبتُ بالعربية أو بالإنكليزية، ولم يسبق لي أن خاطبت قارئاً فرنسياً، وأنا الذي أعيش كلاجئ في باريس منذ خمسة أعوام. لكن، سرعان ما اكتشفت صعوبة المهمة. إذ كيف يمكن كتابة مقال توضيحي لقارئ فرنسي، عن قضية شرق أوسطية شديدة التعقيد، لها دينامياتها وتاريخها وسياقها، من دون الغوص في التفاصيل؟ مقال يجيب عن سؤال بسيط من النوع التالي: كيف يمكن لمنطقة سورية حدودية طرفية، تسكنها أقلية إثنية صغيرة، أن تحتج سلمياً في العام 2023، مُطالبةً بالتغيير السياسي؟
سؤال يستدعي قبل البدء بالإجابة عنه، التوضيح بأن المفاجئ في هذا الاحتجاج الأهلي السلمي في السويداء، أنه جاء بعد 12 عاماً من ثورة السوريين في العام 2011 ضد النظام الديكتاتوري الذي يحكم منذ ستة عقود من دون أي انتخابات حرة. آخر عقد، شهد حرباً أهلية تسببت في مقتل حوالي نصف مليون شخص، ونزوح ولجوء ستة ملايين شخص داخلياً وخارجياً، واعتقال مئات الآلاف، وتدمير مدن وحواضر بأكملها، وتقسيم البلد بين خمسة جيوش أجنبية لكل منها قواعد عسكرية ومناطق نفوذ. حرب شهدت على نطاق واسع، تنفيذ جرائم ضد الإنسانية، وتطبيق سياسات تصفها علوم الاجتماع بالتغيير الديموغرافي أو الهندسة الاجتماعية، وفي حالات خاصة بالتطهير الإثني. كل ذلك العنف، يجري في بلد تعيش أزمات معاصرة أيضاً، ليس أقلها التغيّر المناخي الذي يهدد سبل العيش للسكان.
حفلات ومهرجانات احتجاجية
فلنبدأ هكذا: تتواصل الاحتجاجات السلمية في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا منذ شهر أغسطس/آب، وسط تجذّر واضح في مطالبها، وتنظيمها، وأشكالها، ووسائلها. قرّر الأهالي أنه قد حان الوقت لإنهاء حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم منذ العام 1963 في سوريا، فأغلقوا مقاره على امتداد المحافظة، أو استعادوها وهي بحكم الأملاك العامة، وأعادوا افتتاحها كدور حضانة، أو مدارس، أو نقاط طبية، أو حتى مقرات تنمية مجتمعية. تحاول الاحتجاجات التعامل مع مجموعة متنوعة من وسائل النضال السلمي، عبر احتفالات يومية في مختلف الساحات العامة الرئيسية في مدن وبلدات وقرى المحافظة الـ130. أيضاً، تشارك شريحة نسوية كبيرة ومتجذرة واضحة المطالب والصوت، في لون أصيل ضمن الاحتجاجات. حفلات موسيقية، أغان، مهرجانات تشارك فيها وفود أهلية، عروض خيول، وعروض فولكلورية، وأغان شعبية وأخرى مرتجلة لتناسب الأحداث، وتعطي بُعداً سياسياً إضافياً لعمق الأسباب المباشرة للاحتجاجات، وعجز النظام الحاكم عن المشاركة في حلها.
تحظى هذه الاحتجاجات بدعم أهلي واسع النطاق، وقد انضمت إليها شرائح واسعة من الموظفين في المؤسسات الحكومية والرسمية، والمحسوبين تاريخياً على فئة الموالين المستفيدين من النظام. لكن أولئك الموظفين، وعموم الطبقات الوسطى، باتوا من المتضررين فعلياً من الفشل الخطير الذي تعيشه الدولة السورية، في إدارة أي من الملفات المعيشية الضرورية؛ كسعر صرف الليرة السورية، القدرة الشرائية، الأجور والرواتب، أزمة المحروقات، التقنين الكهربائي، مياه الشرب، البنى التحتية، الصحة، التعليم والقضاء. الدولة مُفلسة، وتعتمد في تمويلها بشكل رئيسي على تشغيل الناس من دون مقابل حقيقي. فالمهم، بالإضافة إلى استمرارية حياة الرفاه الفاخر لأعضاء نادي السلطة، هو تأمين حصة الأجهزة الأمنية والعسكرية الرئيسية، والإبقاء على جهاز الإنعاش للماكينة البيروقراطية العملاقة للدولة.
انتصار بطعم الخسارة
الاحتجاجات الحالية، جاءت رداً مباشراً على تحرير الحكومة الأخير للأسعار. وهذا التحرير للأسعار، ليس إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل تدهور قيمة الليرة السورية والقدرة الشرائية، ومعاناة الناس من مخاطر المجاعة، خصوصاً أن أكثر من نصف السوريين باتوا يعانون جدياً من انعدام الأمن الغذائي. هذا التدهور بدأ بالتسارع منذ أن تراجع نسبياً الطور المسلح من الحرب في العام 2018، في انتصار بطعم الخسارة، حققته قوات النظام عسكرياً على المتمردين في ريف دمشق ودرعا وحمص، وتهجير المعارضين وحواضنهم المحلية قسرياً إلى شمال غربي سوريا. انتصار تسبب بدمار واسع النطاق لحواضر ومدن ومناطق بأكملها ولشبكات الطرق والكهرباء والبنى التحتية على امتداد الساحة، وتغيير ديموغرافي استهدف سكان الأرياف السنّية، وسكان بعض أكبر مدن العشوائيات المحيطة بالمدن الرئيسية الكبرى مثل حلب ودمشق. انتصار النظام في بُعده الأكثر مرارة، هو انتصار على الدولة والمجتمع بالقوة. انتصار عسكري لا يمكن تصريفه بأي شكل سياسي، طالما لغة السياسة الوحيدة التي يفهمها النظام هي الحرب.
الاحتجاجات الأخيرة، أو كما يفضل الأهالي تسميتها بالانتفاضة الشعبية، تأتي تتويجاً لحراك احتجاجي طويل في السويداء، منذ العام 2011. إذ استمرت أول موجة احتجاجية سلمية من العام 2011 إلى العام 2014، وتميّزت بنخبويتها وقلة عدد المشاركين فيها، وشعاراتها السياسية المعارضة للنظام. في العام 2020 ظهرت موجاتٍ أكثر اتساعاً ومطلبيّة، وسط مشاركة شبابية كثيفة فيها، مثل حملات “خنقتونا” و“بدنا نعيش”. هبّة العام 2022، توجهت ضد العصابات الأمنية المسلحة، وقد قادتها فصائل محلية مسلحة.
“تحالف الأقليات”
والسويداء تصنف ضمن مناطق النظام التي تشهد سيطرة هشة له. ويعود ذلك إلى أنها منطقة طرفية في سوريا، لا يمر فيها أي طريق دولي، وليس فيها معبر حدودي رغم تشاركها حدوداً طويلة مع المملكة الأردنية، كما لا تتضمن ثروات أو موارد طبيعية يحتاجها النظام. المنطقة تسكنها الأقلية الدرزية التي تشكل حوالي 3% من سكان سوريا، وتعدادها لا يتجاوز نصف المليون نسمة في السويداء اليوم.
منذ بداية العام 2011، فضّل النظام السوري عدم التدخل الأمني المباشر في السويداء، لمنع الاحتكاك مع الدروز، وإبقائهم إلى صفه في الصراع المسلح مع السنّة الذين يمثلون ما نسبته 70% من السوريين. إذ تسيطر على دائرة صنع القرار في سوريا، وعلى قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأبرز المؤسسات الحكومية والوزارات، غالبية علوية، رغم أن العلويين لا يمثلون أكثر من 12% من السوريين. وفي مواجهة سردية الثورة السورية القائلة بأن الشعب السوري يريد إسقاط النظام، فضّل النظام تقديم سرديته الخاصة القائلة بتحالف الأقليات في سوريا في مواجهة الخطر السنّي المتطرف. ولهذا، سمح النظام بهامش حركة أهلية ضئيل في السويداء، كما فعل الأمر ذاته بشكل أوسع وأكثر منهجية في مناطق الأكراد شمال شرقي سوريا. وبالفعل، تراجع مع الوقت، الحضور المسلح للجيش السوري، وكذلك، حجم التدخل الأمني المباشر في شؤون الحياة اليومية للناس. ولذا، ظهرت في السويداء منذ منتصف العام 2014 جماعات أهلية مسلحة، لحماية مناطقها وأبرزها حركة “رجال الكرامة”، بالإضافة إلى طيف واسع من الميليشيات الموالية والمجموعات الأمنية التابعة للنظام. هذا الهامش الضئيل من الحركة الأهلية، ووجود قوى مسلحة محلية، سمحت للسويداء باتخاذ موقف الحياد تجاه الحرب، منذ العام 2014. إذ منع الدروز أبناءهم، بالاستناد إلى فتوى دينية تحرّم الصلاة على من يُقتلون، من المشاركة في القتال في صفوف قوات النظام حيث الخدمة العسكرية إلزامية. في المقابل، تحولت الجيرة مع فصائل المعارضة المسلحة على حدود السويداء من جهة ريف دمشق ودرعا، إلى علاقة مضطربة ومتوترة مع أسلَمَة المعارضة المسلحة وتطرّفها. واندلعت أكثر من مرة مواجهات أهلية مسلحة بين الطرفين.
الحياد وتّر العلاقة بين النظام والسويداء، فتحولت مع الوقت إلى ما يشبه معتقلاً كبيراً لا يمكن لكثير من شبابها الذكور مغادرته، إذ سيتم توقيفهم وحجزهم عند الحواجز العسكرية والأمنية المحيطة بالمحافظة، لسوقهم للخدمة الإلزامية. تسببت حوادث مماثلة على مر السنوات الماضية في صراع وعض أصابع متواصل بين النظام والمجتمع المحلي في السويداء. وغالباً ما تعقب أي عملية توقيف لأحد أبناء السويداء خارج المحافظة إلى حدوث عمليات توقيف مماثلة، تنفذها عائلاتهم في السويداء لضباط أو موظفين رسميين، لمبادلتهم. إذ لا يصغي النظام السوري في كثير من الأحيان، إلا إذا شد أحدهم بقوة على أصابعه الطويلة.
تهريب الكبتاغون
هذا الحياد، أعطى السويداء فرصة لعدم معايشة الحرب عسكرياً بشكل مباشر، لكنه في الوقت ذاته، تسبب في زيادة تهميشها من قبل حكومة دمشق، وخفض مخصصاتها الحكومية. وما يؤكد ذلك التوجه الحكومي، هو أن معالجة دمشق لكل الملفات في السويداء تركزت فقط على النطاق الأمني، كما حدث في منتصف العام 2015 في تفجير موكب الشيخ وحيد البلعوس، مؤسس حركة “رجال الكرامة”، الفصيل الأهلي المسلح الأكبر في السويداء. قتل الشيخ البلعوس مثّل ضربة قوية وإن كانت غير قاصمة، لأول محاولة أهلية للتنظيم والحماية الذاتية، والذي يدعو علناً للدفاع عن النفس، والحياد الكامل تجاه أطراف الحرب السورية. إهمال النظام للمحافظة بلغ ذروته في نهاية العام 2018، عندما تعرضت قرى المحافظة الشرقية لهجوم دموي نفذه تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتسبب في مقتل مئات المدنيين. وحدها الفصائل المحلية المسلحة من تمكنت من رد الهجوم، من دون تدخل فاعل للجيش السوري. المشكلة الكبيرة التي ظهرت خلال الهجوم، تمثّلت بأن معظم عناصر التنظيم المنفذين للمجزرة، قد جاؤوا من مخيم اليرموك بدمشق إلى صحراء السويداء الشرقية، بموجب اتفاق عقده التنظيم مع قوات النظام برعاية روسية، قبل أشهر، لإنهاء الحرب في المخيم.
مع الوقت، بدأت هذه الفوضى المُدارة أمنياً باكتشاف دور وظيفي للسويداء كمنطقة لتهريب المخدرات إلى الأردن، ومنه إلى الخليج العربي. إذ يتيح هذا الشكل من ضبابية سلطة النظام، والتذرع بالفوضى، هدفَين مباشرَين: عدم تأمين الخدمات للسكان، وتبرير عدم القدرة على ضبط الحدود أمام الأردن. تهريب الكبتاغون إلى الأردن، رافقه إغراق المنطقة بالمخدرات، والعصابات التي نشطت في جميع مجالات اقتصاد الحرب غير الشرعي، كالخطف للفدية، والقتل، والسرقة، وتجارة المخدرات، والسلاح. كل ذلك، كان يدفع الشباب والشابات من السويداء إلى طرق الهجرة بحثاً عن أي فرصة أفضل في أي مكان خارج سوريا.
لذا، لم يكن غريباً، أن الغضب الأهلي، توجه في الاحتجاجات الأخيرة، مباشرة إلى النظام السوري، وطالب بشكل واضح بتغييره، عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 للعام 2015، والخاص بإطلاق عملية سياسية في سوريا، تنتهي بإحداث انتقال سلمي للسلطة بمشاركة النظام، وإقامة نظام تعددي ديموقراطي. إذ أن العملية السياسية مجمدة، ويرفض النظام المشاركة فيها لأنها تتضمن تقاسماً حقيقياً للسلطة مع المعارضة.
محاولات لشق الصفوف
السويداء ليست في لائحة اهتمامات أحد في دمشق. بل، ومنذ اندلاع الاحتجاجات في السويداء، لم يتحدث عنها ولم يزُرها أحد من المسؤولين السوريين في الحكومة، أو السلطة التشريعية، العسكرية، القضائية، أو الأمنية. بل يبدو بأن النظام، وبعد شهرين من الاحتجاجات، وكأنه اعتلى شجرة التجاهل، ولم يجد بعد طريقة لينزل منها. مواجهة الدروز بالعنف، تقوض كامل سرديته عن الحرب ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف. فالدروز تحالف قبلي، يُدينُ بمذهب باطني مغلق، غير معروف عنهم الجهاد ولا التبشير ولا الرغبة في التمدد والتوسع. فلاحون، يعيشون في منطقة تعاني من الجفاف، وقلة مصادر المياه، إضافة لتقلبات الطقس المحيرة التي باتت تؤثر في إنتاجهم الزراعي النوعي من التفاح والعنب والكرز، الزيتون، والقمح والشعير وبعض الحبوب. الدولة عبء ثقيل على الفلاحين، وتحاصرهم بشركات التجزئة التابعة لها، لشراء محاصيلهم بأسعار بالكاد تغطي تكاليف العملية الانتاجية. والمساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، يتم التلاعب السياسي فيها، وإعادة توجيهها إلى شرائح محددة تستهدفها “الأمانة السورية للتنمية” التي تشرف عليها أسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، وهي شريكة جميع المنظمات الدولية المسموح لها بالعمل في مناطق النظام في سوريا.
هذا لا يعني أن النظام لا يعمل على وضع العصي في الدواليب، بل يمارس محاولات حثيثة لشق صفوف المحتجين، وتأليب الأهالي عليهم، واتهامهم بالسعي للانفصال عن سوريا والتعاون مع جهات خارجية ومنها إسرائيل. كما يجند النظام شبكة المنتفعين تاريخياً، من الزعامات الدرزية الدينية والتقليدية، في السويداء وريف دمشق والقنيطرة في سوريا، وفي لبنان أيضاً، للتحريض على المنتفضين. اتهامات لا تجد أي صدى لها في الشارع المنتفض، حيث يبدو أن الناس رغم جوعهم، تعبهم، وقهرهم، ما زالوا مؤمنين بأن الحل الوحيد لهم، ولبقية السوريين، هو تغيير سياسي سلمي حقيقي، يضمن انتقالاً سلمياً إلى دولة ديموقراطية تعددية. وفي هذا الطريق الطويل والصعب، يحاول المنتفضون، الحوار، التفكير، وإيجاد حلول للأزمات اليومية المعاشية التي تخنقهم. حوكمة محلية، من الأسفل إلى الأعلى، في حالة تضامنية افتقدها السوريون كثيراً طيلة العقود الماضية. وفي هذا، مجتمع محلي يحاول، بالحراك الاحتجاجي السلمي، ومن دون الاعتماد على أي حليف داخلي أو خارجي، مواجهة نظام ديكتاتوري تحكمه طغمة عسكرية أمنية خرجت منتصرة في حرب أهلية مدمرة.
هل صار ممكناً القول الآن، أن الصعوبة لم تكن في الكتابة لقارئ أجنبي غير متخصص، بل في كيفية شرح حدوث معجزة في الوقت الحقيقي؟
مازن عزي صحفي وباحث سوري من السويداء، مقيم في باريس.
المصدر: موقع أوريان21