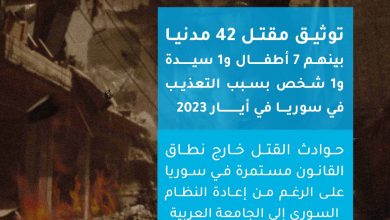ثمّة مشكلات تتخطّى حدود السياسة والحروب والاستبداد، وتتبدّى آثارها المتعدّدة في حياة الناس، فتغيّرها جذريًا وتجعل منها أحيانًا جحيمًا مقيمًا وجرحًا نازفًا لا يبرأ، من هذه القضايا، بل وفي مقدّمتها قضايا المفقودين. هنا يَعملُ الزمنُ بأثر تراكمي على مفاقمة النتائج المترتّبة على فقدان الأشخاص، ليس فقط من ناحية المعاناة النفسية التي يتكبّدها الأحياءُ منهم ويقاسيها ذووهم، بل من ناحية الآثار الاجتماعية المتعدّدة، فتتوقّف مصالح الأسر مثلًا على تبيان مصير المفقودين، حيث ثمّة فرقٌ بين اعتبارهم موتى أم أحياءً، فالأزواج معلقون برابطةٍ لا يُعرف مصيرها إلا بمعرفة مصير المفقود، والآباء والأبناء والإخوة محبوسون بمقتضيات الإرث، كذلك الكثير من الحقوق التي يتوقّف الفصل فيها على التثبّت من حال المفقود المعتبر قانونًا.
في سورية، ومنذ أكثر من 60 عامًا بدأت السلطة السياسية المتمثّلة بحكم الحزب الواحد، ثم الفرد الواحد، بممارسة سياسة الاعتقال خارج القانون والتغييب القسري للبشر. ومنذ ذلك التاريخ، فُقد أشخاصٌ كثيرون لا عدّ لهم ولا إحصاء. ليس السوريون وحدهم ضحايا هذه الممارسات الغاشمة، بل وقع الفلسطينيون واللبنانيون وبعضُ العرب والأجانب أيضًا ضحايا لها أيضًا بحكم الواقع الجغرافي من جهة، وبحكم الواقع السياسي من جهة ثانية، والذي تجسّد في أحداثٍ جسامٍ، خصوصًا منذ تشكيل منظمة التحرير وبعدها النكسة، ومن ثمّ حرب أيلول الأسود في الأردن ثم اجتياح بيروت والاحتلال الذي خضع له لبنان 30 عامًا. تركت هذه الأحداث والمفاصل إرثًا هائلًا من انتهاكات حقوق الإنسان، وكان ملفّ المفقودين والمغيّبين قسرًا واحدًا من أهمّها بالنسبة للسوريين وأقرانهم من أشقائهم العرب وشركائهم في المعاناة.
على الصعيد السوري، كان هناك حدثان هائلان فاقما هذه المأساة، أولهما أحداث حماة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وما رافقها وتلاها من مجازر واعتقالات، والثورة السورية عام 2011 والعشريّة السوداء المستمرّة في فصولها المتعاقبة، بل ودخلت عُشريّتها الثانية. وبمقاربة أوليّة غير دقيقةٍ بكل تأكيد، تتوقّع الأمم المتحدة اختفاء مائة ألف شخص في سورية، بينما تؤكّد المنظمات الحقوقية السورية أنّ الرقم أكبر من ذلك بكثير. يبقى التأكّد من هذا العدد رهنًا بعوامل عديدة لا يبدو في الأفق أنّ ثمّة ما يؤشّر إلى توفر أيّ منها، وفي مقدمة تلك العوامل حصول انتقال سياسي في سورية يجعل بالإمكان فتح ملفات أجهزة النظام الأمنية والعسكرية وفتح أبواب السجون والمعتقلات أمام الفحص والتدقيق.
ضمن ظروفٍ مشابهة لما حصل في سورية بعد الثورة، نشأت في يوغسلافيا السابقة، إثر الحرب الأهلية التي أعقبت تفكّكها، منظمة تُعنى بشؤون المفقودين. جاءت بمبادرة من الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون على هامش قمّة مجموعة السبع الكبار في باريس، وكانت في جزء منها استجابة لمطالبات أهالي الضحايا. تطوّرت المنظمّة التي تأسّست عام 1996 لتصبح ذات طابع دولي عام 2014، عندما وقّع وزراء خارجية هولندا والمملكة المتحدة والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ معاهدة تمنحها وضعًا قانونيًا جديدًا، وأصبح اسمُها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. في سورية، ونتيجة لنضالات عائلات الضحايا السوريين ومنظمّات المجتمع المدني العاملة في مجالات المناصرة والبحث عن الحقيقة والمساءلة، صدر في 29 من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، قرارٌ عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة تمّ بموجبه إنشاء مؤسّسة مستقلّة لجلاء وكشف مصير المفقودين في سورية منذ العام 2011. سيكون على الأمين العام وضع خطّة واضحة لتنفيذ هذا القرار خلال 80 يومًا من تاريخه، على أن يتمّ ذلك بدعمٍ من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، بما يشمل مشاركة الضحايا والناجين والأسر مشاركةً كاملةً ومجدية. فهل ستكون هذه المؤسّسة قادرةً على جلاء مصير المفقودين في سورية فعلًا؟
أثار السفير المصري لدى الأمم المتحدة أسئلة يمكن من خلالها استقراء بعض أوجه العقبات التي يمكن أن تحول دون قيام المؤسسة بمهامها المنوطة بها، والتي لا بدّ أنّها سترفع سقف توقعات الأهالي المكلومين دون أن تحقق لهم شيئًا ملموسًا في القريب العاجل. من بين الأسئلة المصرية عدم تحديد اختصاص المؤسسة بشكل دقيق، وتداخل عملها بشكل غير مفهوم مع عمل المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعدم وضوح التزامات الدول تجاه هذه المؤسسة، وعدم وضوح إجراءات التعامل مع الضحايا والناجين وأسر المفقودين، بالإضافة إلى عدم وجود تعريفٍ واضح للأشخاص المفقودين، وعدم وضوح مصير المعلومات والبيانات التي سيتم جمعها ولا آليات تصنيفها وحفظها واستخدامها. هذا غيضٌ من فيضِ العقبات التي تقفُ كأداءً في طريق تحقيق المؤسّسة أهدافها، ويجب أن نعود لنكرّر أنّ المسؤول الأول، بل والأكبر مسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاعتقال والإخفاء القسري في سورية هو نظام الأسد، وهو قد رفض هذا القرار، وحتى لو قبل به فإنّ سلوكه في السنوات الفارطة كلّها يدلّ على أنّه سيعطّل عملها.
مع ذلك، وكبارقة أملٍ في أجواء الإحباط العامّة في سورية، يمكن القول إنّ البناء على أساس قانوني أمرٌ جيدٌ ومطلوبٌ ولازمٌ، حتى وإن كان غير كافٍ حاليا، فالمستقبل كفيلٌ بإيجاد الظروف التي قد تزيل العقبات أمام المهمّة التي تبدو شبه مستحيلة. كما أنّ النضال السوري لن يتوقّف على هذه المؤسّسة، على الرغم من أهميتها لملفٍ بغاية التعقيد، وبالتالي سيكون علينا، نحن السوريين، أن ننظر إلى الأمر باعتباره خطوة في مضمار الكفاح ضدّ الاستبداد، وأنّ ما لا يُدركُ كلّه لا يُترك جُلّه، وخصوصا أنّه لم يُبق لنا الكثير من ساحات النضال بعد تعثرنا في السياسة وعدم قدرتنا على تشكيل هيئة اعتبارية تمثل الشعب السوري وتحوز ثقته، وتشكّل بديلًا عن نظام الأسد. ما بين الواقع والأحلام تولد الأفكار، وهي تنبت في بيئاتها، فإما أن تثمر تغييرًا نافعًا، أو أن تبقى أضغاثًا لا يقوى على تفسيرها إلا الراسخون في العلم!
المصدر: العربي الجديد