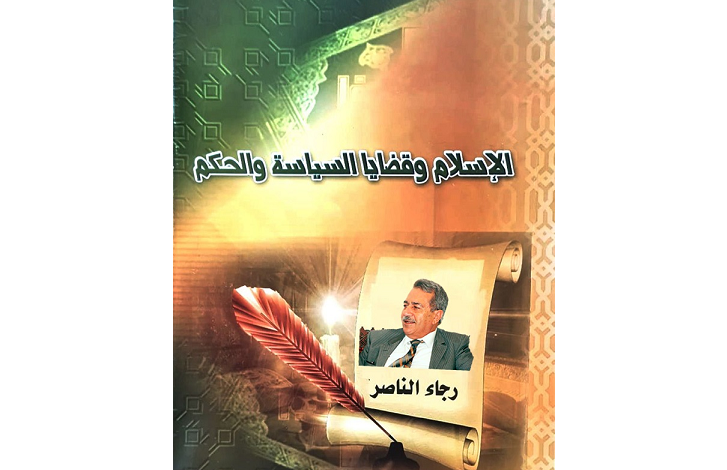
الحلقة الخامسة
طاعة الخليفة، وخلعه، والخروج عليه، ومقاومته عند أهل السنة والجماعة 4 / 5
القضية المركزية في فكر جمهور الفقهاء المسلمين منذ عهد تابعي التابعين في مسألة الخلافة والسلطة، كانت وحدة الأمة الإسلامية وتأمين الاستقرار الداخلي، تلك الوحدة والاستقرار هما المسألتان اللتان لا يمكن أن تتحققا إلا بالتفاف الأمة حول سلطان واحد، يمتلك القوة والقدرة التي تسمح له بتطبيق الوظائف الشرعية المنوطة بهذا المنصب.
ولا شك في أنهم تأثروا كثيرا بحالة الفوضى الشاملة، والاضطراب الشديد الذي عَمَّ البلاد الإسلامية منذ الفتنة الكبرى في زمن الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان، تلك الفوضى والفتن التي استبيحت فيها دماء المسلمين التي تجري انهاراً في طول البلاد وعرضها، واستنزفت فيها طاقات الأمة واندفاعاتها، ولتخلق فيها شروخاً لا تندمل، عندما تفرقت الأمة إلى فئات وجماعات، وتعمقت الخلافات بينها لتطال الكثير من القضايا.
هذه القضية قضية وحدة الأمة وتحقيق أمنها الداخلي، أصبحت مسألة جوهرية بعد أن بدا واضحاً أن تغيير السلطان والقيام عليه وخلعه أمر أكثر تعقيداً، وأشد صعوبة مما تصوره القائمون على الخلافة الأموية.
وعلى ضوء الاعتبار السابق يُحَسم الكثير من الجدل في فهم مبررات مواقف واجتهادات هؤلاء الفقهاء والعلماء حول قضية السلطة، والخلافة. ومن هنا يمكن أن نستوعب مرتكزات إصرارهم الشديد في موضوعة طاعة الخليفة، وتضييق الشروط التي تسمح بالخروج عليه وخلعه، طاعةً عَضُّوا عليها بالنواجذ، بالرغم من رؤيتهم الخلافة الإسلامية وقد تحولت إلى ملك عضوض، بعد أن أُسْقِطَ عنها الكثير من شروطها وصفاتها ومضمونها.
لقد حافظ جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة على هذه المواقف بالرغم من أن بعضهم تعرض للاضطهاد والسجن والتعذيب على أيدي هؤلاء الأمراء الطغاة، وقد نَظّـَروا لمواقفهم هذه ليوجدوا التلاؤم بين هذا الهدف المركزي ـ وهو وحدة الأمة واستقرارها الداخلي ـ والذي اعتبروه رأس المشروعية في نظام الحكم الإسلامي، وبين ما استقرت عليه رؤية المسلمين الأوائل في العهد الراشدي حول طبيعة الخلافة وأسسها وشروطها.
لقد رأينا في المسألة الأولى أن الخلافة الإسلامية قامت على نظام البيعة المرتكز على الشورى، وعلى ترشيح أهل العقد والحل ورضى المسلمين، وتأسست هذه الخلافة على العدل باعتباره جوهر الحكم، فالعدل هو المبدأ العام الذي قام عليه الإسلام، ووضعت الشريعة أعلامه، وليس من المسلمين من لا يستقيم على العدل ولا يحكم به أو ينزل على حكمه (1). لكن مسيرة الخلفاء والأمراء الذين أعقبوا حكم الراشدين، ضربت عرض الحائط بهذه الأسس والمرتكزات والمضامين، فالبيعة أصبحت لا يُطْغى عليها بشدة العنصر الشكلي فحسب والآيل بدوره إلى الانحسار، بل أضحت تُؤْخَذ بحد السيف، وتحولت الخلافة إلى ملك وراثي مطلق، ولم يعد عِلمُ الخليفة وتقواه هما الأصل في شروط اختياره لهذا المنصب.
كانت خلافة الخليفة الأموي الثاني “يزيد بن معاوية” النموذج الصارخ لهذا التحول، سواء في آلية انتقال السلطة، أو حتى في مواصفات وشروط الخليفة المسلم، لقد كان فساده غير قابل للشك. ومع ذلك رضخ الكثير من الفقهاء والعلماء لسلطته، يقول الفقيه ابن تيمية: “يعتقد أهل السنة أنه مَلِكٌ على جمهور المسلمين وصاحب السيف، كما كان أمثاله من بني أمية”، ويقول أيضا: “يزيد في ولايته هو أحد هؤلاء الملوك، ملوك المسلمين المستخلفين في الأرض (2).
ونَظّـَروا لذلك من خلال إحلالهم “الغلبة”، كأحد الأسس المعتبرة في استلام إمارة المسلمين بدلاً عن الشورى، من خلال اعتبارهم “الرضى اللاحق” مثله مثل “الرضى السابق” لتولي هذا المنصب، مثلما تقدم معنا في المسألة الأولى.
وأكدوا على وجوب طاعة هؤلاء الملوك بالرغم من جورهم، مبررين ذلك أيضاً بأن الدين لا يستقيم إلا بوجود الأمير منهم، كما يقول أبو الحسن الماوردي: “يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والفيء والثغور والحدود، لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا، وإن ظلموا…” (3) .
وهذا الرأي يحمله كبار فقهاء مذاهب أهل السنة، فالإمام مالك يقول في كتابه الموطأ عند شرحه لبيعة الرسول f التي جاء فيها: “وألا تنازع الأمر أهله” قال ابن عبد البر: اِخْتُلِفَ في أهله، فقيل هم أهل المُثُلِ والإحسان والفضل والدين، فلا يُنازَعُونَ لأنهم أهله، أما أهل الفسق والجور والظلم فليسوا بأهله، ألا ترى إلى قوله تعالى:(… وَلا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين) [البقرة/124]. وفي منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج.
أما أهل السنة فقالوا: “الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عادلاً محمداً، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه” (4). والرأي عينه يدعو إليه الإمام الشافعي، إذ يقول الشيرازي نقلاً عن الإمام الشافعي: “لا يجوز الخروج على الجائر لِمَا روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من نزع يده من طاعة إمامه، يؤتى به يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية” (5) .
ونرى الموضوع بوضوح أشدّ عندما يرد عن تساؤل حول رأي الإمام أبي عبد الله الشافعي من الموقف حيال الحاكم الجائر: ” إنه لا يخلع بذلك، ولا يجب الخروج عليه” (6) . وتأكيداً لهذا الفهم حول طبيعة الخليفة وطاعته، وعدم التوقف عند شروط البيعة والأهلية، يقول الإمام أحمد ابن حنبل في إحدى رسائله: “الصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل أو جور، ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا” (7) .
ونختم الاستشهادات بقول الإمام المجتهد ابن تيمية “ستون سنة من إمام جائر، أصلح من ليلة بلا سلطان” (8) .
إننا نعتقد أن اجتهادات أولئك الأئمة بصدد الحكام والسلاطين لا يمكن التشكيك في دوافعها ومبرراتها، خاصة وأن معظمهم عرفوا بابتعادهم عن الحكام والسلاطين ومعاداتهم لهم وعلى رأسهم “مالك بن أنس”، و”أحمد بن حنبل”، و”ابن تيمية”، فقد سجنوا على أيدي هؤلاء السلاطين والحكام والخلفاء، وعذبوا، لكنهم ثبتوا على آرائهم.
والدعوة إلى مواجهة السلطان الجائر، ارتكز عليها ما اعتقدوا أنه رئيس وأساسي في وظيفة الخلافة، ألا وهو “وحدة بنية الأمة وحماية استقرارها الداخلي“.
وتأكيداً لهذا المبرر في الاجتهاد بطاعة الأمير الجائر يقول “الزرقاني” في شرحه لـ موطأ مالك: ” أما أهل السنة قالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه، لما فيه من استبدال الخوف بالأمن وإهراق الدماء، وشن الغارات والفساد، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه، والأصول تشهد والعقل والدين، أن أقوى المَكْرُوهَيْنِ أولى بالترك”، ويحدد “أبو حامد محمد الغزالي” المسألة بشكل أدق حينما يقول: “والذي نراه ونقطع به أنه يجب خَلْعَهُ إن قُدِرَ على أن يُسْتَبْدَلَ عنه مَنْ هو موصوف بجميع الشروط، من غير إثارة فتنة ولا تهييج قتال، وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحُكِمَ بإمامته… فإن السلطان الآثم متى سَاعَدَتْهُ الشَّوكَةَ وعُسِرَ خلعه، وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق، وجب تركه، ووجبت الطاعة له” (9) .
النص أعلاء يقطع بأن قولهم بـ “الصبر على السلطان الجائر” لم يكن عن ممالأة، ولا عن تأويل من غير سند، ولا عن جبن أو تخاذل، وإنما عن اجتهاد ارتأوه في مصلحة الأمة، يقوم على قاعدة تغليب الأقل ضرراً على الأشد ضرراً، اجتهادٌ أملته عليهم كثرة الثورات والفتن، وفشل هذه الثورات في تحقيق أهدافها، وتَحوّلِ معظمها إلى مجرد فتن في جسد الأمة، فِتَنٌ ضاع فيها الحق مع الباطل، وأزهقت فيها ظُلْماً أرواح المسلمين.
لكن هذا الاجتهاد في طاعة الأمراء، وعدم الخروج عليهم في كل الظروف -عدا الكفر المبين الواضح الذي أجازوا الثورة فيه واعتبروها جهاداً- لم يكن محل إجماع لدى فقهاء المسلمين من أهل السنة، بل وُجِدَ من كان له رأي آخر، واجتهاد مخالف، وموقف الشرع بالنسبة لذلك الفقيه والمجتهد. فقد أَيَّدَ الإمام “أبو حنيفة النعمان” دعوة “زيد بن علي بن الحسين”، وبايعه، وأسهم في تجهيز ثورته بعشرة آلاف درهم، ووصف خروجه بأنه ضاهى خروج الرسول ﷺ يوم بدر، وبرر عدم خروجه معه بأن ما حسبه هو وجود ودائع الناس لديه، وفي تبرير آخر يذكر: “لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما لا يخذلون آباءهم لجاهدت معه” (10) .
وكانت أيضاً اجتهادات واضحة لأتباع المذهب الظاهري، وبعض الأشاعرة تؤيد الخروج على السلطان الجائر في بعض الحالات والشروط، كأن يكون القيام على الإمام الجائر ممن هو أكثر عدلاً، وفي هذا يقول “ابن حزم”: “فإن قام عليه من هو أعدل منه، وجب أن يُقَاتَلَ مع القائم، أما الجَوَرَةَ من غير قريش فلا يَحِلُّ أن يُقَاتَلَ مع أحدهم، لأنهم كلهم في أهل منكر، إلا أن يكون أقل جَوْراً، فَيُقَاتَلَ معه، من هو أَجْوَرَ منه” (11) .
يتضح عند هؤلاء المجتهدين أن وحدة الأمة لا تكفي مبرراً للسكوت على السلطان، وإنما يتقدم العدل ليكون هدفاً مركزياً يقف إلى جانب المساواة مع وحدة الأمة واستقرارها.
إن طاعة الأمراء مطلوبة من أجل وحدة الأمة واستقرارها، لدى معظم فقهاء أهل السنة والجماعة، إلا أن هذه الطاعة ليست مطلقة، وليست رضوخاً وانقياداً لإرادة الإمام، لأنها طاعة مقيدة بأن لا تكون في معصية، وإنما طاعة في الحق، هذا ما مارسه العلماء المسلمون حين وقف الامام احمد بن حنبل ضد بدعة خلق القرآن التي تبناها بعض الخلفاء العباسيين، ودخل السجن بسبب معارضته هذه البدعة بالحجة والمنطق والجدل والمناظرة، وهذا ما كان سار عليه الإمام أبو حنيفة عندما رفض تولي منصب القضاء للخليفة، وهو ما فعله ابن تيمية وهو يتشدد في نقده السلاطين المماليك الذين حارب التتار تحت رايتهم.
لقد كانت الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شكل المقاومة السلبية للحاكم الجائر مستندين إلى قول الرسول الكريم ﷺ : “إنها ستكون بعدي أَثَرَةً وأموراً تُنْكِرونَها، قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: “تُؤَدُّونَ الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم” –متفق عليه–.
والدعوة هنا موقف أعلاه الفعل، وأدناه النية، أو القلب، وبينهما اللسان، وقد اختار معظم فقهاء السنة والجماعة الحل الوسط، أي الدعوة في مواجهة السلطان باللسان، والامتناع عن تنفيذ أوامره الخارجة عن نصوص الشرع، وفي هذا يذكر كتاب منهاج السنة:
** أن المُخْتارَ للخلافةِ النبوية إذا فَسَقَ خرجت خلافته عن معنى الخلافةِ النبوية، وصارت خلافتُهُ ملكاً عضوضاً، ويستوي مع من لم يُخْتَرْ، وقد اتفق الجمهور بالنسبة له على ثلاثة أمور:
الأول: عدم الخروج عليه، حتى لا يؤدي الخروج إلى فتنة يضيع فيها الحق، ويغلب الشر المطاع، ويتبع الهوى.
الثاني: أنه لا يطاع في معصية قط، فقد قال عليه الصلاة والسلام: “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة” –متفق عليه–.
الثالث: أن كلمة الحق واجبة عند الحاكم الظالم، وفي “مسلم” أن النبي ﷺ قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، وللأئمة المسلمين وعامتهم”، وقال أيضا: “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”. رواه الترمذي.
يتبع / حلقة – 6 –
الهوامش
1ـ ابن قيم الجوزية ـ الطرق الحكمية ص16
2ـ ابن تيمية منهاج السنة، ج ۲، ص 87
3ـ المرجع السابق ص 88
4ـ المهذب في الفقه الشافعي للشيرازي، ج ۲، ص ۲۱۷ – ۲۱۸
5،6ـ المرجع نفسه الموضع نفسه
7ـ مسند الامام أحمد
8- ابن تيمية السياسة الشرعية
9ـ ابو حامد الغزالي ـ الاقتصاد في الاعتقاد ص137
10- محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو حنيفة، ص ١٣، وأبو الفرج الاصفهاني مقاتل المقاتلين ص ۱۳۵ – ۱۳۹، بالرغم من أنه يُروى عنه انه لم يؤيد الخروج على الامام
الجائر، إذ يقول أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين ص 192 طبعة القاهرة 1963 ما نصه: “إذا فسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة، ولا يجوز الخروج عليه”، وهذا مروي عن أبي حنيفة ” لأن في الخروج عليه إثارة للفتن والفساد العام”.
11-الأشعري ـ مقالات الإسلاميين، 133







