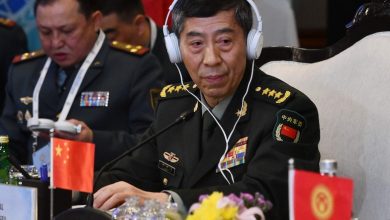أصبحت مقتنعًا بأن أكثر من 90% من المحللين ومن يُطلقُ عليهم وصف الخبراء والمراقبين والإستراتيجيين، الذين يُطلون علينا عبر شاشات القنوات التلفزيونية، هم أكبر المضلِّلين لمن يشاهدونهم ويستمعون إليهم ويتلقون عنهم تفسير ما يحدث في هذا العالم، جراء ما يبدو لي أنه ضحالة في الرؤى وسطحية في الأفكار التي يقيمون عليها تحليلاتهم!!
ومع أنني أزعم أن رأيي هذا يكاد ينطبق على معظم القضايا التي يتصدى أولئك لتفسيرها وشرحها للناس، إلا أن أكثر ما أراه مثيرا للشفقة والسخرية معا، هو حرص الكثيرين منهم وبشتى الطرق على محاولة الإيهام بأن ما يجري في أهم وجه من أوجهه هو ضربٌ مهم وحاسم وجلي من ضروب الصراع الأميركي – الصيني على قيادة العالم، دون أن ألمس أيَّ دليل على ذلك يوردونه خارج نطاق القراءات “المحاسبية” التي يجرونها على مؤشرات الصناعة والتجارة والناتج القومي الإجمالي والتكنولوجيا والأسواق.. إلخ، في البلدين، وكأن السيطرة على العالم وقيادته هي مُخْرَج مُحاسبي يتحدد في دفتر “اليوميات” و”الأستاذ العام” التي يعرفها ويتعامل بها المحاسبون والمدراء الماليون!!
ما لم أسمع أيا من هؤلاء يذكره ويناقشه عند حديثه الذي يكاد يكون لاهوتا جديدا تفوَّقَ على لاهوت الدين في هذا الصدد، عندما يتبارون في الحديث عن الهيمنة على العالم، وعن تقاسم النفوذ العالمي، وعن التنافس على القيادة بين “الصين” و”الولايات المتحدة”.. إلخ، هو أن أيا منهم لا يورد أيَّ ذكر لأيِّ قاعدة من قواعد علم “الجغرافيا السياسية” أو “الجيوبوليتيك”، الذي هو العلم المتخصص في مناقشة وفي تحديد اشتراطات واستحقاقات الهيمنة والنفوذ والقيادة العالمية!!
وهو الأمر الذي لا يعني عندنا شيئا أكثر من أن تلك الأحاديث لا تخرج عن كونها أحاديث شعبوية، وتحليلات محاسبين إذا كانت اقتصادية، وتحليلات محللي شؤون إقليمية إذا كانت سياسية، وفي أكثر الحالات تطرفا نراها تنزع إلى الأَدْلَجَة العمياء التي تحاول الاستقواء على الإحباط بالأمل، وليست أكثر من ذلك على الإطلاق!!
فوِفقَ قواعد علم “الجغرافيا السياسية/الجيوبوليتيك” الذي هو علم حديث جدا بالمناسبة، وهو في طور التكامل التدريجي، فإن السيطرة والهيمنة والنفوذ في العالم كي تكون قابلة لأن تتجسَّد وتستمر لمدى زمني مناسب، وكي لا تتحلل وتتلاشى بسرعة، هذا إن حصلت أصلا – خاصة في هذا الزمن الذي يختلف في معاييره جذريا ليس عن عالم ما قبل ألف عام، بل حتى عن عالم ما قبل خمسين أو ستين عاما فقط – يجب أن تكون سيطرة وهيمنة ونفوذ بالمعنى الحضاري، وليس بالمعنى العسكري أو السياسي فقط!!
فكل الإمبراطوريات التي اعتمدت في مشروع نفوذها الإمبراطوري على السيطرة بالقوة العسكرية وبالأحلاف السياسية غير القائمة على التماهي الفكري، هي مشاريع فشلت كلها في التاريخ، وليست تجارب المغول والنازيين والفاشيست عنا ببعيد!!
أما لكي تكون السيطرة والنفوذ والهيمنة ذات مضمون حضاري وفق قواعد علم “الجغرافيا السياسية”، فيجب أن تتوفر في القوى المهيمنة التي تتولى قيادة العالم أو قيادة إقليم مهم أو أقاليم مهمة من العالم، المواصفات والشروط التالية:
أولا.. أن يكون للقوة المهيمنة مركز وتخوم، يمثل المركز الدولة الأقوى والأهم والقائدة لخندق القوة المهيمنة، فيما تمثل التخوم مجموعة الدول التي تدور في فلك ذلك المركز انطلاقا من أنماط من التماهي تكون هي ذاتها من شروط استحقاق الهيمنة والسيطرة والنفوذ. كما كان حال الخندق الاشتراكي والشيوعي بمركزية “الاتحاد السوفييتي” السابق، وبمجموعة الدول المتحالفة معه علنا أو ضمنا بموجب اصطفافها ضد خندق الرأسمالية أيديولوجيا بالدرجة الأولى.
ثانيا.. أن تكون القوة المركزية المهيمنة دولة ذات ثقل جغرافي وديموغرافي يعتد به، تضاف إلى قوَّته الأثقال الجغرافية والديموغرافية للدول التخومية في هذا الخندق.
ثالثا.. أن تكون القوة المركزية المهيمنة مالكة لإطلالات بحرية ممتدة ومهمة، لتمثل نموذجا لحضارة البحر التي تتفوق دائما على حضارة اليابس، وهو ما حاوله الاتحاد السوفييتي السابق، والذي كان عدم تمكنه من تحقيقه على نطاق واسع، أحد أسباب فشله. وهو ما تحاول فعله روسيا حاليا في مشروعها “الأوراسي”، لتتجنب الثغرات في المشروع السوفييتي.
رابعا.. أن يكون للقوة المركزية المهيمنة تواجد قوي وفاعل ومؤثر وينطوي على دلالات السيطرة الحقيقية عسكريا وسياسيا، في “البحر الأبيض المتوسط” تحديدا، باعتباره بحيرة مركز الثقل في السيطرة العالمية. لذلك وجدنا أن الولايات المتحدة ورغم امتلاكها إطلالتين بحريتين مهمتين جدا على محيطين هما “الأطلسي” و”الهادي”، وسيطرتها على الكثير من الأقاليم المحاذية لها عبرهما، لم تتمكن من أن تصبح قوة عالمية مهيمنة، ولم يتحقق لها ذلك إلا بعد أن امتلكت سيطرة حقيقية على البحر المتوسط من خلال اقتحامها الحالة الأوروبية بالحربين العالميتين الأولى والثانية. وعدم قدرة الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة على امتلاك سيطرة ونفوذ مثلما كان عليه حال الولايات المتحدة، جعله يعاني من ضعف حضارة اليابس، ما أسهم – من بين أسباب أخرى أسهمت هي أيضا – في تفككه وفشل مشروعه الإمبراطوري العالمي. وهو ما تحاول روسيا أن تقوم به من خلال خروجها من عنق زجاجة البحر الأسود وتمترُسِها في البحر المتوسط في سوريا على الأقل بعد أن خسرت ليبيا التي تحاول العودة إليها، نظرا لإدراكها العميق لمركزية البحر المتوسط في معادلات الهيمنة والنفوذ والسيطرة العالمية والإقليمية.
خامسا.. “وهو مهم جدا وأثبته التاريخ الجيوسياسي للعالم”، أن تكون “القارة الأوروبية” و”الأرض العربية في غرب آسيا وشمال إفريقيا”، أو جزءا كبيرا منهما كجغرافيا وكديموغرافيا جزءا لا يتجزأ من القوة المهيمنة. لذلك نلاحظ أن الولايات المتحدة لم تصبح قوة مهيمنة إلا بعد أن أصبح جزء من أوروبا، وجزء من الأرض العربية إما بشكل مباشر وإما بالتبعية لأوروبا، جزءا لا يتجزأ من جغرافيا وديموغرافيا القوة الأميركية المهيمنة. وهو ما حققه الاتحاد السوفييتي أيضا، وما كان ليستطيع تحقيقه إلا بعد أن هيمن على جزء من أوروبا هو “أوروبا الشرقية” حتى بقوة الاحتلال العسكري، فضلا عن جزء من الأرض العربية بمبدأ التحالفات في مصر وليبيا والجزائر.. إلخ. لا بل إن هذا نفسه ما أثبته التاريخ على مدى الألفي سنة الماضية.
فالإمبراطوريات التي هيمنت على العالم: “الإغريقية”، و”الرومانية”، و”العربية”، و”العثمانية”.. إلخ، كانت تهيمن دائما على جزء من أوروبا أو على كل أوروبا، بالإضافة إلى جزء من الأرض العربية أو كلها. وهو نفسه ما تحاول أن تفعله روسيا حاليا بمشروعها الأوراسي.
سادسا.. “وهو الأهم على الإطلاق”، أن تمتلك القوة المركزية المهيمنة وتخومها بالتبعية طرحا فلسفيا أيديولوجيا، يعرض على العالم رؤيته للحياة وللتاريخ وللتطور ولسيرورة المجتمعات، فيما يتعلق بالحرية والعدالة.. إلخ، وهو الأمر الذي فعلته الولايات المتحدة عندما سوقت نفسها مدافعة عن الليبرالية الاقتصادية والسياسية، وعن حقوق الإنسان وعن الديمقراطيات في العالم في مواجهة الشموليات.. إلخ.
وبالمقابل هو نفسه ما فعله الاتحاد السوفييتي عندما طرح نفسه مدافعا عن استقلال الشعوب وعن حقها في تقرير مصيرها، وعن العدالة الاجتماعية ومواجهة الظلم والاستغلال الرأسماليين.. إلخ.
ومن الناحية التاريخية، هذا ما طرحه العرب عندما نشروا الإسلام وهيمنوا على العالم من خلال طرحه منقذا لهم. وهو نفسه ما فعلته الإصلاحات الدينية الأوروبية والثورة الصناعية التي أرفقت بالليبرالية السياسية، عندما حاولت أن تبرر بها استعمارها للجنوب.. إلخ.
وهو ما تعاني منه روسيا حاليا، لأنها لا تملكه بعد أن ألقت وراء ظهرها بالفلسفة الاشتراكية والشيوعية وتبنت الليبرالية بأسوأ مظاهرها وتجلياتها وأكثرها مافياوية، وقلصت حتى من الحريات في الليبرالية السياسية التي تتبناها، ما يجعلها تفتقر في طرحها “الأوراسي” إلى المكون الفلسفي الذي يبرر مشروعها الإمبراطوري للهيمنة أو لتقاسم الهيمنة على العالم، وهي تحاول أن تسابق الزمن لتكيِّفَ أوراسيِّتَها وتصَوِّرُها على أنها فلسفة اجتماعية مختلفة عن الليبرالية وعن الشيوعية، حتى أن فيلسوفها “ألكسندر دوغين” أطلق عليها فلسفة “الطريق الرابع”، ولكن هذا التوجه فشل وسيبقى فاشلا لأن الأوراسية ليست كذلك.
سابعا.. من الناحية الاقتصادية يجب أن تتوفر في القوة المركزية المهيمنة والمسيطرة والنافذة، خاصة بمتطلبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية للهيمنة والسيطرة والنفوذ، الشروط التالية:
أ – أن تمتلك الدولة المركزية في خندق الهيمنة المواد الخام الأساس للعصب الاقتصادي الذي تقوم عليه الطاقة والصناعة والزراعة، وهو “النفط” تحديدا وبالدرجة الأولى، ولمن لا يعلم فإن أهمية النفط لا تتبدى من خلال كونه مصدرَ الطاقة الأول في العالم، فهذا غير صحيح ومضلل جدا، لأن النفط تتراجع أهميته كمصدر للطاقة بشكل كبير، إلى درجة أن الولايات المتحدة لا تستخدم النفط في إنتاج أكثر من 1% من طاقتها الكهربائية، وكذلك الكثير من الدول المتقدمة التي تستخدم الطاقة البيولوجية، وطاقة الرياح والمساقط المائية، والطاقة النووية، وطاقة الفحم، والغاز الطبيعي.. إلخ، لإنتاج الكهرباء، ولكن أهمية النفط تكمن في أن 70% من صناعة العالم – بصرف النظر عن الطاقة المستخدمة في الصناعة – قائمة على صناعة النفط من خلال البتروكيماويات. أي أن العالم لو تمكن من الاستغناء نهائيا عن النفط في توليد الطاقة والكهرباء، فإن هذا لن يغير من حاجته للنفط في البنية الجوهرية للصناعة العالمية.
ومن ثم فإن الدولة المركزية في خندق الهيمنة لا يمكنها أن تحظى بهذه المكانة وكل نفطها الذي هو عماد صناعتها التي تختال بها على العالم، غير متوفر لديها كما هو حال الصين. ولكن الوضع عند الولايات المتحدة مختلف، فهي حتى قبل أن تمتلك كل نفطها، وعندما كامت تحتاج إلى 25% من نفطها من الخارج، كانت حالتها الجيوسياسية العالمية تساعدها ليس فقط على ضمان تدفق النفط إليها، بل على ضمان إدارة تدفقه إلى العالم من خلال سيطرتها على أهم الدول المنتجة له في الخليج العربي. ولذلك أيضا لم يعاني الاتحاد السوفييتي من هذه النقطة بالذات لأنه كان ينتج كل نفطه بل هو كان يزود بعض حلفائه به. بينما أوروبا بعد أن فقدت مستعمراتها أصبحت مضطرة لأن تتبع الولايات المتحدة التي ضمنت لها تدفق احتياجاتها النفطية التي كانت تعتمد في معظمها على الخارج الأوروبي.
ب – أن تكون الدولة المركزية المهيمنة غير مكشوفة اقتصاديا أمام العالم، وذلك بألا يكون ناتجها القومي الإجمالي يعتمد بنسية عالية على الأسواق العالمية تصديرا أو استيرادا أو كليهما، كي لا تبقى عرضة للتقلبات العالمية، وهذا ما كان يتمتع به الاتحاد السوفييتي المنغلق اقتصاديا، والصين سابقا عندما كانت منغلقة اقتصاديا، خلافا لحال اقتصادهما الراهن والمنفتح جدا إلى درجة الانكشاف على الاقتصاد العالمي، حيث تعتمد الصين في “35%” من ناتجها الإجمالي على تجارتها الخارجية مع العالم، وروسيا على “32%”، وهو ما جعل الصين من أكثر الدول تضررا من إغلاق الاقتصاد العالمي، بسبب أزمة كورونا، وأكثرها حرصا وإصرارا على سرعة فتحه.
بينما الولايات المتحدة لا تعتمد في ناتجها القومي الإجمالي إلا على نسبة “5,4%” من التجارة الخارجية مع العالم، وهي نسبة ضئيلة وقليلة التأثير جدا في اقتصادها إذا كانت الأزمة الحاصلة منتِجة لإغلاق اقتصاد العالم أمامها، فإذا كان أضخم ضرر أصاب اقتصاد الصين بسبب الأزمة الراهنة ناتجا عن إغلاق العالم أمام اقتصادها، فإن أكبر ضرر أصاب الولايات المتحدة بسبب الأزمة هو أنها أغلقت اقتصادها داخليا، في حين أن إغلاق الاقتصاد العالمي أمامها يكاد يكون عديم التأثير عليها.
ج – أن يكون اقتصاد الدولة المركزية المهيمنة غير مرتبط ارتباط وجود حقيقي وجوهري بنظام نقدي لدولة أخرى قوية منافسة، كما هو حال ارتباط كل العالم بما في ذلك الصين وروسيا، بنظام “الدولار” إذ أن 70% من المعاملات التجارية الدولية تتم بالدولار، وبنظام “سويفت” للتسويات النقدية العالمية الذي تتم به “100%” من التسويات النقدية في العالم، وهما نظامان أميركيان 100%، ولا سلطة لأحد عليهما غير الولايات المتحدة، وبالتالي فإن كل دولة ترتبط به ارتباط وجود جوهري، يصعب عليها أن تتخطى حدودا معينة في منافسة الولايات المتحدة التي تستطيع منعها من ذلك إن هي شاءت، لذلك رأينا كيف أنها تستطيع معاقبة كل دول العالم بل وأكبرها وأعظمها اقتصادا مثل الصين، دون أن تتمكن هذه الأخيرة من تجاوز تبعات ذلك. لا بل إن محاولة منظمة “البريكس” وهي المنظمة التي تشمل كلا من “روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا”، والتي يبلغ تعداد سكانها نصف سكان العالم، ويكافئ ناتجها القومي الإجمالي مجتمعة ما يقارب ناتج الولايات المتحدة.. إن محاولة هذه المنظمة للتخلص من هيمنة الدولار والسويفت باءت بالفشل حتى الآن، لأسباب تقنية معروفة ليس هنا مجال شرحها.
ثامنا.. من الناحية السياسية، يفترض أن يكون الفضاء الإقليمي للدولة المركزية المهيمنة تحت سيطرتها سيطرة شبه تامة سياسيا واقتصاديا على الأقل، سياسيا من خلال عدم وجود تجاذبات سياسية بينها وبين دول الإقليم – الرئيسة منها على الأقل – تجعل حديقتها الخلفية غير آمنة، واقتصاديا من خلال اعتبار تلك الدول هي أكبر سوق للتعامل الاقتصادي معها في العالم. وهو الأمر المتوفر بالنسبة للولايات المتحدة بإزاء كندا والمكسيك، ومعظم دول أميركا اللاتينية، وهو متوفر بشكل نسبي لروسيا خاصة في بعض دول وسط آسيا المنفصلة عن الاتحاد السوفييتي، لكنه يكاد يكون معدوما بالنسبة للصين، فهي في تجاذبات وتناقضات سياسية واقتصادية مع كوريا الجنوبية، ومع تايوان، ومع هونغ كونغ، ومع سنغافورة، ومع ماليزيا، وإلى حد ما مع إندونيسيا وفيتنام مؤخرا.. إلخ. وبالتالي فإن الفضاء الإقليمي الأهم والأكثر فاعلية للصين هشٌّ جدا إذا ما قيست الهشاشة بمدى القدرة على أن يمثل ذلك الفضاء مجالا للاختراق وللتهديد.. إلخ.
تاسعا.. وأخيرا يأتي دور الثقافة الوطنية، والموروث الثقافي لجهة الدور القومي للأمة، إذ يجب أن يكون هناك موروث تاريخي للدولة المركزية المهيمنة وفي ثقافة شعوبها، ينطوي على خبرات وتجارب وممارسات تثبت أن تلك الدولة كانت لها على الدوام تطلعات نفوذ إقليمي أو عالمي، بحيث يمكن البناء عليها للتأسيس لثقافة النفوذ الراهنة، وإلا فإن تلك الدولة ستحتاج إلى وقت طويل من التجاذبات المحدودة والإقليمية مع القوى المهيمنة الأخرى حتى تترسخ هذه الثقافة لدى شعوبها. وفي دولة مثل الصين حيث لا يوجد في تاريخها على مدى الألفي سنة الأخيرة ما يشير إلى تلك الثقافة، فإن الحديث عن تطلعات عالمية للهيمنة والنفوذ سوف تصطدم بموروث ثقافي صيني عريق من السلمية والحكمة وعدم التطلع للتوسع.. إلخ.
في ضوء كل تلك الشروط التي تمثل استحقاقات لا مفر منها للحديث عن آفاق وإمكانات للتنافس العالمي بين الصين والولايات المتحدة لجهة الهيمنة والنفوذ والقيادة العالمية، هل يمكن القول بأن الصين تمتلك أي مقوم من مقومات يمكنها أن تنفتح عن حالة صراع على قيادة العالم بينها وبين الولايات المتحدة؟!
لن نجيب على السؤال وسنترك للقارئ وحده فرصة معرفة الإجابة في ضوء قواعد علم “الجغرافيا السياسية”، كي لا نبقى عرضة لهلوسات المحللين والخبراء الذي يطلون علينا عبر الشاشات!!