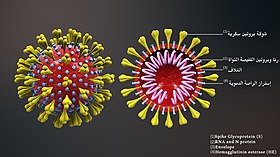منذ مطلع هذا العام 2020 انشغل العالم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن بدأت معالمه وأخطاره تتضح باعتباره تحديا عالميا، وبعد أن ضرب مختلف مظاهر الحياة في العالم كله، وبعد أن عطل كل شيء، وألجأ الناس إلى بيوتهم لا يخرجون منها، وفرض تطبيقا صارما لمفهوم التباعد الاجتماعي.
وتدريجيا ظهر للجميع أن الأعباء الاقتصادية والمادية الناجمة عن هذا التحدي تنوء بحملها الأمم جميعها صغيرها وكبيرها، والاقتصاديات جميعها، ما كان يوصف منها بالمتقدمة أو المتخلفة، وبات انتشار الفيروس يهدد السلم الاجتماعي وينذر بثورات اجتماعية يصعب إدراك أبعادها.
وفي خضم هذا التحدي ظهر أن النظام العالمي، النظام الاقتصادي والاجتماعي والأمني مكشوف بأكثر مما كان متوقعا، وضعيف على نحو لا يستقيم الاستمرار فيه، وأنه مقام على أصول أنانية لا يصح معها اعتماده كنظام دولي حقيقي مثمر وآمن.
وفي تحدي كورونا المستجد ظهر الخلل أكثر في الدول الأكثر تقدما وقوة، ولم يكن ذلك مستغربا لأنها الدول الأكثر سيطرة على عناصر النظام الدولي، وعلى مؤسساته، لذلك رمى الفيروس القفازات في وجه هذه الدول أولا، وظهر الضعف والانكشاف في هذه الدول أولا، وبات على هذه الدول قبل غيرها أن تجري المراجعات اللازمة في أنظمتها الوطنية، وفي النظام الدولي الذي تساهم في إقامته والسيطرة عليه، ليتمكن النظام المرتقب بعد كورونا من تجاوز هذا الضعف والانكشاف.
وفي هذا المقال نحاول أن نرصد أهم أربعة مفاهيم يفرض تحدي كورونا مراجعتها:
أولا: مفهوم الأمن القومي
حتى 23 / 4 / 2020 سجلت الولايات المتحدة أكثر من 880 ألف إصابة بالفيروس، و 50 ألف حالة وفاة، وسجل نحو أربعين في المائة من حالات الوفاة هذه في ولاية نيويورك، التي كانت قد سجلت أول حالة وفاة فيها في الأول من مارس.
وفي مؤتمر صحفي عقده حاكم نيويورك “أندو كومو” في 17 / 4 / أعلن فيه أنه شأنه شأن حكام الولايات الأخرى والحكومة الاتحادية توجه إلى الصين لشراء مستلزمات مواجهة كورونا: الكمامات، الألبسة الواقية، واقي الوجه، أجهزة التنفس، المواد اللازمة لفحص الكورونا، وقال إن كل هذه السلع تصنع في الصين، وتحتاجها الولايات المتحدة في هذه المحنة، لذلك فهي مضطرة شأنها شأن الدول الأخرى مثل ايطاليا وكوريا الجنوبية وغيرهما للتوجه إلى الصين للحصول عليها، ثم يطرح “كومو” تساؤلا شديد الأهمية قائلا: هذه كلها “أي الاحتياجات السابقة” أمن قومي، كيف يجوز أن يرتبط الأمن القومي الأمريكي بإنتاج يأتي من الخارج.
هذا التساؤل الحقيقي يفرض على أصحاب القرار في كل بلد أي يجيبوا عليه، وهو يفتح الباب للتساؤل الأعم، والخاص بمكانة القطاع الصحي في سلم أولويات مفهوم “الأمن القومي”. تقليديا كان الأمن القومي، أو الوطني، يتصل بقضايا الدفاع والقدرة على حماية الوطن تجاه أي عدوان خارجي، ثم توسع ليشمل أمن القطاعات الاستراتيجية ” مياة ..طاقة ..مناخ …تسلح .. غذاء” وهي قطاعات تتغير أهميتها من مجتمع إلى مجتمع، ثم شمل أمن المؤسسات الصناعية والابتكارات في هذه المجالات وأخيرا أمن الفضاء السبراني ” الألكتروني”، فصار الأمن التكنولوجي والبحثي والالكتروني جزءا من “الأمن القومي”، وانشئت لفروع هذه الأمن مؤسسات أمنية خاصة لحمايتها من الاختراق، لكن من غير المعروف أن القطاع الصحي ومكوناته اعتبر واحد من عناصر الأمن القومي الرئيسية.
الآن كشف فيروس كورونا عن هذا الوجه للقطاع الصحي وللمنتجات المتصلة به، بل أن تحدي كورونا رفع أهمية هذا الأمن ليكون الأول على المستويين الوطني القومي والعالمي.
أمن صحة المجتمع، أمن القطاع الصحي، أمن مستلزمات هذا القطاع، بات من أولويات الأمن القومي على مستوى كل مجتمع، ومن أولويات أمن المجتمع الانساني، اي أمن البشرية على المستوى العالمي.
هذا التجلي الجديد لمفهوم الأمن يحتاج إلى وقفة ومراجعة في كل دولة ومجتمع، مراجعة تغطي الجوانب البشرية والعملية والمؤسساتية والصناعية، بحيث تأخذ هذه كلها مكانتها الصحيحة في سلم اهتمامات الأمن القومي.
الطبيب، والممرض، والمستشفى، شبكة التأمين الصحي، ومراكز البحث المتصلة، والصناعات المتصلة بهم، من أدوية ومراكز انتاجات للأجهزة والاحتياجات اللازمة كلها باتت مكون من مكونات هذا القطاع من الأمن القومي المتصل بفاعلية بكل قطاع الأمن الأخرى وبالمجتمع ككل. بل وظهر جليا أن ظلال هذا القطاع تلقي بإثقالها على المجتمع كله، ولذلك فإن الاقتناع بالأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع بات عاما شاملا لا يجادل به أحد، لكنه يحتاج إلى وضعه في بنية وخريطة الأمن القومي وإجراء التعديلات والتغييرات اللازمة على هذه الخريطة لتستوعب هذا الوافد الجديد عليها.
ثانيا : مفهوم السلام الاجتماعي
مع سياسة الإغلاق والعزل ومنع التجول، بات من ضروريات الحفاظ على السلام الاجتماعي في كل مجتمع، وأن يتم في ظل هذه الظروف توفير الاحتياجات الضرورية للحياة: للأفراد والأسر، التي يقوم مصدر دخلها على العمل اليومي، على الأجور التي ينالها العاملون وفق نظام العمل المتبع.
على مستوى القطاع الخاص فإن الأجر يدفع مقابل العمل الذي يشكل مكونا رئيسيا من المنتج الذي يعرض للبيع، أو الخدمة التي تعرض للمستفيد منها، لكن التوقف عن العمل يؤدي حتما إلى التوقف عن دفع الأجور للعمال مباشرة أو تدريجيا.
وبسرعة قد تنقص قليلا أو تزيد قليلا تجف مصادر الدخل، والادخار، لدى العمال والموظفين، وبالتالي ينكشف وضع هؤلاء، ويظهرون عرايا في نظام قائم على مبدأي العرض والطلب، والمنفعة، وهذا قوام القطاع الخاص وقانونه.
ولما كان قطاع كبير من الشركات الخاصة تصنف عادة بأنها شركات صغيرة، وهي شركات تعطى في الاقتصاد الحديث أهمية خاصة وذلك لدورها في تحريك النمو، فإن “الحجر والإغلاق” من شأنه أن يميت هذه الشركات، ويدفع إلى إفلاسها، وبالتالي إلى تسريح أعداد العاملين فيها، ولكثرة هذه الشركات وانتشارها في معظم القطاعات الانتاجية والخدمية فإن أعداد العاملين الذين يخرجون من سوق العمل كبير جدا.
ولا تقتصر هذه الحقيقة على الشركات الصغيرة، وإنما تطال الشركات الكبيرة العملاقة ذات تكلفة التشغيل العالية مثل شركات الطيران، والسياحة والفنادق وخدماتها، وما يرتبط فيها من شركات ومؤسسات.
في مواجهة هذه الحقيقة الصارخة قررت معظم الدول ميزانيات إعانة لهذه الشركات، ولهذه الأسر، وتقدر هذه الميزانيات بآلاف المليارات أو بآلاف الملايين، حسب كل دولة، لكن هذا كله يمثل ضغطا كبيرا على ميزانية هذه الدول لا تستطيع تحمله لفترة طويلة، مما يدفع بالاقتصاد نحو مزيد من التباطؤ، وصولا إلى الانكماش.
أي أن موجة تسريح العمال واغلاق المؤسسات الانتاجية، وخفض النفقات سوف تزداد يوما بعد يوم، وأن أبعاد الكارثة سوف تتكشف مع كل يوم يضاف إلى أيام الأزمة، وأن استمرار هذا الوضع من شأنه أن ينذر بثورات اجتماعية فوضوية لا ينتج عنها تغييرات في النظم الاجتماعية كمثل ما شهده التاريخ الاجتماعي من ثورات، وإنما ينتج عنه فوضى مدمرة لأن هذه الثورات لا تستند إلى قوى اجتماعية وأحزاب سياسية تملك برامج تغيير ورؤى تتجه إلى تطبيقها، وإنما تستند إلى قوى اجتماعية قتلتها الفاقة والفقر، ولم تعد قادرة على دفع تكلفة أي حاجة تحتاجها، أو خدمة تتطلبها، بعد أن أصبحت كل الحاجات والخدمات محكومة بقوانين العرض والطلب، وبمفهوم المنفعة الفردية والربح الشخصي، وهي في لحظة معينة ستتجه إلى الحصول على احتياجاتها الضروية بالقوة الذاتية التي تملكها.
ويبدو أن الدول المختلفة باتت تشعر بخطورة ما يواجهها لذلك تتجه إلى التخلي التدريجي عن اجراءات العزل والحجر ومنع التجول، لكن أي قرار يتخذ في هذا السبيل بدافع تفادي الفوضى الاجتماعية، وبدافع وقف مسلسل الأزمة الاقتصادية من شأنه أن يفكك ويعطل كل الخطوات التي اتخذت من أجل محاصرة الفيروس ومنع انتشاره، أي أنه قد يفسح المجال لانتشار جديد للفيروس، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة الإسراع في التخلي عن إجراءات الحماية والوقاية والعزل، وخطورة أن يشهد العالم نتيجة ذلك موجة مرتدة من انتشار الفيروس.
الأمر على الوجهين: استمرار اجراءات الحماية والحجر، أو التخلي عن هذه الاجراءات، يمثل تحديا مباشرا للسلام الاجتماعي، ويفرض إعادة النظر في طرق تأمين هذا السلام، باعتبار تحدي كورونا المستجد، ليس أمرا طارئا، وليس أمرا عابرا، فهو ما زال قائما بقوة، وما من عاقل يستطيع أن يجزم بعدم تكرار هذا التحدي مستقبلا، فكل انتشار لفيروس جديد متحول يمكن أن يشكل تهديدا حقيقا بأكثر مما شكله فيروس كورونا المستجد.
وكما أن الدول تعد احتياطيا استراتيجيا للأسلحة والذخيرة والمواد الغذائية، بات عليها أن تعد احتياطيا استراتيجيا من الثروات لمواجهة مثل هذا التحدي، ولا يعني احتياط الثروات أن يوجد صندوق خاص للكوارث، وإنما بشكل أعمق أن يعاد بناء سياسات التنمية: الصناعية والزاعية والصحية والاجتماعية، على قاعدة تخفيض تكلفة الحياة على المواطن، ليكون أقدر على مواجهة أي طارئ، وأن تتوفر له الخدمات الرئيسية: العمل، التعليم، الصحة، المسكن، الأمن، على قواعد أكثر انسانية من قوانين القطاع الخاص التي تركز على جانب الربح، والعائد المباشر، أي أن تقدم هذه الخدمات باعتبارها من”حقوق الإنسان” الحياتية التي وجد مفهوم الدولة الحديثة لتأمينها، وتمثل إحدى وظائف الدولة الحديثة، واعتبار تحقيق ذلك جزءا من مفهوم السلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي.
ثالثا: العمل الإنتاجي وأمن المجتمع
لماذا تحولت الصين إلى مصنع للعالم، لماذا اتجهت كل المصانع، على اختلاف مستوياتها، الانتاجية والاستهلاكية إلى الصين، لماذا كل رجال الأعمال في كل مكان في العالم اتجهوا إلى الصين، وجعلوا هذا البلد محطة رئيسية في خارطة تحركهم وانتقالاتهم.
الجواب واضح ومعروف للجميع، فقد وفرت الصين بيئة إنتاج ذات تكلفة أدنى، وحرية أعلى، ووفرت إمكانات تقنية وعلمية ذات مستوى رفيع، فصار بإمكان الجميع أن ينتج ما يريد بتكلفة أقل، ثم ينقل هذا الانتاج إلى مختلف الأسواق محققا ربحا أكبر، وتصدق هذه المعادلة على جميع أنواع الانتاج من الصناعي الثقيل إلى الاستهلاكي العام، العالم ينتج في الصين، والعالم يستهلك من انتاج الصين، ولولا أن الأرض الزراعية لا تنتقل، لانتقل إنتاج الذرة والقمح والزيتون والقطن والأرز …. الخ إلى الصين.
الرئيس الأمريكي رونالد ترامب تنبه إلى هذه المسألة مبكرا، لكنً تنبهَهُ كان قاصرا، لأنه نظر للأمر من منظور صاحب شركة، من منظور الضرائب وفرص العمل ومن منظور حاجته إلى تعزيز فرص انتخابه لولاية ثانية، وليس من منظور أمن المجتمع الأمريكي، وأمن العملية الانتاجية، و قد حاول من خلال إعادة التفاوض مع الصين من جهة، ومن خلال الضغوط التي مارسها على الشركات الأمريكية لتعيد مصانعها إلى الولايات المتحدة من جهة أخرى، أن يعالج هذا الخلل، واعتقد أن توصله إلى اتفاق مع الجانب الصيني على تصحيح عجز الميزان التجاري بين البلدين، وأن تزيد الصين من وارداتها من الولايات المتحدة من شأنه أن يقوم هذا الخلل. لكن هيهات هيهات، فأصل الخلل في الولايات المتحدة، وليس في الصين، كيف يمكن للدولة أن تتيقن أن الحفاظ على شركاتها داخل أرض الوطن جزء من أمن الوطن والمواطن، وأن كل قرار أو إجراء أو سلوك تقدم عليه الدولة ويؤدي إلى زيادة تكلفة الانتاج من شأنه أن يدفع هذه الشركات للبحث عن فرص للعمل والانتاج خارج هذه الحدود أقل تكلفة وأكثر ربحا.
تحدي فيروس كورونا أظهر أن على الدولة أن تعيد النظر في العملية الانتاجية الوطنية برمتها، في اتجاهين اثنين:
الأول: التخفيف قدر المستطاع من ارتفاع تكاليف الانتاج، وذلك بالعدول عن فرض المزيد من الضرائب على الأفراد والشركات، والرسوم والأعباء المختلفة التي باتت الدولة تلجأ إليها في كل حين، وكأنها السبيل الأيسر لتمويل الميزانية.
الثاني: إعادة ترتيب القطاعات الانتاجية حسب حاجة المجتمع إليها، وأثرها الاستراتيجي على استقرار المجتمع وأمنه، بحيث لا يسمح بانتقال هذه القطاعات إلى خارج الدولة، ليس بما تملكه الدولة من قوة ووسائل قهرية، وإنما بما توفره من بيئة لازمة لبقاء هذه القطاعات داخل الوطن، وتمكنها من تصريف منتجاتها، والمنافسة داخليا ودوليا.
إن ترك الأمر للقطاع الخاص سيؤدي إلى خلل كبير، لأن دوافع هذا القطاع مختلفة عن دوافع الدولة، التي تنظر إلى كل القطاعات، وتنظر إلى احتياجات كل المجتمع، وتوازن بين هذه وتلك، وتقرر إجراءاتها وتوجهاتها من هذا المنظور.
توفير فرص العمل والإبداع، ودخول ميادين الإنتاج والخدمات للقطاع الخاص جزء رئيس من اهتمامات الدولة، لكنه لا يمثل كل اهتمامها، وهذا هو الفارق الرئيسي، والأمثلة في هذا المجال عديدة:
** هل يمكن للدولة أن تسند الدفاع عن المجتمع في مواجهة مخاطر الداخل والخارج للقطاع الخاص؟، لاشك أن القطاع الخاص يمكن أن يشارك في هذا الجانب، لكن أن يترك الأمر له، أو أن يسيطر هو عليه، فإن من شأن ذلك أن يحول “الجيش والقطاع الأمني” إلى “قطاع مرتزقة”، يخدم من يدفع له.
** هل يمكن للدولة أن تسند السيطرة على الثروات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية إلى القطاع الخاص؟، الانتاج العسكري، الطاقة ، الغذاء، الثروات الباطنية، المياه.
** هل يمكن للدولة أن تخلي مسؤوليتها عن تنشئة الجيل الجديد تشئة صحة وعلمية وروحية وتترك ذلك لقوانين القطاع الخاص، بما في ذلك برامج ومناهج التعليم سواء في المرحلة السابقة على المرحلة الجامعية أو في المرحلة الجامعية؟!.
تحدي كورونا يقول إن كل ما تمت الإشارة إليه وأمثاله، مما لا يجوز أن تتخلى الدولة عن دورها فيه، وهو دور غير قابل للتراجع، بل كلما ازداد المجتمع تقدما ازدادت مسؤولية الدولة في هذا الجانب. وإن من مسؤولية الدولة أن تأتي قراراتها لتمكين “المجتمع”، بكل تكويناته، وطبقاته، وتميزاته على تحقيق سلامة وأمن هذه القطاعات، وتمكينه من أخذ احتياجاته الرئيسية منها دون أي عقبات، وفي مختلف الظروف.
رابعا: مفهوم المسؤولية الأممية في مواجهة التحديات العامة
العالم والعولمة والمنظمات الأممية، هذه العناوين مما بات من الضروري إعادة النظر في مفهومها ومكوناتها وأليات تجسيدها وعملها.
لم يسجل الاتحاد الأوربي اي نجاح أو تميز في مواجهة تحدي كورونا، وبدت كل دولة أوربية وكأنها لوحدها لم يجمعها مع دول الاتحاد قرابة الأربعين عام، منذ التوقيع على معاهدة ماستريخت عام 1992 التي سجلت انطلاق هذا العمل الوحدوي الأوربي، رغم ان هذا الاتحاد قام أصلا لتلبية احتياج الدول الاوربية لموقف موحد في مواجهة الظروف الداخلية والإقليمية، قبل كورونا ظهر فشل الاتحاد الأوربي في اعتماد سياسة موحدة في مسائل عدة، منها ملف الهجرة واللجوء، ومشروع إقامة جيش أوربي موحد، والأزمة الليبية، لكن كان متوقعا أن يقف الاتحاد موقف رجل واحد في التصدي لهجوم كورونا، لكنً هذا لم يحدث، ووقفت إيطاليا وحدها تواجه هجوم الفيروس، ثم وقفت إسبانيا وحدها تفعل ذلك، ثم وقفت فرنسا لوحدها كذلك، وتحركت روسيا والصين لتقديم المساعدة لهذه البلدان الثلاثة، فيما بقيت دول الإتحاد جميعها حذرة من تقديم أي مساعدة، وهي ترقب وصول الفيروس إليها بقلق بالغ.
ولم يسجل حلف الناتو أي تحرك جماعي أمام هذا الخطر الداهم، وبقي هذا التشكيل الدفاعي الذي أنشئ منذ العام 1949 دون حراك. مع العلم أنه بحكم طبيعته العسكرية يملك إمكانات ومخزونات طبية استراتيجية يمكن أن تساعد الدول المنكوبة في مواجهة هذا الفيروس.
ولم يعقد مجلس الامن الدولي “السلطة العليا في النظام الدولي”، أي اجتماع لمواجه انتشار الفيروس حتى 9 ابريل، لكن انقسام دوله حال دون تبني استراتيجية مواجهة في هذا الاجتماع، ثم عقد جلسته يوم 22 ـ 23/ 4 ، لبحث مشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به فرنسا.
وأياً ما كانت قيمة وجدية القرار الذي سيعتمده مجلس الأمن فإن ما يجب الوقوف عليه أن هذا المجلس لم يتحرك إلا بعد أن ضرب الوباء كل دول المعموره، وتجاوز عدد المصابين مليونين وسبعمائة ألف مصاب، والوفيات 190 ألف وفاة.
وحدها منظمة الصحة العالمية باعتبارها منظمة نوعية، وقفت لمواجهة هذا التحدي بإمكاناتها العادية، وتلقت رغم ذلك الكثير من الهجوم والتشكيك والمحاصرة.
هذا يعني أن المؤسسات الإقليمية والدولية الحديثة والعريقة فشلت في مواجهة هذا التحدي، هذا هو الدرس الأول في القفاز الذي رماه فيروس كورونا في وجه الجميع.
ورغم الكثير من الأبحاث والدراسات والمؤتمرات التي تحدثت عن العولمة، وبأن العالم بات محكوما من القوى الكبرى تتقدمهم الولايات المتحدة، فإن تحد واحدٍ لفيروس صغير أسقط هذه الإدعاءآت وأظهر أن معظمها كان تعبيرا عن رغائب وليس بحثا عن حقائق، وأعاد الجميع إلى طاولة البحث والتمحيص في هذا النظام العالمي الجديد.
لم تظهر أي دولة كبرى بدءا من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوربي”إذا اعتبرناه كيانا سياسيا واحدا”، إلى روسيا أنها قادرة على التصدي لهذا الوباء على أراضيها، وهي أعجز عن القيام بقيادة العالم في هذه المواجهة وتحمل مسؤولية هذه القيادة.
ولم تظهر أي دولة أو تكتل دولي قيما إنسانية عامة تستأهل أن تكون قيما حاكمة، تعم التعاملات بين الدول، وتكون مرتكزا في أي مواجهة طارئة على المستوى الدولي، لقد ظهرت الأنانية والفردية، واللامسؤولية في التعاطي مع هذا التحدي.
وظهرت الحاجة إلى آلية عمل دولية، تكون قادرة على التحرك السريع لمواجهة أي حالة طارئة تهدد العالم، وإلى مرجعية فكرية وثقافية، مرجعية قيمية، يمكن الاستناد إليها في تلك المواجهة، مرجعية قيمية قائمة على العدل، وعلى الكرامة الانسانية، وعلى حقوق الانسان الثابتة.
هل يستطيع العالم أن يواجه حالة طارئة دولية، وهو في مثل هذا الوضع؟. ما ثبت أنه لا يستطيع، وما ثبت أيضا أن العالم بحاجة لأن يكون قادرا على مثل هذه المواجهة، لأن تحديا من هذا النوع لا يقتصر على دولة بعينها، ولا منطقة بعينها، وإنما يعم المعمورة كلها.
وفي مثل هذه المواجهة تتضح المعاني الحقيقية الواجبة للعولمة، المعاني الناجمة عن عوامل موضوعية، وليس عن رغبات دول كبرى متنفذة، وظالمة، وتحاول أن تستبد في شؤون العالم.
تحدي فيروس كورونا رمى القفاز في وجهة العولمة التي خلفها تفكك الاتحاد السوفياتي، لقد فشلت تلك العولمة بأقطابها الجدد: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والناتو وروسيا والصين بالمشاركة أو بالصمت حين تم غزو افغانستان، وغزو العراق واحتلاله، وحين تم التدخل عسكريا في ليبيا، وحين بدأت عملية تدمير سوريا وتهجير شعبها، وحين تم دعم عدوانية الكيان الصهيوني على أبسط الحقوق الوطنية وأكثرها حظوة بالقرارات الأممية، وحين تم دعم الأنظمة الطائفية والمستبدة في هذه البلدان، ومنعت الشعوب من إحداث تغيير حقيقي ينقلها إلى نظم ديموقراطية تعبر فيها عن ارادتها الحرة.
فيروس كورونا عرى هذه الأشكال من العولمة، وبات ضروريا الانتقال إلى شكل جديد من العولمة، شكل يقوم فكرا وقيما على المشتركات بين الشعوب والأمم المختلفة، فلا تُفرض على شعوب بعينها مفاهيمُ وأفكارُ وقيمُ مجتمعات أخرى، ومن زاوية المصالح المشتركة يقومُ على مواجهة ما يمثل تهديدا للحياة والسلام على هذا الكوكب، من خطر الفيروسات، وتحولها إلى سلاح يستخدم في الصراعات، إلى خطر التغييرات البيئية المولدة للحرائق والفيضانات والجفاف، إلى خطر الهجرة غير الشرعية وما يدفع إليها من الظلم والفقر والتخلف، إلى خطر الصراع المحتمل على الفضاء والكواكب البعيدة. الى خطر التلاعب في الخارطة الجينية للإنسان والاعتداء عليها. إلى أخطار عديدة يمكن أن تتكشف في المستقبل.
وقد يسأل سائل، ما الذي سيدفع الى تغيير النظام الدولي الراهن، ومؤسساته في اتجاه أكثر تمثيلا للشعوب وتنوعا في القيم والثقافات، وأكثر ديموقراطية في التوجهات والقرارات، وأكثر مصلحة لعموم الانسان على هذه الأرض.
هذا سؤال حقيقي، فالتغييرات الكبرى في التاريخ لا تأتي استجابة للتحليل المنطقي، ولا للرؤية الأخلاقية، ولا للنوازع الإنسانية، وإنما تحدثها القوة ومن يملكها، وتوجهها المصالح ومن يمثلها.
والحق أن تحدي فيروس كورونا، وما يمكن أن يظهر من تحديات مشابهة في اي وقت لاحق، يكشف عن عناصر القوة التي ستفرض التغيير.
حينما تنتهي أزمة كورونا ـ وهي لابد منتهية بإذن الله ـ ، وحين تقف المجتمعات أمام أعداد من أصيبوا بالفيروس، وأعداد من فقدوا حياتهم، والخسائر المادية المقدرة بالتريليونات، وبمشاهد الانهيارات الاقتصادية، وموجة الإفلاسات، وكذلك الاضطرابات المتوقعة، ومئات الملايين الذين كانوا في صفوف أصحاب الدخل المحدود، ودُفعوا نتيجة هذه الأزمة إلى تحت خط الفقر، رغم كل الاجراءات التي اتخذتها حكومات عديدة في العالم.
حينما يكون المشهد على هذا النحو، فإن من شأن هذا المشهد أن يولد القوة اللازمة لفرض نظام دولي أكثر عدلا وأمنا واتساقا مع سنن الحياة الطبيعية والاجتماعية. وأكثر تحقيقا لمصلحة الانسان في اي مجتمع وجد.