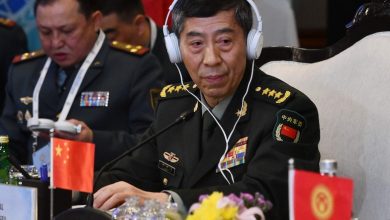النظام الدولي ينهار، ويبدو أن الجميع يعرف كيف يصلحه. وفقاً للبعض، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تكريس نفسها فحسب لقيادة النظام الليبرالي الذي ساعدت في تأسيسه منذ حوالى 75 عاماً. بينما يجادل آخرون بأن القوى العظمى في العالم يجب أن تتفق وتنسّق في ما بينها لتوجيه المجتمع الدولي نحو عصر جديد من التعاون المتعدد الأقطاب. في المقابل، لا يزال البعض الآخر يدعو إلى صفقة كبرى تقسم العالم إلى مناطق نفوذ مستقرة. والقاسم المشترك بين تلك الرؤى وغيرها من رؤى النظام الدولي هو افتراض أن الحوكمة العالمية يمكن تصميمها وفرضها من أعلى الهرم إلى أسفله. بوجود قيادة حكيمة وعقد مؤتمرات كثيفة على مستوى القمة، يمكن ترويض الغابة الدولية وزراعتها. ويمكن التفاوض على استبعاد تضارب المصالح والأحقاد التاريخية واستبدالها بالتعاون المفيد لكل الأطراف.
بيد أن تاريخ النظام الدولي لا يعطي سوى أسباب قليلة تشجّع على التحلي بالثقة بالحلول التعاونية من أعلى إلى أسفل. في الواقع، أقوى الأنظمة في التاريخ الحديث، من ويستفاليا في القرن السابع عشر إلى النظام الدولي الليبرالي في القرن العشرين، لم تكُن منظمات شاملة تعمل من أجل مصلحة البشرية العامة، بل كانت تحالفات بنتها قوى عظمى لخوض منافسة أمنية ضد خصومها الرئيسيين. في الحقيقة، ما جمع تلك الأنظمة معاً، هو الخوف والبغض من عدو مشترك، وليس الدعوات المستنيرة لجعل العالم مكاناً أفضل. والجدير بالذكر أن التقدم في القضايا العابرة للحدود، عندما تم إحرازه، برز إلى حد كبير كنتيجة ثانوية للتعاون الأمني الصارم. ولم يكُن ذلك التعاون يدوم عادةً، إلا إذا ظلّ التهديد المشترك قائماً ويمكن التحكم فيه.
وحينما كان ذلك التهديد يتبدد أو يزداد بشكل كبير جداً، انهارت الأنظمة. وحاضراً، يتلاشى النظام الليبرالي لأسباب متعددة، لكن السبب الأساسي يكمن في أن التهديد الذي صُمم في الأصل لهزيمته (أي الشيوعية السوفياتية) اختفى قبل ثلاثة عقود. لم يستمر أي من البدائل المقترحة للنظام الحالي، لأنه لم يكُن هناك تهديد مخيف أو واضح بما يكفي لفرض تعاون مستمر بين الجهات الفاعلة الرئيسة.
حتى الآن. من خلال موجة من القمع والعدوان، أرعبت الصين البلدان القريبة والبعيدة. وهي تتصرف بشكل عدائي في شرق آسيا، وتحاول إنشاء مناطق اقتصادية خالصة في الاقتصاد العالمي، وتصدّر الأنظمة الرقمية التي تجعل الاستبداد أكثر فاعلية من أي وقت مضى. للمرة الأولى منذ الحرب الباردة، تواجه مجموعة كبيرة من البلدان تهديدات تشكّل خطراً على أمنها ورفاهيتها وأساليب حياتها، تنبع جميعها من مصدر واحد.
لحظة الوضوح هذه أثارت موجة من الردود. يتسلّح جيران الصين ويتحالفون مع القوى الخارجية لتأمين أراضيهم وممراتهم البحرية. وبطريقة موازية، يعمل عدد من الاقتصادات الكبرى في العالم بشكل جماعي على تطوير معايير تجارية واستثمارية وتقنية جديدة تنطوي ضمنياً على تمييز ضد الصين. وعلى نحو مماثل، تتجمع الديمقراطيات لوضع استراتيجيات مكافحة الاستبداد في الداخل والخارج، وتظهر منظمات دولية جديدة لتنسيق المعركة. في الواقع، تبدو تلك الجهود مبعثرة عند النظر إليها في الوقت الفعلي، ولكن إذا ابتعدنا عن الاضطرابات اليومية، ستظهر صورة أكثر اكتمالاً: المنافسة مع الصين تكوّن نظاماً دولياً جديداً، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ.
أنظمة الاستبعاد
يربط العقل الليبرالي الحديث النظام الدولي بالسلام والوئام. في المقابل، من الناحية التاريخية، تمحورت الأنظمة الدولية حول السيطرة على المنافسين وليس حول التقريب بين الجميع. وكما جادل الباحث النظري في العلاقات الدولية كايل لاسكوريت (Kyle Lascurettes)، فالأنظمة الرئيسة في القرون الأربعة الماضية كانت “أنظمة استبعاد”، صممتها القوى المهيمنة لنبذ الخصوم والتغلب عليهم. إذاً، لم يهدف بناء النظام إلى فرض ضوابط على الصراع الجيوسياسي، بل كان بمثابة سياسة قوة ولكن بوسائل أخرى، وسيلة فاعلة من حيث التكلفة لاحتواء الخصوم من دون الانزلاق إلى حرب.
شكّل الخوف من العدو، وليس الثقة بالأصدقاء، حجر الأساس لنظام كل عصر، وطوّر الأعضاء مجموعة مشتركة من المعايير من خلال اعتبار أنفسهم خصوماً لذلك العدو. وبذلك، استفادوا من الدافع الأكثر بدائية للعمل الجماعي لدى الإنسان. وفي سياق متصل، يسمّي علماء الاجتماع ذلك بـ”الديناميكية داخل المجموعة / خارج المجموعة”، فيما يسمّيها الفلاسفة بـ”نظرية سالوست” على اسم المؤرخ القديم الذي جادل أن الخوف من قرطاج أبقى الجمهورية الرومانية متماسكة. وفي العلوم السياسية، المفهوم المشابه هو التحزب السلبي، أي ميل الناخبين إلى أن يصبحوا موالين بشدة لحزب سياسي واحد بشكل أساسي لأنهم يحتقرون منافسه.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الديناميكية السلبية تسود تاريخ بناء الأنظمة. في عام 1648، صانت الممالك المنتصرة في حرب الثلاثين عاماً قواعد الدول المستقلة في “صلح وستفاليا” لتقويض سلطة الكنيسة الكاثوليكية والإمبراطورية الرومانية المقدسة. كذلك، صممت بريطانيا العظمى وحلفاؤها معاهدة أوتريخت عام 1713 لاحتواء فرنسا عن طريق نزع الشرعية عن التوسع الإقليمي من خلال الزيجات الملكية وتأكيد الروابط الأسرية، وهي الطريقة المفضلة لدى لويس الرابع عشر لحشد القوة. وبالاسترجاع، استخدمت الأنظمة الملكية المحافِظة “التوافق الأوروبي” في مرحلة السلام بعد نابليون، علماً أن هذا التوافق تأسس في فيينا عام 1815، بهدف إحباط صعود الأنظمة الثورية الليبرالية. في الحرب العالمية الأولى، بنى المنتصرون نظام ما بين الحربين العالميتين للسيطرة على ألمانيا وروسيا البلشفية. وبعد الحرب العالمية الثانية، صمم الحلفاء في البداية نظاماً عالمياً، يتمحور حول الأمم المتحدة، لمنع عودة الفاشية والميركانتيلية على الطريقة النازية. في مقلب مغاير، عندما أعاق نشوب الحرب الباردة ذاك النظام العالمي بسرعة، أنشأ الغرب نظاماً منفصلاً لاستبعاد الشيوعية السوفياتية والتغلب عليها. وخلال فترة الحرب الباردة، انقسم العالم إلى نظامين: نظام مهيمن بقيادة واشنطن، وآخر أضعف ومحوره موسكو.
في الواقع، تنحدر السمات الرئيسة للنظام الليبرالي السائد اليوم مباشرة من تحالفات الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. فبعد أن قرر السوفيات عدم الانضمام إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (غات Gatt)، تغيّرت وجهة استعمال تلك المؤسسات وتحوّلت إلى أدوات للتوسع الرأسمالي، بدايةً، من أجل إعادة بناء الاقتصادات الرأسمالية، ولاحقاً من أجل الترويج للعولمة. وبطريقة موازية، أرسى مشروع مارشال الأساس للمجتمع الأوروبي من خلال إغداق المساعدات الأميركية على الحكومات التي وافقت على طرد الشيوعيين من صفوفها والسعي إلى اتحاد اقتصادي. ثم أنشأ حلف “ناتو” جبهة موحدة ضد الجيش الأحمر. في المقابل، أُنشئت سلسلة من التحالفات الأميركية في أنحاء شرق آسيا لاحتواء التوسع الشيوعي هناك، خصوصاً من الصين وكوريا الشمالية. وكان ارتباط الولايات المتحدة مع الصين، الذي استمر من سبعينيات القرن الماضي إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بمثابة مناورة لاستغلال الانقسام الصيني السوفياتي.
شكّلت كل مبادرة من تلك المبادرات في الواقع، عنصراً في نظام صُمّم أولاً وقبل كل شيء لهزيمة الاتحاد السوفياتي. لولا وجود تهديد الحرب الباردة، لما تحمّلت اليابان وألمانيا الغربية الاحتلال العسكري الأميركي المطول على أراضيهما، ولما جمع البريطانيون والفرنسيون والألمان مواردهم الصناعية. وعلى نحو مشابه، لما وضعت الولايات المتحدة كامل ثقلها لدعم المؤسسات الدولية، بعد أن أمضت القرنين الماضيين في التملص من الالتزامات الدولية وحماية اقتصادها من الرسوم الجمركية، ولما قدّمت ضمانات أمنية ومساعدات ضخمة وقدرة وصول سهلة إلى الأسواق لعشرات البلدان، بما في ذلك دول المحور السابقة. إذاً، لا شيء قد يجبر هذا العدد من الدول على تنحية مصالحها المتضاربة وخصوماتها الطويلة الأمد جانباً وبناء أقوى مجتمع أمني وأقوى نظام للتجارة الحرة في التاريخ، إلا التهديد المتمثل في وجود قوة شيوعية عظمى مسلحة نووياً.
الانهيار تحت الضغط
على مدى عقود، عرفت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما الذي يؤمنون به ومن هو العدو. ولكن بعد ذلك، انهار الاتحاد السوفياتي، فحلّت مجموعة متنوعة من التهديدات الصغيرة مكان تهديد شامل وحيد. في بيئة ما بعد الحرب الباردة الجديدة وغير المؤكدة، لجأ الحلفاء الغربيون إلى مصادر النجاح السابقة. وبدلاً من بناء نظام جديد، أصرّوا على النظام الموجود. فبحسب اعتقادهم، ربما كان عدوهم تفكّك، لكن مهمتهم بقيت كما هي، متمثلة في زيادة حجم مجتمع ديمقراطيات السوق الحرة. خلال العقود الثلاثة التالية، عملوا على توسيع النظام الليبرالي الغربي ليصبح نظاماً عالمياً. وتضاعفت عضوية “ناتو” تقريباً. ثم تحوّلت المجموعة الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو اتحاد اقتصادي كامل يضم أكثر من ضعف عدد الدول الأعضاء. وكذلك، تحوّلت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة Gatt إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) التي رحبت بالعشرات من الأعضاء الجدد، ما أطلق العنان لفترة غير مسبوقة من العولمة المفرطة.
لكنها لم تستطِع أن تدوم، إذ إن النظام الليبرالي، مثل كل الأنظمة الدولية، هو شكل من أشكال النفاق المنظم الذي يحتوي على بذور زواله. وبهدف تشكيل مجتمع متماسك، يتعين على بناة النظام استبعاد الدول المعادية، وحظر السلوكيات غير المتعاونة، وكبح المعارضة المحلية التي تقف في وجه عملية صنع القواعد الدولية. في الواقع، تؤدي تلك الأعمال القمعية بطبيعتها إلى رد فعل عنيف في النهاية. في منتصف القرن التاسع عشر، جاءت في شكل موجة من الثورات الليبرالية، أدت إلى تآكل الوحدة والتماسك الأيديولوجي في “التوافق الأوروبي” الملكي. خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، دمرت القوى الفاشية المتضررة النظام الليبرالي الناشئ في فترة ما بين الحربين والذي وقف في طريق طموحاتها الإمبريالية. بحلول أواخر الأربعينيات، رفض الاتحاد السوفياتي النظام العالمي الذي أسهم في التفاوض بشأنه قبل بضعة أعوام لا غير، وذلك بعدما استولى على أراضٍ في أوروبا الشرقية بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. كما سخر ممثل الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة من مؤسسات “بريتون وودز” ووصفها بأنها “فروع من وول ستريت”. وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الدولية إقصائية بطبيعتها، لذا فهي تحرّض على المعارضة لا محالة.
لطالما اعتقد كثيرون في الغرب أن النظام الليبرالي سيكون استثناءً للنمط التاريخي، إذ من المفترض أن التزام النظام بالانفتاح وعدم التمييز جعل “إبطاله سهلاً والانضمام إليه صعباً”، وفق ما ناقشه العالم السياسي ج. جون إيكينبيري في تلك الصفحات عام 2008. كان يمكن لأي دولة، كبيرة كانت أو صغيرة، أن تدخل في الاقتصاد المعولم. وبطريقة موازية، استطاعت المؤسسات الليبرالية استيعاب جميع أنواع الأعضاء، حتى غير الليبراليين منهم، علماً أن النظام سيصلحهم تدريجاً ليصبحوا أصحاب مصلحة مسؤولين. ومع انضمام مزيد من الدول، نشأت حلقة مفرغة، إذ ولّدت التجارة الحرة الرخاء، وهذا الأمر أسهم في نشر الديمقراطية، ما عزز بدوره التعاون الدولي، وأدى إلى مزيد من التجارة. الأهم من ذلك، أن النظام لم يواجه معارضة كبيرة، لأنه سبق أن هزم عدوه الرئيس. إذاً، فقد بعث زوال الشيوعية السوفياتية برسالة واضحة إلى الجميع مفادها بأنه لا يوجد بديل قابل للتطبيق يحلّ محل الرأسمالية الديمقراطية.
لقد تبيّن أن تلك الافتراضات خاطئة. فالنظام الليبرالي، في الواقع، إقصائي للغاية. من خلال تعزيز الأسواق الحرة والحدود المفتوحة والديمقراطية والمؤسسات الدولية واستخدام المنطق لحل المشكلات، يتحدى النظام المعتقدات التقليدية والمؤسسات التي وحّدت المجتمعات لقرون، المتمثلة في سيادة الدولة والقومية والدين والعرق والقبيلة والأسرة. والجدير بالذكر أن تلك الروابط الدائمة بالدم والأرض تعرّضت للكبت خلال الحرب الباردة، عندما كان على الولايات المتحدة وحلفائها الحفاظ على جبهة موحدة لاحتواء الاتحاد السوفياتي. لكنها عاودت الظهور خلال فترة ما بعد الحرب الباردة. في عام 1988، قال المسؤول السوفياتي جورجي أرباتوف لجمهور أميركي: “سنقترف سوءاً بحقكم. سنحرمكم من عدو لكم”. وتبيّن أن التحذير كان تنبّؤياً. فمن خلال قتل النظام الليبرالي لخصمه الرئيس، أطلق العنان لكل أنواع المعارضة القومية والشعبوية والدينية والسلطوية.
إن عدداً من أعمدة النظام ينهار تحت الضغط. فيما يتمزق حلف “ناتو” بسبب الخلافات حول تقاسم الأعباء. كما أن الاتحاد الأوروبي كاد يتفكك خلال أزمة منطقة اليورو، وفي الأعوام التي تلت ذلك، خسر المملكة المتحدة وأصبح مهدداً بصعود الأحزاب اليمينية المعادية للأجانب في جميع أنحاء القارة. إضافة إلى ذلك، استمرت الجولة الأخيرة من محادثات التجارة المتعددة الأطراف التي أجرتها منظمة التجارة العالمية لمدة 20 عاماً من دون أي اتفاق، علماً أن الولايات المتحدة تشلّ السمة الأساسية للمؤسسة (أي محكمة الاستئناف، التي تحكم في النزاعات بين الدول) بسبب فشلها في تنظيم الحواجز غير الجمركية الصينية. بشكل عام ، يبدو النظام الليبرالي غير مهيّأ للتعامل مع المشكلات العالمية الملحة مثل تغيّر المناخ والأزمات المالية والأوبئة والمعلومات المضللة الرقمية وتدفق اللاجئين والتطرف السياسي، التي يمكن القول إن قسماً كبيراً منها هو نتيجة مباشرة لنظام مفتوح يروّج لتدفق الأموال والسلع والمعلومات والأشخاص عبر الحدود بلا قيود.
لقد أدرك صناع السياسة تلك المشكلات منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من ذلك، لم يلقَ أي من أفكارهم الرامية إلى إصلاح النظام رواجاً، لأن بناء النظام مكلف. فهو يتطلب من القادة توجيه الوقت ورأس المال السياسي، بعيداً من تنفيذ أجنداتهم من أجل الاتفاق على القواعد الدولية وإقناع الجمهور المتشكك بها، كما يتطلب من الدول اعتبار مصالحها الوطنية أقل أهمية من الأهداف الجماعية، والثقة بأن الدول الأخرى ستفعل الشيء ذاته. لا تأتي تلك الإجراءات بشكل طبيعي، ولهذا السبب يحتاج بناء النظام عادة إلى عدو مشترك. على مدى 30 عاماً، كانت تلك القوة الموحدة غائبة، ونتيجة لذلك تفكك النظام الليبرالي.
دخول التنين
لم يكُن هناك أي شك حول ما تريده الصين، لأن القادة الصينيين أعلنوا الأهداف ذاتها لعقود من الزمن: إبقاء الحزب الشيوعي الصيني (CCP) في السلطة وإعادة ضم تايوان والسيطرة على شرق الصين وبحر الصين الجنوبي وإرجاع الصين إلى المكانة التي تليق بها كقوة مهيمنة في آسيا وأقوى دولة في العالم. خلال معظم العقود الأربعة الماضية، اتّبعت الدولة نهجاً صبوراً وسلمياً نسبياً لتحقيق تلك الأهداف. ومن خلال تركيز الصين على النمو الاقتصادي والخوف من أن يتجنبها المجتمع الدولي، تبنّت استراتيجية “الصعود السلمي”، بالاعتماد في المقام الأول على النفوذ الاقتصادي في تعزيز مصالحها، وبشكل عام اتباع مقولة للزعيم الصيني دينغ شياو بينغ: “إخفِ قوّتك وانتظر الوقت المناسب”.
لكن في الأعوام الأخيرة، توسعت الصين بقوة على جبهات متعددة. وحلّت دبلوماسية “الذئب المحارب” محل دبلوماسية الصداقة. بالتالي، باتت تردّ على الإهانات المحسوسة من الأجانب، مهما كانت صغيرة، بإدانة على نسق أسلوب كوريا الشمالية. إذاً، تسرّب الموقف القتالي إلى كل جزء من سياسة الصين الخارجية، حتى صار يعرّض عدداً من البلدان إلى أخطر تهديد لها منذ أجيال.
ويتجلى ذلك التهديد بشكل أكبر في منطقة شرق آسيا البحرية، حيث تتحرك الصين بعنف لتعزيز مطالبها الإقليمية الشاسعة. في ذلك المجال، تقوم بكين بإنتاج السفن الحربية بشكل أسرع من أي بلد منذ الحرب العالمية الثانية، وقد ملأت الممرات البحرية الآسيوية بخفر السواحل الصيني وسفن الصيد. إضافة إلى ذلك، عززت المواقع العسكرية عبر بحر الصين الجنوبي وزادت بشكل كبير استخدامها السفن المجهزة للاصطدام والاعتراضات الجوية من أجل إخراج الجيران من المناطق المتنازع عليها. في مضيق تايوان، تجري دوريات عسكرية صينية، يضم بعضها عشرات السفن الحربية وأكثر من 50 طائرة مقاتلة، تطوف البحر يومياً تقريباً وتحاكي الهجمات على أهداف تايوانية وأميركية. وبحسب ما قاله مسؤولون صينيون للمحللين الغربيين، فالدعوات لغزو تايوان تنتشر داخل الحزب الشيوعي الصيني. ويشعر مسؤولو البنتاغون بالقلق من أن مثل هذا الهجوم ربما يكون وشيكاً.
دخلت الصين في الهجوم الاقتصادي أيضاً. وفي ذلك السياق، تُوجّه خطتها الخمسية الأخيرة دعوة للسيطرة على ما يسمّيه المسؤولون الصينيون بـ”نقاط الاختناق”، أي السلع والخدمات التي لا تستطيع البلدان الأخرى العيش من دونها، ثم استخدام تلك الهيمنة، إضافة إلى إغراء السوق المحلية الصينية، لإجبار البلدان على تقديم التنازلات. وبهدف تحقيق تلك الغاية، أصبحت الصين الموزع المهيمن للقروض الخارجية، محمّلةً أكثر من 150 دولة ما يتخطى تريليون دولار من الديون. لقد دعمت بشكل كبير الصناعات الاستراتيجية بهدف احتكار مئات المنتجات الحيوية، وقامت بتركيب الأجهزة المناسبة للشبكات الرقمية في عشرات البلدان. وكونها مسلّحة بالنفوذ الاقتصادي، استخدمت الإكراه ضد أكثر من 12 دولة خلال الأعوام القليلة الماضية. في حالات متعددة، كانت العقوبة غير متناسبة مع الجريمة المفترضة، على سبيل المثال، فرض رسوم جمركية على عدد من صادرات أستراليا بعدما طلبت تلك الدولة إجراء تحقيق دولي في أصول فيروس كورونا.
أصبحت الصين أيضاً قوة فاعلة في مناهضة للديمقراطية، تروّج لأدوات استبداد متطورة في جميع أنحاء العالم. من خلال الجمع بين كاميرات المراقبة والرصد الذي توفّره وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، والقياسات الحيوية، وتقنيات التعرف على الكلام والوجه، باتت الحكومة الصينية رائدة في نظام يسمح للطغاة بمراقبة المواطنين باستمرار ومعاقبتهم على الفور عن طريق منع وصولهم إلى التمويل أو التعليم أو التوظيف أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو السفر. في الحقيقة، يمثّل ذاك الجهاز حلم طاغية، والشركات الصينية تبيع أشكالاً منه وتشغلها في أكثر من 80 دولة.
الفعل ورد الفعل
بينما تحرق الصين ما تبقّى من النظام الليبرالي، فهي تثير ردود فعل دولية عنيفة. في ذلك الإطار، ارتفعت الآراء السلبية عن البلاد في جميع أنحاء العالم إلى مستويات عالية لم نشهدها منذ مذبحة ميدان تيان أنمين عام 1989. ووجد استطلاع أجراه “مركز بيو للبحوث” عام 2021 أن ما يقرب من 75 في المئة من الناس في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لديهم وجهات نظر معارضة للصين ولا يثقون بأن الرئيس شي جينبينغ سيتصرف بمسؤولية في الشؤون العالمية أو يحترم حقوق الإنسان. وكشف استطلاع آخر أجراه “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” عام 2020، أن حوالى 75 في المئة من نخب السياسة الخارجية في تلك الأماكن ذاتها اعتقدوا أن أفضل طريقة للتعامل مع الصين هي تشكيل تحالفات من الدول ذات التفكير المماثل ضدها. في الولايات المتحدة، يدعم كلا الحزبين السياسيين الآن سياسة صارمة تجاه الصين. وعلى نحو مماثل، أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً أن الصين “خصم منهجي”. في آسيا، تواجه بكين حكومات معادية بشكل علني في كل الاتجاهات، من اليابان إلى أستراليا إلى فيتنام إلى الهند. حتى الأشخاص في البلدان التي تتاجر بكثافة مع الصين يشعرون بالمرارة تجاهها. تظهر الاستطلاعات أن الكوريين الجنوبيين على سبيل المثال، يكرهون الصين الآن أكثر من كرههم لليابان التي كانت تستعمرهم سابقاً.
إذاً، بدأت المشاعر المعادية للصين تُترجم في رد فعل سلبي ملموس. في المقابل، لا تزال المقاومة غير ناضجة وغير مكتملة، ويرجع ذلك أساساً إلى أن مجموعة من الدول لا تزال مدمنة على التجارة الصينية. بيد أن الاتجاه العام واضح، إذ بدأ فاعلون مختلفون بتوحيد قواهم من أجل دحر قوة بكين. في الوقت ذاته، هم يعيدون ترتيب العالم.
في الواقع، ينحرف النظام الناشئ المناهض للصين بشكل أساسي عن النظام الليبرالي، لأنه موجّه نحو تهديد مختلف. على وجه الخصوص، يقلب النظام الجديد التركيز النسبي على الرأسمالية مقابل الديمقراطية. خلال الحرب الباردة، شجع النظام الليبرالي القديم الرأسمالية أولاً وأتت الديمقراطية في المركز الثاني بفارق كبير. ودعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأسواق الحرة إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه قوتهم، ولكن عندما أجبروا على الاختيار، أيّدوا في معظم الأوقات المستبدين اليمينيين أكثر من الديمقراطيين اليساريين. إذاً، كان ما يُسمّى بـ”العالم الحر” عبارة عن بنية اقتصادية بشكل أساسي. حتى بعد الحرب الباردة، عندما صار الترويج للديمقراطية حرفة موجودة في كل منزل في العواصم الغربية، غالباً ما أهملت الولايات المتحدة وحلفاؤها المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مقابل القدرة على الوصول إلى الأسواق، على غرار ما فعلوه بشكل ملحوظ من خلال إدخال الصين إلى منظمة التجارة العالمية.
لكن الانفتاح الاقتصادي أصبح الآن عبئاً على الولايات المتحدة وحلفائها، لأن الصين قابعة في كل جوانب النظام الليبرالي تقريباً. والنظام الرأسمالي الاستبدادي الصيني بعيد كل البعد من الاضمحلال بسبب العولمة، لا بل يبدو مصمماً بشكل مثالي تقريباً على استنزاف الأسواق الحرة من أجل تحقيق مكاسب تجارية. واستطراداً، تستخدم بكين الدعم المالي والتجسس لمساعدة شركاتها في الهيمنة على الأسواق العالمية وحماية سوقها المحلية بالحواجز غير الجمركية. كذلك، تفرض رقابة على الأفكار والشركات الأجنبية على الإنترنت الخاص بها وتدخل بحرّية إلى الإنترنت العالمي لسرقة الملكية الفكرية ونشر بروباغندا الحزب الشيوعي الصيني. بطريقة موازية، هي تتولى مناصب قيادية في المؤسسات الدولية الليبرالية، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم تأخذها في اتجاه غير ليبرالي. إضافة إلى ذلك، هي تتمتع بشحن آمن في جميع أنحاء العالم في ما يتعلق بآلة التصدير الخاصة بها، بفضل البحرية الأميركية، وتستخدم جيشها لتأكيد السيطرة على مساحات شاسعة من شرق الصين وبحر الصين الجنوبي.
أدركت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخطر. فالنظام الليبرالي، خصوصاً الاقتصاد المعولم الموجود في نواته، يمنحان القوة لخصم خطير. رداً على ذلك، يحاولون بناء نظام جديد يستبعد الصين من خلال جعل الديمقراطية شرطاً للعضوية الكاملة. عندما عقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمره الصحافي الأول في مارس (آذار) 2021، ووصف التنافس بين الولايات المتحدة والصين بأنه جزء من منافسة أوسع بين الديمقراطية والاستبداد، لم يكُن ذلك تنميقاً خطابياً. بل كان يرسم خط معركة على أساس اعتقاد شائع بأن الرأسمالية الاستبدادية تشكل تهديداً مميتاً للعالم الديمقراطي، تهديداً لا يمكن احتواؤه من خلال النظام الليبرالي. وبدلاً من إصلاح القواعد الحالية، بدأت الديمقراطيات الغنية بفرض قواعد جديدة من خلال التكاتف معاً، واعتماد معايير وممارسات تقدمية، والتهديد باستبعاد الدول التي لا تتبعها. والجدير بالذكر أن الديمقراطيات لا تعمل على إقامة توازن في وجه الصين فحسب، من خلال زيادة إنفاقها الدفاعي وتشكيل تحالفات عسكرية، بل تعيد أيضاً ترتيب العالم من حولها.
قيد الإنشاء
لا تزال بنية النظام الجديد عملاً قيد التنفيذ، وعلى الرغم من ذلك، يمكن تمييز سمتين رئيستين فيه. الأولى كتلة اقتصادية فضفاضة ترسيها مجموعة السبع، تضمّ مجموعة الحلفاء الديمقراطيين الذين يسيطرون على أكثر من نصف ثروة العالم. وتتعاون تلك القوى الرائدة مع مجموعة متناوبة من الدول ذات التفكير المماثل، من أجل منع الصين من احتكار الاقتصاد العالمي. في الواقع، لقد أثبت التاريخ أن أي قوة تهيمن على السلع والخدمات الاستراتيجية في حقبة ما، تهيمن على تلك الحقبة. في القرن التاسع عشر، تمكّنت المملكة المتحدة من بناء إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس على الإطلاق لأنها برعت في مجال الحديد والبخار والتلغراف بشكل أسرع من منافسيها. في القرن العشرين، تقدّمت الولايات المتحدة على البلدان الأخرى من خلال استخدام الفولاذ والمواد الكيماوية والإلكترونيات والفضاء وتكنولوجيا المعلومات. وحاضراً، تأمل الصين في أن تهيمن على القطاعات الاستراتيجية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأن تخفّض مرتبة الاقتصادات الأخرى لكي تجعلها في حالة من الإذعان.
في اجتماع عُقد عام 2017 في بكين، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لمستشار الأمن القومي الأميركي آنذاك هربرت ريموند ماكماستر، كيف تصور أن الولايات المتحدة والدول الأخرى ستندمج في الاقتصاد العالمي في المستقبل. وتذكّر ماكماستر قول لي إن دورهم “لن يتخطى تزويد الصين بالمواد الخام والمنتجات الزراعية والطاقة لتغذية إنتاجها للسلع الصناعية والاستهلاكية المتطورة في العالم”.
ولكي تتجنب الديمقراطيات الرائدة أن تصبح عجلة ثانوية في إمبراطورية اقتصادية صينية، بدأت تشكيل شبكات تجارية واستثمارية حصرية مصممة لتسريع تقدمها في القطاعات الحيوية وإبطاء النمو الصيني. بعض علاقات التعاون تلك، على غرار “الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان الهادفة إلى تعزيز المنافسة والقدرة على مواجهة الكوارث” (U.S.-Japan Competitiveness and Resilience Partnership,) التي أُعلن عنها عام 2021، تقوم بإنشاء مشاريع مشتركة في مجال البحث والتطوير لمساعدة الأعضاء في التفوق على الابتكار الصيني. في المقابل، تركز مخططات أخرى على تقليص النفوذ الاقتصادي الصيني من خلال تطوير بدائل للمنتجات الصينية وتمويلها. ستوفّر مبادرة “إعادة بناء عالم أفضل” (Build Back Better World) التي أطلقتها مجموعة الدول السبع ومبادرة “البوابة العالمية” (Global Gateway) التي تبنّاها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تمويلاً للبنية التحتية في الدول الفقيرة كبديل لـ”مبادرة الحزام والطريق” (Belt and Road Initiative) الصينية. على نحو مماثل، وحّدت أستراليا والهند واليابان جهودها لبدء “مبادرة مرونة سلسلة التوريد” (Supply Chain Resilience Initiative)، التي تقدّم حوافز لشركاتها لكي تنقل عملياتها خارج الصين. وبناء على طلب من الولايات المتحدة، فالبلدان التي تشكّل أكثر من 60 في المئة من سوق المعدات الخليوية في العالم، فرضت قيوداً أو تفكّر في فرض قيود على شركة “هواوي”، المزود الصيني الرئيس لاتصالات الجيل الخامس.
وفي الوقت ذاته، تعمل التحالفات الديمقراطية على تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة. على سبيل المثال، تآمرت هولندا وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة لإبعاد الصين عن مجال إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة، ومنعها عن استخدام الآلات التي تصنع تلك الموصلات. واستكمالاً، تعمل مؤسسات جديدة على إرساء الأسس لنظام شامل متعدد الأطراف يهدف إلى مراقبة الصادرات. فيما يضع “مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي” (U.S.-EU Trade and Technology Council) معايير مشتركة عبر المحيط الأطلسي لفحص الصادرات إلى الصين والاستثمار هناك عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة. بطريقة موازية، تهدف “مبادرة ضوابط التصدير وحقوق الإنسان” (Export Controls and Human Rights Initiative)، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تم الكشف عنه في أواخر عام 2021، إلى فعل الأمر ذاته بالنسبة إلى التقنيات القادرة على دعم الاستبداد الرقمي، مثل أدوات التعرف إلى الكلام والوجه. كذلك، تتفاوض الولايات المتحدة وحلفاؤها الديمقراطيون أيضاً على صفقات تجارية واستثمارية للتمييز ضد الصين، وتضع معايير العمل والبيئة والحوكمة التي لن تلتزم بها بكين على الإطلاق. في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 مثلاً، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وضع ترتيب جديد يفرض رسوماً جمركية على منتجي الألمنيوم والصلب الذين يشاركون في إغراق السوق بمنتجات معينة [ما يؤدي إلى انخفاض سعرها] أو في الإنتاج الكثيف للكربون، علماً أنه إجراء سيضرب الصين أكثر من أي بلد آخر.
أما الميزة الثانية للنظام الناشئ، فهي وجود حاجز عسكري مزدوج لاحتواء الصين. في ذلك الإطار، تتكوّن الطبقة الداخلية من منافسين يحدّون شرق الصين وبحر الصين الجنوبي. ويتسلّح عدد كبير من تلك الدول، بما في ذلك إندونيسيا واليابان والفيليبين وتايوان وفيتنام، بقاذفات صواريخ وألغام متحركة. وهدف تلك الدول هو تحويل نفسها إلى قنافذ شائكة قادرة على حرمان الصين من السيطرة البحرية والجوية بالقرب من شواطئها. وحاضراً، تعزز تلك الجهود طبقة خارجية من القوى الديمقراطية، بشكل أساسي أستراليا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتقدم تلك الديمقراطيات المساعدة والأسلحة والمعلومات إلى الدول المجاورة للصين، إضافة إلى تدريب مشترك لتتمكّن من شن ضربات صاروخية بعيدة المدى على القوات الصينية وفرض حصار على واردات الصين من النفط، وتنظيم تدريبات حرّية الملاحة المتعددة الجنسيات في جميع أنحاء المنطقة، بخاصة بالقرب من الصخور والشعب المرجانية والجزر التي تسيطر عليها الصين في المناطق المتنازع عليها.
في الحقيقة، يزداد هذا التعاون الأمني قوة ويكتسب طابعاً مؤسسياً أكثر فأكثر. فلنشاهد عودة ظهور الحوار الأمني الرباعي، أو “كواد”، وهو تحالف يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، كان هامداً بعد وقت قصير من تأسيسه عام 2007. أو فلننظر إلى إنشاء اتفاقيات جديدة، وأبرزها “أوكوس” (AUKUS)، وهي عبارة عن تحالف يربط بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. الهدف الأسمى من كل هذا النشاط هو الحفاظ على الوضع الإقليمي الراهن في شرق آسيا. لكن الهدف الأكثر وضوحاً هو إنقاذ تايوان، الدولة الديمقراطية الموجودة في الخطوط الأمامية الأكثر عرضة لخطر الغزو الصيني. في ذلك السياق، وضعت اليابان والولايات المتحدة خطة معركة مشتركة للدفاع عن الجزيرة، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون إنه “من غير المعقول” ألّا تنضم بلاده أيضاً إلى القتال. في المقابل، تبنّى البرلمان الأوروبي من جهته خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مرونة تايوان الاقتصادية والاعتراف الدولي بها.
عند النظر إلى تلك الجهود بشكل فردي، تبدو كأنها عشوائية وتفاعلية. في المقابل، تكشف تلك الجهود معاً رؤية إيجابية لنظام ديمقراطي، يختلف اختلافاً جوهرياً عن النموذج التجاري الصيني وأيضاً عن النظام الدولي القديم، وتكمن في جوهره الأرثوذكسية النيوليبرالية. من خلال غرس معايير العمل وحقوق الإنسان في الاتفاقيات الاقتصادية، تعطي الرؤية الجديدة الأولوية للناس بدلاً من أرباح الشركات وسلطة الدولة. كما أنها ترفع مستوى البيئة العالمية من مجرد سلعة إلى مشاع متقاسم ومحميّ بشكل مشترك. ومن خلال ربط الحكومات الديمقراطية معاً في شبكة حصرية، يحاول النظام الجديد إجبار الدول على إصدار سلسلة من الأحكام التقديرية ويفرض عقوبات حقيقية على السلوك غير الليبرالي. هل تريد أن تصنع فولاذاً كثيف الكربون يعتمد على العمل بالسخرة؟ استعد لتحمّل الرسوم الجمركية التي فرضتها أغنى دول العالم. هل تفكر في ضم مياه دولية؟ توقّع إذاً زيارة من أسطول متعدد الجنسيات.
إذا استمرت الصين في تخويف الديمقراطيات وجعلها تعمل معاً، قد تتمكّن حينئذ من إحداث أهم تغييرات في الحوكمة العالمية خلال جيل أو أكثر. ومن خلال احتواء التوسع البحري الصيني مثلاً، يمكن أن يصبح نظام الأمن البحري في شرق آسيا آلية قوية لتطبيق قانون البحار. وعلى نحو مماثل، من خلال إدخال تعريفات على الكربون في الصفقات التجارية بهدف التمييز ضد الصين، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها إجبار المنتجين على تقليل انبعاثاتهم، ما يخلق عن غير قصد أساساً لفرض ضريبة دولية على الكربون. في سياق متصل، أدى نجاح مجموعة “كواد” في تأمين مليار جرعة من لقاحات كورونا في جنوب شرقي آسيا، في محاولة لجذب القلوب والعقول بعيداً من بكين، إلى توفير مخطط لمكافحة الأوبئة في المستقبل. والجدير بالذكر أن الجهود المتحالفة لمنع انتشار الاستبداد الرقمي يمكن أن تشجع على إنشاء أنظمة دولية جديدة متعلقة بالتدفقات الرقمية وخصوصية البيانات، كما يمكن أن تؤدي حتمية التنافس مع الصين إلى زيادة غير مسبوقة في الإنفاق على البحث والتطوير والبنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
على غرار الأنظمة الماضية، يُعتبر النظام الناشئ نظام إقصاء، يدعمه الخوف ويجري فرضه من خلال الإكراه. وخلافاً لمعظم الأنظمة السابقة، فهو موجّه نحو الانتهاء التدريجي.
تصادم الأنظمة
إن تاريخ بناء النظام الدولي هو تاريخ منافسة شرسة بين أنظمة متصادمة، وليس تاريخ تعاون متناغم. في أفضل الأوقات، اتخذت تلك المنافسة شكل حرب باردة، شهدت تنافس الأطراف على المصالح وقيام كل طرف بجسّ نبض الآخر في كل إجراء من دون الانزلاق إلى استخدام القوة العسكرية. وعلى الرغم من ذلك، في كثير من الحالات، تحوّلت المنافسة في النهاية إلى حرب نارية وانتهت بسحق أحد الجانبين للآخر. وهكذا، كان النظام المنتصر يحكم إلى أن يدمره منافس جديد، أو إلى أن ينهار ببساطة من دون وجود تهديد خارجي يحافظ على تماسكه.
في وقتنا هذا، يدعو عدد متزايد من صانعي السياسات والخبراء إلى توافق جديد بين القوى من أجل حلّ مشكلات العالم وتقسيم الكرة الأرضية إلى مناطق نفوذ. لكن فكرة النظام الشامل الذي لا تسود فيه رؤية خاصة بسلطة معينة، هي وهم لا يمكن أن يكون موجوداً إلا في مخيلات الحالمين في الحكومات العالمية والمنظرين الأكاديميين. لا يوجد سوى نظامين قيد الإنشاء في الوقت الحالي، أحدهما بقيادة الصين والآخر بقيادة الولايات المتحدة، والتنافس بين الاثنين يتحوّل إلى صدام بين الاستبداد والديمقراطية، إذ يضع البلدان نفسيهما ضد بعضهما البعض ويحاولان غرس هدف أيديولوجي في تحالفاتهما. تقدّم الصين نفسها على أنها المدافع العالمي عن التسلسل الهرمي والتقاليد ضد الغرب المنحط وغير المنضبط، فيما تستجمع الولايات المتحدة بشكل متأخر تحالفاً جديداً للتحقق من القوة الصينية وجعل العالم مكاناً آمناً للديمقراطية.
صراع الأنظمة هذا سيحدد القرن الحادي والعشرين ويقسّم العالم. ستنظر الصين إلى النظام الديمقراطي الناشئ على أنه استراتيجية احتواء تهدف إلى خنق اقتصادها وإسقاط نظامها. ورداً على ذلك، ستسعى إلى حماية نفسها من خلال تأمين سيطرة عسكرية أكبر على ممراتها البحرية الحيوية، وإنشاء مناطق اقتصادية حصرية لشركاتها، ودعم الحلفاء الاستبداديين بينما تزرع الفوضى في الديمقراطيات. في المقابل، سيؤدي تصاعد القمع والعدوان الصيني إلى دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى نبذ بكين وبناء نظام ديمقراطي. وللحصول على لمحة صغيرة عما قد تبدو عليه تلك الحلقة المفرغة، فلنتذكر ما حدث في مارس 2021، عندما عاقبت كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أربعة مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. كانت تلك العقوبة بمثابة صفعة خفيفة على اليد، لكن بكين فسّرتها على أنها اعتداء على سيادتها وأطلقت العنان لخطاب حاد طويل دبلوماسي وسلسلة من العقوبات الاقتصادية. وردّ الاتحاد الأوروبي من خلال تجميد “الاتفاقية الشاملة للاستثمار” (Comprehensive Agreement on Investment) المقترحة بينه والصين.
في الأعوام المقبلة، ستستعر الحروب التجارية والتكنولوجية التي بدأت خلال إدارة ترمب بين الصين والولايات المتحدة، فيما يحاول الجانبان توسيع نطاق نفوذهما. وسوف تجد البلدان الأخرى صعوبة متزايدة في حماية نفسها من خلال الحفاظ على الروابط مع الكتلتين. عوضاً عن ذلك، ستدفع الصين والولايات المتحدة شركاءهما للانحياز إلى جانب واحد، وستجبرانهم على إعادة توجيه سلاسل التوريد الخاصة بهم واعتماد النظام البيئي الكامل للتكنولوجيات والمعايير التابع لأحد النظامين. كذلك، سينقسم الإنترنت إلى قسمين. هكذا، عندما يسافر الأشخاص من نظام إلى آخر، إذا كان بإمكانهم حتى الحصول على تأشيرة، فسوف يدخلون إلى عالم رقمي مختلف. لن تعمل هواتفهم، ولا مواقعهم المفضلة أو حسابات بريدهم الإلكتروني أو تطبيقاتهم الثمينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وستشتدّ حدة الحرب السياسية بين النظامين، فيما يحاول كل منهما تقويض شرعية منافسه المحلية والجاذبية الدولية التي يتمتّع بها. إضافة إلى ذلك، ستكون الممرات البحرية في شرق آسيا مكتظة بالسفن الحربية، وستشهد القوات المتنافسة مواجهات قريبة متكررة.
لن تنتهي المواجهة إلا عندما يهزم أو يرهق أحد الجانبين الآخر. حاضراً، تميل دفّة الأموال الذكية نحو الولايات المتحدة، التي تمتلك ثروة وأصولاً عسكرية أكثر بكثير مما تمتلكه الصين، وآفاقاً أفضل للنمو المستقبلي. بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، سيكون شي، المدخن البدين الذي يعمل في وظيفة مرهقة، في العقد الثامن من عمره، إذا كان لا يزال على قيد الحياة. من الآن إلى ذلك الحين، ستصل الأزمة الديموغرافية في الصين إلى ذروتها، إذ من المتوقع أن تفقد الدولة ما يقرب من 70 مليون من البالغين في سن العمل وتكسب 130 مليون شخص من كبار السن.
ستكون مئات المليارات من الدولارات من القروض الصينية في الخارج مستحقة الدفع، وسيعجز عن سدادها قسم كبير من شركاء الصين الأجانب. في الواقع، من الصعب أن نرى كيف يمكن لدولة تواجه هذا الكمّ من التحديات أن تحافظ على نظامها الدولي لفترة طويلة، خصوصاً في مواجهة معارضة حازمة من أغنى دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك، ليس مضموناً أيضاً أن النظام الديمقراطي الذي تقوده واشنطن سوف يتماسك. قد تعاني الولايات المتحدة من أزمة دستورية في الانتخابات الرئاسية عام 2024 وتغرق في حروب أهلية. وحتى لو لم يحدث ذلك، فمن المحتمل أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها ممزقة في انقساماتها. في الحقيقة، يعاني العالم الديمقراطي من أكبر أزمة ثقة ووئام منذ الثلاثينيات. في المقابل، تتزايد القومية والشعبوية ومعارضة العولمة، ما يجعل العمل الجماعي صعباً. وفي الوقت ذاته، تعاني ديمقراطيات شرق آسيا من نزاعات إقليمية مستمرة في ما بينها. فيما ينظر عدد من الأوروبيين إلى الصين على أنها فرصة اقتصادية أكثر من كونها تهديداً استراتيجياً ويشككون بجدية في مصداقية الولايات المتحدة كحليف، بعد تحمّل أربعة أعوام من الرسوم الجمركية وازدراء الرئيس دونالد ترمب، الذي قد يعود إلى السلطة قريباً. لدى الأوروبيين أيضاً وجهات نظر غير تلك التي يتبنّاها الأميركيون بشأن أمن البيانات والخصوصية، وتخاف الحكومات الأوروبية من هيمنة التكنولوجيا الأميركية بقدر ما تخشى تقريباً الهيمنة الرقمية الصينية. وبطريقة موازية، قد لا تكون الهند مستعدة للتخلي عن سياستها التقليدية المتمثلة في عدم الانحياز ودعم نظام ديمقراطي، خصوصاً عندما تصبح أكثر قمعية في الداخل، وسيواجه النظام المبني حول الديمقراطية معاناة في تكوين شراكات مثمرة مع الأنظمة الاستبدادية التي قد تشكّل شراكة مهمة في أي تحالف ضد الصين، مثل سنغافورة وفيتنام. وفي ذلك الإطار، قد يكون الخوف من الصين قوة جبارة، لكنّ قوته لن تكون كافية ربما للتغلب على التصدعات المتعددة الموجودة داخل التحالف الناشئ المناهض للصين.
إذا فشل هذا التحالف في ترسيخ نظامه الدولي، سينزلق العالم مجدداً بثبات نحو الفوضى، نحو صراع بين القوى الفاسدة والكتل الإقليمية بحيث يحقق الأقوياء ما في وسعهم ويرضخ الضعفاء. وفي سياق متصل، يفترض بعض العلماء، أو يأملون، أن عالماً غير منظم سوف يرتّب نفسه من تلقاء نفسه، وأن القوى العظمى ستقيم مجالات نفوذ مستقرة وتتجنب الصراع أو أن انتشار التجارة الدولية والأفكار المستنيرة سوف يحافظ بشكل طبيعي على السلام والازدهار العالميين. لكن السلام والازدهار أمران غير طبيعيين. عندما يتم تحقيقهما، يكونان نتيجة التعاون المستمر بين القوى العظمى، أي نتيجة تطبيق نظام دولي.
الإصرار على الديمقراطية
يُظهر التاريخ أن عصور تعددية الأقطاب المتقلبة تنتهي عادةً بكارثة، بغض النظر عن الأفكار اللامعة أو التقنيات المتقدمة المتداولة في ذلك الوقت. شهدت أواخر القرن الثامن عشر ذروة عصر التنوير في أوروبا، قبل أن تنحدر القارة إلى جحيم الحروب النابليونية. في بداية القرن العشرين، تنبّأت أذكى العقول في العالم بنهاية صراع القوى العظمى، بعد أن ربطت السكك الحديدية وكابلات التلغراف والبواخر بين البلدان. وسرعان ما تبع ذلك أسوأ حرب في التاريخ حتى تلك اللحظة. الحقيقة المحزنة والمتناقضة هي أن الأنظمة الدولية ضرورية لتجنّب الفوضى، لكنها لا تظهر عادة إلا خلال فترات التنافس بين القوى العظمى. وستكون المنافسة مع الصين محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، لكنها قد تكون الطريقة الوحيدة لتفادي مخاطر أكبر.
ومن أجل بناء مستقبل أفضل، ستحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تبنّي نظرة أكثر وعياً واستنارة بشأن مصالحهم مقارنة بتلك التي تبنّوها خلال الحرب الباردة حتى. في ذلك الوقت، كانت مصالحهم الاقتصادية تتوافق بشكل جيد مع مصالحهم الجيوسياسية. والجشع البسيط، على الأقل، يمكن أن يجبر الدول الرأسمالية على التكاتف لحماية الملكية الخاصة ضد هجمة شيوعية. لكن الخيار الآن، ليس بهذه البساطة، لأن الوقوف في وجه الصين ستترتب عليه تكاليف اقتصادية كبيرة، بخاصة على المدى القصير. قد تتضاءل أهمية تلك التكاليف مقارنة بالتكاليف الطويلة الأجل المترتبة على العمل كالمعتاد مع بكين، إذ قُدّر أن التجسس الصيني يحرم الولايات المتحدة وحدها من مبلغ يتراوح بين 200 مليار دولار و600 مليار دولار سنوياً، ناهيك عن المآزق الأخلاقية والمخاطر الجيوسياسية للتعاون مع نظام شمولي وحشي يمتلك طموحات انتقامية. وعلى الرغم من ذلك، فالقدرة على إجراء مثل هذا الحساب المستنير الذي يؤيد مواجهة الصين قد تتجاوز قدرات أي دولة، بخاصة تلك التي تشهد قطبية [انقساماً] مثل الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الديمقراطيين.
إذا كان هناك أي أمل، فهو يكمن في تجديد الالتزام بالقيم الديمقراطية. تتشارك الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاً مشتركاً بتحقيق نظام دولي قائم على المبادئ الديمقراطية ومجسّد في الاتفاقيات والقوانين الدولية. في الواقع، يجري تشكيل جوهر مثل هذا النظام في تجربة المنافسة مع الصين ويمكن تطويره إلى النظام الأكثر استنارة الذي قد يشهده العالم على الإطلاق، إلى عالم حر حقيقي. ولكن من أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تقبّل المنافسة مع الصين والمضي قدماً يداً بيد في صراع غامض آخر.
مايكل بيكلي هو بروفيسور مشارك في العلوم السياسية في جامعة توفتس، وزميل متقدم غير مقيم في معهد “أميركان إنتربرايز” ومؤلف كتاب “منقطعة النظير: لماذا ستبقى أميركا القوة العظمى الوحيدة في العالم”
مترجم من الفورين أفيرز
المصدر: اندبندنت عربية