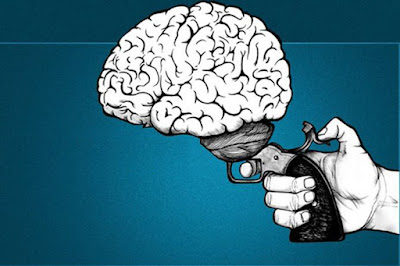
دفعني المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم المقام في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إلى مراجعة ذاتية لمفهوم التجديد، رغم أنّ التجديد سمة لا غنى عنها لكل مجتمع يتطلع إلى الارتقاء، وهنا التجديد بكل معانيه، الفكرية والتطبيقية وما يتفرع عنها. حتى أنّه لا يمكننا تخيّل الاشتغال على الحكامة والتطلع نحو حكم رشيد، دون وجود خطاب تجديدي، ديني أو سياسي أو مجتمعي، أو سواها.
رغم ذلك، ألحظ بوناً شاسعاً بين المشارقة والمغاربة في معنى التجديد ذاته، على الأقل من زاويتي. وأقصد بالمشارقة هنا شرق المتوسط ومصر خصوصاً، كون الكارثة الفكرية تقع في هذه البيئة في العشرية السوداء الماضية، نتاجاً لها ومتفاعلة معها، ومعيداً لإنتاجها.
تجديد الخطاب الإسلامي، هو بالأصل تنحية كلّ ما هو متطرّف منه وشاذّ وغير منضبط بالأصول الإسلامية، والتطرّف بالحتمية هو نتاج جهل أو أغراض سياسية أيديولوجية –كما لدى كل جماعات الإسلام السياسي دون استثناء على ما أظن–.
هذا التجديد يحتاج بيئة سلميّة أولاً باعتبارها أولى أركان هذا الخطاب، تكون بيئة نابذة للعنف والتطرف الفكري والسلوكي، وتكون أيضاً بيئة علمية رافضة للجهلة الذين يشتغلون على قيادة المجتمعات نحو الخراب لأهداف مصلحية ثانياً، إذاً هي بيئة منبثقة من داخل الإسلام ومن علماء لهم يد طولى في العلوم الدينية، إذ لا يمكن تخيل تجديد فكري من خارج الفكر، وأقصد من غير إلمام بحدوده التي تمنع تدميره كلياً، وهنا أتجرأ على وصف بعضهم بالتهديميين ولم يكونوا يوماً تجديديين.
كما يحتاج هذا الخطاب قادة يفهمون معنى السلم المدني ويشتغلون عليه ثالثاً، ويدركون أبعاد إدارة التنوع الثقافي بكل مفرداته الدينية والاجتماعية.
وهذا ما اجتمع عليه قادات مجتمعية إفريقية (مسلمون وغير مسلمين)، في نواكشوط، تحت رعاية العلامة عبد الله بن بيّه، لمحاربة آفة تتفاقم في بلدان غرب إفريقيا، متخذة من “الإسلام” ستاراً لها، وأقصد تعاظم التطرف الإرهابي الذي يستهدف المسلمين أنفسهم قبل سواهم، بالتزامن مع ما أسماه السيد ولد أباه “صدمة الانتقال السلمي”، أي عودة الانقلاب العسكرية وتهديد الديموقراطيات الهشة في هذه الدول، بالتزامن مع ما أجمع عليه الكثيرون من مشاكل اجتماعية واقتصادية تغذي هذ الآفة.
هذه الجماعات المتطرفة، عانينا منها نحن المشارقة كثيراً، بل إن جاز القول، نحن الذين عانينا منها، منذ ولوج القاعدة إلى بلادنا، وما تفرع عنها وتشابك معها، وما ترافق معها من ميليشيات شيعية، وبالتالي نحن أولى بإنتاج خطاب “تجديدي”، وهنا وللمرة الأولى، سأتحفظ على مفهوم التجديد.
مشرقياً، خلال العشرية الماضية ونيف، كان مفهوم التجديد تائهاً لا ضوابط له ولا حدود ولا معنى، لأنه لم ينضبط بالأركان الرئيسة، فلا هو أُنتِج في بيئة سلمية بل هي بيئة منتجة ومصدرة للعنف، ولا هو أُنتِج في بيئة علمية بل بيئة أعطت لأشباه المتعلمين “في العلم الديني” مكاناً مرموقاً، ولم يكن هناك قادة يشتغلون على مفهوم السلم المدني.
إذاً، ظهرت اتجاهات متطرفة –حتى خارج الجماعات الإرهابية–، هي تيارات شعبية بحثت عن التطرف وعززته، وهو اليوم في أشد مراحله، ويمكن ملاحظته في سهولة التكفير وشيوعه لدى جيل الحروب والثورات. بل يمكن ملاحظة مدى التطرف الديني لدى شباب لم يتعلموا إلا نزراً يسيراً، وأصبحوا مُوَجِّهين لسواهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا كان الركن الرابع قد سقط (التواصل مع الشباب باعتبارهم هدفاً رئيساً لخطاب التجديد).
هذه الاتجاهات، دفعت لظهور ما سيُعرف بالمجدّدين مشرقياً، كان قسم منهم أبعد ما يكون عن ذلك، هم شخصيات لا علم ديني لها، بل هم على خصومة حادة مع الإسلام أحياناً، واشتغلوا على صناعة خطاب ديني بعيد عن قواعد الإسلام ومفاهيمه (بأدواته لكن من خارجه). أو أشبه بصناعة نسختهم من الإسلام، بما يتفق معهم وحدهم، واستطاعوا بدورهم أن يجذبوا جمهوراً هو أيضاً متطرف في المقلب الآخر، وبالغ التطرف حد العداء نحو الإسلام، باعتبار أن:
“الإسلام ليس هو الإسلام، بل ما قال به هؤلاء المجددون”، الذين أُطلِق عليهم من قبل أتباعهم بالمفكرين والمجددين والمحدثين وما إلى هنالك من تسميات لا علاقة لها بمضمون ما يطرحونه. نتيجة سقوط الأركان الأربعة السابقة. وهنا أعيد التذكير بأنني أعني القسم الذي بات الأكثر شهرة في المجتمعات وفي الإعلام وبين جمهور مضطرب الهوية وعدائي التوجه.
طبعاً ذلك مرتبط بشكل أبعد، بالصراعات الطائفية والمذهبية والدينية، وهنا يسقط مرة أخرى ركن (القدرة إدارة التنوع البشري). وهو ومرتبط بالحتمية بالصراع الديني-العلماني، وبالصراع الأكثري-الأقلوي، وهو ما أنتج خطابين متطرفين متضادين، أحدهما يدعي امتلاك الإسلام جملة وتفصيلاً، وآخر يدعي صناعة إسلام جديد، سيُعرَف بين بعض من الجمهور باسم (الإسلام الكيوت cute Islam)، وخطابات ثالثة رافضة للهوية الإسلامية كلياً، وما بينها.
أما الركن الآخر الذي يغيب مشرقياً (وتحديداً الدول الفاشلة والمنهارة: العراق، سورية، لبنان، اليمن، ويمتد إلى أبعد من ذلك)، وهو عدم وجود أنظمة سياسية تشتغل على صيانة المجتمعات، بل كانت تلك الأنظمة مسبباً رئيساً بدروها لشكلي التطرف، بعد أن كانت سبباً في انهيار الدولة بأسرها، متشاركة في هذه المهمة مع التدخلات الخارجية التي أتى قسم منها على شكل احتلالات جديدة للدول العربية، غذت بدورها كل اتجاه متطرف.
المصدر : صفحة د. عبد القادر نعناع
باحث مختص بشؤون الشرق الأوسط







