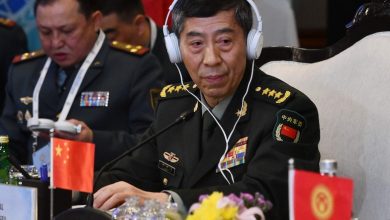هل بدأ العالم بالدخول في حرب باردة جديدة؟ إجابتنا هي نعم ولا. نعم، إذا كنا نقصد تنافساً دولياً طويل الأمد، لأن الحروب الباردة بهذا المعنى قديمة قدم التاريخ نفسه، ولقد تحول بعضها إلى حروب ساخنة، وبقي بعضها على حاله، ولا يوجد قانون يضمن أياً من النتيجتين. والإجابة الثانية هي لا، إذا كنا نقصد الحرب الباردة بنفس المعنى الشائع لذلك الصراع الذي اندلع في فترة معينة (من 1945-1947 إلى 1989-1991)، بين خصوم معينين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وحلفائهما)، وحول قضايا معينة (موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية، والاشتباكات الأيديولوجية، وسباقات التسلح). ففي الوقت الراهن، لا تبرز بشكل كبير أي من هذه القضايا، وعلى الرغم من وجود أوجه تشابه – مثل تزايد القطبية واشتداد الجدل وزيادة حدة الفروق بين الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات – فإن السياق مختلف تماماً.
لم يعد موضع جدل أن الولايات المتحدة والصين، الحليفين الضمنيين خلال النصف الأخير من الحرب الباردة الأخيرة، بدأتا تدخلان في حربهما الباردة الجديدة: لقد أعلنها الرئيس الصيني شي جينبينغ، وقبل إجماع نادر من الحزبين في الولايات المتحدة الدخول في هذا التحدي. إذاً، ما الذي يمكن أن تكشف عنه المنافسات السابقة – الحرب الباردة الوحيدة والحروب الباردة العديدة السابقة – عن هذه المعركة؟
إن المستقبل بطبيعة الحال ليس معلوماً مثل الماضي، لكنه ليس مجهولاً من جميع النواحي، حيث نعلم أن الوقت سيمضي باستمرار، وسيظل قانون الجاذبية سارياً، ولن يعيش أي منا أكثر من حدود فترتنا الجسدية. هل هناك حقائق معلومة وذات مصداقية مشابهة تؤثر في تشكيل الحرب الباردة الناشئة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما المجهول الكامن بداخل هذه الحقائق؟ لقد كان لدى ثوقيديدس توقعات ومفاجآت مماثلة عندما حذر، قبل 24 قرناً، من أن المستقبل سوف يشبه الماضي، ولكن لن يعكسه من جميع النواحي – حتى عندما جادل أيضاً بأن أعظم حرب في عصره كشفت عن حقائق خالدة حول جميع الحروب التي ستأتي بعدها.
إن هدفنا هنا، إذاً، هو إظهار كيف يمكن لأعظم حرب لم يتم خوضها في عصرنا – وهي الحرب الباردة السوفياتية الأميركية – بالإضافة إلى الصراعات السابقة الأخرى، أن توسع التجربة وتعزز المرونة في التنافس الصيني – الأميركي الذي يبقى مستقبله الساخن أو البارد غير واضح. ويوفر ذلك التاريخ إطاراً يمكن من خلاله تحمل حالة عدم اليقين، وربما حتى الازدهار في خضمها، بغض النظر عما سيلقي به بقية القرن الحادي والعشرين في طريقنا.
فوائد الحدود
إن أول ما نعرفه هو الجغرافيا، والتي سيغيرها الانجراف القاري مع مرور الوقت، ولكن ليس في عصرنا. ستبقى الصين بشكل رئيس قوة برية، تكتنفها معضلة قديمة. إذا حاولت، بحثاً عن عمق استراتيجي، توسيع محيطها، فمن المحتمل أن تتحمل ما يفوق طاقتها وتثير مقاومة جيرانها الخائفين. وإذا انكفأت على نفسها، لاستعادة حيويتها، فإنها تخاطر بدعوة الأعداء. حتى خلف الأسوار العظيمة، ترقد بعدم الارتياح رؤوس أولئك الذين لا تزال حدودهم غير ثابتة.
في المقابل، تستفيد الولايات المتحدة من حدود رسمتها الجغرافيا. هذا هو السبب في أن المملكة المتحدة، بعد عام 1815، اختارت عدم الوقوف في طريق ريادة وليدتها في أميركا الشمالية، حيث كان تحريك الجيوش عبر 3000 ميل من المحيط مكلفاً للغاية حتى بالنسبة لأعظم قوة بحرية في العالم. لقد منحت الجغرافيا الأميركيين هيمنة هجينة: السيطرة على قارة، والوصول دون عوائق إلى محيطين شاسعين، ربطت بينهما بسرعة بخط سكة حديد عابرة للقارات. ولقد أتاح لهم ذلك تطوير الإمكانات العسكرية الصناعية التي أنقدوا بها الأوروبيين في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحرب الباردة من محاولات الضم القارية التي واجهوها.
لكن لماذا أخذ الأميركيون على عاتقهم هذه المسؤوليات الثقيلة وهم في بيت آمن؟ ربما نظروا في المرآة وخافوا مما رأوه: دولة مثلهم تهيمن على قارة ومحيطاتها. كان التحذير المحفز هو استكمال روسيا لخطها السككي العابر لسيبيريا في عام 1904، وهو مشروع متسرع سرعان ما طمرته الحرب والثورة – ولكن ليس قبل أن يثير تحذير الجيوسياسي البريطاني هالفورد ماكيندر عندما قال إن سيطرة الدول القارية (Heartland) على الدول الشاطئية (Rimland) الأورو-آسيوية يمكن أن يعزز أشكالاً طموحة عالمية للهيمنة المختلطة. كان هذا الاحتمال في ذهن الرئيس وودرو ويلسون عندما أعلن الحرب على ألمانيا الإمبراطورية في عام 1917، وأعطى الرئيس فرانكلين روزفلت بعداً أكبر لهذه الفكرة في 1940-1941 عندما أصر – بشكل صحيح كما أثبت المؤرخون الآن – على أن الهدف النهائي لأدولف هتلر كان الولايات المتحدة، لذلك عندما دعا الدبلوماسي الأميركي جورج كينان، في عام 1947 إلى “احتواء” الاتحاد السوفياتي الحليف الأكثر جرأة في الحرب العالمية الثانية كان لديه إرث طويل يمكن الاعتماد عليه.
تثير مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني “شي” مخاوف مماثلة. ويراد لـ”الحزام” أن يكون شبكة من ممرات السكك الحديدية والطرق عبر أوراسيا. ويقصد بـ”الطريق” شبكة من طرق الملاحة البحرية في المحيطين الهندي والهادي، وإذا سمح الاحترار العالمي بذلك، فإن هذه الطرق ستكون أيضاً في القطب الشمالي، مدعومة بقواعد وموانئ في الدول التي ستصبح صديقة للصين نتيجة “فوائد” مبادرة الحزام والطريق. إن أي محاولة قام بها الألمان أو الروس من قبل لم تجمع بين مثل هذا الطموح والخصوصية، إذ تسعى الصين إلى هيمنة هجينة على نطاق غير مسبوق. ويقودنا هذا إلى أول وضع مجهول بالنسبة لنا، وهو: ما الذي قد يعنيه ذلك بالنسبة لأوراسيا وبقية العالم؟
نظام “شي” العالمي
سجلت القرون الثلاثة الماضية بشكل بارز نجاح قوى موازنة في ما وراء البحار في إحباط الطامحين إلى الهيمنة على الشواطئ. حدث هذا أولاً عندما وقفت بريطانيا العظمى ضد فرنسا في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ثم التحالف الأنغلو أميركي ضد ألمانيا مرتين خلال النصف الأول من القرن العشرين، ثم بين تحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفياتي في النصف الثاني من نفس القرن. من السهل جداً الادعاء بأن الدول البحرية تستعرض قوتها من دون إثارة مقاومة، لكن لو كان الأمر كذلك لكان الاستعمار لا يزال مستمراً، لكن العلاقة بين الجغرافيا والحكم واضحة بما يكفي لتكون ثاني حقيقة معلومة لدينا.
عادة ما ينشأ المستبدون في القارات – باستثناء أميركا الشمالية، حيث إنه عندما لا ترسم الجغرافيا حدود الدول، تتحرك الأيدي القاسية للمطالبة بالحق وادعاء الواجب للقيام بذلك، سواء كحماية من الأخطار الخارجية أو للحفاظ على النظام الداخلي. وفي هذه المواقف، تفرض الحرية من الأعلى إلى الأسفل، ولا تتطور من الأسفل إلى الأعلى، لكن هذا يحمل مثل هذه الأنظمة المسؤولية عما يحدث، إذ لا يمكنهم، كما تفعل الديمقراطيات بانتظام، توزيع اللوم. فالأنظمة الاستبدادية التي تعاني القصور – مثل الاتحاد السوفياتي – تخاطر بإفراغ نفسها من الداخل.
لقد سعى قادة الصين في حقبة ما بعد الحرب الباردة، بعد أن درسوا النموذج السوفياتي بشراهة إلى تجنب تكراره عن طريق تحويل الماركسية إلى رأسمالية استهلاكية، وفي الوقت نفسه من دون السماح بالديمقراطية، وبذلك صححوا ما اعتبروه أكبر خطأ ارتكبه الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف عندما سمح بالديمقراطية من دون ضمان الازدهار. يبدو أن ما قامت به حديثاً من “تصحيح الأسماء” – وهو إجراء صيني قديم لمطابقة الأسماء مع الحقائق المتغيرة – قد نجح حتى وقت قريب. ولقد عززت إصلاحات الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ المؤيدة لاقتصاد السوق بعد وفاة ماو تسي تونغ (عام 1976) شعبية النظام، وجعلت الصين نموذجاً يحتذى به لمعظم دول العالم. كان من المتوقع على نطاق واسع أن يواصل شي، عند توليه السلطة، السير على هذا الطريق.
دراسة التاريخ أفضل دليل لاستكشاف المستقبل
لكنه لم يفعل. بدلاً من ذلك، قطع “شي” سبل التواصل مع العالم الخارجي، ويتحدى القواعد القانونية الدولية، ويشجع دبلوماسية “الذئب المحارب”، وكلها إجراءات لا يبدو أنها تهدف لكسب الحلفاء أو الاحتفاظ بهم. في الداخل، يقوم بفرض تعليم العقيدة (الشيوعية) وتبييض التاريخ واضطهاد الأقليات بطرق ربما كان سيرحب بها الأباطرة الروس والصينيون البائدون. والأهم من ذلك، أنه سعى إلى تأمين هذه الانتكاسات من خلال إلغاء حدود ولايته في الحكم.
ومن هنا يبرز المجهول الثاني: لماذا يتراجع “شي” عن الإصلاحات، ويتخلى عن الحنكة الدبلوماسية، التي سمحت للصين بالصعود في المقام الأول؟ ربما يخشى مخاطر تقاعده، على الرغم من تصاعدها مع كل تطهير أو إيداع في السجن للمنافسين. ربما أدرك أن الابتكار يتطلب العفوية، لكن قد يولدها أيضاً داخل بلده. ربما يشعر بالقلق من أن عداء المنافسين الدوليين المتزايد لن يتيح له الوقت الكافي لتحقيق أهدافه. ربما يرى أن المفهوم السائد للنظام العالمي نفسه يتعارض مع تفويض من السماء أو ماركس أو ماو.
ربما يتصور “شي” نظاماً عالمياً جوهره الاستبداد، ومركزه الصين. قد يتوقع أن تجعل التكنولوجيا الوعي البشري شفافاً كما جعلت الأقمار الصناعية سطح الأرض خلال الحرب الباردة. ويحتمل أن يفترض أن الصين لن تبعد أصدقاءها الأجانب أبداً، أو أن التوقعات داخل الصين لن تتوقف أبداً عن الارتفاع لأي سبب كان. وسيكتسب “شي”، مع تقدمه في العمر، الحكمة والطاقة والعناية بالتفاصيل، التي لا يثق إلا في نفسه كقائد أعلى، أن يوفرها.
ولكن إذا كان شي يؤمن بكل هذا حقاً، فإنه قد أغفل بالفعل الفجوات بين الوعود والأداء التي لطالما كانت معضلة للأنظمة الاستبدادية. فإذا تجاهلت مثل هذه التصدعات، مثلما فعل أسلاف غورباتشوف، فإنها ستزداد سوءاً، ولكن إذا اعترفت بوجودها، كما فعل غورباتشوف نفسه، فسوف تقوض ادعاء العصمة الذي يجب أن تستند إليه الشرعية في الحكم المطلق. هذا هو السبب في ندرة المنافذ الرؤوفة للمستبدين.
جذور الصمود
تكتنف الديمقراطية الأميركية فجواتها الخاصة بين الوعود والأداء، لدرجة أنها تبدو في بعض الأحيان وكأنها تعاني شللاً يشبه شلل بريجنيف، لكن تختلف الولايات المتحدة عن الصين في كون عدم الثقة بالسلطة منصوصاً عليه دستورياً، حيث يضمن الفصل بين السلطات مركز ثقل يمكن للأمة العودة إليه بعد أي موجة فوران قد تحدث نتيجة الأزمات. والنتيجة هي ما يسميه علماء الأحياء التطوري “التوازن المتقطع”: مرونة متأصلة في التعافي السريع من الظروف غير المتوقعة. في الصين، هناك وضع معاكس. يتغلغل احترام السلطة في ثقافتها، لكن الاستقرار تتخلله اضطرابات طويلة الأمد عندما تفشل السلطة، وقد يتطلب التعافي في غياب الجاذبية عقوداً من الزمان. غالباً ما تفوز الأنظمة الاستبدادية بسباقات قصيرة وسريعة، لكن المستثمرين الأذكياء يراهنون في السباقات الطويلة على الديمقراطيات. لذا فإن الحقيقة الثالثة المعروفة لدينا هي أن هناك جذوراً مختلفة تماماً للصمود.
يظهر هذا النمط بوضوح من الحربين الأهليتين الأكثر تكلفة في القرن التاسع عشر: تمرد تايبينغ بين 1850 و1864 الذي أودى بحياة 20 مليون صيني، أي نحو خمسة في المئة من السكان، والحرب الأهلية الأميركية بين 1861 و1865 التي أودت بـ750 ألف مقاتل، أي 2.5 في المئة من سكان بلد أقل ازدحاماً. ومع ذلك، من خلال شهادة قادتها الحاليين، شهدت الصين بعد تمرد تايبينغ عقوداً من الاضطرابات التي خرجت منها فقط بعد إعلان ماو جمهورية الصين الشعبية في عام 1949. في المقابل، تعافت الولايات المتحدة بسرعة كافية للانضمام إلى المفترسين الأوروبيين ضد الصين منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى اليوم. وبغض النظر عن دقة المعلومات التاريخية هذه، فإن النقطة الأهم هنا هي اعتماد الرئيس “شي” بشكل متزايد على هذه الرواية وما تثيره من شعور قومي قابل للاشتعال في الثقافة الصينية، وهو أمر مفيد حالياً للنظام – ولكن قد لا يتم إخماده بسهولة.
غالباً ما تفوز الأنظمة الاستبدادية بسباقات قصيرة وسريعة، لكن المستثمرين الأذكياء يراهنون في السباقات الطويلة على الديمقراطيات
من هنا يبرز المجهول الثالث بالنسبة إلينا: هل يستطيع “شي” إشعال الغضب الداخلي وإخماده، كما فعل ماو مراراً خلال سنواته في السلطة؟ أم أن “شي” قيد نفسه بالاعتماد على العداء الخارجي الذي من دونه لم يكن جوزيف ستالين، كما قال كينان في عام 1946، يعرف كيف يحكم؟ ولأن مثل هذه الأنظمة لا يمكن طمأنتها بأي شيء، يرى كينان أن الإحباطات المتراكمة فقط هي الكفيلة بإقناع ستالين أو، على الأرجح، خلفائه بأن من مصلحتهم تغيير أسوأ جوانب نظامهم، لكن هذه الاستراتيجية لم تعتمد على أي طرف لتحديد المواعيد النهائية، لذا أشار كينان إلى أنها لم تكن لتنجح أبداً مع هتلر، الذي كان لديه جدول زمني محدد، يمليه هلاكه، لتحقيق أهدافه.
لقد أعطى ماو بمهارة نظامه 100 عام لاستعادة تايوان. واستبعد “شي” تمرير هذه المشكلة من جيل إلى جيل، على الرغم أنه لم يحدد بعد موعداً لحلها. ومع ذلك، فإن خطابه العدواني بشكل متزايد يزيد من خطر أن تتسبب قضية تايوان في إشعال حرب باردة صينية أميركية، لأن الولايات المتحدة تركت سياستها بشأن تايوان غير واضحة بشكل متعمد. كل هذا يستدعي بشكل مخيف كيف دخلت أوروبا الحرب في عام 1914: غموض في التزامات القوى العظمى، مصحوب بغياب زر منع التصعيد.
سلام آخر طويل الأمد
فيما عدا ذلك، لدينا في الحرب الباردة فاصل معروف يمكننا الاستفادة منه: كيف نحول هذا الصراع إلى “سلام طويل الأمد”. لم يثبت النصف الأول من القرن العشرين أن التنافس بين القوى العظمى يمكن حله سلمياً. تنبأ الدبلوماسي الأميركي جوزيف غرو في عام 1945 بأن اندلاع “حرب مستقبلية مع روسيا السوفياتية أمر مؤكد بقدر ما يمكن أن يكون مؤكداً أي شيء في العالم”. فما الذي سمح للقوى العظمى في الحرب الباردة بالإفلات من هذا الاحتمال، وما مدى أهمية تلك الظروف اليوم؟
تكمن إحدى الإجابات في تحول التاريخ نفسه خلال تلك السنوات إلى نبوءة. وبالنظر إلى ما جربه معظم القادة في الحرب العالمية الثانية، لم يتحمس الكثيرون للمخاطرة بالدخول في حرب ثالثة. كما ساعد أيضاً اعتبار القادة في واشنطن وموسكو الوقت حليفاً لهم، ولو لأسباب مختلفة، حيث اعتمدت استراتيجية الاحتواء الأميركية على الوقت لإحباط الطموحات السوفياتية، فيما توقع ستالين أنه مع الوقت ستندلع حروب بين الأشقاء الرأسماليين تضمن انتصارات ثورية عمالية. عندما أدرك خلفاء ستالين حجم حساباته الخاطئة، كان الوقت قد فات لعكس آثارها، وبذلك أمضى الاتحاد السوفياتي بقية الحرب الباردة متخلفاً عن الركب.
ولكن ماذا لو تلاشى العزم على تجنب الحرب القادمة مع تلاشي ذكريات الحرب الأخيرة؟ هكذا فسر بعض المؤرخين الحرب العالمية الأولى: لقد مر قرن دون حرب أوروبية كبرى. هل يهم أن ثلاثة أرباع القرن تفصل الآن القادة الأميركيين والصينيين عن الحروب الكبرى لأسلافهم؟ كان لدى الأميركيين بعض الخبرة القتالية في الصراعات “المحدودة” و”منخفضة الحدة” التي تورطوا فيها – وكانت النتائج متباينة بالتأكيد – لكن الصينيين، باستثناء غزوهم القصير لفيتنام في عام 1979، لم يخوضوا أي حرب ذات أهمية لأكثر من نصف قرن. قد يكون هذا هو السبب في أن شي، بخطابه “تهشيم الرؤوس الدموي”، يبدو أنه يحتفل بالعدوانية، وقد لا يعرف ما يمكن أن تكون تكاليفه.
لقد أوضحت أن “السلام الطويل” هو أن الأسلحة النووية قمعت التفاؤل حول كيفية انتهاء الحروب. لا توجد طريقة لمعرفة ما الذي ردعه الردع في الحرب الباردة على وجه اليقين: هذا تاريخ لم يحدث، لكن هذا في حد ذاته يشير إلى نقص متوازن في التصميم. وبحسب ما قاله رئيس الوزراء السوفياتي نيكيتا خروتشوف والرئيس الأميركي جون كينيدي علناً، لم يرغب أي منهما في الموت من أجل برلين. وبدلاً من ذلك، توافقاً على مدينة مسورة داخل بلد مقسم في وسط قارة مقسمة. لا يمكن لأي تصميم كبير أن ينتج مثل هذه الغرابة، ومع ذلك فقد صمد حتى وصلت الحرب الباردة إلى نهايتها السلمية، وإن كانت غير متوقعة أيضاً. لم يكن من الممكن أن يحدث أي من هذا من دون القدرات النووية، لأنها وحدها قادرة على تعريض الأرواح للخطر في وقت واحد في واشنطن وموسكو.
إذاً ماذا عن واشنطن وبكين؟ حتى مع التعزيزات الأخيرة، تمتلك الصين أقل من عشرة في المئة من عدد الأسلحة النووية التي تحتفظ بها الولايات المتحدة وروسيا، وهذا الرقم يمثل 15 في المئة فقط مما كان لدى القوتين العظميين في ذروة الحرب الباردة. هل هذا مهم؟ نشك في ذلك، بالنظر إلى ما حققه خروتشوف في عام 1962: على الرغم من تخلفه بنسبة تسعة مقابل واحد في الأسلحة النووية، فإنه منع غزو كوبا ما بعد خليج الخنازير الذي كان كينيدي يخطط له. ومنذ ذلك الحين تعايشت الولايات المتحدة مع حالة شاذة مجاورة لها، وهي جزيرة شيوعية في وسط نفوذها المزعوم في بحر الكاريبي.
علاوة على ذلك، بات أقل منطقياً اليوم أن تستخدم الولايات المتحدة الأسلحة النووية للدفاع عن تايوان، لأن تلك الجزيرة أهم بالنسبة لبكين من كوبا أو برلين بالنسبة لموسكو. ومع ذلك، فإن غياب المنطق في ذلك قد يقود “شي” إلى الاعتقاد أنه قادر على غزو تايوان دون المخاطرة برد نووي أميركي. وقد تشجعه قدرات الصين الإلكترونية والمضادة للأقمار الصناعية المتنامية أيضا، لأنها تعيد احتمالات الهجمات المفاجئة التي تبددت لعقود مع ثورة الاستطلاع في الحرب الباردة.
ماذا سيفعل “شي” بتايوان إذا استولى عليها؟
لكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا سيفعل “شي” بتايوان إذا استولى عليها؟ إن الجزيرة ليست مدينة يسهل السيطرة عليها مثل هونغ كونغ، كما أنها ليست شبه جزيرة القرم، التي يقطنها سكانها إلى حد كبير، وليست الجزر الكبيرة الأخرى في المنطقة ــ اليابان والفيليبين وإندونيسيا وأستراليا ونيوزيلندا ــ قطعاً متأرجحة من الدومينو. ولن يكون من المرجح أن تقف الولايات المتحدة “مكتوفة الأيدي،” بقدراتها التي لا مثيل لها. وكما قد يقولها الصينيون: “الغموض” يعني إبقاء الخيارات مفتوحة، وليس استبعاد أي رد على الإطلاق.
قد يكون أحد هذه الردود هو استغلال الضعف الذي سيولده التمدد الصيني بقوة في محيطها، وهي مشكلة عانتها موسكو ذات يوم. كان قمع “ربيع براغ” سهلاً بالنسبة للاتحاد السوفياتي في عام 1968، إلى أن تدهورت الروح المعنوية العسكرية عندما أوضح التشيك لمحتليهم أنهم لم يشعروا “بالتحرر”. إن مذهب بريجنيف – المتمثل في الالتزام بالعمل بشكل مشابه في أي مكان آخر قد تكون فيه “الاشتراكية” معرضة للخطر – أثار انزعاجاً أكثر مما طمأن قادة الدول الأخرى المماثلة، ولا سيما ماو، الذي بدأ سراً في التخطيط لـ”الانفتاح” في عام 1971 لواشنطن. عندما لجأ الاتحاد السوفياتي إلى هذه العقيدة مرة أخرى، في أفغانستان عام 1979، لم يكن لديه سوى القليل من الحلفاء الذين يمكن الاعتماد عليهم.
يمكن أن يكون لتهديدات “شي” لتايوان تأثير مماثل على الدول المحيطة بالصين، والتي قد تبحث بدورها عن “انفتاح” خاص بها على واشنطن. لقد أدت المزاعم الصينية المبالغ فيها في بحر الصين الجنوبي إلى زيادة المخاوف بالفعل في تلك المنطقة. في هذا الصدد، يمكن النظر إلى تحالف أستراليا الذي لم يكن متوقعاً مع الأميركيين والبريطانيين بشأن الغواصات النووية، فضلاً عن تعاون الهند الموسع مع حلفائها في المحيطين الهندي والهادي. علاوة على ذلك، قد لا تتجاهل دول وسط آسيا القمع الذي يمارسه الرئيس “شي” ضد التبتيون والأويغور. كما أن مصائد الديون والتدهور البيئي وشروط السداد المرهقة تزعج المستفيدين من فوائد مبادرة الحزام والطريق. من ناحيتها، يمكن أن تجد روسيا نفسها، وهي التي كانت المصدر الأصلي لمخاوف “قلب العالم” في أوائل القرن العشرين. يمكن أن تجد نفسها الآن محاطة “بأراضٍ” صينية في آسيا وشرق وجنوب شرقي أوروبا، وحتى في القطب الشمالي.
كل هذا يثير احتمال أن الأحادية القطبية الأميركية قد لا تنتهي بقطبية ثنائية صينية – أميركية غير مستقرة، ولكن بتعددية قطبية تقيد بكين وتجعل الحزم الذاتي يأتي بنتائج عكسية. كان كليمنس فون مترنيش (سياسي ورجل دولة نمساوي) وأوتو فون بسمارك (رجل دولة بروسي – ألماني) سيوافقان على ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لمحارب أميركي بارد وماهر كان يأمل، على غرارهما، في اتباع استراتيجية مماثلة. في عام 1972، قال الرئيس ريتشارد نيكسون لمجلة “تايم”: “أعتقد أنه كان سيكون عالماً أكثر أماناً وعالماً أفضل لو كانت الولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد السوفياتي والصين واليابان قوية وفي حالة جيدة لوازن كل واحد الآخر”.
مفاجآت متنوعة
إن الحقيقة المعلومة الأخيرة هي حتمية المفاجآت. يخبرنا المنظرون أن الأنظمة الدولية هي أنظمة فوضوية لا يستفرد داخلها عنصر واحد بالسلطة المطلقة. قد تقلل الاستراتيجية من الغموض، ولكنها لن تقضي عليه تماماً لأن البشر عرضة للخطأ، وكذلك الذكاء الاصطناعي بالتأكيد. ومع ذلك، هناك أنماط من المنافسة عبر الزمان والمكان، قد تتولد منها – بخاصة من الحرب الباردة السوفياتية – الأميركية – مفاجآت قي تحصل في الحرب الباردة الصينية – الأميركية.
تعتبر المفاجآت الوجودية تحولات في مسارح التنافس بين القوى العظمى، والتي لا تتحمل أي منهما المسؤولية عنها، ولكن تعرضها للخطر. وضع الرئيس الأميركي رونالد ريغان هذا في الاعتبار عندما فاجأ غورباتشوف في أول لقاء بينهما في عام 1985 بادعاء أن غزو المريخ سيجبر الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على تسوية خلافاتهما بين عشية وضحاها: ألم تكن الأسلحة النووية على الأقل خطيرة للغاية؟ لم يأتِ أهالي المريخ بعد، لكننا نواجه تهديدين وجوديين جديدين: المعدل المتسارع لتغير المناخ وتفشي وباء عالمي بين عشية وضحاها تقريباً في عام 2020، وليس أي من الحدثين غير مسبوق. لطالما تقلب المناخ، ولهذا كان من الممكن المشي من سيبيريا إلى ألاسكا. وصف ثوقيديدس الطاعون الذي ضرب أثينا عام 430 قبل الميلاد. الجديد هو المدى الذي سرعت به العولمة من هذه الظواهر، ما أثار التساؤل حول ما إذا كان يمكن للمنافسين الجيوسياسيين أن يعالجوا بشكل تعاوني التواريخ العميقة التي تغير تاريخهم بشكل متزايد.
أظهرت الحرب الباردة التي استعرت بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أن التعاون لتجنب وقوع كارثة لا يحتاج إلى أن يكون علنياً، فما من معاهدة من المعاهدات التي أبرمت بعد عام 1945 نصت على أن الأسلحة النووية لن تستخدم مرة أخرى في الحرب. بدلاً من ذلك، تمخض عن المخاطر الوجودية تعاون ضمني عوض مفاوضات شكلية كان من المرجح أن تبوء بالفشل. وقد يوفر تغير المناخ فرصاً مماثلة في الحرب الباردة الصينية – الأميركية، على الرغم من أن “كوفيد-19” لم يثر حتى الآن إلا جفاء الصين وحدها. فالوضعية تقتضي الحفاظ على شعرة معاوية بين الأطراف لاستجلاء فرص التعاون التي قد تنشأ من المشكلات الوجودية عوض الترحيب بتلك المشكلات ذاتها.
تتسبب جهود يبذلها متنافسون فرادى لإذهال أو إرباك أو ترويع خصومهم في مفاجآت مقصودة. وخير مثال على هذه المفاجآت هي الهجوم على بيرل هاربور دون أن نغفل أبداً الفشل الاستخباراتي، غير أن أعظم مفاجآت الحرب الباردة كانت التحولات القطبية التي كان ماو يتقنها. فعندما مال نحو الشرق خلال سنتي 1949 و1950، صدم إدارة ترومان وفتح الطريق أمام الحرب الكورية والتوسع الشيوعي في آسيا. وعندما ولى وجهه نحو الغرب سنتي 1970 و1971، تحالف مع الولايات المتحدة وجعل الاتحاد السوفياتي عرضة للخطر على جبهتين، وهو ضرر لم يتعافَ منه السوفيات أبداً.
لذا، فإن “انفتاح” الولايات المتحدة يوماً على روسيا سيحول موسكو ضد بكين. فقد استغرق نشوء الانقسام الصيني – السوفياتي الأصلي عقدين من الزمن، حيث سعت إدارة أيزنهاور إلى تسريع الانقسام من خلال دفع ماو إلى تبني علاقة تنافر مع خروتشوف. وقد تؤدي مبادرة الحزام والطريق التي يتبناها الرئيس تشي وحدها إلى هذا الوضع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اشتكى منذ مدة طويلة من “احتواء” الولايات المتحدة لروسيا، لكن “الاحتواء” الصيني، من وجهة نظر الكرملين، قد يصبح في نهاية المطاف الخطر الأكبر.
شكل آخر من أشكال المفاجأة المقصودة يأتي من الذين يفترض أنهم تابعون، ويتبين أنهم ليسوا كذلك. فلم تكن واشنطن ولا كانت موسكو راغبتين في حدوث أزمتي الجزر في 1954-1955 و1958: فقد تسبب فيهما كل من شيانغ كاي شيك في تايبيه وماو في بكين. من جهة أخرى، دفعت تحذيرات الزعيم الشيوعي والتر أولبريشت من انهيار وشيك لألمانيا الشرقية خروتشوف على إشعال أزمتي برلين سنوات 1958-1959 و1961. ولقد أدت القوى الصغيرة التي كانت تسعى إلى تحقيق أجنداتها الخاصة إلى إخراج الانفراج السوفياتي الأميركي عن مساره في السبعينيات، مثل هجوم مصر على إسرائيل عام 1973، وتدخل كوبا في أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 1975-1977، والاتصالات المبلغ عنها بين حفيظ الله أمين في أفغانستان والمسؤولين الأميركيين التي تسببت في غزو السوفيات لأفغانستان الذي انتهى بهزيمتهم عام 1979. مع ذلك، لم تكن هذه الأزمات سابقة في التاريخ، إذ كشف ثوقيديدس كيف كانت كورنث وكورسيرا تفعلان شيئاً مماثلاً لما كان يفعله الإسبرطيون والأثينيون قبل 24 قرناً.
إن احتمال أن تتحكم الذيول في الرؤوس في الحرب الباردة الصينية – الأميركية واضح بالفعل، حيث إن التوترات المتزايدة في مضيق تايوان هي نتيجة للتغيرات الحاصلة في سياسة تايوان خلال السنوات الأخيرة أكثر مما هي نتيجة قرارات مقصودة في واشنطن أو بكين. وإذا كانت الصين تحاول من خلال مبادرة الحزام والطريق بناء نظام يعزز قوتها إلى الحد الأقصى، فقد ينتهي بها الأمر بإنشاء نوع التبعية العكسية التي أزعجت القوى العظمى في الحرب الباردة من خلال العلاقات التي تبنيها مع أنظمة غير آمنة وغير مستقرة. وهذا هو ما يمكن أن يكون وصفة لعدم الاستقرار: فالتاريخ مليء بالحالات التي ورط فيها فاعلون محليون قوى أكبر منهم.
وأخيراً، هناك مفاجآت بنيوية. فقد انتهت الحرب الباردة بطريقة لم يتوقعها أحد في ذلك الوقت بالانهيار المفاجئ لقوة عظمى وللأيديولوجية المصاحبة لها. لقد كان المنظران اللذان توقعا مثل هذه الإمكانية، وهما كارل ماركس وفريدريك إنجلز، مؤسسي تلك العقيدة في منتصف القرن التاسع عشر. وكانا على يقين أن الرأسمالية ستدمر نفسها في النهاية من خلال خلق فجوة كبيرة جداً بين وسائل الإنتاج والفوائد التي توزعها. وبعد قرن من الزمان، قلب كينان نظرية ماركس وإنجلز رأساً على عقب، إذ أصر في 1946-1947 على أن الفجوة بين وسائل الإنتاج والفوائد الموزعة ستؤدي عوضاً عن ذلك إلى انهيار الشيوعية داخل الاتحاد السوفياتي والدول التي تدور في فلكه بعد الحرب العالمية الثانية. لم يرحب كينان بما حدث أخيراً عامي 1990 و1991، إذ شكل الانهيار الداخلي للاتحاد السوفياتي نفسه إخلالاً كبيراً بتوازن القوى حتى بالنسبة له، لكنه بالتأكيد فهم كيف يمكن للضغوط داخل المجتمعات بحد ذاتها أن تخلق المفاجأة بشكل كبير.
وإذا كان من الصعب التنبؤ بوقوع الزلازل الجيولوجية، فلا أحد يستطيع أن يتوقع موعد حدوث زلزال جيوسياسي جديد. غير أن الجيولوجيين يعرفون بالفعل أين يتوقعون حدوثها. وهذا هو ما يجعل كاليفورنيا دون ولاية كونيتيكت تتلقى تحذيرات من الزلازل. هل هشاشة الأنظمة الاستبدادية – إيمانها الغريب بخلود هياكل القيادة من أعلى إلى أسفل – هو ما يجعلها عرضة للخطر على نحو مماثل؟ أم أن استعصاء الديمقراطيات الراسخ – مقاومتها للقيادة – يشكل مخاطر أكبر عليها؟ الوقت وحده هو الكفيل بالإجابة عن هذه الأسئلة، ربما في وقت أقرب مما نتوقع.
الاستراتيجية وعدم اليقين
هذه التوليفة من الأشياء المعروفة والمجهولة معاً والمفاجآت تتركنا مع المعادلة التاريخية لمشكلة عناصرها ثلاثة: نظراً لتعايش إمكانية التنبؤ ونقيضها، لن نعرف النتيجة إلا عندما نراها. أما الاستراتيجية فلا تتوفر على تلك الرفاهية، إذ يتطلب نجاحها العيش مع حالات عدم اليقين التي سيجود بها المستقبل. وقد استطاعت استراتيجية الاحتواء، على الرغم من العيوب التي تشوب إنجازاتها، وكون إخفاقاتها في بعض الأحيان مأساوية، أن تنجح في إدارة تناقضاتها الخاصة مع توفير الوقت اللازم لمن هم داخل النظام السوفياتي وحتى لقادته في نهاية المطاف ليصبحوا واضحين.
فعلت استراتيجية الاحتواء ذلك بشكل رئيس من خلال الجمع بين بساطة المفهوم والمرونة في التطبيق، لأن حتى أكثر الوجهات وضوحاً قد لا تكشف دائماً، أو في كثير من الأحيان، المسارات التي يمكن من خلالها بلوغها. قد يكون من الضروري على سبيل المثال التعاون مع ستالين لهزيمة هتلر، أو مع تيتو لمقاومة ستالين، أو مع ماو لإرباك بريجنيف. فكل الشرور لا تكون متساوية في جميع الأوقات. كما أن تكديس الأسلحة ليس دائماً سيئاً أو أن المفاوضات دائماً جيدة: فقد استخدم أيزنهاور وكينيدي ونيكسون وريغان كلاهما لبدء تغيير الخصوم الذين يواجهونهم. لم يكن كينان يثق في مثل هذه المرونة في السعي وراء الاحتواء، ولكن هذه القدرة على المناورة بالتحديد هي التي ضمنت وصول الاستراتيجية بأمان إلى وجهتها المقصودة.
الطريقة الثانية التي نجح فيها الاحتواء كانت من خلال التعامل مع العفوية كقوة. كانت منظمة حلف شمال الأطلسي منظمة أوروبية النشأة بقدر كونها صناعة أميركية، في تناقض صارخ مع منافسها، حلف وارسو، الذي تهيمن عليه موسكو. ولم تكن الولايات المتحدة تصر على أن يكون أصدقاؤها خارج أوروبا موحدين أيديولوجيا، لأن الهدف كان جعل التنوع سلاحاً ضد منافس عازم على محو ذلك التنوع: استخدام مقاومة التنميط المتأصلة في تاريخ الشعوب وثقافاتهم وعقائدهم المميزة كحاجز أمام طموحات التوحيد للمهيمنين المحتملين.
أما العنصر الثالث فهو دورة الانتخابات الأميركية على الرغم من أنه لم يكن يبدو كذلك دائماً في ذلك الوقت. فقد أثارت اختبارات الإجهاد التي تجرى كل أربع سنوات للاحتواء قلق مهندسيها، وأثارت غضب الخبراء المتعاطفين، وبثت الذعر بين الحلفاء في الخارج، لكنها كانت على الأقل توفر ضمانات ضد التحجر. لا يمكن لأي استراتيجية طويلة الأمد أن تنجح إذا سمحت للطموحات بأن تفوق قدراتها أو لقدراتها أن تفسد تطلعاتها، ولكن كيف يطور الاستراتيجيون الوعي بالذات – والثقة بالنفس – للإقرار بأن استراتيجياتهم لا تعمل؟ من المؤكد أن الانتخابات أدوات فظة، لكنها أفضل من عدم وجود وسيلة لتغيير الحكام المستبدين المسنين غير موتهم الذي لا يعرف أتباعهم متى سيرحلون عن هذا العالم.
في الولايات المتحدة لا توجد شؤون خارجية حصرية. فبما أن الأميركيين يعلنون مثلهم العليا بشكل صريح، فإنهم يبرزون ابتعادهم عنها جميعاً بشكل أكثر وضوحاً. تظهر الإخفاقات المحلية، مثل عدم المساواة الاقتصادية والفصل العنصري والتمييز الجنسي والتدهور البيئي والتجاوزات غير الدستورية بشكل كبير للعالم ليراها. وكما قال كينان في أكثر مقال تم الاستشهاد به في هذه الصفحات، فإن “استعراضات التردد والانقسام والتفكك الداخلي داخل هذا البلد” يمكن أن “يكون لها تأثير مفرح” على الأعداء الخارجيين. ولكي تدافع عن مصالحها الخارجية “لا تحتاج الولايات المتحدة إلا أن ترقى إلى مستوى أفضل تقاليدها، وأن تثبت أنها تستحق الحفاظ على ذاتها كأمة عظيمة”.
لكن القول أسهل من الفعل، وهنا يكمن الاختبار النهائي للولايات المتحدة في منافستها مع الصين: التأني في إدارة التهديدات الداخلية لديمقراطيتنا، والتسامح مع التناقضات الأخلاقية والجيوسياسية التي يمكن من خلالها الدفاع بشكل أكثر فاعلية على التنوع العالمي. ودراسة التاريخ هي أفضل بوصلة نمتلكها للإبحار في هذا المستقبل – حتى لو تبين أنه ليس ما كنا نتوقعه ولا ما عشناه من قبل في غالب الأحيان.
هال براندز أستاذ كرسي هنري كيسنجر للشؤون العامة بجامعة جون هوبكنز، وزميل أول في معهد أميركان إنتربرايز، وهو مؤلف كتاب “صراع الشفق” (The Twilight Struggle) ماذا تعلمنا الحرب الباردة عن تنافس القوى العظمى اليوم؟
جون لويس غاديس هو أستاذ روبرت أ. لوفيت للتاريخ العسكري والبحري بجامعة ييل ومؤلف كتاب “حول الاستراتيجية الكبرى”
المصدر: اندبندنت عربية