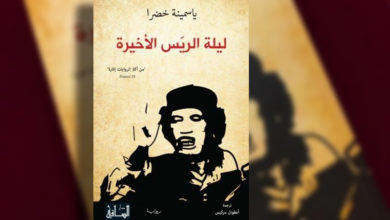تضغط حكومة الوحدة الوطنية من أجل بسط سلطتها على كافة مناطق ليبيا، مُستقوية بمواقف الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتي حضت مرات ومرات على سحب المرتزقة والميليشيات من الأراضي الليبية. وكان متوقعا من الأطراف المتضررة من الحل السياسي أن تعرقل قطار السلام بواسطة الألغام التي وضعتها على الطريق الساحلي ومحاولة تعطيل أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأخيرا بمنع الطائرة التي كانت تقل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعضاءها، في مطار بنينا، بمدينة بنغازي الأحد الماضي. وأتت الخطوة الأخيرة في اعقاب إعلان رسمي عن ميقات الزيارة، وبعد ترتيبات مسبقة. كما تم اتخاذ قرار الزيارة تلبية لطلبات عبر عنها سكان بنغازي والمنطقة الشرقية عموما، واستجابت لها الحكومة تجسيدا لوحدة البلد، وأيضا «لتفقد أحوال أهلها وتلبية حقوقهم وخدمتهم» على ما قال بيان رسمي.
وتعللت أوساط الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بأن من بين حراسات رئيس الوزراء عناصر متطرفة وإرهابيين ومطلوبين للعدالة، وأصر على ألا تؤمن حراسة الوفد الحكومي سوى قوات موالية له. وهذه الرسالة تعني محاولة العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي أن تكون المنطقة الشرقية في قبضة حفتر، بينما يُترك الغرب لحكومة الوحدة الوطنية، أسوة بالوضع الذي كان سائدا على أيام حكومة فائز السراج.
واتضحت دوافع هذا الموقف عندما عُرف أن حفتر لم يتخذ قرار منع نزول الوفد الوزاري في بنغازي إلا عندما اطلع على برنامج الزيارة، الذي لم يتضمن لقاء بينه وبين الدبيبة في مقر الأول بقاعدة الرجمة. وبتعبير آخر كان حفتر ينتظر من رئيس الحكومة اعترافا بسلطات لم يحصل عليها الجنرال بالطرق الدستورية.
أكثر من ذلك، هو يُعتبر مستهينا بالمؤسسة العسكرية بتمرده على القيادة العليا للجيش، ممثلة بالمجلس الرئاسي مجتمعا. كما استخف بمرجعية وزارة الدفاع، التي يضطلع بها الدبيبة، زيادة على رئاسته الحكومة. وأول سؤال يتبادر إلى الذهن في ضوء هذا العناد المُعرقل للمسار السياسي هو التالي: لماذا صمت الجنرال طيلة الفترة الماضية، وهو يراقب سير الأمور في اتجاه الحل السلمي، الذي ما فتئ يُعارضه علنا وبإصرار؟ ومن هي القوة التي استطاعت إسكاته، ولماذا يعود الآن إلى الواجهة؟
عودة شبح التقسيم؟
وفي تفسير منع الطائرة من الهبوط في بنغازي اتجهت التعاليق إلى التحذير من عودة شبح التقسيم، وتفكيك الدولة. وفي السياق اعتبر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، أن منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي «يمنح الفرصة لمن يسعى لانهيار العملية السياسية» متأسفا من أن «هناك طرفا يسعى لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكيك الدولة وابتزاز مؤسساتها».
وأثار أبوجناح مسألة مهمة تتعلق بالتضييق على الحريات العامة والخاصة في المنطقة الشرقية، الواقعة تحت نفوذ رجل عسكري عتيق، مؤكدا تمسكه «بحق الليبيين في معارضة أي سلطة سياسية في البلاد، ضمن إطار حرية التعبير، الرافض لاستخدام العنف والتخريب للتعبير عن المعارضة». وتزامن هذا الموقف مع إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا عن أوضاع الحريات المحاصرة في مناطق نفوذ حفتر. لذا شدد أبو جناح، مثل غالبية الليبيين، على ضرورة «درء الفتن وعدم السماح بالعودة إلى الوراء أو التخلي عن تعهداتنا لليبيين بالبناء وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطنية».
ومن الواضح أن الانعطاف الذي أخذه الصراع في ليبيا بعد مؤتمر برلين، في مطلع العام الماضي، أقام خطين متوازيين بين من أدركوا أن الحرب عقيمة وأن «اللعبة انتهت» ومن ظل يحلم بحكم ليببا، بعد الاستيلاء على العاصمة بقوة السلاح. والمؤكد أن الوزن الذي منحه الألمان لذلك المؤتمر بحضور المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، أرعب معسكر الحرب الليبي، خاصة بعد التلويح بفرض عقوبات على المُعطلين والمتنطعين. ولأن حفتر أدرك صعوبة الوضع الجديد عليه، مع التقدم المُسجل باتجاه الحل السياسي، اختار أن يلوذ بالصمت طيلة الفترة الماضية. ولم يستطع حتى استخدام الضباط الذين يمثلون معسكره في اللجنة العسكرية المشتركة لتفجير اللجنة أو التشويش على أعمالها.
أربعة محاور
بالرغم من تلك المحاولات، قطعت حكومة الوحدة الوطنية أشواطا مهمة على أربعة محاور لم يكن أحد يتخيل أنها ستتحقق في هذه الفترة، التي لم تتجاوز خمسين يوما.
ففي المحور الأول حافظت على وقف إطلاق النار على نحو جعل الليبيين يذوقون طعم السلام للمرة الأولى، بعد حوالي عشر سنوات من الصراع الأهلي. وفي المحور الثاني أعدت موازنة موحدة للمرة الأولى منذ سنوات، وعرضتها على مجلس النواب (الذي استعاد وحدته أيضا) وبعد المناقشة أعادها إلى الحكومة لتعديلها ثم إرجاعها إلى البرلمان للتصديق عليها. وفي المحور الثالث كثفت من خطط مكافحة جائحة كوفيد-19 مُحققة في هذا المجال نجاحات لم يستطع تحقيقها الجيران.
أما المحور الرابع فكان متصلا بالتحرك الخارجي في اتجاه العواصم المؤثرة في الملف الليبي، والذي جسدته الجولة المهمة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، لكل من مصر والإمارات وأنقرة وموسكو ثم روما، إضافة إلى زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى باريس. ويمكن القول إن حكومة الوحدة الوطنية ركزت على ضرورة سحب القوات الأجنبية والميليشيات من ليبيا، وهي مسنودة في هذا الموقف من قوى دولية مؤثرة، من أبرزها الموقف الأمريكي، الذي اعتبر على لسان الناطقة باسم وزارة الدفاع «البنتاغون» أن «متابعة المسار السياسي تتطلب من جميع الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمجموعات التابعة للجهات الخارجية والمرتزقة».
وبعدما أعلن اللواء المتقاعد حفتر أنه لا يعترف بالمؤسسات التنفيذية الجديدة ولا يتعامل معها، يتخذ الموقف الأمريكي بعدا آخر، إذ أنه يُساهم في تجريد التمرد من أي غطاء دولي، خصوصا بعدما أكد البنتاغون أن أمريكا «تتابع دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتتعامل بجدية مع الخطر الناشئ عن المجموعات الإرهابية في ليبيا».
لُقية المنقوش
ويجوز القول إن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، كانت الأشد وضوحا في هذا الباب، إذ اقترحت وضع جداول زمنية واضحة لسحب المرتزقة، ما أثار في وجهها عاصفة من التهجمات الصادرة عن المستفيدين من بقاء أولئك المرتزقة في ليبيا. وفي مواجهة الحملة التي استهدفت الوزيرة، دافع بيان رسمي للوزارة على تصريحاتها خلال جلسة استماع، مع لجنة الشؤون الخارجية في مقر مجلس النواب الإيطالي. وجدد البيان التأكيد على أن موقف الحكومة الليبية «ثابت وواضح تجاه كل المرتزقة على الأراضي الليبية، من دون استثناء أو تحديد».
بهذا المعنى ستكون مسألة إخراج المرتزقة السوريين الذين جلبهم الأتراك، موضع خلاف شديد بين تيار الإسلام السياسي، الرافض لمغادرتهم، بذريعة أن انسحابهم سيُعيد فتح باب الحرب من جديد، والفريق المقابل المُصر على أن يشمل الانسحاب جميع القوى الخارجية بلا استثناء. والأرجح أن الموقف الأمريكي سيحسم هذا الجدل، إذ تكلم الأمريكيون للمرة الأولى عن اتصالات تمت بينهم وبين حفتر أثناء الهجوم على طرابلس، وعن أفكار واقتراحات قدموها له لإنهاء الهجوم، إلا أنه رفضها على ما قال السفير الأمريكي نورلاند. ولم يكشف نورلاند فحوى الاقتراحات، لكنه قال إنها «تطرقت للتشكيلات المسلحة وتوزيع إيرادات الدولة وجماعة الإخوان المسلحين والمتشددين» من دون إعطاء تفاصيل.
أكثر من ذلك حمل السفير الأمريكي الجنرال حفتر مسؤولية إفشال تلك المحاولة، لأنه «أدار ظهره لكافة هذه المقترحات والمبادرات». كما أقر نورلاند بأنه ما كان يمكن أن يوقف هذا الهجوم (على طرابلس) سوى التدخل التركي، وهذا إقرار بالغ الأهمية. من هنا ندرك حقيقة الدور الذي لعبته واشنطن خلال الهجوم على طرابلس، بوصفه دور الاطفائي الذي لم يُفلح في تبريد الصراع ووقف إطلاق النار.
الصراع على المناصب العليا
وسيُطرح قريبا موضوع خلافي شائك آخر، سيساهم في تشنيج اللواء حفتر، وهو المتعلق بالمناصب العليا في مؤسسات الدولة، ومنها منصب النائب العام ورئاسة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. وبعدما نظرت لجنة من مجلس النواب في لائحة الأسماء المقترحة لشغل تلك المناصب، أحالتها على المجلس الأعلى للدولة، قبل إعادتها إلى مجلس النواب لاعتمادها أو رفضها.
ومع تواتر الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات العامة في ميقاتها، أي قبل نهاية العام الجاري، يتساءل مراقبون عن خفوت أصوات الأحزاب التي يُفترض أنها تستعد على قدم وساق لهذا الاستحقاق السياسي المهم. ومن العيوب التي تنتقص من دور تلك التشكيلات الحزبية أنها إذا ما وُجدت في الشرق لا تجدها في الغرب، وإذا ما انتشرت في الغرب يُحاصرها أزلام حفتر في المنطقة الشرقية ويشلون عملها. كما أن مكونات المجتمع المدني، التي عانت طيلة السنوات الماضية من المصادرة والقمع، وحتى الاغتيال، خفت صوتها أو اضطرت للهجرة، ما سيُضعف من دورها في الانتخابات المقبلة، ليس فقط في مستوى الحملات الانتخابية ومراقبة شفافية الاقتراع ونزاهته، وإنما أيضا على صعيد الترشح لعضوية البرلمان.
وربما تُعزى قلة الثقة بالأحزاب والزعامات إلى التجربة الأليمة التي مر بها الليبيون في السنوات العشر الماضية، إذ تعاطت غالبية الأحزاب مع المناصب، بوصفها طريقا سريعا للإثراء والوجاهة. ولم تُقدم أكثريتها أهدافا واضحة وأجندات للتغيير الدستوري والسياسي والاجتماعي وخريطة للمستقبل. والظاهر أن الأحزاب بقيت عند حد إسقاط النظام السابق لكن من دون تصور أو رؤية لليوم التالي. وسرعان ما تفجرت الصراعات الأيديولوجية، وحجبت عن أنظار تلك القيادات استحقاقات المرحلة الجديدة، ما قاد إلى صراعات ارتدت طابعا مذهبيا أحيانا، أو مناطقيا أحيانا أخرى، أو حتى شخصيا. وكانت تلك الخصومات أرضية صالحة لاندلاع صراعات مسلحة استنزفت البلد على مدى عشر سنوات، ولا يُعرف إذا ما كانت الانتخابات العامة، إذا ما أجريت في ميقاتها، ستُنهي تلك الصراعات أم سيكون المشهد السياسي في ليبيا، في مرحلة ما بعد القذافي، شبيها بنظيره في الجارة تونس؟
المصدر: القدس العربي