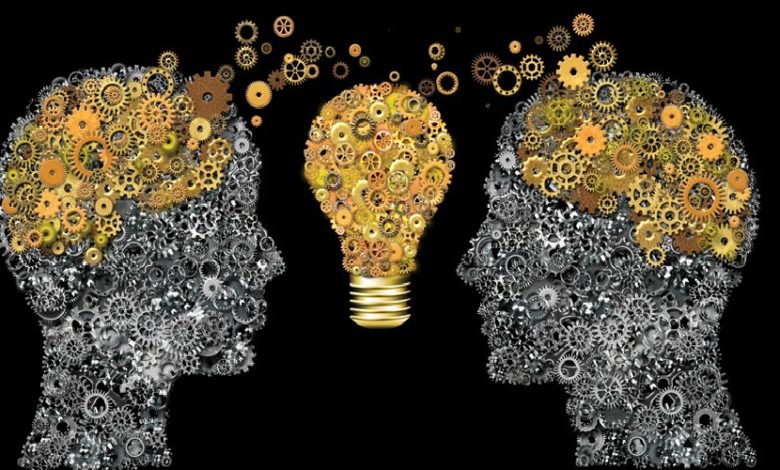
حبذا لو نقيم مؤسسات بحثية تعمل في داخل كل دولة وعلى مستوى المنطقة عموماً في مثل هذه الأوقات المصيرية من تاريخ بلداننا، بخاصة تلك التي تخوض معركة بناء السلام وتحتاج بالتالي إلى توظيف كل الخبرات والقدرات لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في السلام والاستقرار والتنمية.
دمّر المغول مكتبة بيت الحكمة في بغداد وألقوا مجلداتها في نهر دجلة فصبغ حبرها مياهه باللون الأسود.. أُحرقت مكتبة الإسكندرية فضاع معها قسم كبير من أرشيف الحضارتين الفرعونية والإغريقية، وشهدت مكتبة قرطبة الدمار نفسه، فخسرنا الكثير من إرث الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. يحق لنا أن نرثي حتى يومنا هذا ضياع هذه الثروات المعرفية وأن نتحسر عليها. لكن أكثر ما أعجب له، هو أننا لا نحاول إعادة إنتاج هذه المعارف، ونهدر أي فرصة أمامنا لبناء حضارة جديدة اليوم! فنقف جامدين أما حاضرة “الآخر”، في الغرب خصوصاً، ونذوب فيها حتى كاد يغيب ذكرنا عن أية مساهمة في صرح الحضارة الحديثة.
عندما نتغنى بالحضارة العربية وكل الثقافات التي استوطنت بلادنا، ألا يجب أن نسأل أنفسنا عن الأجيال القادمة وهل سيتغنى أحفادنا بمنجزاتنا؟ وأيُّ منجزات؟ فنظرة سريعة على حال العالم العربي تظهر جلياً واقع الأوضاع المعرفية المُؤسف. وهذا الواقع ليس نابعاً من نقص في الإمكانات أو الموارد البشرية الرائدة، إنما من غياب المؤسسات الفكرية والثقافية والبحثية القادرة على احتضان هذه الإمكانات واستثمار قدراتها وتقديم المنصات المناسبة لها، لتكون مؤثرة وقادرة على لعب دور في بناء حضارتنا من جديد.
إذا ألقينا نظرة خاطفة على الوضع الفكري العالمي، نجد تركيزاً كبيراً، بخاصة في الدول المتقدمة، على ما يسمى مراكز التفكيرThink Tanks (أو مراكز الدراسات والبحوث)، التي لعبت وتلعب دوراً مهماً في تقدم هذه الدول على الصعد العلمية والمعرفية كلها. لكن، ماذا عن واقع مراكز التفكير العربية، وتحديداً تلك المختصة منها بالسياسة والعلوم الإنسانية بالعموم؟
يقول تقرير مراكز التفكير والمجتمع المدني الصادر عن “معهد لودر” في جامعة بنسلفانيا لعام 2021، إنه في العام الماضي بلغ عدد مراكز التفكير حول العالم 11175 مركزاً، كانت حصة الوطن العربي –كله– منها نحو 390 مركزاً (أغلبها مغمور أو حكومي شكلي أو مؤدلج أو ضعيف الأثر)، بينما لدى الولايات المتحدة الأميركية وحدها نحو 2200 مركز!.
مازال مصطلح “مراكز التفكير” ملتبساً على الكثير من الناس، وهذا أمر مفهوم نتيجة لأدوار هذه المؤسسات المركبة، ولأهدافها التي لا تخلو من التعقيد، فهي ترفد صانع القرار بالمعلومات وبقراءة الوقائع مرة، وتثقِّف الأفراد والمجتمع وتعلِّمهم مرة ثانية، وتعمل على التأثير في الرأي العام لتحقيق أهدافها أو أهداف صناع القرار مرة ثالثة. هي إذن أداة لصنع السياسية لتطبيقها بشكل أو بآخر. ورغم انتشار هذه المراكز في العديد من الأنظمة السياسية حول العالم، وتواجدها في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، ومساهماتها في عمل الحكومات والبرلمانات والمداولات العامة، ما زال تعريفها بدقة أو تحديدها بسمات توضح دورها وأهميتها في العملية السياسية أمراً بالغ الصعوبة حتى الآن.
تؤدي مراكز البحوث مهمتها عبر “إنتاج المعرفة”، فهي تجمع بين التخصصات الأكاديمية وتتيح إجراء تحليلاتٍ متعددة الأوجه، ورؤى مختلفة ومتباينة؛ تشمل المفاهيم والأفكار والفواعل –أفراداً ومؤسسات– وآليات التأثير والاهتمامات والعلاقات والتفاعلات وموازين القوة، لتصل في النهاية إلى “معرفة سياسية” جديدة مبنية على وقائع صحيحة ومدعمة بالأدلة. كما تزعم مؤسسات التفكير أنها “تخاطب السلطة بالحقائق” من خلال إنتاج مخرجات سهلة الفهم تستهدف صانع القرار المؤمن بأن “السياسة الناجحة” لا بد وأن يكون لها أساس معرفي معزز بالبراهين والأدلة.
يطلق عالم السياسة الأميركي البروفسور جون كينغدون على المشتغلين في مراكز الفكر والرأي اسم “رواد الأعمال السياسيين”، إذ يلعبون أدواراً مهمة في مختلف مراحل “عملية” صنع السياسات، فقد يكون لهم تأثير خلال لحظات تأطير المشكلة، أو عند البحث عن حلول، أو عند تقديم هذه الحلول لصناع القرار، أو حتى عند الدعوة لمناصرة سياسات معينة من قبل الجمهور الأوسع.
وفي عالم يعاني من “أزمة معرفية” نتيجة كمّ المعلومات الضخم، وسرعة انتقالها الفائقة، وبخاصة المغلوط منها، تصير مراكز التفكير ضرورة أساسية لتمايز ما بين الغث والسمين. وتزداد الحاجة إليها في منطقة كالبلاد العربية لأن هذه المؤسسات تمثل جسراً يصل بين الأكاديميات وجماعات صناعة القرار من جهة، وبين الحكومات والمجتمعات المدنية والرأي العام بالعموم من جهة أخرى. ناهيك بحاجة صانعي السياسات العرب وبشكل متزايد إلى آراء الخبراء والمفكرين والأكاديميين والمختصين لمساعدتهم على تحديد المعلومات والبيانات والتجارب التي يجب استخدامها في عمليات صنع القرار.
إنَّ التركيز على مراكز البحوث في عالمنا العربي بات ضرورة ملحة في زمننا الراهن، لكل الأسباب السابقة، ولأنها أيضاً تمتلك من المرونة ما لا تمتلكه أي مؤسسات سياسية رسمية، وهي بالتالي قادرة على تأدية مجموعة متنوعة من المهام عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية ومن خلال الاستفادة من علاقاتها الجيدة في الداخل والخارج. وكثيراً ما خلقت مراكز البحوث في الدول الليبرالية المتقدمة شبكات سياسية عابرة للحدود تشمل الأحزاب السياسية، ومجموعات المصالح، والشركات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجامعات والمؤسسات الرسمية.
نحن نعيش اليوم في زمن المعرفة، ومن يصنع المعرفة يصنع المستقبل، ومن يمتلكها يمتلك القوة في العلم وفي السياسة على حدٍّ سواء. أما غياب مراكز التفكير، فيعني أن هنالك من سيفكر لنا ويصنع لنا معرفتنا وبالتالي مستقبلنا، لكن على قياساته هو وبحسب مصالحه الخاصة. والمسؤولية هنا لا تقع على عاتق الحكومات العربية وحدها، بل علينا نحن رجال الأعمال أيضاً، لأننا شركاء المصلحة الأوائل، والأقدر على دعم تشكُّل خط فكري ثالث قد يؤثر أو يتأثر بالحكومات لكنه لا يتبع لها.
لقد آمنت بهذه الحقيقة منذ زمن، ولم أعمد إلى التنظير والكلام، بل عمدت إلى تأسيس مركز بحوث في بلدي الأردن. واليوم أعيد التجربة مرة ثانية بعدما باتت أوضح وتبلورت عندي بشكل أكبر، وهذه المرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالريادة برأيي ليست بالأعمال فقط، ولكن في التفكير أيضاً، وسأسعى جاهداً لأن يستقطب مركزا البحوث هذين خبرات المتخصصين العرب، ومواهب وقدرات الشباب العربي، المهتمين بالعمل الفكري، لأن قلة مراكز البحوث والدراسات العربية، وضعف أدوارها، فرصة مهدورة يجب أن نتنبَّه لها وفي أسرع وقت، فمآزقنا لن تحل سوى عبر عقولنا النهمة التي تبحث دون كلل عن الحلول.
ولئن استُهدفت مخازن أفكارنا سابقاً لأهميتها، فلنسحب اليوم الحبر المهرق الذي صبغ نهر دجلة مرةً، ولنبدأ إنتاج معارف جديدة تجعلنا أكثر قدرة على الحكم السليم الموجّه أكاديمياً وعلمياً، فتستعيد شعوبنا ثقتها بقيادتها، وبالتالي يبني الجميع معاً ويصنعون معارف جديدة ترسم ملامح مستقبل عربي يلبي الطموحات ويؤمن مصالح الدول العربية، بعيداً عن الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية.
المصدر: النهار العربي







