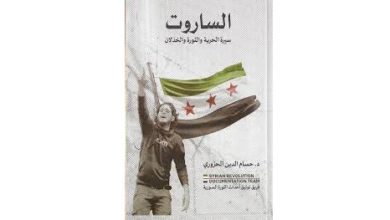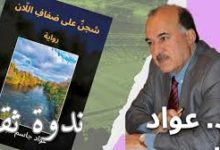في مكتبتي المتواضعة و”المنسية” منذ وقت بعيد، ومثلي مثل كثيرين من المهتمين بالمسرح؛ أحتفظ بمئات النصوص المسرحية العالمية والعربية والمحلية، التي يعلوها الغبار وتبدأ بنخرها سوسة الانتظار! فمن من المسرحين لا يتذكر تلك النصوص العظيمة التي صدرت في مصر الستينيات، ضمن سلسلة “المسرح العالمي” أو “روائع المسرح العالمي”، أو تلك السلسلة الشهيرة التي أصدرتها وزارة الإعلام الكويتية “من المسرح العالمي”، وغيرها الكثير الكثير من المسرحيات التي صدرت بعد منتصف القرن العشرين، وتوقف جلها في مطلع هذا القرن!
أن المخرجين المعاصرين -دون استثناء تقريبًا- باتوا يعتبرون النص المسرحي محض خطة أو “سيناريو”، وفي أفضل الأحوال مشروع عرض لا أكثر، يعكفون –أولًا- على إعادة صياغته، حذفًا وإضافة وتأويلًا، ليصبح مناسبًا للخشبة، وغاية العرض الفكرية والجمالية. وقد بدأ ذلك –على استحياء- تحت راية الإعداد، أو إعادة التأليف، ليتحول المخرج إلى كاتب جديد على أنقاض الكاتب الأصلي! يأخذ من نصه ما يراه مناسبًا ويهمل الباقي، دون شفقة أو رحمة.! ثم تطور الأمر إلى أن حلت مهنة “الدراماتورغ” المعاصرة، محل الكاتب عمليًا.
حدث ذلك منذ عصر النهضة، عندما قام الكتاب الكبار أنفسهم (شكسبير وراسين وكورنيه وسيرفانتس وغوته وشيلر…) بإعادة تأليف التراجيديات اليونانية القديمة، وتقديمها بصياغة جديدة، لكنه تجذر وساد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ حيث بدأ تحطيم قانون الوحدات الثلاث (الزمان والمكان والموضوع)، ونشوء مفهوم وفلسفة “الدراما” النثرية الحياتية، التي أزاحت سيطرة التراجيديا القدرية والبطل الأسطوري، وزعزعت مقولة التطهير اﻷرسطي؛ ثم حلت محلها -بشكل مطلق- في النصف الأول من القرن العشرين؛ حيث ظهرت فنون الإخراج والأداء والسينوغرافيا، المتمردة على “العلبة الإيطالية”. لكن هذا التطور المتسارع، لم يكن بسبب تقدم وسيادة تلك الفنون فحسب، بل لأسباب كثيرة متشعبة، جمالية وفكرية وتكنولوجية، أدت إلى ارتقاء فني “الدراماتورغية” والفرجة المسرحية معًا، وتوُّجت أولًا، بنظرية الواقعية (من شكسبير والكوميديا ديلارتي الارتجالية، مرورًا بتشيخوف وإبسن وستراندبيرغ…) ومهدت لنظريات جديدة في المسرح، كان أهمها نظرية فسيفولد ميرخولد (البيوميكانيك) التي اعتمدت، ليس على الكلمة والخطابة، ولا حتى على واقعية “مستنسخة”، قاتلة للمخيلة والتجديد؛ بل على الفعل والتعبير الحركي (جسد الممثل)، والواقعية الشرطية (الشعرية).. وصولًا إلى نظرية (التغريب) الملحمية الشاملة لبرتولد بريخت، التي دفعت مفهوم التطهير النفسي إلى الخلف، وأحلت محله مفهوم التفكير العقلي، فأعادت فن المسرح إلى جذره الأصيل (الفرجة)، ونقلت مركز التلقي -بعد قرون طويلة- من الأذن (الاستماع والإصغاء) إلى العين (المشاهدة والمشاركة).
ما الذي حدث إذن؟ وما هي العوامل التي سببت هذا الانقلاب في شكل المسرح وغايته؟
من المعروف أن النص المسرحي ثنائي الحضور، وهو الوحيد بين أنواع الأدب، الذي ينتمي لفنّي الكتابة والتمثيل معًا، فهو يُكتب كي يُجسد على الخشبة، وهو “غير صالح” للقراءة فقط، مثل القصة والرواية، وقد استمد سلطته الأولى من الشعر. صحيح أن الأسطورة والطقس الديني هما أساس الفن المسرحي، لكن التعبير عنه (الطقس) لا يمكن أن يتم إلا بواسطة الشعر والإلقاء فوق الخشبة، وكانت تقوم به جوقة من المنشدين (كورس). وقد كان المؤلف المسرحي اليوناني “ثيسبيس” هو من اخترع الممثل الأول في تاريخ المسرح؛ عندما طلب من أحد أعضاء هذه الجوقة الانفراد عن الجوقة ومحاورتها (صولو)؛ ثم جاء بعده أسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس ليضيف كل منهم ممثلًا جديدًا للعرض.
كانت الكلمة العليا للكاتب، وهذا ما منح النص سلطة حقيقة وعملية ومطلقة، وصلت إلى حد القداسة، وتجذرت مع تولي هذا الكاتب مهمة “الإخراج” وقيادة المجموعة، وهي سلطة ميدانية إبداعية نشأت مع فن المسح وطبعته بطابعها، مدة تزيد عن عشرين قرنًا! لكن ظهور الاختصاص في فنون المسرح المتنوعة، وبخاصة فن الإخراج بدأ يسيطر بالتدريج، اعتبارًا من منتصف القرن التاسع عشر، حتى استحوذ على هذه السلطة -كاملة- في وقتنا الراهن، وبات من الصعب مشاهدة عرض مسرحي يسود فيه النص أو كاتبه، كما بات من الدارج تناول النصوص الكلاسيكية العظيمة والعمل عليها، باعتبارها مادة أولية للعرض. حتى لو تمّت المحافظة على النص الأساس، كما هو (وقد بقي هذا دارجًا في المسرح الواقعي لمدة طويلة) فإن القناع الإغريقي بات من الماضي، وأصبح من السذاجة تقديم النص بعيدًا من فنون الأداء والإخراج الحديثة (التجريب والارتجال وفنون الضوء والحركة والرقص والغناء).
هكذا، حلّ “الدراماتورغ” (مؤلف نص العرض)، مكان المؤلف الحقيقي، وهكذا تراجعت هيمنة الكلمة، لتأخذ مكانها الطبيعي في للعرض، لأن المرتبة الأولى في المسرح، هي للأفعال وليس للأقوال.
المصدر: جيرون