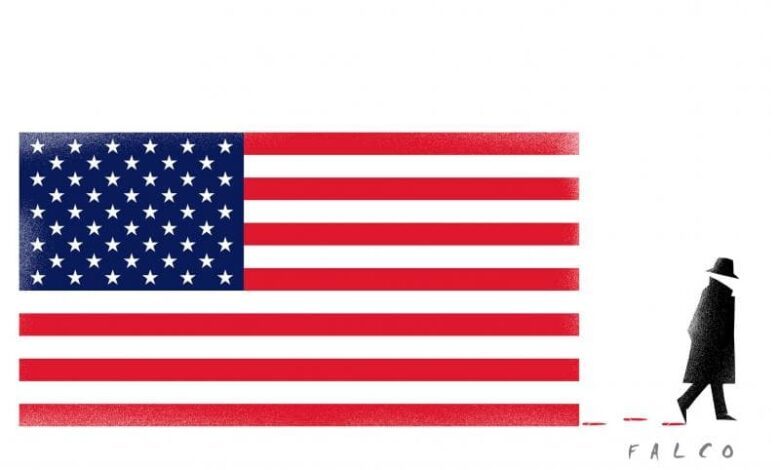
في العام 2004، نقل الصحفي رون سسكيند عن مستشار للبيت الأبيض في عهد بوش، كارل روف، قوله متبجحاً: “نحن إمبراطورية الآن، وعندما نتصرف، فإننا نخلق واقعنا الخاص”. ورفض روف افتراض ساسكيند بأن السياسة العامة يجب أن تكون متجذرة في “المجتمع القائم على الواقع”. وقال له المستشار: “نحن فاعلو التاريخ… وأنتم، أنتم كلكم، سوف تُتركون لتدرسوا ما نفعله فقط”.
وبعد ستة عشر عامًا لاحقاً، أدت الحروب الأميركية وجرائم الحرب التي ارتكبتها إدارة بوش إلى نشر الفوضى والعنف على نقاط عريض وفي كل مكان، وأدى هذا الاقتران التاريخي بين الإجرام والفشل، وعلى نحو كان قابلاً للتوقع، إلى تقويض قوة أميركا ونفوذها على المستوى الدولي. وبالعودة إلى الأرض الأم للإمبراطورية، حققت صناعة التسويق السياسي التي كان روف وزملاؤه جزءًا منها نجاحًا أكبر في تقسيم -فحُكم قلوب وعقول الأميركيين أكثر مما فعلت مع العراقيين أو الروس أو الصينيين.
كانت المفارقة في ادعاءات إدارة بوش الإمبريالية هي تجاهل حقيقة أن أميركا كانت إمبراطورية منذ بداية تأسيسها، وأن قيام أحد موظفي البيت الأبيض بالاستغلال السياسي لمصطلح “إمبراطورية” في العام 2004 لم يكن فيه إحالة إلى إمبراطورية جديدة وصاعدة كما زعم، وإنما إلى إمبراطورية متحللة متراجعة، تدور متعثرة بعمى في دوامة موت مضنية.
ولم يكن الأميركيون جاهلين دائمًا وإلى هذا الحد بالطبيعة الإمبريالية لطموحات بلدهم. وقد وصف جورج واشنطن نيويورك بأنها “مقر إمبراطورية”، ووصف حملته العسكرية ضد القوات البريطانية هناك بأنها “الطريق إلى الإمبراطورية”. وقد اعتنق النيويوركيون بشغف هوية ولايتهم على أنها “ولاية إمبراطورية”، والتي ما تزال مكرسة في مبنى الـ”إمباير ستيت” وعلى لوحات ترخيص المركبات في ولاية نيويورك.
أدى توسع السيادة الإقليمية لأميركا على أراضي الأميركيين الأصليين، و”شراء لويزيانا” وضم شمال المكسيك في الحرب المكسيكية الأميركية، إلى بناء إمبراطورية تفوقت كثيرًا على تلك التي بناها جورج واشنطن. لكن ذلك التوسع الإمبراطوري كان أكثر إثارة للجدل مما يدركه معظم الأميركيين. فقد صوت 14 من أصل 52 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي ضد معاهدة 1848 لضم معظم المكسيك، والتي من دونها ربما كان الأميركيون ما يزالون اليوم يزورون كاليفورنيا، وأريزونا، ونيو مكسيكو، وتكساس، ونيفادا، ويوتا ومعظم كولورادو، كوجهات سفر مكسيكية غريبة.
في فترة الازدهار الكامل للإمبراطورية الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك قادتها المهارة والبراعة اللازمتين لممارسة القوة الإمبريالية في عالم ما-بعد-الكولنيالية. وفهموا أنها لا توجد دولة تقاتل من أجل الاستقلال عن المملكة المتحدة أو فرنسا والتي كانت ستستقبل الغزاة الإمبرياليين من أميركا. ولذلك، طور قادة أميركا نظامًا من “الكولنيالية الجديدة” neocolonialism، والذي يمارسون من خلاله سيادة إمبريالية شاملة وممتدة على جزء كبير من العالم، بينما يتجنبون بحزم مصطلحات مثل “إمبراطورية” أو “إمبريالية”، والتي يكون من شأنها أن تقوض أوراق اعتمادهم ما-بعد-الكولنيالية.
تُرك الأمر للنقاد، مثل الرئيس الغاني كوامي نكروما، ليستنطقوا بجديّة السيطرة الإمبريالية التي ما تزال البلدان الغنية تمارسها على بلدان ما-بعد-الاستعمار المستقلة اسمياً مثل بلده. وفي كتابه “الاستعمار الجديد: المرحلة الأخيرة من الإمبريالية”، أدان نكروما “الكولنيالية الجديدة” باعتبارها “أسوأ أشكال الإمبريالية”. وكتب: “إنها تعني، بالنسبة لأولئك الذين يمارسونها، السلطة من دون مسؤولية؛ وبالنسبة لأولئك الذين يعانون منها، فهي تعني التعرض للاستغلال من دون تعويض ولا شفاء”.
وهكذا، نشأ أميركيو ما بعد بعد الحرب العالمية الثانية في جهل مصنوع بعناية بحقيقة الإمبراطورية الأميركية ذاتها، ووفرت الأساطير التي نُسِجت لإخفائها تربة خصبة للتفكك والانقسامات السياسية الحاضرة اليوم. ويناشد كلُّ من وعد ترامب “لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى” ووعد بايدن بـ”استعادة القيادة الأميركية” كلاهما ذلك الحنين إلى قطف ثمار الإمبريالية الأميركية.
الآن، عادت ألعاب اللوم السابقة حول من خسر حرب الصين، أو فيتنام، أو كوبا إلى الوطن لتصبح محل تجاذب في جدال حول من خسر أميركا، ومن هو الذي يمكنه بطريقة ما استعادة عظمتها الأسطورية أو قيادتها السابقة. وحتى في الوقت الذي تقود فيه أميركا العالم في السماح للوباء بتدمير شعبها واقتصادها، لم يكن أي من قادة الحزبين على استعداد لإجراء نقاش أكثر واقعية حول كيفية إعادة تعريف وإعادة بناء أميركا كدولة ما-بعد-كولنيالية في عالم اليوم متعدد الأقطاب.
توسعت كل إمبراطورية ناجحة وحكمت واستغلت أراضيها النائية من خلال توظيف مزيج من القوة الاقتصادية والعسكرية. وحتى في مرحلة الكولنيالية الجديدة للإمبراطورية الأميركية، كان دور الجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية هو فتح الأبواب التي يمكن من خلالها لرجال الأعمال الأميركيين “أن يتبَعوا العلَم” لإنشاء متجر وتطوير أسواق جديدة.
لكن العسكريتارية الأميركية والمصالح الاقتصادية الأميركية افترقا اليوم. وباستثناء عدد قليل من المتعاقدين العسكريين، لم تتبع الشركات الأميركية العلَم إلى أنقاض العراق أو مناطق الحرب الأميركية الحالية الأخرى بأي طريقة تتسم بالديمومة. بعد ثمانية عشر عامًا من الغزو الأميركي، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للعراق، بينما أكبر شريك لأفغانستان هو باكستان، وأكبر شريك للصومال هو الإمارات العربية المتحدة، وأكبر شريك لليبيا هو الاتحاد الأوروبي.
بدلاً من فتح الأبواب أمام الشركات الأميركية الكبرى أو دعم الموقف الدبلوماسي الأميركي في العالم، أصبحت آلة الحرب الأميركية مجرد ثورٍ في متجر الصين العالمي، حيث تمارس القوة التدميرية البحتة لزعزعة استقرار البلدان وتدمير اقتصاداتها، وإغلاق الأبواب أمام الفرص الاقتصادية بدلاً من فتحها، وتحويل الموارد عن الاحتياجات الحقيقية في الداخل، والإضرار بمكانة أميركا الدولية بدلاً من تعزيزها.
عندما حذر الرئيس أيزنهاور من “النفوذ غير المبرر” للمجمع الصناعي العسكري الأميركي، فإنه كان يتوقع على وجه التحديد هذا النوع من الانقسام الخطير بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للشعب الأميركي وآلة الحرب التي تكلف أكثر من الجيوش العشرة التالية في العالم مجتمعة، وإنما التي لا يمكنها الفوز في حرب أو هزيمة فيروس، ناهيك عن استعادة إمبراطورية مفقودة.
أصبحت الصين والاتحاد الأوروبي الآن هما الشريكان التجاريان الرئيسيان لمعظم دول العالم. وما تزال الولايات المتحدة قوة اقتصادية إقليمية، ولكن حتى في أميركا الجنوبية، أصبحت معظم الدول تتاجر أكثر مع الصين. وقد سرّعت العسكريتاريا الأميركية هذه الاتجاهات من خلال إهدار مواردنا على الأسلحة والحروب، بينما استثمرت الصين والاتحاد الأوروبي في التنمية الاقتصادية السلمية وتهيئة البنية التحتية للقرن الحادي والعشرين.
على سبيل المثال، أنشأت الصين أكبر شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم خلال 10 أعوام فقط (2008-2018)، وتقوم أوروبا ببناء وتوسيع شبكتها عالية السرعة منذ التسعينيات، لكن السكك الحديدية عالية السرعة ما تزال على لوحة الرسم فقط في أميركا.
وقد انتشلت الصين 800 مليون شخص من براثن الفقر، في حين أن معدل الفقر في أميركا تزحزح بالكاد خلال 50 عامًا بينما ازداد فقر الأطفال. وما تزال لدى أميركا أضعف شبكة أمان اجتماعي في أي دولة متقدمة، ولا يوجد فيها نظام رعاية صحية شامل، كما أن عدم المساواة في الثروة والسلطة الناجم عن “الليبرالية الجديدة” المتطرفة ترك نصف الأميركيين مع مدخرات قليلة -أو من دون مدخرات على الإطلاق- للعيش عليها في سن التقاعد أو لمواجهة أي اضطرابات يصادفونها في حياتهم.
إن إصرار قادتنا على تحويل 66 في المائة من الإنفاق التقديري الفيدرالي للولايات المتحدة للحفاظ على آلة الحرب وتوسيعها، والتي تجاوزت منذ وقت طويل أي دور مفيد في الإمبراطورية الاقتصادية الأميركية المتدهورة، هو إهدار مُنهِك للموارد، والذي يعرض مستقبلنا للخطر.
منذ عقود، حذرَنا مارتن لوثر كينغ الابن من أن “أمة تستمر عامًا بعد عام في إنفاق أموال على الدفاع العسكري أكثر مما تنفقه على برامج النهوض الاجتماعي، إنما تقترب من الموت الروحي”.
والآن، بينما تناقش حكومتنا ما إذا كان بإمكاننا “تحمل” كلفة التعافي من “كوفيد”، وإبرام “صفقة خضراء جديدة” ورعاية صحية شاملة، سوف نكون حكيمين إذا أدركنا أن أملنا الوحيد في تحويل هذه الإمبراطورية المتدهورة الآفلة إلى دولة-ما بعد-إمبريالية ديناميكية ومزدهرة، هو تحويل أولوياتنا الوطنية بعمق وبسرعة من العسكريتارية المدمرة وغير ذات الصلة إلى برامج النهوض الاجتماعي التي دعا إليها الدكتور كينغ.
*Medea Benjamin: ناشطة أميركية، وأحد مؤسسي منظمة “كودبينك” للسلام. وهي مؤلفة للعديد من الكتب، منها “مملكة الظالمين: خلف العلاقة الأميركية-السعودية”.
*Nicolas J. S. Davies: كاتب في “نيوز كونسورتيوم”، وباحث مع “كودبينك”، ومؤلف كتاب “الدم على أيدينا: الغزو الأميركي وتدمير العراق”.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Decline and Fall of the American Empire
المصدر: الغد الأردنية/(كاونتربنتش)







