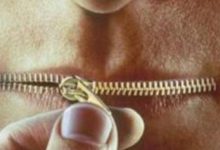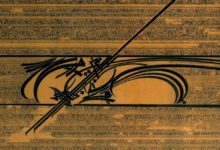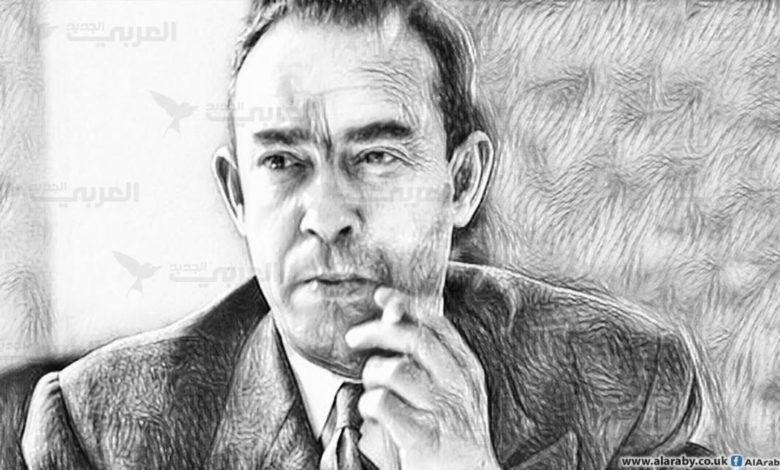
لم يكن المعارض المغربي الراحل، المهدي بن بركة، جمهورياً، ولا عُرف عنه ذلك من قبلُ مطلقاً، ولكنّه كان إصلاحياً، فأكَّد عمله وفكره الإصلاحي في ارتباط بالحركة الوطنية التي وافق أغلب زعمائها على الاستقلال في 1956 من خلال المشاركة الفعالة في البناء العام لمشروع الدولة الوطنية المأمولة. والقول هنا إنّ بن بركة كان في هذا البناء مشاركاً، حيوياً، وفاعلاً بكثير من الأعمال التي ذُكِرَت له، قبل الانشقاق عن حزب الاستقلال (1959) وبعده، لا يُرَدُّ، لأنه كان من البُناة الذين فَرَشُوا للملكية ما كانت تحتاج إليه من شرعية تاريخية وبساط إيديولوجي للتحكم المطلق. والحق أن ذلك تواصل، ولو في جو من التناقض والصراع بين الفرقاء الوطنيين وغير الوطنيين، إلى أن كانت البدايات الأولى للستينيات التي قصمت ظهر البعير الوطني، حين انعقد المؤتمر الاستثنائي لحزب القوات الشعبية (1962) فأوجب اختياراً نضالياً فيه مراهنات معينة، نَفَسُها يَعْقُوبِيٌّ أثِيرٌ، على الديموقراطية المفترضة، في حين ظهر جلياً أن الملكية التنفيذية مصمّمة على الانفراد بالسلطة الفعلية للتحكّم النهائي في التطور المستقبلي للبلاد وللعباد.
ولم يُفصح المهدي بن بركة عن أي موقف جمهوري مكتوب إلّا حين كان اليوم الذي صاغ فيه تقريره الأيديولوجي للمؤتمر الاستثنائي (1962) للتعبير الصريح عن المعارضة المطلقة، وفي صلبها اعترافه الحامل لمعاني الثورة على النظام القائم، أي قبول الحاكمين بالاستقلال الشكلي الذي كرس، في تقديره، مختلف أشكال السيطرة الاستعمارية، فضلاً عن أنه قوّض الأحلام الوطنية، وخصوصاً منها ما كان قد تبلور في وثيقة المطالبة بالاستقلال (1944)، غير أنّ التعبير الجمهوري كان ملتبساً لم يفصح عن أي تصور قد تُدرَكُ علامتُه الأيديولوجية بصيغة من الصيغ، ولعله فُهِم، في مناخ مطبوع بالنهوض التحرّري، على أنه دعوة للانشقاق الشخصي والحزبي عن المَلَكية التي أفسدت “العمل الوطني”، أكثر من كونه، في الاعتبار والاختيار، “الإيحاء” بالدعوة لقيام نظام جديد يكون بديلاً للملكية، أو هوّ، على الأقل، محتوى واختيارات، على مثال ما كان قد أصبح في الجزائر، بالطريقة الانقلابية الدموية المضمونة، نموذجاً للحكم الجمهوري الرئاسي الحالم بقيام “الاشتراكية العربية” في يوم ما.
كان بن بركة، قبل اغتياله في أكتوبر/ تشرين الأول 1965، قد تحوّل، في العمل والنضال والتبلور الفكري والذهني كذلك، إلى واحد من العاملين في سبيل تحرّر الشعوب، ولكنّه كان أيضاً قد قطع بصفة نهائية، وخصوصاً حين أدين بالإعدام مرتين، مع طبيعة التطوّر في المغرب الذي كان، في ذلك الوقت، على أعتاب الدخول في مرحلة الاستثناء التي قَضَت دستورياً على مختلف مظاهر العمل السياسي الشرعي المعارض، و”شرّعت” للتحكم الاستبدادي و”تجذير” الاستغلال و”تسييد” القمع… إلخ.
كان بن بركة، قبل اغتياله في أكتوبر 1965، قد تحوّل، في العمل والنضال والتبلور الفكري والذهني كذلك، إلى واحد من العاملين في سبيل تحرّر الشعوب
أُدْرِكُ أنَّ مشروع “الاختيار الثوري” تولّد عن مناخِ وتناقضات المرحلة التي تَهَيَّأَ فيها المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وَانْعَقَدَ (1962)، حين عَدَّدَ المهدي بن بركة أيامها “ثلاثة أخطاء” اعتبرها، باندفاعه المعارض وَحُلمه “الثوري” المتوثب، “قاتلة” تَرَتَّبت عن ممارسة الحركة التقدمية في علاقتها بالمجال السياسي، وبالصراع الوطني، وبالمتغيرات الظرفية التي سبقت وأعقبت استقلال المغرب عام 1956. وهي الأخطاء التي نَتَجَت، في تقديره للسيرورة النضالية التي كان منخرطاً فيها، عن سياسات العمل “التقدمي” التي خيضت في البدايات الأولى للمرحلة الاستقلالية، واستند تشخيصها الفعلي على عناصر مستقاة من الأوضاع القائمة وعلى رأسها: القبول بالاستقلال الشكلي الناتج عن مشاورات “إيكس ليبان”، في ارتباط مع ضرورة استمرار الكفاح وتوسيعه (المغرب العربي) حتّى يتحقق الاستقلال التام والحقيقي، وعدم القبول “بتبرير التسويات كأنها انتصارات تخدم في الواقع أغراضاً انتهازية”. وثانيها، القبول بالتسوية السياسية “خلال الصراعات الرهيبة التي خيضت في الفترة الاستقلالية” التي اعتُبِرت بمثابة توقف مرحلي “في مسيرتنا الثورية”، وكان من المفروض، ضمنياً، استغلال التوقف لمعالجة التضخم الذي أصاب “الحركة الوطنية”، في محاولة لاستيعاب القطاعات الثورية الجديدة في صفوفها، ضمن استراتيجية شاملة. وثالثها، عدم تبيان واضح من “القوة الثورية الجديدة” لمعالم المجتمع الجديد “الذي نسعى لبنائه” في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في تعارض مع أهداف ومطامح “القوة الرجعية” التي استبدت بكل شيء.
هو التشخيص الذي يتوافق أيضاً مع الظرفية الجديدة التي أعقبت فترة الحماية والحصول على الاستقلال على واجهتَين مترابطتَين: المرحلة الانتقالية بما ظهر فيها وتَبَلورَ وتكَدَّر من توترات ومشاكل سياسية غِبَّ السنوات الأولى التي تلت زوال نظام الحماية. وَوَاجِهَة حقيقةِ النظام السياسي نفسه (الملكية بصورة خاصة) الذي لم يكن من المقدر له أن يستمر ويسود، رغم الشرعية التاريخية والدينية، إلا بفضل (المكون الوطني) الذي أبلى كثيراً، وغالباً بالحساب السياسي المتعلق بالمرحلة الوطنية، في الدفاع عنه في المشاورات التي سبقت الحصول على الاستقلال (إيكس ليبان، 1955). مع التأكيد هنا أنّ (الملكية) كانت قد تحولت، في هذه الفترة، إلى قوة رئيسية تقود النظام السياسي برمته، مثلما أصبحت الفاعل الأقوى تحكماً في الوضعية القائمة من خلال تنظيم الجيش، والسيطرة الشاملة على الثروة الاقتصادية، وبناء التحالفات القبلية والمدينية، والتأليف العضوي بين النخب الموالية والأعيان المتحالفين مع الملاكين الزراعيين الكبار الذين استفادوا، كما استفادت الدولة المركزية نفسها، من استرجاع أراضي المعمّرين الفرنسيين القدامى… إلخ.
وبمعنى ما، أعلن بن بركة في هذه الأجواء، اعتماداً على قراءة إيديولوجية فيها عناصر ثورية وقومية متبلورة، من خلال فكرتي التقدم والتحرّر، عن موقف علني حاسم أنهى به مختلف الترددات التي نضجت واعتملت على الصعيدين الشخصي والحزبي، فعبرت موضوعياً عن ظهور الفاعل الثوري في ساحة الصراع على السلطة عامة، وضد السلطة الحاكمة خاصة، اعتماداً، بطبيعة الحال، على اختيار أيديولوجي أعلن انحيازه للصف الاشتراكي، وبأسلوب منظم راهن، لأول مرة، على الكفاح المسلح لإحداث الانقلاب الثوري في الوضعية، وفتح الطريق، كما حدث في الجزائر تماماً، أمام اختيار جديد يلتقي، بحكم طبيعة المرحلة، مع اختيارات أخرى أصبحت تخطو حثيثاً نحو الصراع الشامل الذي “فجرته” الحرب الباردة بين القطبَين على الصعيد الدولي.
مشروع “الاختيار الثوري” تولّد عن مناخِ وتناقضات المرحلة التي تَهَيَّأَ فيها المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وَانْعَقَدَ (1962)
الموقف هذا، صريح وصارخ، حقق، بصورة لا رجعة فيها كما ظهر في وقته، تلك القطيعة المؤجلة مع النظام الملكي ومع بنية “المخزن”، معلناً بذلك حربه عليهما من خلال “الاختيار الثوري”، الصيغة الجديدة لتحرّر الشعوب وللتحالف الأممي (الأممية الثالثة بصورة خاصة) وكذا لمقاومة المد الإمبريالي حيثما توسّع واستقر أو تحالف وَتَجَبَّر. غير أن هذا الموقف أحدث من حوله مباشرة وضعيتَين متعارضتَين، أجْلاهُما أنَّ المهدي بن بركة تحول إلى زعيم ثوري “فوق وطني” يخوض في شؤون الصراعات الدولية وتحرّر شعوب “القارات الثلاث”. وأما الوضعية الثانية، وعلى الصعيد الداخلي، فقد جعل الحزب، الذي أنشأه إلى جانب ثلة من زعماء المد التقدمي في المرحلة الاستقلالية، يَرْسُفُ، وِفْقَ معادلة مضطربة، في وضعية سماها شهيد الحزب، عمر بن جلون، قبل اغتياله (1975) بـ”جدلية القمع والنضال”، وكان تعبيرها المباشر متجلياً في التناقض الفعلي المُؤثر بين العمل الديمقراطي الشرعي، وبين متطلبات الكفاح المسلح الساعي إلى إسقاط النظام، من خلال الثورة أو الانقلاب عليه، كما عبرت عنهما وثائق وممارسات “الاختيار الثوري”.
يمكن القول، مع ما فيه من مفارقات، إن اغتيال المهدي بن بركة كان بمثابة قتل لنوعَين من المعارضة: الراديكالية، أو الثورية، التي أصبحت خارج المجال الشرعي، وَتُدَار من الخارج (الجزائر، ليبيا، أوروبا…)، والأخرى “الإصلاحية” التي أصبحت تقاوم، بإجهاد سياسي كبير، بين تبرير الوضع القائم من حول الحزب، والنضال فيه بطبيعة الحال، في المجال الاجتماعي والسياسي للتغلب على مختلف الموانع والسياسات، والإحباطات كذلك، التي تتفاعل فيه بشتى الطرق والأساليب والمناورات، وبين نوع آخر محتشم من التبرير، لا يعبر عن أي نوع من أنواع القطيعة السياسية ولا الأيديولوجية مع النظام القائم، يمكن أن يصلح، عند الاقتضاء، أسلوباً من أساليب الضغط، أو المساومة، أو التلويح بالتهديد، أو ما شابه من المسوغات السياسية البعيدة عن الحسم المطلق والقريبة من البرغماتية في التصور والفهم.
أضِف إلى هذا أنّ اغتيال بن بركة جرى على مستويَين آخرين أيضاً: للتفكير الجمهوري المعارض، الذي ظهرت بوادره، ومناقشات خيضت حوله، منذ الانشقاق الذي أُعْلِنَ بصورة حاسمة عن حزب الاستقلال في 1959، وبصورة خاصة عندما أعلن المهدي بن بركة نفسه أن الاستقلال لم يكن إلا شكلياً، والملكية لم تكن إلّا قوة رجعية. ثم كان القتل، في المستوى الثاني، لفكرة “القارات الثلاث” التحريرية التي “خرجت” من مؤتمر باندونع (1955)، وتبلورت حول كوبا في ما بعد (1966) لمعارضة التجبر الإمبريالي وتزكية التحرر العام للشعوب في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
ولو تَحَقَّق بالحجة الدامغة، وهي مستحيلة، من خلال الكتاب الجديد، (قضية بن بركة، نهاية الأسرار، دراسة ووثائق، أكتوبر/تشرين الأول 2025)، لمؤلفيه، سطيفان سميث ورُونين برغمان، بالاعتماد على وثائق المخابرات الإسرائيلية، أن المجرم الحقيقي، نيابة عن باقي المجرمين المحترفين، هو الجنرال المغربي الدموي الذي أغرق رأس المهدي بن بركة في حوضِ ماءٍ حتى أزهق روحه، لوجب أن نتأكد بصورة نهائية، على أن الغاية الكبرى التي توخاها النظام الحاكم، منذ ذلك الوقت، هي القتل العمد لعملية التطور الديمقراطي التي كان بإمكان مغرب ناهض، قبل 60 سنة، أن يدشنها في سيره نحو المستقبل.
المصدر: العربي الجديد