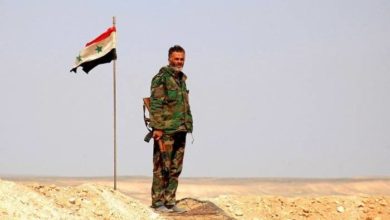“يمكن رَكن عربة الموت المتنقلة في شوارع حمص في المرآب بكل بساطة. لكن الذي يستطيع فعل ذلك، لا يريد”.
قرأت هذا الاقتباس في صفحة “محمد صالح” صديقي ورفيق سجن صيدنايا. سيبدو حكمه قاسيا للبعض، حسناً، لكنه قولٌ لرجل طالما دعا إلى تعزيز سلطة القانون. أما من حيث تاريخه الشخصي، فقد أمضى الرجل سنوات طويلة من حياته في معتقلات الأسد الأب وسجونه. وأكثر من ذلك، فقد اعتقل مراراً خلال الثورة، بتهمة دعم (الإرهابيين)، وقضى في السجون فترات متفاوتة، إلى أن سقط نظام الأسد، فانتهت جلساته المتكررة في محكمة “الإرهاب” المنحلّة، ونجا من اعتقال جديد.
أوردت ما سلف لمن لا يعرفونه، للقول إنه شخص طالما كان يرى الحقَّ بمعيار نزيهٍ وشفاف. ولكن لماذا يمكن أن تكون كتابته قاسية؟ لأن كثيرين سيعتبرونها كذلك، ولن يتفقوا معها، خصوصاً أولئك ممن يرون أن ما يحدث ليس سوى عمليات انتقام عمياء بسبب تأخر انطلاق مسار العدالة بعد سقوط الأسد. وأن هذا القتل المتنقل لا يعبر عن إرادة حكومية بقدر ما يظهر ضعف سطوة الدولة في بلد قيدَ التشكّل، وما زال يعجّ بالسلاح المنفلت. طبعاً ليس بواردي أن أتحدّث هنا عمن سيعترض على قوله لأسباب ثأرية أو طائفية.
قد يبدو هذا الانتقاد لقول الرجل وجيهاً من موقع المتفرج على ما يجري، لكن ليس من موقع من يتعرض لخطر القتل في الأحياء ذات الغالبية العلوية في حمص. خلال زيارتي الأخيرة، كنت ألحظ القلق في عموم المدينة. القلق من الغد الذي لم تتبيّن ملامحه بعد، من القلّة والغلاء والفوضى وانقطاعات الكهرباء والماء، لكن الغالب على هذا القلق في معظم الأحياء أنه ما زال ممزوجاً بفرحة الخلاص من نظام الأسد، حتى خُيِّل لي أن المدينة اختزنت من الفرح ما سوف يكفيها لسنوات تالية، أما في الأحياء التي كانت تحسب على النظام، فإن طبيعة القلق مختلفة تماماً. إنه قلقٌ وجوديّ.
لم تكن عبارات الصديق، كما قرأتُها، صوتاً شخصياً، لكنه تعبير عن شعور أعمّ لدى بعض الأهالي في المناطق العلويّة أو المختلطة طائفيّاً. شعور يكتنز الكثير من الإحساس بالخطر، ما يؤدي في معظم الحالات إلى الانكفاء على الحيّ أو الطائفة، مع اعتقاد سائد بأن الدولة أو المؤسسات الأمنية عاجزة أو غير راغبة في ضبط هذا النوع من الجرائم. مهما كانت الأسباب، فإن هذا الشعور غير مقبول في دولة يتحدث مسؤولوها يومياً عن العدالة والمساواة والقانون. حتى لو كانت بعض الجرائم التي تحدث ليست ذات بعد طائفي، وربما تأتي في سياق السرقة وفي حالات الخطف بدافع الابتزاز، يبقى جذر المشكلة هو ضعف سلطة القانون التي تبدو تمييزية في العديد من الحالات.
كل هذا ترك فراغاً مقلقاً في الثقة بالدولة، الأمر الذي سيشجع الناس، مستقبلاً، على تعبئة هذا الفراغ بأنفسهم، وربما اللجوء إلى وسائل حماية خاصة. وهذا وارد جداً، مع الميل للاعتقاد بأن “عربة الموت” تستهدف أحياء بذاتها، حتى لو لم يكن ما يحدث في تلك الأحياء ذا طابعٍ حصري، لكنه سيُبقي الطابع الأمني والاجتماعي فيها هشّاً وأكثر عرضةً للاهتزاز. فغياب الدولة هو الجزء الأهم في المشكلة. إن لم يكن هناك ضبط وتوقيف ومساءلة، فإن الفراغ الأمني سوف يولّد عقلية “الحماية الذاتية”، وهو ما سيزيد في إضعاف بناء الدولة.
في حيّ الزهراء، قال لي رجل ستينيّ “أخاف على أولادي، حين يخرجون مساءً. لا أعرف الخطر الذي يمكن أن ينتظرهم في الشارع، ولا أعرف لمن سوف أشتكي إن حصل شيء. يقولون إن الأمن مستتب، لكننا لا نراه”. بدا لي أن خوف الرجل كان حقيقياً. واللافت أن الإعلام الرسمي ومن في كنفه يعترف بالخطف، ويذكر اسم المخطوفـ/ة فقط لو تبين أنه لأسباب اجتماعية، أو أنه خطف وهمي أو جنائي. كذلك يعترف بحالات القتل المتنقلة عندما يكتشف أن القتل لأسباب جنائية وليس ثأرياً على أرضية طائفية. أما الحوادث التي يمكن أن تنطوي على بعد طائفي واضح، فتبدو كأنها من المسكوت عنها، وهذا بطبيعة الحال أمر مقلق، حين يبدو كما لو أنه منهجية إعلامية معتمدة. طبعاً هذا لا يعني أنني لا أرى أن هناك جهات تحاول تسييس هذا الملف والاستثمار فيه، ومنها من تستخدمه بطرق غير أخلاقية في عدائها للسلطات الجديدة، مما يساهم بإضاعة الحقيقة عبر إغراقها بالتلفيق.
أرى شخصياً، وأرجو أن أكون مخطئاً، أن الخطر الحقيقي هو أن تتعوّد المجتمعات على غياب الدولة، كما تعوّدت سابقاً على قسوتها وعسفها. وأن يصبح القتل جزءاً من المشهد اليومي، بينما تنشغل السلطة المحلية بمظاهر الاستقرار الشكلية.
أرى شخصياً، وأرجو أن أكون مخطئاً، أن الخطر الحقيقي هو أن تتعوّد المجتمعات على غياب الدولة، كما تعوّدت سابقاً على قسوتها وعسفها. وأن يصبح القتل جزءاً من المشهد اليومي، بينما تنشغل السلطة المحلية بمظاهر الاستقرار الشكلية. يبدو لي أن علينا البدء من البديهيات. أهم تلك البديهيات هي الإيمان بأن العدالة ليست انتقاماً، وأن الانتقام الشخصي ليس عدالة. هنا تماماً يجب أن تتركز الجهود الحكومية والمجتمعية، فتقدم نموذجاً يؤكد أنه بعد كل هذا الدم، ما زال الطريق يبدأ من كلمةٍ تأخرت كثيراً، “العدالة”. فمن دونها ستبقى عربات الموت تتجول، قد تتغيّر وجوه سائقيها، لكن يبقى الضحايا هم أنفسهم، مواطنون سوريون خائفون، في وطنٍ لم يقرّر بعد أن ينظر إلى نفسه ومشكلاته الحقيقية بتمعّن.
تُظهر تجارب دول عديدة أن السلام بلا عدالة لا يصنع استقراراً. في لبنان، دَفنَ العفو العام بعد الحرب الأهلية الجرائم من دون محاسبة، لكن ذاكرة الناس لا تُدفن، فظلّ الانتقام كامناً في الذاكرة، يعود كل حين بأشكال جديدة، أقلّها الإقصاء. وفي كولومبيا، استمرت عمليات القتل بعد اتفاق السلام، لأن العصابات الجديدة وجدت فراغاً أمنياً وفرصةً للانتقام، فالسلام على الورق لم يمنع عربات الموت من التجوّل في الريف الكولومبي.
هذان النموذجان يذكّراننا بأن العدالة ليست ترفاً لكنها ضرورة أمنية وسياسية. فحين لا يشعر الناس أن القانون يحميهم، يصبح السلاح والقوة الفردية بديلاً عنه، أو على الأقل خياراً وارداً. ما يجعلني أعتقد أننا في سوريا اليوم نختبر من جديد معنى الدولة. هل هي سلطة تملك السلاح فقط، أم عقدٌ أخلاقي يحمي الإنسان من الشعور بالخوف؟
الانتقام، حتى لو بدا للبعض مبرّراً بأسباب وجيهة، ربما يبرّد نار الثأر الشخصي، لكن لن يعيد الكرامة لا إلى الضحايا ولا إلى البلد بأسره، بل على العكس، سوف يسحب الكرامة من الجميع. وكذا المسامحة، كما أنها لا يمكن أن تُفرض، لكنها أيضاً لن تنمو في الفراغ من تلقاء نفسها، من دون جهود مدنية وحكومية وبمساعدة دولية لو اقتضى الأمر. فما يحتاجه السوريون اليوم ليس “نسياناً وطنياً”، بل شجاعة مواجهة الماضي، ومحاسبة الفاعلين، وردّ الحقوق للضحايا أياً كانت طائفتهم.
ذكرتها سابقاً مراراً، ولا بأس من إعادتها. بعد حالات النزاع، لا يمكن أن تثق الجماعات ببعضها بعضا من دون عدالة، ومن دون مصارحة، ومن دون شجاعةٍ في مواجهة ماضيها. الانتقام، حتى لو برّره البعض، لا يبني مجتمعاً. هو فقط يكرّر دورة المظلومية، ويُبقي الجميع أسرى ذاكرة الدم. لكن في المقابل، لا يمكن مطالبة الناس بمسامحة مجانيّة، ولا بنسيانٍ فوريّ يغلق الجرح قبل تطهيره. فلا يمكن أن نتحدث برومانسية عن تسامح من دون كشفٍ للحقيقة، كما لا يمكن الحديث عن الأمن من دون تطبيق عادل للقانون.
ما تحتاجه سوريا اليوم ليس فقط ضبط الأمن، بل الأهم هو استعادة المعنى الأخلاقي والحقيقي للأمن، بعد أن لوّثته حقبة الأسد. يجب أن يشعر المواطن، كل مواطن، أن كرامته مصونة، وأن العدالة والمحاسبة ليست ورقة مساومة، إنما حقّه الإنساني البديهي. من دون هذه الاستعادة، سيبقى كل سلاحٍ في الشارع مؤهلاً لأن يتحوّل إلى “عربة موت”، والأدهى أن كل صمتٍ رسمي سيتحول إلى موافقةٍ غير معلنة على استمرار الفوضى.
المصدر: تلفزيون سوريا