
“على الدولة وحدها أن تحتكر العنف والسلاح”. عبارةٌ يردّدها أغلب السوريين اليوم. قد تبدو هذه المقولة الشهيرة محقة نظرياً، بل ومُستلهمَة من الأدبيات الحقوقية، حيث من البديهي أن الدولة هي الكيان الوحيد المخوَّل باستخدام العنف. لكن في الظرف السوري الراهن، حتى البديهيات تحتاج للحوار.
مع بعض التبصّر، سنجد أن إيراد العبارة بطريقةٍ مجتزأة، دون فهم لبنية الدولة ومفهوم السلطة، ورقابة المجتمع والقضاء والقوانين، يجعلنا كمن يعطي تصريحاً لاستخدام العنف ضد الخصوم تحت عباءة الشرعية. لم ينسَ السوريون بعد، أن دولة الأسد احتكرت العنف لعقود، لكن على طريقتها. احتكرته بالكيماوي، والبراميل، وصواريخ سكود، بقتل المتظاهرين السلميين، واعتقال المعارضين، والإخفاء القسري. واليوم، حين يطالب مؤيدو الإدارة الجديدة بالاحتكار ذاته، فإن هذا المطلب، على وجاهته ظاهرياً، إنما تلزمه اشتراطات، أهمها أن يأتي في سياق ضمانات ديمقراطية ودستورية وقانونية.
ما يحدث عادةً في السياقات السلطوية غير المستقرة، هو محاولة تفريغ المفاهيم القانونية، وحتى الدستورية، من مضمونها بهدف إعادة تعبئتها في قوالب جديدة تناسب مقاس السلطة الجديدة.
طرح هذا الأمر اليوم في السياق السوري يبدو، حتى لو لم يُرد أصحابه، وكأنه يدلل على دعم غير مشروط للسلطة في احتكار ليس العنف وحسب بل كل شيء، كما توحي معظم المؤشرات في سوريا حتى الآن. فقد تحوّل هذا المفهوم، بعموميته، إلى غطاء للسيطرة على البلاد بكل تفاصيلها. الاقتصاد والموارد الشحيحة المتاحة، المؤسسات، والوظائف العامة. وقريباً، بعد تمام ابتلاع الدولة، ربما يصل إلى كل مفاصل المجتمع. كل ذلك يبدو للمراقب أنه يتمّ استقواءً بالرعاية الغربية والإقليمية، (هذه ليست شيكاً دائماً على بياض) دون التفاتٍ للداخل الوطني، ولا حتى اهتماماً كافياً بمستقبل البلد ومواطنيه.
بينما الطبيعي أن الدولة، حتى لو حظيت بالرعاية الدولية، فإنها لا تحتكر العنف لقمع المجتمع أو بعضه، بل لضبط الأمن ضمن القانون. أما التذرع والاطمئنان للشرعية الخارجية دون الالتفات للمحاسبة داخلياً، فهو ما سوف يدفع كثيرين للبحث عن سلطات موازية تحميهم. فشرعية احتكار العنف لا تُمنَح بمنطق الغلبة، ولا بتصفيق الموالين، بل تُنتَزع بثقة الناس. ثقةٌ لم تُبنَ حتى الآن، بل على العكس، يجري تبديدها كل يوم بفعل الصمت عن الانتهاكات المتكررة، واستمرار السير بمنطق الميليشيا التي تتزيّا بزيّ الدولة. وبديهيّ أن الأوطان لا تُبنى بالمراوغة، وأن الثقة لا تُستعاد بالبيانات الحكومية، بل بالأفعال المؤسسية الشجاعة.
ما يحدث عادةً في السياقات السلطوية غير المستقرة، هو محاولة تفريغ المفاهيم القانونية، وحتى الدستورية، من مضمونها بهدف إعادة تعبئتها في قوالب جديدة تناسب مقاس السلطة الجديدة. فتُستخدم فكرة “الشرعية” لتبرير التجاوزات والانتهاكات، ويُرفع شعار “الدولة” لتبرير احتكار المصالح من فئة بعينها لمفاصل تلك الدولة ومؤسساتها الاقتصادية الفاعلة. مع ذلك، يبدو الخطر الأكبر هنا في انزلاق المجتمع نفسه إلى هذا الفخ الكارثيّ، فنرى الجمهور يطالب بالانضباط بعيداً عن كل مستلزماتهِ وأهمها العدالة، ويتنازل عن حقه في مساءلة السلطة وانتقادها بدعوى الاستقرار، بل وتبدأ حملات لتقريع كل من يوجّه ولو انتقاداً بسيطاً. في مثل هذا المناخ، لا يكون الاحتكار أداةً لتنظيم العنف، بقدر ما هو محاولة لإخفاء أصله ومنابعه. فتتحوّل “الدولة” إلى قناعٍ لمصالح القوة والاقتصاد، بدل أن تكون تجسيداً لسيادة القانون.
كيف يمكن أن تتحول الدولة من كيان يثير الريبة والخوف، مثلما عاش السوريون في عهد الأسدين، إلى كيان يُعوَّل عليه في حماية الناس؟
في هذا المقام، وعلى ذكر المعارضة والموالاة، يبدو لي أن تربية الأسد لم تضِع معنا في الكثير من المناحي. كان الأسد الأب، ومن بعده الابن، يعتبرُ المعارضين خونة وعملاء ويستحقون الموت أو أقلّه السجن. اليوم، في الأوساط السورية الموالية والمعارضة، نُفجع يومياً بذات اللغة. فالمعارض الحالي يرى الموالي، بل وحتى من يرى الأمور بإنصاف وبعينين مفتوحتين، مجرد خائن لمبادئ الثورة. أما الموالين للسلطة الجديدة فلا يرون في المعارضين لها سوى خونة وعملاء دون أدنى شك، يستحقون الموت والسجن، حتى لو كان دافع هؤلاء المعارضين القلق على مستقبل البلد. الواقع أننا نحتاج لغة جديدة تقطع مع ثقافة “سوريا الأسد”. فالمعارض قد يكون بمثابة سفينة الإنقاذ، أو على الأقل البوصلة التي تصوِّب نحو الاتجاه الصحيح، في الكثير من الأحيان. بينما يمكن أن يكون الموالي، في العديد من الحالات، مصيباً وليس مجرد ذيل و”مُطبِّل” يؤيد السلطة بعماءٍ مطلق، كما يصفه المعارضون.
بالعودة إلى صلب الموضوع، فالدولة المحتكرة للسلاح بمعناها الحديث، ليست الحاكم، ولا الأجهزة الأمنية، ولا حزباً بعينه. الدولة هي منظومة مؤسسات تستمد شرعيتها من الناس، وتُحاسَب حين ينحرف من هم في مفاصلها. هي عقد اجتماعي، لا أداة لقهر المختلف، ولا وسيلة لإعطاء الضوء الأخضر للمحازبين والموالين لاقتناء السلاح، مع سحبه من المختلفين. بكلمة بسيطة، احتكار العنف ليس امتيازاً، بل تفويضٌ مشروط بتحقيق العدالة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، حيث لا تبدو القرارات الارتجالية معبّرةً عن سيادة الدولة، بل قناعاً يحاول تغطية عجزها.
مثلكم، أعلم أن كل ما سبق لا يجيب وحده عن سؤال السلاح والشرعية والمواطنة، بل يفتح الباب لطرح الأسئلة الأهم: كيف يمكن أن تتحول الدولة من كيان يثير الريبة والخوف، مثلما عاش السوريون في عهد الأسدين، إلى كيان يُعوَّل عليه في حماية الناس؟ وما الذي يجعل احتكارها للسلاح حقاً مشروعاً، لا تهديداً إضافياً؟ فيما سيأتي تالياً، من خلال التوقف عند بعض التجارب الدولية التي واجهت تحديات مماثلة، ومقارنة مساراتها بما يحدث اليوم في سوريا، قد نتلمَّس ملامح خطواتٍ ممكنة تتجاوز التنظير واللغة الإنشائية وتلامس الواقع على الأرض.
المصدر: تلفزيون سوريا







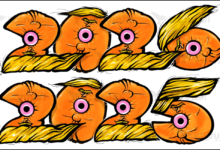
“على الدولة وحدها أن تحتكر العنف والسلاح” وأن تتحول الدولة من كيان يثير الريبة والخوف، مثلما عاشها السوريون في عهد الأسدين، إلى كيان يُعوَّل عليه في حماية الناس، الدولة هي منظومة مؤسسات تستمد شرعيتها من الناس، وتُحاسَب حين ينحرف من هم في مفاصلها. هي عقد اجتماعي، لا أداة لقهر المختلف .