
في هذا المقال، أود أن أتناول بإيجاز وتحليل هادئ إحدى القضايا التي أُسيء فهمها أو توظيفها أحياناً، وهي قضية “مصطلح كردستان”، التي عالجتها بشكل موسّع في كتابي “أكراد سورية: التاريخ – الديموغرافيا – السياسة”.
ليست الغاية من هذا المقال – كما لم يكن من غايات الكتاب الذي أتناول منه هذه المسألة- نفي الوجود الكردي في المشرق العربي، ولا التقليل من مطالب الأكراد الثقافية والسياسية، لكنّ مسؤوليتنا ككتّاب وباحثين تقتضي تفكيك المصطلحات المتداولة بعمق ومسؤولية، ومنها مصطلح “كردستان” بوصفه أداة خطابية مشبعة بالدلالات السياسية غير الدقيقة. الهدف هنا هو محاولة تفكيك هذا المصطلح من خلال منظور تاريخي وجغرافي دقيق، والتمييز بين الحق المشروع في الهوية، وبين التوظيف القومي المتعمد للمفردات لصياغة مشروع سياسي فوق واقعه الحقيقي.
من تسمية إثنية إلى خطاب قومي
مصطلح “كردستان” مركب من كلمتين: “كرد” (الكرد) و”ستان” (وتعني بالأعجمية الأرض أو البلد)، ويقابلها “بلاد الأكراد”. ولكن ظهوره التاريخي الأول كان في آواخر العهد السلجوقي، في ولاية إدارية في أذربيجان الحالية حملت هذا الاسم، ولم تكن دولة قومية كردية، بل منطقة قبلية مختلطة خاضعة للحكم الإسلامي.
مصطلح “كردستان” مركب من كلمتين: “كرد” (الكرد) و”ستان” (وتعني بالأعجمية الأرض أو البلد)، ويقابلها “بلاد الأكراد”. ولكن ظهوره التاريخي الأول كان في آواخر العهد السلجوقي، في ولاية إدارية في أذربيجان الحالية حملت هذا الاسم، ولم تكن دولة قومية كردية، بل منطقة قبلية مختلطة خاضعة للحكم الإسلامي.
ومنذ ذلك الحين، استخدم المصطلح في الوثائق الإدارية بوصفه توصيفاً جغرافياً مرناً، وليس اسماً لكيان سياسي قائم. بل إنّ جيمس بوريس، الباحث المتخصص في التاريخ الكردي، فضّل استخدام تعبير “الأراضي القبلية للأكراد” (The Kurdish tribal lands)) بدلاً من “كردستان”، لأنه أكثر دقة في وصف واقع قبائل رحّل غير مستقرة، لا تملك كياناً سياسياً موحداً.
أما الأنثروبولوجي الأميركي إفرايم سبايزر فيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حين يؤكد أن “الكرد لا يُشكلون مجموعة إثنية واحدة، بل هم مزيج من عناصر فارسية وسامية وآرية”، وبالتالي فإن أي خطاب قومي يدّعي وجود هوية موحدة تمتد عبر خرائط “كردستان الكبرى” هو إعادة تصنيع لهوية قومية لم تكن قائمة فعليًا في أي لحظة تاريخية.
جدل الباحثين حول غياب كيان سياسي موحّد
يُشكك أرشاك بولاديان في أصل المصطلح ويرى أن “كردستان” تسمية لاحقة، وليست مستندة إلى جذور تاريخية قوية، بل جاء استخدامها في فترات متأخرة وتحت تأثير أيديولوجي.
المؤرخ الأميركي هنري فيلد يشير إلى أن الكرد لم يشكّلوا وحدة سياسية أو ديموغرافية متجانسة، وأن “الأكراد عاشوا ضمن كيانات متعددة، ولم يعرفوا كياناً موحداً يحمل اسم كردستان عبر التاريخ.” ويؤكد أن استخدام مصطلح “كردستان” لا يعكس الواقع السكاني، بل هو توصيف قبلي-جغرافي.
الباحث المعاصر محمود الدرة يرى صراحة أن الأكراد لم يخلقوا عبر التاريخ كياناً سياسياً يحمل اسم كردستان، وأنّ كل ما يُنسب لهذا الاسم هو إسقاط رجعي في ضوء الطموح القومي الحديث.
المصطلح في زمن الدولة العثمانية
خلال العهد العثماني، ورد اسم “كردستان” في بعض الوثائق الإدارية، لكنه كان يتقلص ويتوسع تبعاً للتنظيمات الإدارية لا للهوية القومية. أحياناً أُطلق على ناحية، وأحياناً على قرية، أو حتى على جبل بعينه، من دون أن يكون هناك تحديد ثابت أو خريطة متفق عليها.
ويُقرّ الباحثون أن الأكراد أنفسهم لم يتفقوا يوماً على حدود واضحة لكردستان، ولهذا يعمد القوميون إلى تجاوز البعد الجغرافي لصالح تصور عاطفي يقوم على “الخرائط المتخيلة”
الوظيفة السياسية للمصطلح في العصر الحديث
مع بروز النزعة القومية في القرن العشرين، لا سيما بعد معاهدة سيفر 1920، بدأ مصطلح “كردستان” يُستخدم بشكل موسّع ضمن خطاب يستند إلى خرائط متخيلة لا واقعية. إذ لم يُرسم هذا المصطلح اعتماداً على التوزيع الديموغرافي، بل انطلاقاً من الطموحات القومية التوسعية.
بحسب الكاتب باسيل نيكيتين، فإن الأقاليم التي حملت اسم “كردستان” – سواء في تركيا أو إيران – لا تطابق واقع توزّع الأكراد، بل تمثل تنميطاً لا يُعتمد عليه في تحديد المجال الحيوي للكرد. ويدعو نيكيتين للرجوع إلى الجغرافيا الطبيعية لا الخيال السياسي.
ويصل إلى نتيجة نهائية بأن: “كردستان المرسومة في الأدبيات القومية الكردية لا تمثل الواقع الإثني، بل خريطة تخيلية مبنية على شعور قومي، لا على معطى جغرافي أو ديموغرافي.”
كذلك يمكن الإشارة إلى ما طرحه عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، الذي دعا في أدبياته الأخيرة إلى التخلي عن فكرة الدولة الكردية لصالح “الأمة الديمقراطية”، أي كيان لا مركزي متجاوز لحدود الدول الوطنية.
لكن هذا المفهوم ليس بديلاً بريئاً عن الدولة القومية، بل غلاف مرن لمشروع هيمنة كردية ناعمة تحت عنوان “الإدارة الذاتية”، التي حاول تطبيقها في شمال شرقي سوريا. وهنا لا تغيب عبارة أوجلان الشهيرة: “كردستان هي أكثر من وطن… إنها الحياة ذاتها” – بما يُشير إلى تحول المصطلح من دلالة إقليمية إلى أسطورة سياسية مفتوحة بلا جغرافيا دقيقة.
ضرورة إعادة تأطير المصطلح: بين الإنصاف والتوظيف
إن نقد استخدام مصطلح “كردستان” في سياق سياسي حديث لا يعني تجاهل المعاناة التاريخية للأكراد، ولا نفي الواقع الذي دفعهم إلى التمسك برموز قومية جامعة.
فمنذ سقوط الدولة العثمانية، وتوقيع معاهدة سيفر عام 1920، بدا أن هناك اعترافاً دولياً محتملاً بحق الأكراد في حكم ذاتي وربما حتى في إقامة كيان سياسي. لكن هذه الوعود ما لبثت أن تبخرت بعد معاهدة لوزان 1923، التي أنكرت الوجود القومي الكردي بالكامل، في الوقت الذي جرى فيه الاعتراف بدول قومية لليونانيين، والأرمن، والعرب، والأتراك.
وفي هذه اللحظة المفصلية، وجد الأكراد أنفسهم موزعين على أربع (تركيا، وإيران، والعراق، وسوريا)، محرومين من أي تمثيل سياسي جامع، وتعرضوا في بعض المراحل لسياسات قمع وتعريب وتتريك وتفريس، وهو ما خلق جرحاً نفسياً وجماعياً لا يمكن التغافل عنه.
وبالتالي، فإن تبني مصطلح “كردستان” كرمز قومي جامع منذ بدايات القرن العشرين، لم يكن فقط تعبيراً أيديولوجياً، بل أيضاً محاولة نفسية لاستعادة كيان تم إنكاره في الهندسة الجيوسياسية لما بعد الحرب العالمية الأولى.
لكن، وكما أشرت في هذه المقالة، فإن تحويل هذا المصطلح إلى أداة سياسية قائمة على الخرائط المتخيلة وإلغاء الآخر، يمثل مخاطرة على التعدد والتعايش، ويُفضي في النهاية إلى خطاب إقصائي يتناقض مع الواقع المركّب لتاريخ المنطقة.
الحل ليس في الإلغاء، ولا في الإملاء، بل في الاعتراف المتبادل بعضنا ببعض في هذا الفضاء الجامع، واستيعاب أن الواقع لا يتحمل ظهور خرائط سياسية عاطفية جديدة، كذلك يجب السعي إلى المساواة في حقوق الأفراد ضمن دولة عادلة جامعة ولاؤها للدولة الوطنية، لا تحتكرها قومية أو عشيرة أو طائفة ولا تُقهر فيها أخرى.
المصدر: تلفزيون سوريا



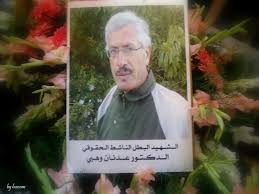




قراءة موضوعية دقيقة للموقف السياسي الدولي من وجود دولة كردية، منذ سقوط الدولة العثمانية، وتوقيع معاهدة سيفر عام 1923 المعدلة، تبخر إحتمالية الدولة الكردية، لأنها أنكرت الوجود القومي الكردي بالكامل، مع الاعتراف بدول قومية لليونانيين، والأرمن، والعرب، والأتراك، كردستان أي “بلاد الأكراد” لم تنوجد إلا بالعهد السلجوقي وليست على أساس أثني.