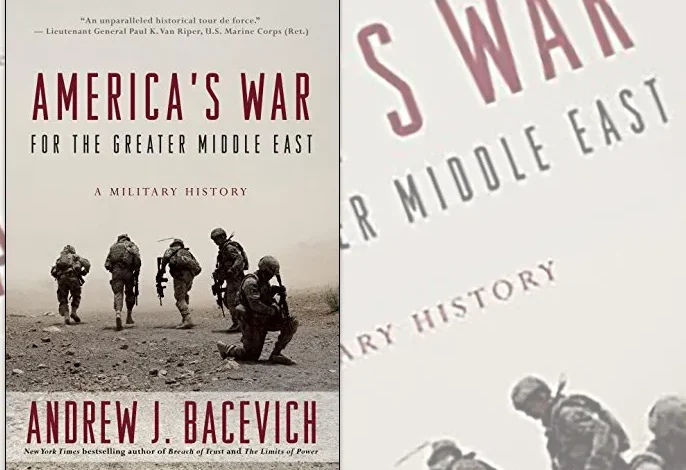
لعل إحدى الطرق لفهم حمام الدم المستمر في الصراع الجاري بين إسرائيل وحماس هي النظر إليه على أنه الفصل الأخير فقط في صراع وجودي يعود تاريخه إلى تأسيس الدولة اليهودية في العام 1948. وفي حين أن النطاق المروع للقتال في غزة وحجم التدمير الذي يخلفه ومدته ربما يفوق الفصول السابقة، إلا أن هذا التحول الأخير يخدم بشكل رئيسي في إعادة التأكيد على الاستعصاء الذي لا يُصدَّق لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
على الرغم من أن شكل هذه الحرب تغير بمرور الوقت، إلا أن ثوابت معينة تظل قائمة. وعلى سبيل المثال، لا يبدو أي من الجانبين قادرًا على تحقيق أهدافه السياسية النهائية من خلال العنف. ويرفض كل جانب بشدة الرضوخ للمطالب الأساسية لخصمه. وفي الحقيقة، في حين أن القتال الفعلي ربما يمر بحالات مد وجزر، ويتوقف ويُستأنف، فقد أصبحت الأرض المقدسة موقعا لما هو فعليا صراع دائم.
لعقود عدة، سعت الولايات المتحدة إلى البقاء على مسافة من تلك الحرب من خلال تقديم نفسها في دور الحكم الإقليمي. وبينما ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تزود إسرائيل بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي، فإنها سعت في الوقت نفسه إلى عرض الولايات المتحدة على أنها “وسيط نزيه”، ملتزم بتعزيز القضية الكبرى المتمثلة في جلب السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط. وبطبيعة الحال، كانت جرعة سخية من المصلحة الذاتية ترشد دائما “عملية السلام” التي أشرفت عليها.
ومع ذلك، أخرجت اللحظة الحالية القطَّ تماما من الحقيبة. فقد ردت إدارة بايدن على الهجوم العنيف الذي شُن في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بتأييد الجهود الإسرائيلية للقضاء على حركة “حماس” ودعمها بشكل لا لبس فيه، بينما يتعرّض سكان غزة لحملة قصف شرسة على غرار حملات الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، تجاهل المستوطنون الإسرائيليون احتجاجات إدارة بايدن الفاترة، وهم يواصلون طرد الفلسطينيين من أجزاء من الضفة الغربية حيث عاشوا لأجيال. وإذا كان الهجوم الذي نفذته “حماس” في تشرين الأول (أكتوبر) مأساة، فقد رآى فيه مؤيدو “إسرائيل الكبرى” أيضًا فرصة فريدة انتهزوها بحماس. أما “عملية السلام” التي كانت تعيش مُسبقا على أجهزة دعم الحياة، فيبدو أنها ماتت الآن جملة وتفصيلا. وتبدو احتمالات إحيائها في أي وقت قريب بعيدة.
في الكواليس يجلب القتال هذا التأثير الإضافي -أكثر أو أقل: بينما تستخدم “قوات الدفاع الإسرائيلية” الأسلحة والذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة لتحويل غزة إلى أنقاض، فقدَ “النظام الدولي القائم على القواعد” الذي وصفته إدارة بايدن بأنه أحدث مبدأ تنظيمي لفن الحكم الأميركي، أيَّ مصداقية طفيفة ربما تكون قد تبقت له. ويبدو الهجوم الروسي على أوكرانيا مقتصِدًا وإنسانيا بالمقارنة.
وكما لو كان ذلك للتأكيد على ولاء واشنطن المحدود لهذا النظام القائم على القواعد، ركز رد الرئيس بايدن الفوري على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) على العمل العسكري من جانب واحد، وتعزيز وجود القوات البحرية والجوية الأميركية في الشرق الأوسط، مع إهالة المزيد من الأسلحة على إسرائيل. والقوات الأميركية في المنطقة، المكلفة ظاهريا بالتأكد من الحيلولة دون أي انتشار إضافي للعنف، أصبحت بدلاً من ذلك تتجه بثبات نحو أن تصبح قوة مقاتلة كاملة.
في الأسابيع الأخيرة، تعرضت القوات الأميركية لعشرات الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا، والتي شُنت بشكل أساسي بالصواريخ والطائرات المسلحة من دون طيار. ونسبت الولايات المتحدة تلك الهجمات إلى “الجماعات التابعة لإيران”، وردت بضربات جوية استهدفت المستودعات ومرافق التدريب ومراكز القيادة الخاصة بها في سورية والعراق.
وفقا لمتحدث باسم البنتاغون، فإن الغرض العام من العمل العسكري الأميركي في المنطقة هو “توجيه رسالة قوية جدا إلى إيران والجماعات التابعة لها للتوقف”. وحتى الآن، كان تأثير هذه الرسائل غامضًا في أحسن الأحوال. ومن المؤكد أن الجهود الانتقامية الأميركية لم تتمكن من ثني إيران عن مواصلة حربها بالوكالة ضد المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة. ومن ناحية أخرى، ما يزال حجم تلك الهجمات المدعومة من إيران متواضعًا. ومن الملاحظ أن أي جندي أميركي لم يُقتل -بعد.
في الوقت الحالي على الأقل، قد تكون هذه الحقيقة هي التعريف العملي الذي تضعه الإدارة للنجاح. طالما لم تظهر توابيت ملفوفة بالعلم الأميركي في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير، قد يجد جو بايدن أنه من المقبول تمامًا جعل الاحتكاكات الفرعية بين الولايات المتحدة وإيران من الحرب بين إسرائيل و”حماس” تغلي على موقد هادئ إلى أجل غير مسمى.
حظي هذا النمط من العنف المتبادل المتناسب والمنخفض باهتمام عام متقطع في أحسن الأحوال. أما إلى أين سيفضي (إذا كان سيفضي إلى أي مكان) فما يزال غير مؤكد. ومع ذلك، تبقى الولايات المتحدة معرَّضة لخطر فتح جبهة جديدة فعليا في ما كانت تسمى “الحرب العالمية على الإرهاب”. وكانت هذه الحرب حتى الآن نائمة تقريبًا، أو على الأقل مخفية عن المشهد العام. ويمكن أن يؤدي الاحتمال الحقيقي جدا لأن يسيء أي من الجانبين تفسير “رسائل” الطرف الآخر أو تجاهلها عمدًا، إلى إشعالها من جديد، ونشوب حرب موسعة تضع الولايات المتحدة مباشرة ضد إيران على نحو يجعل الحرب بين إسرائيل وغزة تبدو وكأنها مجرد شجار تافه بالمقارنة.
ثم هناك التداعيات المحلية المحتملة. لا شك في أن المستشارين السياسيين للرئيس بايدن على دراية بإمكانية نشوب حرب كبرى تؤثر على نتيجة انتخابات العام 2024 (وليس بالضرورة لصالح شاغل المنصب الحالي). ويمكن للمرء أن يتخيل بسهولة أن يستغل دونالد ترامب حتى ولو حفنة من القتلى العسكريين الأميركيين في مناوشات الشرق الأوسط ليعرضها كدليل قاطع على عدم الكفاءة الرئاسية، على غرار الانسحاب الفاشل من كابول، أفغانستان، خلال السنة الأولى لوجود بايدن في المنصب.
حربان تتقاربان
يتطلب فهم الآثار الأكبر المترتبة على هذه التطورات وضعها في سياق أوسع. في غزة في الشهرين الماضيين، تقارب أخيرًا صراعان كبيران مطوَّلان كانا يتكشفان على مسارين متوازيين لعقود. ومن المرجح أن تكون لذلك آثار عميقة على سياسة الأمن القومي الأميركية الأساسية، حتى لو بدا أن قلة في واشنطن تدرك التداعيات المحتملة.
على المسار الأول الذي يعود تاريخه إلى العام 1948 (على الرغم من أن التمهيد له كان قد بدأ قبل عقود)، ثمة الصراع العربي الإسرائيلي. وبينما يُنظر إلى أحداث العام 1948 في أوساط الإسرائيليين على أنها “حرب الاستقلال” فإن العرب ينظرون إليها على أنها “النكبة”. وقد تلا ذلك الحدث اندلاع أعمال عنف لاحقة من وقت لآخر، حيث صبّت الدول العربية غضبها على الدولة اليهودية وسعت إسرائيل وراء الفرص لخلق كيان أكثر تماسكًا من الناحية الاستراتيجية وأكثر قابلية للحياة اقتصاديا، ناهيك عن محاولة تحقيق “إسرائيل الكبرى” التي تحدث عنها الكتاب المقدس.
بمرور الوقت، سمح المسؤولون الأميركيون الذين كانوا عاكفين على الابتعاد عن الصراع العربي الإسرائيلي -بل وإدانة السلوك الإسرائيلي أحيانًا- لأنفسهم بأن ينجذبوا تدريجيا ليصبحوا أقرب حليف لإسرائيل. ومع ذلك، بموجب شروط العلاقة أثناء تطورها، أصر القادة الإسرائيليون على الاحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال الاستراتيجي. على سبيل المثال، على الرغم من اعتراضات واشنطن الصاخبة، حازت إسرائيل ترسانة نووية قوية. ولضمان أمنهم، ركز الإسرائيليون بشكل أساسي على قدراتهم العسكرية الخاصة، وليس على قدرات الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، وعلى المسار الآخر الذي يعود تاريخه إلى إصدار “مبدأ كارتر”** الذي وضعه الرئيس جيمي كارتر في العام 1980، أبقت القوات الأميركية أيديها منشغلة في منطقة الشرق الأوسط. وبينما كانت إسرائيل تُفاقم أو تصد التهديدات الموجهة إلى أمنها، تعهدت الإدارات الأميركية المتعاقبة بسلسلة من الالتزامات العسكرية الجديدة والتدخلات والاحتلالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الكبير، والتي كان لها القليل من الصلة، أو لم تكن لها صلة تذكر، بحماية إسرائيل.
في الخليج الفارسي وبلاد الشام والقرن الأفريقي والبلقان وآسيا الوسطى، تعامل البنتاغون مع مشاكل خاصة به حيث أصبحت تلك المناطق أماكن لاستضافة القوات الأميركية المشاركة في عمليات تهدف إلى الحماية، أو العقاب، أو حتى “التحرير”. وأصبحت مثل هذه الجهود العسكرية ووجود القوات الأميركية شأنًا شائعًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط -باستثناء إسرائيل. في أعقاب هجمات 9/11، وصلت أعمال واشنطن العسكرية إلى ذروتها عندما شرع الرئيس جورج دبليو بوش في حملة عالمية بهدف القضاء على ما أسماه الشر.
وفي الأثناء، حققت الاشتباكات المختلفة التي انخرطت فيها القوات الإسرائيلية منذ خمسينيات القرن العشرين إلى القرن الحالي نتائج مختلطة. فمن ناحية، ما تزال الدولة اليهودية قائمة، بل وتوسعت -في تعريف مبسط لـ”النجاح”. ومن ناحية أخرى، تؤكد الأحداث الأخيرة أن التهديدات لوجود إسرائيل ما تزال قائمة أيضًا.
وبالمقارنة، أثبتت “الحرب العالمية على الإرهاب” التي تقودها الولايات المتحدة كونها فشلاً ذريعًا، حتى لو بدا عدد قليل من الأميركيين العاديين (وحتى عدد أقل من أعضاء المؤسسة السياسية) مستعدّين للاعتراف بهذه الحقيقة.
بمجرد انهيار النظام المدعوم من الولايات المتحدة في كابول في العام 2021، ظهر أن المغامرات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط الكبير قد تكون في طور التلاشي. ويبدو أن النتيجة المهينة لعملية “الحرية الدائمة” في أفغانستان في أعقاب النتيجة المخيبة للآمال لعملية “حرية العراق” قد استنفدت شهية واشنطن لإعادة تشكيل المنطقة. وإلى جانب ذلك، كانت هناك روسيا لتعتني بالمنطقة -والصين. وبدا أن الأولويات الاستراتيجية آخذة في التغير.
أجراس إنذار على الطريقة الأميركية
مع ذلك، الآن في أعقاب الأعمال التي ارتكبت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وإذعان واشنطن الضمني للأهداف القصوى التي وضعتها إسرائيل للحرب، اكتسبت الفكرة المشكوك فيها والقائلة إن المصالح الأميركية الحيوية ما تزال على المحك في الشرق الأوسط الكبير حياة جديدة. وكانت واشنطن، منذ ثمانينيات القرن العشرين، قد طرحت مجموعة متنوعة من الحجج عن سبب استحقاق هذا الجزء من العالم لإنفاق الدم والمال الأميركيين: تهديد العدوان السوفياتي؛ واعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي؛ والدكتاتوريون العرب المتطرفون؛ والجهادية الإسلامية؛ ووقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدٍ معادية؛ والتطهير العرقي المحتمل والإبادة الجماعية. وتم الدفع بكلِّ واحدة من هذه الحجج إلى الخدمة من وقت لآخر لتبرير الاستمرار في التعامل مع الشرق الأوسط كأولوية استراتيجية للولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، لم يصمد أي منها في الحقيقة أمام اختبار الزمن. وثبت أن كل واحدة منها كانت مضلِّلة. وأظهر الواقع أن الجهود المبذولة لعلاج مصادر الاختلال الوظيفي التي ابتليت بها المنطقة هي في الحقيقة “مهمة أحمق” كلفت الولايات المتحدة غاليًا في المال والأرواح في حين لم تجلب سوى القليل من القيمة.
ولهذا السبب، فإن السماح لصراع إسرائيل مع “حماس” بجر الولايات المتحدة إلى حملة صليبية جديدة في الشرق الأوسط سيكون ذروة الحماقة. ومع ذلك، مع قلة الاهتمام العام، بل وحتى القليل من إشراف الكونغرس نفسه، سيكون هذا بالضبط ما قد يحدث في الواقع. وتبدو “الحرب العالمية على الإرهاب” على وشك امتصاص حرب غزة إلى شكلها وترتيباتها الحالية.
في السنوات الأخيرة، أدى التحول في أولويات البنتاغون إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإلى مواجهة مستقبلية محتملة مع الصين إلى ترك حوالي 2.500 جندي أميركي فقط في العراق، و900 آخرين في سورية. والمهمة الاسمية لهذه الحاميات متواضعة الحجم هي مواصلة القتال ضد فلول “داعش”.
ومع ذلك، لم يبذل مسؤولو البيت الأبيض جهدًا للخروج وشرح ما تفعله تلك القوات حقا هناك. في الممارسة العملية، أصبحت فعليا أهدافًا ثابتة جذابة. ونتيجة لذلك، وليس للمرة الأولى، برزت “حماية القوات” كذريعة ملائمة لإطلاق رد عقابي أوسع نطاقًا.
مع قبول الكونغرس للادعاءات بأن “التفويض باستخدام القوة العسكرية” الذي تم إقرارُه ردا على هجمات 9/11 يكفي لتغطية أي قوات أميركية في المنطقة لمدة قد تصل إلى 22 عامًا بعد ذلك، فإن لدى إدارة بايدن، من الناحية العملياتية، حرية التصرف كما يحلو لها. وكان المسار الذي اختارته هو استخدام حرب إسرائيل في غزة كأساس منطقي لعكس المسار في الشرق الأوسط وجعل العنف والتهديد بالعنف مرة أخرى أساس سياسة الولايات المتحدة هناك. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تدُق حقيقة أن بعض القوات الأميركية تعمل الآن سرا في إسرائيل في حد ذاتها أجراس الإنذار.
سوف تغير حرب غزة إسرائيل بطرق قد يكون من الصعب التنبؤ بها. سوف يترك فشل مؤسساتها العسكرية والاستخباراتية المتبجحة في توقع وإحباط أسوأ هجوم في تاريخ ذلك البلد اليهود الإسرائيليين مع شعور غير مسبوق بالهشاشة. ولن يكون مفاجئًا إذا تطلعوا إلى واشنطن من أجل الحماية، وفي هذه الحالة يمكن أن يصبح بقاء إسرائيل مسؤولية أميركية.
وهذه دعوة ستُحسن الولايات المتحدة صنعًا إذا رفضتها. وسوف يضع قبولها الأميركيين في مواجهة تحديات ليسوا مجهزين لمواجهتها والتزامات لا يمكنهم تحملها. ولن يؤدي تعميق انخراط البنتاغون في “الشرق الأوسط الكبير” سوى إلى تفاقم الإخفاقات التي أخضعت “عقيدة كارتر” هذه الأمة لها فعليا، بينما تتدافع الأولويات الاستراتيجية الأميركية المتلاطمة بطرق من المؤكد أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية.
في العام 1796، حذر جورج واشنطن مواطنيه من مخاطر السماح “للارتباط العاطفي” بأمة أخرى بالتأثير على السياسة. وما يزال هذا التحذير صالحا اليوم. إن حرب غزة ليست -ولا ينبغي أن تصبح- حرب أميركا.
*أندرو باسيفيتش Andrew Bacevich: مؤلف كتاب “حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير: تاريخ عسكري” America’s War for the Greater Middle East: A Military History، الذي صدر مؤخرا عن “راندوم هاوس”.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Here We Go Again: America’s War for the Greater Middle East (Cont.)
هامش:
** عقيدة كارتر، أو “مبدأ كارتر” Carter Doctrine: هي سياسة أميركية أعلنها الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، خلال خطاب “حالة الاتحاد” السنوي في 23 كانون الثاني (يناير) 1980. وتنص هذه العقيدة على السماح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي. وجاء هذا المبدأ ردا على غزو الاتحاد السوفياتي لأفغانستان في العام 1979، حيث قال كارتر إن القوات السوفياتية في أفغانستان “تشكل تهديدا خطيرا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط”.
المصدر: الغد الأردنية/(كاونتربنش)







