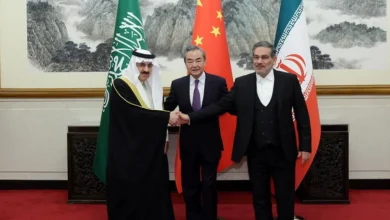استغلّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منبر الأمم المتحدة لترويج رؤيته عمّا أسماه الشرق الأوسط الجديد، حيث عرض خريطة جديدة تلغي وجود فلسطين، وتتّسع فيها الدولة الصهيونية لتشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولأن هذه الرؤية تتعاكس مع الشرعية الدولية التي يتحدّث الرجل من على منبرها، فقد ألقى خطابه على قاعة شبه فارغة، إذ استقبل ممثلو الدول خطابه بمغادرة القاعة. وفي رأي هذا الشخص، الذي يقود حكومة مستوطنين، يقود التطبيع مع السعودية إلى واقع جديد، تمثّله تلك الخريطة، وهو ما يقود إلى التفسير بأنه أراد استغلال هذه المناسبة (الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة)، كي يعبّر عن رؤيته التفاوضية مع الرياض، فالسلام مع العاصمة العربية والإسلامية الأهم إنما يعني، بالنسبة له، الجولة الأخيرة من الحرب الصهيونية على الوجود الفلسطيني أرضاً وشعباً وكياناً، فيما يواصل المسؤولون السعوديون الإعراب عن أن مبادرة السلام السعودية – العربية لعام 2002 هي مرجعية السلام، وأن حل الصراع الفلسطيني يستند وجوباً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، بعاصمتها في القدس الشرقية، وهو ما عبّر عنه، أخيراً السفير السعودي لدى دولة فلسطين، نايف السديري، الذي قدّم أوراق اعتماده، قبل أيام، للرئيس محمود عبّاس، معلناً بالمناسبة أن الرياض سوف تفتتح قنصلية لها في القدس، من دون أن يحدّد موعداً لذلك، وإن من المفهوم أن الأمر مرتبط بوصول المفاوضات أو المباحثات مع الجانبين، الأميركي والإسرائيلي، إلى الخاتمة المأمولة والمطلوبة.
وأمام تباعد الشقّة بين الموقفين، السعودي والإسرائيلي، بخصوص الشأن الفلسطيني، سوف تتولّى واشنطن، عرّابة مشروع التطبيع، مهمة شاقة لتذليل العقبات وردم الفجوات الواسعة، وذلك إلى جانب التباحث بالمطالب السعودية من الجانب الأميركي. ويكمن الخلاف الجوهري في تباعد الرؤى حتى بين الرياض وواشنطن، إذ ترغب الرياض في رفع مستوى العلاقة مع واشنطن إلى مستوى الشريك الاستراتيجي الذي يتمتع بمزايا الشراكة بدون العضوية في حلف شمال الأطلسي، فيما استندت الرؤية القاصرة لإدارة الرئيس جو بايدن إلى أن إقامة العلاقات بين الرياض وتل أبيب تتيح تحسين القدرات الدفاعية السعودية أمام التحدّي الإيراني، وهي الرؤية التي تستند إليها حكومة نتنياهو التي ترغب في مجرّد تطبيع ثنائي وسريع في العلاقات، بمعزل عن الحاجة الموضوعية والضاغطة لإرساء سلام أوسع، يشمل، بالضرورة وفي المقام الأول، حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وهذا ما يمليه الموقع القيادي للرياض في العالمين، العربي والإسلامي، كما تقتضيه الحاجة إلى معالجة أسباب الصراع التاريخي ونتائجه.
على هامش زيارته نيويورك، لم يتوان نتنياهو عن إطلاق تصريحاتٍ تتماشى مع خريطته، إذ انبرى الرجل لتخطئة السعودية على عدم انضمامها إلى الاتفاقات الإبراهيمية، رغم أن الرياض لم تعارض تلك الاتفاقيات ولم تؤيدها، غير أن غاية الرجل هي التأشير على ما يرغبه من اتفاقياتٍ تقتصر على علاقات ثنائية، تقفز عن مجمل الصراع العربي الإسرائيلي، وما يتصل به من قراراتٍ دولية. وسبق لوزير الخارجية السعودي، فرحان بن فيصل، أن صرّح بأن بلاده لن تنهج النهج الإبراهيمي، وأنها تعمل من أجل سلام يضمن الحقوق الفلسطينية، حقوق الضحية الكبرى للصراع.
وبينما يركز الجانب الإسرائيلي، هذه الأيام، على خطواتٍ من قبيل السماح لوزير السياحة الإسرائيلي بالمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة في الرياض، تصمت حكومة نتنياهو صمت القبور بشأن تمسّك الرياض بمبادرة السلام العربية، فيما يتبرّع ناطقون باسم تلك الحكومة، ومنهم المحرّر الدبلوماسي، شلومو غانور، بالتصريح بأن الحكومة ليست في وارد تقديم “تنازلات” للجانب الفلسطيني، وإن أقصى ما يمكن أن يقدّمه نتنياهو هو الوعد بعدم ضم الضفة الغربية، وإلى فترة تمتد حتى خمس سنوات مقبلة، وهو الوعد الذي سبق تقديمه لدى توقيع الاتفاقات الإبراهيمية، من دون أن يمنع هذا الوعد الأجوف من تسريع عملية الضمّ الفعلي.
من المثير للاستغراب أن وكالات أنباء عالمية بارزة، منها رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة أسوشييتد برس، تتحدّث في تقاريرها عن تنازلاتٍ قد يشترطها الجانب السعودي على الحكومة الإسرائيلية للدفع بعملية التطبيع، والمقصود وضع حد للاحتلال الاستيطاني والعسكري للأراضي الفلسطينية. وباستخدامها تعبير تنازلات، تملّك هذه الوكالات الأراضي المحتلة لغير أصحابها، لنتنياهو ورهطه، ذلك أن الأمر لا يتعلق أبداً بتنازلات، وإلا لجرى اعتبار تخلّي لص عن مسروقاتٍ استولى عليها بالسطو المسلح بأنه بمنزلة تنازلٍ منه، وهو ما لا ترتضيه أية عدالة، لأنه يجافي الإدراك السليم وطبيعة الأشياء ومنطق الأمور. وجعبة الأمم المتحدة حافلة بالقرارات التي تدعو الدولة القائمة على الاحتلال إلى التراجع عن السيطرة على الأراضي المحتلة، وكذلك الحال مع وكالات المنظمة الدولية. وبهذا الصدد، مَن سوف يتنازل حقاً لدى قيام دولة فلسطينية على أراضي عام 1967 هو الجانب الفلسطيني، وذلك بـ “التخلّي” عن 78% من أرض فلسطين الانتدابية، وعن أراض تتبع الدولة الفلسطينية في قرار التقسيم لعام 1947.
المطلوب من نتنياهو، ومن المؤسسة الإسرائيلية، التراجع عما جرى السطو عليه في حرب عام 1967، وليس التنازل عن شيء. إنكار وجود شعب فلسطين على أرضه، وتعداده سبعة ملايين نسمة، هو من قبيل العماء الأخلاقي والعنصرية البغيضة. وتتسهل حياة الفلسطينيين بوضع حدّ للاحتلال، ونيلهم الاستقلال على جزء من أرضهم التاريخية، متمتّعين بالحرية والكرامة، وهذا ما يقتضيه أي سلام يستحقّ أن يُنعت بأنه سلام. وقد واكبت المملكة الكارثة الفلسطينية، والكفاح من أجل الحرية والتحرّر عقوداً طويلة، وكانت لها إسهاماتها الكبيرة والمقدّرة في رفد هذا الكفاح المشروع بكل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والمالي. وأن تقف المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة، فهذا يقتضي، حُكماً ووجوباً، وبين أمور أخرى، تفعيل مبادرة السلام العربية المستندة إلى الشرعية الدولية، وطي صفحة العسف والقهر والاستحواذ غير المشروع التي ميزت الاحتلال الإسرائيلي منذ 56 عاماً، دونما تناسي الاستيلاء على فلسطين التاريخية منذ 1948 على أيدي عصابات مهاجرين وافدين من وراء البحار، وبدعم مُشينٍ من الانتداب البريطاني.
المصدر: العربي الجديد